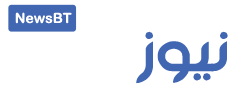ثورة 36-39 في فلسطين
خلفيات و تفاصيل و تحليل
غسان كنفاني
النقاط الثلاث
بين 1936-1939 تلقت الحركة الثورية الفلسطينية ضربة ساحقة في النقاط الثلاث التي تبلورت منذ ذاك بصفتها المعضلة الأساسية التي يواجهها شعب فلسطين: القيادات المرجعية المحلية، والأنظمة العربية المحيطة بفلسطين، والحلف الإمبريالي-الصهيوني، وسوف يترك هذا “العدو” المثلث بصماته على تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية منذ 1936 بصورة أوضح مما كانت في أي وقت مضى، وحتى الهزيمة الثالثة التي تلحق الجماهير الفلسطينية والعربية في 1967. وستحاول هذه الدراسة أن تركز بصورة خاصة على هذه النقاط الثلاث وعلى الجدلية المتضمنة في كل منها على حدة والقائمة فيما بينها جميعاً.
إن عنف التجربة الوطنية الفلسطينية التي تفجرت منذ 1918 وكانت تترافق بصورة أو بأخرى مع الكفاح المسلح، لم تستطع أن تعكس نفسها على البنية الفوقية للحركة الوطنية، التي ظلت تحت هيمنة القيادات شبه الإقطاعية- شبه الدينية، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى سببين متداخلين: أ- وجود وفاعلية الحركة الصهيونية التي ضاعفت من ثقل وهيمنة التحدي القومي على جميع أشكال التحديات الأخرى، وعكس هذا التحدي نفسه على الطبقات الكادحة العربية التي كانت تعاني من الغزو الصهيوني المدعوم من الإمبريالية البريطانية معاناة يومية مباشرة. ب- وجود حد من التناقض بين القيادات العائلية الإقطاعية الدينية العربية وبين الإمبريالية البريطانية، يجعل دفع الثورة إلى مدى معين من مصلحة هذه الطبقات التي تجد عادة مصلحتها في ظروف مغايرة مختلفة عن الاستثناء الفلسطيني الخاص بالتحالف شبه الكامل مع الإمبريالية. وقد نشأ ذلك الحد غير العادي من التناقض عن وجود “عميل ملائم أكثر” للإمبريالية البريطانية هو الحركة الصهيونية، جرى توظيفه بدل تلك الطبقات.
إن هاتين المسألتين المتشابكتين قد جعلتا لنضال شعب فلسطين خصوصية لم تكن في ذلك الحين تشبه تلك الخصائص التي كانت لنضالات الشعوب العربية المحيطة بفلسطين، وقد أدت هذه الخصوصية إلى نتائج خطيرة، منها مثلاً اندفاع هذا النوع من القيادات الإقطاعية إلى ممارسة أو قبول ممارسة أرقى أشكال النضال السياسي (الكفاح المسلح)، ومنها إصرار هذه القيادات _ من حيث الشكل على الأقل _ على رفع الشعارات التقدمية، وكونها _ رغم كل ما فعلت _ مثلت مرحلة من النضال الوطني الفلسطيني. على أن ما هو أكثر أهمية هو تفسير تلك الاستطالة غير العادية التي عاشتها القيادات الإقطاعية الدينية على رأس حركة الجماهير (من 1918-1948)، ذلك أن التحول في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي في فلسطين، والذي كان يحدث بسرعة مذهلة، كان يصيب بالدرجة الأولى القطاع اليهودي على حساب البورجوازية الفلسطينية المتوسطة والصغيرة وخصوصاً على حساب الطبقة العاملة العربية، إن تحول الاقتصاد من إقطاعي إلى رأسمالي كان يجري بتمركز متزايد في يد الحركة الصهيونية وبالتالي في يد المجتمع اليهودي في فلسطين.
وقد نتج عن ذلك ظاهرة لافتة للنظر: فأصوات المهادنة العربية التي أخذت تظهر منذ الثلاثينات وأوائل الأربعينات لم تكن أصوات أسياد الأرض والفلاحين المتوسطين بصورة عامة، ولكنها كانت أصوات كبار بورجوازيي المدن العرب الذين كانوا مجرد وسطاء للإمبريالية والذين بدأت مصالحهم تتسلق المصالح المتسعة للبورجوازية اليهودية الآخذة في شق طرق التصنيع، خالقة في الوقت ذاته وكلاءها.
في غضون ذلك كانت البلاد العربية المحيطة بفلسطين تلعب دورين متعاكسين، ففي حين كانت حركة الجماهير العربية تدفع النفس الثوري للجماهير الفلسطينية وتبني مع حركتها علاقة جدلية متبادلة التأثير، كانت الأنظمة المهيمنة في هذه البلدان تبذل كل ما في وسعها لكبح حركة الجماهير الفلسطينية وإجهاضها. إن هذه الظاهرة مهمة للغاية ذلك أن طبيعة التناقضات المركبة والحادة التي كانت تعيشها الساحة الفلسطينية كان من شأنها أن تطور بصورة متسارعة أشكال النضال التي كانت تعرفها الساحات العربية الأخرى وترتقي بها إلى أشكال أكثر عنفاً، وكان ذلك يشكل درجة أعلى من الاحتمالات الثورية في البلاد العربية لم يكن بمقدور الطبقات الحاكمة آنذاك أن لا تكترث به اكتراثاً شديداً، وكان هذا الواقع يدفعها دائماً إلى الوقوف إلى جانب الإمبريالية البريطانية ضد شركائها الطبقيين الذين كانوا يقودون الحركة الوطنية الفلسطينية. ومن جهة أخرى كان الحلف الصهيوني الإمبريالي يزداد متانة، وقد تبلورت في تلك الفترة بالذات (1936-1939) ليس فقط الطبيعة العسكرية العدوانية لمجتمع الغزو الذي أرست الصهيونية جذوره في المجتمع اليهودي بفلسطين، ولكن أيضاً الهيمنة شبه الكاملة على الهيكل التحتي للاقتصاد الفلسطيني الذي سيكون له فيما بعد تأثيرات جذرية على الصراع القائم. ففي تلك الفترة قضت الصهيونية متحالفة مع الانتداب على كل آمال نشوء أو تطور حركة عمالية يهودية تقدمية، وكذلك على آمال أخوة بروليتارية عربية يهودية، فقد شجب صوت الحزب الشيوعي الفلسطيني على طرفي الصدام، وهيمن الهستدروت الرجعي كلياً على الحركة العمالية اليهودية (التي كانت أصلاً مؤهلة للسقوط في شراكه) فيما أخذ النفوذ الذي كان آخذاً بالتصاعد بالنسبة للقوى التقدمية العربية في جمعيات العمال العرب في حيفا ويافا بالتراجع، مفسحاً المجال لهيمنة القيادات الرجعية التي كانت تحتكر العمل السياسي آنذاك.
الخلفيات:
العمال
لم تكن الهجرة اليهودية إلى فلسطين، والإشكالات المنبثقة عنها، مسألة أخلاقية أو مسألة قومية صرف، بل كانت لها انعكاسات اقتصادية مباشرة ذات تأثير يومي متعاظم، ملموس بوضوح شديد، على الشعب العربي في فلسطين، وخصوصاً على صغار الفلاحين والفلاحين المتوسطين والعمال وقطاعات من البرجوازية الصغيرة والوسطى.
إن الانعكاسات الاقتصادية للهجرة اليهودية كانت حادة في حد ذاتها، ولكنها تضاعفت أيضاً بسبب النتائج القومية والدينية التي حملتها معها بالطبيعة. فبين عام 1933 و 1935 هاجر 150 ألف يهودي إلى فلسطين، وأصبح عدد اليهود في فلسطين 443.000 نسمة يمثلون 29.6 بالمائة من عدد السكان الإجمالي. وإذا أخذنا جانباً آخر من هذه الأرقام، كي ندرك معناها إدراكاً حقيقياً، فإنه ينبغي لنا أن نلاحظ بأنه بينما كان المعدل السنوي لعدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين بين عامي 1926- 1932 يبلغ 7201 يهودي في العام، أصبح هذا المعدل بين عامي 1933 – 1936 يبلغ 42.985 يهودياً في العام(1). إن العسف الهتلري هو الذي أدى إلى تصاعد الهجرة اليهودية في تلك الأعوام على وجه التحديد: في 1932 دخل فلسطين 9 آلاف يهودي ألماني وفي 1933دخلها30 ألف يهودي ألماني، وفي 1934 دخلها 40 ألفاً، وفي 1935 دخلها 61 ألفاً(2)، اتجه حوالي ثلاثة أرباعهم إلى المدن.
وإذا كانت الهتلرية هي المسؤولة عن إرهاب اليهود الألمان ودفعهم إلى الهرب، فإن الرأسمالية “الديمقراطية” هي التي كانت مسؤولة، جنباً إلى جنب مع الصهيونية، في توجيه جزء كبير نسبياً من هذه الهجرة إلى فلسطين، ونستطيع التحقق من ذلك من خلال الأرقام التالية: فالولايات المتحدة رفضت أن تقبل في بلادها، من أصل 2.562.000 يهودي هربوا من الاضطهاد النازي بين عامي 1935 و 1943 سوى 170 ألفاً (أي 6.6 بالمئة) وبريطانيا 50 ألفاً (أي 1.9 بالمئة) وتعين على فلسطين أن تستوعب 8.5 بالمئة، بينما وجد 1.930.000 من اليهود الألمان (أي 75.3 بالمئة ) ملجأ في الاتحاد السوفيتي(3). أن الهزة الاقتصادية التي تعنيها أرقام الهجرة اليهودية بالنسبة للمجتمع العربي في فلسطين، يمكن تبينها من خلال معرفة أن نسبة الرأسماليين اليهود من مجموع المهاجرين في عام 1933 كانت 11 بالمئة أي 3250 رأسمالياً يهوداً، و12 بالمئة في 1934 أي 5124 رأسمالياً و10 بالمئة في 1935 أي 6309 رأسماليين(4).
بين عامي 1932و1936 دخل فلسطين حسب الإحصاءات الرسمية 1380 يهودياً يملكون أكثر من ألف ليرة فلسطينية و17119 يهودياً يعتمدون عليهم، يقابلهم حوالي 130الف يهودي وصفوا رسمياً بأنهم قادمون للاستخدام أو معتمدون على هؤلاء القادمين أو على مهاجرين سبقوهم(5). إن ذلك يعني، بكلمات أخرى، أن الهجرة كانت، في الوقت الذي تحرص فيه على تأمين تمركز رأسمالي يهودي في فلسطين يهيمن على عملية تحول الاقتصاد “الفلسطيني” من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد صناعي، فإنها كانت تحرص أيضاً على تزويد هذا التحول ببروليتاريا يهودية، وكان لهذا السلوك، الذي أعطى نفسه شعار “اليد العاملة اليهودية فقط” نتائج خطيرة، إذ أنه ساق بسرعة لا مثيل لها نحو بروز الفاشية في مجتمع المستوطنين اليهود.
لقد نشأ عن ذلك، بالبداهة، تناقض تناحري بين البروليتاريا اليهودية والبروليتاريا العربية، وكذلك بين الفلاحين والمزارعين والعمال الزراعيين اليهود، ولكن هذا الصدام كان يرتفع أيضا إلى الطبقات الأعلى، إذ أن ملاكي الأرض المتوسطين والبرجوازية المدينية الوسطى العربية كانت تشعر بأن الرأسمال اليهودي آخذ في الهيمنة على مصالحها. ففي عام 1935 مثلاً كان اليهود يسيطرون على 872 مؤسسة صناعية في فلسطين من أصل 1212، يستخدمون فيها 13.678 أجيراً فيما كانت المؤسسات الصناعية العربية الـ340 تستخدم حوالي 4000 أجير فقط، وكان اليهود يوظفون في مؤسساتهم 4 ملايين و 391 ألف جنيه فلسطيني مقابل 704 آلاف جنيه يوظفها العرب، وينتجون بما قيمته 6 ملايين جنيه تقريباً مقابل مليون و545 ألف جنيه تنتجها المؤسسات العربية، وبالإضافة لذلك كان اليهود يسيطرون على 90 بالمئة من الامتيازات التي تمنحها حكومة الانتداب والتي تبلغ توظيفاتها 5ملايين و789 ألف جنيه وتستخدم 2619 أجيراً(6).
إن المعدل العام، للنسبة المئوية في زيادة أجور العمال اليهود على العمال العرب، حسب إحصاء رسمي جرى في أيلول 1937 قد بلغ 145بالمئة وفي بعض الأعمال كانت تبلغ 433بالمئة (بين النساء العربيات واليهوديات العاملات في النسيج) و233 بالمئة (الفرق بالأجور بين العاملات العربيات والعاملات اليهوديات في فرز التبغ) و84 بالمئة (بين العمال العرب والعمال اليهود في تنضيد الحروف) ..الخ(7). “إن الأجور الحقيقية للعامل العربي هبطت في أيلول 1937عشرة بالمئة بالمقابلة مع أجور1931 بينما ارتفعت الأجور الحقيقية للعامل اليهودي عشرة بالمئة”(8).
هذه الانعكاسات الاقتصادية لحركة الهجرة اليهودية أضحت أكثر خطورة حين بدا واضحاً أن الانتداب البريطاني قد سهل للرأسمال اليهودي ومكن له من السيطرة على الهيكل التحتي للاقتصاد الفلسطيني، بحيث بدا المستقبل-أيضاً-دون آمال تذكر(مشاريع الطرق، معادن البحر الميت، الكهرباء، الموانئ ..الخ). لقد أدت هذه الحقائق إلى انهيار شبه كلي في الاقتصاد العربي في فلسطين وتحمل العمال العرب العبء الأوفر منه، ويقول جورج منصور سكرتير جمعية العمال العرب في يافا، في شهادته أمام لجنة بيل الملكية أن 98 بالمئة من العمال العرب يعيشون “في حالة هي دون الوسط بكثير”. ويقول أنه بناء على إحصاء تناول ألف عامل في يافا عام 1936تبين لجمعية العمال العرب أن 57 بالمئة من العمال العرب يبلغ دخلهم أقل من 2.750جنيه (المعدل الوسطي للحد الأدنى الذي تحتاجه العائلة 11 جنيهاً) وهناك 24 بالمئة دخلهم أقل من 4.250 جنيهات و12 بالمئة أقل من 6 جنيهات و4 بالمئة أقل من 10 جنيهات و1.5بالمئة أقل من 12 جنيهاً و0.5 بالمئة أقل من 15 جنيهاً(9).
وقد رفضت الحكومة البريطانية إعطاء إذن لتظاهرة قرر القيام بها ألف عامل عاطل عن العمل في يافا في 6/12/1935، وقالت مذكرة جمعية العمال العرب للحكومة أنه إذا لم تقم هذه الأخيرة بحل المشكلة “فإن الأيام المقبلة ستضطرها إلى إطعام العمال خبزاً أو رصاصاً”(10).كانت الثورة، عند ذاك، على الأبواب.
أن جورج منصور (الذي كان شيوعياً في السابق ويبدو أنه في ذلك الحين ترك الحزب نتيجة خفوت دوره) يقدم للجنة بيل أمثلة حسية مذهلة: فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في يافا في أواخر 1935، 2270 عاملاً وعاملة، وهذا رقم كبير في مدينة كان عدد سكانها آنذاك 71 ألفاً(11). ويعدد منصور خمسة أسباب لهذه البطالة أربعة منها تتعلق بالهجرة اليهودية أساساً: 1-الهجرة 2-نزوح الفلاحين للمدن 3-طرد العمال العرب من الأعمال 4-سوء الحالة الاقتصادية 5-تحيز الحكومة الشنيع للعمال اليهود(12). وعلينا أن نلاحظ أنه في غضون ذلك زاد عمال الهستدروت في 9شهور فقط 41 ألف عامل، ويثبت ذلك مقال الأدون فروكمن في العدد 3460 من جريدة دافار، فقد جاء فيه أن عدد عمال الهستدروت بلغ في أواخر أيلول 1936: 150 ألف عامل بينما يقول تقرير الحكومة الرسمي لـ 1935 (ص117) أن عددهم كان في أواخر سنة 1935 فقط 74ألفاً(13).
كان ذلك يؤدي ليس فقط إلى طرد العمال العرب من المؤسسات أو المشاريع التي يهيمن عليها الرأسمالي اليهودي بل إلى صدامات دامية: ففي 4مستعمرات يهودية فقط, هي ملبس وديران ووادي حنين والخضيرة كان يعمل 6214عاملاً عربياً في شباط 1935 وبعد 6 أشهر فقط نقص العدد إلى 2276وبعد حوالي عام نزل إلى 677عاملاً عربياً فقط(14).
وقد وقعت تعديات دامية على العرب, منها إرغام الحاميات اليهودية لمقاول عربي وعماله على الانسحاب من عملهم في عمارة الأدون بروتنسكي في حيفا بالقوة عام 1934, كان الطرد يتناول عمال البيارات ومعامل السجاير والمحاجر وأعمال البناء ومعامل الكلس وغيرها(15). ومن 1930إلى1935 هبطت قيمة صادرات صناعة الأصداف العربية من 11.532 جنيهاً إلى 3.777 جنيهاًًًًً وتناقصت معامل الصابون العربية من 12معملاً في يافا وحدها عام 1929إلى 4 في 1935, وبينما كانت هذه المعامل تصدر في 1930ما قيمته 206.259 جنيهاً تدنت القيمة في 1935 إلى 79.311جنيهاً(16). إن أفضل وصف لهذه الحالة هو أن البروليتاريا العربية كانت “ضحية الاستعمار البريطاني والرأسمالية اليهودية ,وعلى الأول تقع المسؤولية “(17).ويضيف “يهودا بوير” إلى ذلك كله(18) أن فلسطين “كانت عشية الاضطرابات (1936) البلد الوحيد في العالم, فيما عدا الاتحاد السوفياتي, التي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية (العالمية)، وعلى العكس فقد تمتعت بازدهار حقيقي نتيجة استيراد رأسمال مالي بلغ أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني بين 1932-1936، بيد أن هذا الرأسمال لم يكن كافياً ليغطي كل برامج الاستثمار التي بدأت بتفاؤل مبالغ فيه”. إلا أن هذا الازدهار الذي كان قائماً على أسس هشة تهاوى فجأة حين توقف تدفق الرأسمال الخاص نتيجة التخوف من انفجار الحرب في المتوسط “وقد تقوض نظام التسليف وظهرت علامات البطالة بصورة جدية وتناقصت أعمال البناء كثيراً. طرد العمال العرب من أماكن عملهم اليهودية أو العربية ليعودوا، على الأقل جزئياً، إلى قراهم .. ووجدت مطرقة الدعاية القومية في الأزمة الاقتصادية سندانها”(19). إن كلام بوير، بالطبع، يحذف العامل الأهم وهو الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتصاعدها. فإذا تذكرنا قول الخبير السير جون هوب سمبسون في تقريره، ص117 “إنها سياسة سيئة وربما خطرة أن ترصد أموال كبيرة في صناعات غير متحققة الفائدة في فلسطين لتبرير زيادة عدد المهاجرين” فإن كلام بوبر السابق يبدو دون سند منطقي: إذ أن تدفق الرأسمال اليهودي – عكس ما يقول – ظل في تصاعد خلال السنوات التي يتحدث عنها، والواقع أنه بلغ ذروته في 1935.وكذلك بالنسبة لعدد المهاجرين الذي تصاعد في هذه السنوات وارتفعت رؤوس الأموال اليهودية المستثمرة في الصناعات والحرف اليهودية من 5.371.000 ج.ف في 1933 إلى 11.637.300 ج.ف في 1936(المصدر ص313)، كما أن عمليات طرد العمال العرب من الأعمال اليهودية قد بدأ قبل ذلك بكثير(20). وكانت قوافل من الفلاحين العرب، في هذه الأثناء، تطرد وتقتلع من أراضيها وتتدفق إلى المدن نتيجة الاستعمار الصهيوني في الأرياف(21). يقول إسرائيليون يساريون: إن تجربة 50عاماً لا تحتوي على مثال واحد يشير إلى تعبئة العمال الإسرائيليين حول قضايا مادية أو اتحادات عمال لتحدي النظام الإسرائيلي نفسه، من المستحيل تعبئة حتى البروليتاريا بهذه الطريقة”(22).
والواقع أن هذا الوضع لم يكن نشوءاً عشوائياً غير محسوب، نتج عن خطأ غير متوقع في مخطط دقيق، بل على العكس تماماً. فالحركة الصهيونية منذ البدء كانت على وعي لما سيحدث: “إن الأراضي الخاصة في المناطق الممنوحة لنا يجب أن نستولي عليها من أيدي المالكين، ويجب إجلاء الفقراء من السكان بهدوء خارج الحدود وذلك عن طريق توفير أعمال لهم في البلاد التي يرحلون إليها، ولكننا نحرم عليهم أي عمل في بلادنا، أما أصحاب الأملاك فسينضمون إلينا.”(23).
إن الهستدروت يضع هذه الحقيقة بصورة واضحة: “إن السماح للعرب بالتغلغل في سوق اليد العاملة اليهودية يعني أن يستخدم ضخ الرأسمال اليهودي لمصلحة التطور العربي ضد الأهداف الصهيونية، وبالإضافة لذلك فإن توظيف العمال العرب في الصناعة اليهودية سيؤدي إلى تقسيم طبقي في فلسطين يتبع الخطوط العرقية: اليهود كرأسماليين يستخدمون العرب كعمال، وبذلك نعيد في فلسطين الأسس غير الطبيعية التي أدت إلى ظهور اللاسامية في التيه”(24). إن هذا التطابق الأيديولوجي والواقعي على عملية الغزو الاستيطاني قد استولد، مع تصاعد التناقض مع المجتمع العربي، أشكالاً فاشية من التنظيمات الصهيونية، واستخدمت الفاشية الصهيونية هذه أساليب الفاشية الصاعدة آنذاك في أوروبا.
وكان العامل العربي، في هذه الصورة, تحت قاع ذلك الهرم الثقيل الشديد التعقيد. وازداد الوضع سوءاً نتيجة ارتباك الحركة النقابية العربية الناشئة. والواقع أنه في الفترة الممتدة بين أوائل العشرينات وأوائل الثلاثينيات تلقت الحركة العمالية اليسارية، في الجانب العربي وفي الجانب اليهودي على حد سواء، ضربات ساحقة جعلتها بالإضافة للأسباب الذاتية حركة كسيحة. فمن جهة كانت الحركة الصهيونية التي شرعت تتجه بسرعة نحو الفاشية والإرهاب المسلح تشكل تهديداً معنوياً ومادياً للحزب الشيوعي الذي كان معظم زعمائه من اليهود، والذي لم يكن يهضم بأي شكل من الأشكال آنذاك، داخل الحركة الصهيونية الممثلة بأحزابها “العمالية”، من الجهة الأخرى كانت القيادة الإقطاعية الدينية الفلسطينية لا تتحمل بدورها نشوء حركة نقابية عربية خارج هيمنتها (ولم يكن ممكناً لحركة نقابية عمالية حقيقية أن تنشأ وتنمو فعلاً إلا خارج هيمنتها). وهكذا تعرضت هذه الحركة الوليدة(*) إلى إرهاب القيادات الإقطاعية: ففي أوائل الثلاثينات اغتالت جماعة المفتي ميشيل متري رئيس جمعية العمال العرب في يافا، وبعد ذلك بحوالي عشر سنوات اغتيل بالطريقة نفسها النقابي سامي طه رئيس جمعية العمال العرب في حيفا. لقد كانت العلاقة السياسية بين العمال العرب وبين القيادات الإقطاعية، بسبب غياب قوة بورجوازية لها نفوذ سياسي واقتصادي في البلاد، ذات طبيعة تناحرية لا يمكن التقليل من حدتها إلا عندما تتحقق للقيادات الإقطاعية-الدينية السيطرة على العمل النقابي، ولكن إذا حدث ذلك فإن العمل النقابي يفقد جوهر دوره النضالي، ومع ذلك فإن مساحة معينة من القضية المشتركة كان يمكن العثور عليها دائماً، نتيجة لاحتدام النضال القومي.
إن دور الحزب الشيوعي هنا مهم للغاية، وفي مطلع العشرينات كان يمكن العثور على بوارق من أمل لم يكن من الممكن آنذاك الاعتقاد بأنها بوارق مزيفة، مثلاً: تظاهرة شيوعية من نحو 55 شخصاً صباح أول آيار 1921 في تل أبيب تصطدم بتظاهرة صهيونية، وقد أرغم الشيوعيون على الهرب من تل أبيب، فألجأهم حي المنشية العربي في يافا، واصطدم الجميع بالبوليس البريطاني حين جاء ليقبض على البولشفيك(25). وفي بيان جرى توزيعه في اليوم نفسه، قالت “اللجنة التنفيذية للحزب الشيوعي الفلسطيني”: “يعيش معكم العمال اليهود، الذين لم يأتوا لاضطهادكم بل كي يعيشوا معكم، وهم مستعدون للجهاد بجانبكم ضد هؤلاء الأعداء الماليين من اليهود والعرب والإنكليز … وإذا كان أصحاب الأموال يدفعونكم ضد العمال اليهود حتى يأمنوا من تعديكم عليهم، فهل تبقون على خطأكم هذا؟ إن هذا العامل اليهودي، جندي الثورة، جاء يمد يده إلى أيديكم كزميل لكم لمقاومة الماليين الإنكليز واليهود والعرب … نناديكم للجهاد ضد الأغنياء الذين يبيعون البلاد وأهاليها للأجانب، فلتسقط الحراب الإنكليزية والفرنسية وليسقط أصحاب الثروات العرب والأجانب …”(26). إن المدهش في هذا البيان الطويل ليس فقط ذلك التحليل التجريدي، الخيالي، لحالة الصراع ولكن أيضاً خلوه كلياً من كلمة “صهيوني” : الخطر الذي كان يحسه العامل والفلاح العربيان إحساساً يومياً، والذي ربما أحسه، صبيحة اليوم ذاته الذي وزع فيه ذلك المنشور، 55 شيوعياً “يهودياً” ضربهم الصهاينة في تل أبيب، وطردوهم نحو يافا.
سيظل الحزب الشيوعي الفلسطيني واقفاً على هذا البعد من أرض الواقع حتى 1930 حين انعقد مؤتمره السابع آخر ذلك العام، واعترف في مقرراته أنه “اعتمد موقفاً أساسياً خاطئاً في المسألة القومية الفلسطينية أي في مسألة دور الأقلية القومية اليهودية في فلسطين إزاء الجماهير العربية، ونتيجة لذلك لم يقم الحزب بنشاط عملي بين الجماهير العربية، وظل قطاعاً انعزالياً يعمل بين العمال اليهود وحدهم، وهذه العزلة انعكست في موقف الحزب أثناء الثورة العربية عام 1929، حين انقطع الحزب عن حركة الجماهير” (27).
وبالرغم من أن الحزب يكيل الاتهامات للبورجوازية الفلسطينية التي كانت آنذاك في وضع حرج، وبالرغم من أنه يتجه نحو نبذ تكتيكات الجبهات الشعبية والتحالفات بين طبقات الثورة فإن وثائق المؤتمر السابع للحزب الشيوعي الفلسطيني 1930-1931 هي من أثمن وأدق التحليلات في تاريخ هذا الحزب، ففيها يكرس الحزب أولوية حل قضية العرب القومية كواجب من أهم واجبات الكفاح الثوري، وفيها يعترف بأن الانقطاع عن حركة الجماهير كان “نتيجة انحراف صهيوني أعاق تعريب الحزب”. وتشكو الوثائق من “مساع انتهازية … لتجميد تعريب الحزب”. إن المؤتمر السابع يقر هذه الحقيقة البديهية الرئيسية: على الحزب أن يزيد كوادر القوى الثورية القادرة على توجيه نشاط الفلاحين في الطريق الصحيح، أي كوادر العمال العرب الثوريين، ولذا فان تعريب الحزب، أي تحويله إلى الحزب الحقيقي للجماهير الكادحة العربية، هو الشرط الأول والأساسي”لعمل ناجح في الأرياف”(28).ولكن الحزب لم يستطع قط أن ينجز مهام التعريب، ولذلك ظلت الشعارات الثورية الصحيحة التي أقرها المؤتمر بريقاً نظرياً لا أكثر: “لا دونم واحد للغاضبين الإمبرياليين والصهيونيين”، “الاستيلاء الثوري على الأرض العائدة للحكومات والمستعمرين اليهود الأغنياء والطوائف الصهيونية وكبار الملاكين والمزارعين العرب”، “عدم الاعتراف بالاتفاقات المتصلة ببيع الأرض”، “النضال ضد الغاضبين الصهيونيين”. ويقرر المؤتمر: “أن حل المسائل الملتهبة كافة، والتصفية الحقيقية للاضطهاد ممكن فقط بثورة مسلحة تحت قيادة الطبقة العاملة”(29). “ممكن فقط” كانت هذه هي العبارة المهمة.
إن الحزب الشيوعي الفلسطيني لم ينجز مهمة التعريب، وهكذا تهاوى بنيان المخطط برمته، وظل الميدان مفتوحا ً أمام هيمنة القيادات الإقطاعية–الدينية.
إن أسباب ذلك عديدة، ولكن ربما يكون أهمها هو أن هذا الخط في الحزب الشيوعي كان انعكاساً للموقف المتصلب والثوري الذي اشتهر عن الكومنترن في فترة 1928-1934. ورغم صغر عددهم، وعزلهم، وعدم نجاحهم الكامل في تعريب الحزب، وفشلهم في الوصول إلى الريف، فقد ألقى الشيوعيون بكل ثقلهم في معركة 1936، وأخذوا مواقف شجاعة وتعاونوا مع بعض القادة المحليين، وأيدوا المفتي، وخسروا كثيراً من الشهداء والمعتقلين، ولكنهم لم يفلحوا في أن يكونوا قوة مؤثرة. ويبدو أن شعار التعريب ضاع في مكان ما بعد ذلك، إذ تجرؤ الازفستيا في 22/1/1946( أي بعد حوالي عشر سنوات ) على تشبيه “نضال اليهود” في فلسطين بالنضال البلشفي قبل ثورة 1917.
مهما يكن فإن مقررات المؤتمر السابع للحزب الشيوعي الفلسطيني لم يكشف عنها إلا مؤخراً، وعملية التعريب لم تحدث، وبالرغم من الدور الثقافي الذي لعبه الحزب، والعناصر المناضلة في هذا الصعيد التي أنتجها، فإنه لم يلعب في الحركة النضالية الفلسطينية في تلك الفترة الدور الذي رشحه له مؤتمره السابع، وقد انشطر الحزب من القاعدة خلال ثورة 1936 وتعرض لانشطار أخر، قاعدي، في 1948، وفي 1965 انشق مرة أخرى، والسبب بالضبط يتعلق بمسألة التعريب، إذا أن المنشقين كانوا من دعاة تبني سياسة “بناءة ” إزاء الصهيونية.
إن غياب دور الحزب الشيوعي على هذه الصورة، وضعف البورجوازية العربية الصاعدة، وتشتت الحركة العمالية العربية، جعل دور القيادات الإقطاعية – الدينية مرشحاً للعب دور رئيسي عندما تصاعدت الأحداث إلى انفجار 1936.
الفلاحون
تلك كانت الأوضاع العمالية عشية انفجار ثورة 1936، إلا أن هذه الأوضاع كانت تشغل نصف مساحة الخارطة التي كان يحتدم فيها ذلك التناقض المركب بين المجتمع اليهودي في فلسطين وبين المجتمع العربي ثم داخل كل واحد من هذين المجتمعين على حدة. أما النصف الآخر من الخارطة فقد كان في الريف. فهناك أخذ الصراع شكله القومي المباشر، لأن الأموال اليهودية المتدفقة بغزارة على فلسطين مضافاً إليها القوات العسكرية للإمبرياليين البريطانيين، والنفوذ الهائل للجهاز الإداري الإنكليزي، قد حققت بالنسبة إلى مخططات الصهيونية في إقامة دولة يهودية نتائج تافهة (6752مستوطناً مستعمراً) ولكنها نجحت في مزاولة تأثير تخريبي على الجماهير العربية… إن ملكية الجماعات اليهودية قد ارتفعت على حساب الأراضي الريفية والمدنية من 300 ألف دونم عام 1929 إلى مليون و250 ألف دونم عام 1930. إن هذه الـ100 ألف هكتار لا تساوي شيئاً يذكر بالنسبة للاستعمار الجماعي، ولحل “المسألة اليهودية”، ولكن … الاستيلاء على حوالي مليون دونم أي ما يقرب من ثلث الأرض الزراعية، يعني الإفقار للفلاحين والبدو على نطاق ووتيرة لم يسمع بهما من ذي قبل، إن عدد عائلات الفلاحين الذين طردوا من أرضهم من قبل الصهاينة عام (1931) يبلغ20 ألفاً(30).على أنه بالإضافة لعملية الإفقار المنظمة هذه، فإن العامل القومي ها هنا يلعب دوراً رئيسياَ. فالحياة الزراعية في العالم المتخلف عموماً، وبصورة خاصة في العالم العربي، ليست نمطاً من الإنتاج فحسب، بل هي أيضاً وبدرجة مساوية أسلوب حياة اجتماعية ودينية وطقوسية راسخة. وبالتالي فإن الصدام على هذا الصعيد يشكل صداماً يأخذ بالدرجة الأولى شكل الصراع القومي البحت. فحتى عام1931 كان 151يهودياً فقط من كل ألف يهودي في فلسطين يعتمدون في معيشتهم على الزراعة، بينما كانت النسبة بين العرب المسلمين 637 شخصاً في كل ألف، وهكذا فإنه من أصل حوالي 119 “فلاح” يشتغل بالأعمال الزراعية في فلسطين لا يوجد إلا 11 ألف يهودي تقريباً(31).
وفي حين أنه (في عام 1931) كان هناك 19.1 بالمئة من اليهود فقط يعملون في الزراعة كان هناك 59 بالمائة من العرب يمارسون هذا العمل.
إن الأساس الاقتصادي لهذا الصدام فادح الخطورة بالطبع، ولكن كي نفهمه تماماً ينبغي أن ندرك وجهه القومي: إن 30 بالمئة من الفلاحين العرب في 1941 لم يكن لديهم أية قطعة أرض، فيما كان يملك 50 بالمائة من الباقي أرضاً صغيرة لا تكفيهم، هنالك – من جهة أخرى – 250 إقطاعياً عربياً كانوا يملكون 4 ملايين دونم، و25 ألف عائلة فلاحية بدون أرض، و46 ألف عائلة فلاحية لها أرض صغيرة بمعدل 100 دونم للعائلة، و15 ألف عامل زراعي مأجور يعملون عند ملاكين. وحسب دراسة أجريت على 322 قرية عربية في 1936 تبين أن 47 بالمائة من الفلاحين يملكون أقل من 7 دونمات، و63 بالمائة يملكون أقل من 20 دونماً (الحد الأدنى اللازم لإطعام عائلة فلاحية 130 دونماً)(32). ولكن من خلال انسحاق الفلاح العربي بين كابوس مثلث: الغزو الصهيوني للأرض، والملكية الإقطاعية العربية، وفداحة الضرائب التي تفرضها حكومة الانتداب، فإن التحدي الذي يأخذ مكان الصدارة هو التحدي القومي. إن كثيراً من الفلاحين العرب الصغار، في انتفاضة آب 1929 وانتفاضة 1933 باعوا أراضيهم للملاكين العرب الكبار كي يشتروا بأثمانها سلاحاً لمقاومة الغزو الصهيوني والانتداب البريطاني. إن الغزو، الذي يتحدى طراز عيش له نفوذ الدين والتقليد والشرف، هو الذي مكن القيادات الإقطاعية – الاكليركية من مواصلة لعب دورها بالرغم من الجرائم التي ارتكبتها، ففي كثير من الحالات كانت العناصر الإقطاعية التي تشتري تلك الأرض تبيعها للرأسمال اليهودي.
وخلال الفترة الممتدة بين 1933 و 1936 كان 62.7 بالمئة من مجموع الأرض التي اشتراها الصهاينة أراضي ملاكين متواجدين في فلسطين، و14.9 بالمئة أراضي ملاكين غائبين، و 22.5 بالمئة أراضي فلاحين صغار بينما كانت هذه النسبة، بين 1920 و 1922: 75.4 بالمئة أراضي ملاكين غائبين، و20.8 بالمئة أراضي ملاكين متواجدين و 3.8 بالمئة أراضي فلاحين صغار(33).
إن القوانين التي سنتها حكومة الانتداب قد صممت لخدمة أهداف الاستيطان اليهودي، ورغم أنه من حيث الشكل حاولت تلك القوانين الإيحاء بوجود ضمانات للفلاح إزاء عملية طرده من الأرض التي يعمل عليها، أو عدم إرغامه على البيع، إلا أن هذه القوانين لم تحل دون حدوث ذلك، مثل “حادث وادي الحوارث التي تبلغ مساحته 40 ألف دونم، وحادث قرية شطة البالغة مساحة أراضيها 16 ألف دونم وحوادث أخرى كثيرة أخذ فيها اليهود الأراضي وشتتوا شمل المزارعين العرب، وبسبب ذلك أصبح الخمسون ألف يهودي الذين يعيشون في المستعمرات الزراعية يملكون مليوناً و 200ألف دونم، بمعدل 24 دونماً للفرد.
أما الفلاحون العرب الذين يبلغ عددهم 500 ألف فيملكون مساحة تقل عن 6 ملايين دونم، بمعدل 12 دونماً للفرد”(34). وقد ظلت – على سبيل المثال- قضية 8730 فلاحاً طردوا من مرج بن عامر (240 ألف دونم) الذي باعته عائلة سرسق الإقطاعية البيروتية لليهود معلقة منذ حصول البيع والطرد في 1921 حتى انتهاء الانتداب في 1948(35). ” إن كل قطعة أرض يشتريها اليهود تصبح غريبة عن العرب وكأنها اقتطعت من جسم فلسطين ونقلت إلى بلاد أخرى”(36). ورغم أن هذا الكلام المؤثر هو لأحد كبار الإقطاعيين الفلسطينيين الذين أسهموا في تزعم الحركة الوطنية الفلسطينية، فإنه هو نفسه الذي يقول “يقول اليهود أن عشرة بالمئة من الأراضي التي ابتاعوها كانت من الفلاحين والبقية من الملاكين الكبار” وكأنه يجد في هذا القول ما لا يعجبه فيستطرد: “ولكن الحقيقة هي أن 25 بالمئة من الأراضي التي ابتاعوها كانت من الفلاحين”(37). وهذا الشعور الخجول عند الإقطاعي المذكور له ما يبرره تماماً. فقد بين غرانوت – خبير الأراضي اليهودي – أن ما كسبته 3 شركات يهودية فقط حتى عام 1936، (وهو يشكل نصف ما كسبه اليهود حتى ذلك التاريخ) “إنما حصلت على 52.6 بالمئة منه من كبار أصحاب الأرض الغائبين، و24.6 بالمئة من كبار أصحاب الأرض المقيمين، و13.4 بالمئة من الحكومة والكنائس والشركات الأجنبية، و9.4 بالمئة من الأفراد الفلاحين”(38).
كانت عملية الشراء تخلق طبقة متزايدة الاتساع من الفلاحين المعدمين الذين كانوا يتحولون إلى عمال زراعيين موسميين، ولكنهم كانوا في الغالب يتجهون إلى المدن ويضحون يداً عاملة غير ماهرة ورخيصة، إذ لم يحدث أن “أخرج فلاح من أرضه وتأمن على أرض جديدة، ولا في حادثة واحدة، أما التعويض فقد كان قليلاً جداً، ولم يكن سخياً إلا في حالة المختار وأعيان القرية، أما الأكثرية الساحقة فلا”(39). وكان هؤلاء يتوجهون في معظم الحالات إلى المدن “إن عمال التنظيفات في يافا أكثرهم من القرى (بربرة وخلافها)، وشركة السجاير والتنباك العربية في الناصرة تقول بأن أكثر عمالها قرويون أو من أصل قروي”(40). إن ما يحدث هناك يصبح مفهوماً ” فقد سألنا الشركة (المذكورة) عن عدد عمالها فقالت 210، فسألناها كم دفعت لهم أجوراً أسبوعية فأجابت 62جنيهاً، فإذا قسمنا المبلغ على 210 نحصل على رقم 29 قرشاً ونصف وهذا معدل أجرة العامل الأسبوعي”(41) (أجرة العاملة اليهودية في ذلك الوقت، التي تعمل في شركات التبغ كانت تتراوح بين 170 و 230 قرشاً يومياً)(42) وحتى على الصعيد الرسمي، حين كان القروي العربي المعدم ينزح إلى المدينة ويجد عملاً في دائرة حكومية مثل دائرة الأشغال، فقد كان الفارق في الأجر بينه وبين زميله اليهودي في الدائرة نفسها يتجاوز غالباً الـ 100 بالمئة(43).
وكانت لجنة جونسون-غروسبي قد قدرت متوسط دخل الفلاح العربي سنوياً(عام 1930) بمبلغ 31.37 جنيهاً قبل دفع الضرائب، ولكن هذا التقرير نفسه أظهر أن الفلاح يدفع 3.87 جنيهاً تسديداً لثلاث ضرائب، فإذا حذفنا 8 جنيهات سنوية يدفعها كفائدة على دينه السنوي يصبح على الفلاح أن يعيش بـ19 جنيهاً ونصف سنوياً هو وعائلته بينما المعدل اللازم لتغطية أود عائلة فلاحية، كما يقول التقرير نفسه، هو 26جنيهاً.
“إن طبقة الفلاحين هي في الحقيقة الطبقة الوحيدة التي يتحتم عليها أن تساعد في القيام بعبء جميع أنواع الضرائب في فلسطين … إن السياسة التي تتبعها الحكومة ترمي إلى وضع الفلاح في حالات اقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي”(44).
لقد كان للهجرة اليهودية، والمسألة المهمة المرتبطة بها وهي تحويل الاقتصاد “الفلسطيني” من اقتصاد زراعي عربي إلى اقتصاد صناعي يهودي أثرهما المباشر على الفلاح العربي الصغير بالدرجة الأولى كما رأينا: إن الإعفاءات الضريبية التي كانت تمنح للمهاجرين اليهود، والإعفاءات التي كانت تغطي استيرادات تتعلق بتنشيط الصناعة اليهودية وذلك بفرض ضريبة جمركية عالية على المنتوجات المستوردة، وبإعفاء المواد الخام، والمواد المصنوعة صنعاً أولياً، والفحم والأكياس والآلات .. الخ من الضرائب الجمركية كانت تعوض عن طريق ابتزاز الفلاح العربي. فقد ارتفع معدل ضريبة الجمرك من 11 بالمئة في بدء الانتداب إلى أكثر من 26 بالمئة في 1935: 100 بالمائة على السكر و 149 بالمئة على الدخان و 208 على البنزين، و400 بالمائة على الثقاب، و26 بالمئة على القهوة(45). إن طوق الحصار الاقتصادي تلخصه بصورة رمزية هذه الحكاية التي روادها المطران غريغوريوس حجار أمام لجنة بيل في 1937: “كنت مرة في قرية الرامة في قضاء عكا، وهنالك سمعت شكوى السكان (في) هذه البلدة وجوارها (التي) فيها أكبر موسم للزيتون والزيت النقي، وطالما كرر (الأهالي) الشكاوي إلى المندوب السامي عن استعمال معمل شيمن للزيت الصناعي، (وهو المعمل) الذي تعززه الحكومة بأن تعفى من الرسوم الجمركية كل ما يرد إليه من الفول السوداني، الذي يستخرج منه الزيت وبعد ذلك يخلط هذا الزيت بزيت الزيتون، وتباع بأسعار دنيئة جداً، وقد ألح الأهالي في شكاوي (كذا بالأصل) متكررة بطلب حماية زيتهم من هذه الآفة، فألفت الحكومة لجنة كلفتها بالاستماع إلى شكاوي أهل القرية، وتوجهت إلى الرامة، وما كان أشد دهشة هؤلاء وامتعاضهم عندما رأوا على رأس هذه اللجنة مدير معمل شيمن نفسه”(46). “إنه ليس محزناً فحسب، بل مسبب للاشمئزاز أن الضرائب في فلسطين تفرض على طبقات الشعب بالطريقة الآتية: تسمح الحكومة بأن يكلف الرجل الذي يكون محصوله السنوي 23 جنيهاً و 370ملا بدفع 25 بالمئة من الضرائب، بينما التاجر، وأصحاب المهن الحرة والمستخدمون الذين دخلهم ألف جنيه في السنة ينالهم 12 بالمئة من جميع ضرائب الحكومة”(47).
كان الفلاح الصغير والمتوسط يرزح تحت ذلك العبء، ليس فقط بسبب سياسة الإفقار و السلب، ولكن بسبب الشعار الذي كان يرفعه الصهاينة: “اليد العاملة العبرية فقط” وشعار “الإنتاج العبري فقط” وكان ذلك يؤدي “ليس فقط إلى تشغيل الصناعيين والمزارعين اليهود لعمال يهود فحسب، ودفع أجور أعلى، ولكن أيضاً لتحديد أسعار أعلى لمنتوجاتهم. إن مبدأ الإنتاج العبري كان يشجع السكان اليهود على تفضيل المنتوجات اليهودية بأسعارها الأعلى من منافستها العربية(48).
فإذا تذكرنا – كما رأينا في السابق – أن معظم المواد الخام كانت معفاة من الضرائب، وأن الضرائب الجمركية كانت عالية على السلع المستوردة والتي كانت تنتج المصانع اليهودية في فلسطين مثلها، أدركنا أن شعار “الإنتاج العبري فقط” كان شعاراً يتحمل عبئه الفقراء العرب بالدرجة الأولى مقابل ذلك كانت الطبقة التي اصطلح على تسميتها بطبقة “الأفندية” والتي تعيش في المدن، تحصل على الجزء الأوفر من دخلها من الأرض الزراعية المؤجرة للفلاحين ومن فوائد الديون التي كانوا يقدمونها للفلاح – وفي الثلاثينات لم يكن هؤلاء الأفندية قد شرعوا بتوظيف أموالهم في الصناعة وفي الأعمال في المدن (شرعوا في ذلك مع بداية الأربعينات على نطاق محدود)، ولكن حتى هذا الابتزاز كان يشكل بالنسبة للفلاح شراً أقل فتكاً من شر الصهيونية، فاستغلال “الأفندية”، الطبقة التي نمت حول الأرستقراطية الإقطاعية وكسبت حمايتها منذ الحكم التركي، لم يكن يصل إلى حد الاقتلاع، وكانت “المؤسسات” التي نمت منذ عهود سحيقة حول هذه العلاقات (الحمولة، العائلة، العشيرة، الطائفة .. الخ) تجعل ذلك التناقض الفادح يبدو أقل خطراً، قياساً على الخطر المباشر الذي كانت تمثله الصهيونية.
إن “طبقة” لم تعط الأهمية الكافية في الدراسات الفلسطينية هي “طبقة” البدو، الذي بلغ تعدادهم في فلسطين عام 1931: 66.553 بدوياً (كان عددهم 103.000 في 1922). أن هذه القوة التي شاركت مشاركة بارزة في ثورة 1936 كانت قد لعبت دوراً مهماً في انتفاضة شهر آب 1929 ولفتت نظر الحزب الشيوعي الفلسطيني في مؤتمره السابع الذي سبقت الإشارة إليه. إن هؤلاء البدو الذين يشكلون 35 بالمئة من السكان تقريباً “يجعلهم الجوع الدائم في حالة غضب يبقى دائماً على حافة الانتفاضة المسلحة، إن اشتراكهم في انتفاضة آب يدلك على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبوه في تمرد ثوري للجماهير، وفي الوقت نفسه يغدو من الواضح أن شيوخ وزعماء هذه القبائل يمكن أن يفسدوا بالمال… والبدو يمدون بلا انقطاع جيش الفلاحين المحرومين من الأرض وأنصاف البروليتارية بأيد وأفواه جديدة”(49).
في غضون ذلك كانت البرجوازية العربية المدينية الصغيرة والممزقة في حالة تخبط وضياع وتمزق، وكانت سرعة تحول المجتمع إلى الاقتصاد الصناعي اليهودي تجري دون أن تتيح لهذه البورجوازية الناشئة، ولا للإقطاعيين، فرصة المشاركة بهذا التحول أو الاستفادة منه، ولذلك فإنه لم يكن غريباً قط أن نرى بأن معظم الزعماء الفلسطينيين الذي شهدوا أمام لجنة “بيل” الملكية في 1937 وكذلك أمام اللجان التي سبقتها، يصرفون وقتاً طويلاً في امتداح الاستعمار العثماني وإطراء معاملته قياساً على معاملة الاستعمار البريطاني: فقد كانوا يشكلون آلة الباب العالي وذراع السلطان وجزءاً لا يتجزأ من نظام الهيمنة والاستغلال والقمع، وقد صرفهم الاستعمار البريطاني من دور الوكيل الأول، لأنه وجد وكيلاً أكثر كفاءة وأشد رسوخاً وأرقى تنظيماً هو الحركة الصهيونية.
وهكذا جرى رسم أفق الدور الذي كان على القيادات الإقطاعية – الإكليركية أن تلعبه في الأساس، “النضال” من أجل موقع أفضل في النظام الاستعماري، ولكنها لم تكن لتستطيع أن تخوض ذلك “النضال” دون أن ترص وراءها صفوف الطبقات التي كانت تتعطش لطرد القهر القومي المزدوج، والقهر الطبقي المزدوج، عن صدرها، وكي تنجح في ذلك رسمت لنفسها برنامجاً أكثر تقدماً من طاقتها، واستعارت شعارات الجماهير التي لم تكن لتستطيع ولا ترغب في دفعها إلى مداها، وسلكت أشكالاً في النضال ليست من طبيعتها. وبالطبع، لم يكن لهذه القيادات مطلق الحرية في التصرف، كما يحب الكثير أن يوحوا، بل كانت تتعرض لجملة الضغوط التي كانت تحرك الأحداث ولتصاعد التناقضات واحتدامها، ولجملة التأثيرات التي مررنا عليها، وذلك يفسر التناقضات الجزئية التي كانت أحياناً تقوم بينها وبين الأنظمة العربية المحيطة بفلسطين والتي هي شريكة طبقية لها، وكذلك يفسر أحلافها الواسعة النطاق داخل البنية الطبقية في فلسطين.
المثقفون
بعد 13 سنة من الاحتلال البريطاني لفلسطين، (أي في1930) يعترف مدير المعارف بتقريره: “لم تتكفل الحكومة منذ الاحتلال حتى اليوم بنفقات كافية لبناء أية مدرسة في البلاد” وفي 1935 رفضت الحكومة 41 بالمئة من طلبات الالتحاق بالمدارس التي قدمها عرب. وفي 800 قرية عربية كانت موجودة في فلسطين كان هناك 15 مدرسة للبنات فقط و269 للصبيان، ووصلت 15 فتاة قروية فقط إلى الصف السابع الابتدائي. وكان هناك 517 قرية عربية لا مدارس فيها للذكور ولا للإناث، ولا توجد أية مدرسة ثانوية في القرى العربية وبالإضافة لذلك كانت الحكومة: ” تراقب الكتب وتعارض كل صلات ثقافية مع العالم العربي، وهي لم تفعل شيئاً لرفع المستوى الاجتماعي بين الفلاحين …”(50). في 1931، إذن، كان المتعلمون بين مسلمي فلسطين251 بالألف بين الذكور و33 بالألف بين الإناث 715 بالألف بين الذكور المسيحيين و441 بالألف بين الإناث. (وكانت النسبة 934 بالألف بين ذكور اليهود و787 بين إناثهم!”(51). ومع ذلك فإن هذه الأرقام وإن عكست الواقع التعليمي في الريف خصوصاً فهي لا تعكس الواقع الثقافي في مجمل فلسطين، هذا الواقع الذي لعب دوراً طليعياً منذ بدء النهضة العربية في مطلع القرن العشرين. ففي الحقيقة كان عدد كبير من المطابع قد تأسس في فلسطين قبل الاحتلال البريطاني، وفي المدة الواقعة بين 1904و1922 ظهرت في فلسطين حوالي 50 صحيفة عربية، وقيل انفجار ثورة 1936 أضيفت عشر صحف أخرى على الأقل، كان رواجها واسعاً.
إن عوامل كثيرة، ليس هنا مجال التوسع فيها، قد جعلت من فلسطين مركزاً ثقافياً عربياً مهماً، وكانت الحركة الدائبة للمثقفين المهاجرين من وإلى فلسطين عاملاً أساسياً في ترسيخ الدور الثقافي في فلسطين، وكذلك إنشاء الجمعيات والنوادي الأدبية الذي بدأ منذ مطالع العشرينات. على أن هذا التطور الثقافي الذي كانت تغذية باتصال أفواج من المتخرجين العرب من بيروت والقاهرة رافقته حركة ترجمة واسعة النطاق عن الفرنسية والإنكليزية، ولا شك أن الإرساليات الأجنبية والتي كانت كثيرة بحكم خصوصية فلسطين بالنسبة لها لعبت دوراً بارزاً في نشر الجو التعليمي في المدن. إن الذي يعنينا هنا ليس الجو الثقافي العام في فلسطين خلال الثلاثينات، على أهميته، ولكن تعنينا على وجه التحديد الانعكاسات التحريضية التي أدى إليها من خلال علاقته مع تفاقم المأزق الاقتصادي والقومي، ومن الممكن قياس هذه الانعكاسات، في أشكالها ومظاهرها المختلفة والمتعددة من خلال رصد الحركة الأدبية في فلسطين في تلك الفترة، ومن خلال رصد تطور ما يمكن أن نصفه بالثقافة الشعبية، وهو ذلك الطراز من الوعي الذي ينمو في الريف الغارق في مجاهل الأمية، ولكن – في الوقت نفسه – الذي يعاني من التحدي اليومي المباشر بصورة تجعله دائم التيقظ. أنه من الواضح أن مثقفي المدن في معظمهم، لهم منشأ طبقي مختلف عن ذلك الذي كان “للدعاة” الريفيين، ورغم أنهم كانوا ينتمون إلى العائلات الإقطاعية أو البورجوازية التجارية أو الصغيرة في المدن، فقد دفعتهم ظروفهم، في مرحلة دقيقة من حياة بلادهم، إلى لعب دور فريد من نوعه، فقد كانوا دعاة ثورة بورجوازية ولكن هذه “الثورة البورجوازية” التي كانوا هم طلائع دعوتها لم تكن موجودة وجوداً مادياً حقيقياً مبلوراً في حركة ذات نفوذ وذات برنامج، كان الميدان متروكاً لهيمنة الإقطاع (الذي بذل كل ما لديه من جهد لمحاولة امتصاصهم تحت قيادته وتركت هذه المحاولات بصماتها بوضوح) ولذلك استطاع هؤلاء المثقفون أن يكونوا أكثر طلاقة إذ أنهم لم يكونوا مرتبطين بوجود حقيقي أو قاعدة صلبة لهذه البورجوازية ولذلك بالذات كانت الحدود التي ينبغي لهم التقيد بها بحكم منشأهم الطبقي، حدوداً مائعة يسرت لهم التقدم في دعواهم أكثر من الشعراء والأدباء الذين يوازونهم، طبقياً وثقافياً، في البلاد العربية الأخرى، في الفترة ذاتها. أما في الريف فقد كان “القوالون”، بحكم تجوالهم واحتكاكهم بالفلاحين، يطورون نوعاً من الزجل السياسي الذي كان يعكس هموم ومطامح الفلاحين بتصاعد يتناسب مع تصاعد الصراع الذي كانت أسبابه تزداد اتساعاً وعمقاً، وفي الريف يشكل الشعر الشعبي، وكل ما يتفرع عنه، طقساً من طقوس الحياة وتقليداً من تقاليدها يزداد رسوخاً مع الوقت، ومن هذه الناحية يصبح لهذا الشعر الشعبي، الذي يتبلور شكله النهائي من خلال إسهامات لا حصر لها وأزمان متطاولة وصدمات اجتماعية متكررة، سطوة تشبه سطوة الإعلام المعاصر.
إن ميكانيكية حدوث ذلك كله، وطبيعة الصدام المركب والمعقد على صعيد الثقافات بين الدعوة إلى الثورة والدعوة إلى الاستكانة، والتي تأخذ أكثر أشكالها تعقيداً وبطئاً في الريف المختلف على وجه الخصوص، هي مسألة ليست من اختصاص هذا البحث هنا، ولكن مع ذلك لابد من الإشارة إلى أن كثيراً من العناصر التي يبدو لأول وهلة أنها ستلعب دوراً سلبياً في هذا الشأن، (مثل إمام المسجد، على سبيل المثال، وهو أكثر الدعاة في الريف نفوذاً) لا تفعل ذلك بالصورة المطلقة التي تقفز إلى الخيال، وفي فترات معينة يكون مستوى التناقض الوطني قد بلغ حداً يستلزم حتى من إمام المسجد أن يبرر مكانته، ومثل هذا العمل، إن لم يؤد إلى نتائج إيجابية مباشرة، فهو يخلخل بالنتيجة “سطورة العصمة” التي لرجل الدين في الريف. من هذه الزاوية كان الصراع الثقافي بين الدعاة الثوريين وبين الرجعيين (في الريف) وبين الدعاة الثوريين وبين العدميين والرومانطيكيين (في المدينة)، يكسب في كل يوم، لمصلحة الثقافة الثورية، مساحة جديدة. لا نعرف كاتباً أو أديباً فلسطينياً واحداً في الفترة التي نحن بصددها لم يخض غمار الدعوة المناهضة للعدو الاستعماري بهذه الدرجة أو تلك وعلى هذا المستوى من الوعي أو ذلك، وقلة من الشعراء لم تكتب عن المسألة الوطنية.
إننا نتحدث عن السمة العامة للجو الثقافي في فلسطين، حيث لعب المثقفون دوراً كان أكبر حجماً من الدور الذي تلعبه هذه الفئة، خصوصاً حين لا تكون حزبية، في أمكنة أخرى تعيش الشروط الكلاسيكية لمعركة التحرر الوطني. كانت خصوصية الوضع بالنسبة للمثقف العربي فريدة: ففي المدينة كان أبناء الأغنياء يرون – بعد عودتهم من الجامعات أو بعد إنهائهم علومهم – كيف تقف الطبقة التي ينتمون إليها عاجزة كلياً عن قيادة المعركة التي انتدبت نفسها لها: مدركين في كل الأحوال تخلفها وكساحها الثقافي أمام رياح العصر، ولكنهم في الوقت ذاته كانوا يعانون من عجزهم عن إيجاد مكان لأنفسهم في حركة المجتمع المتقدم نحو تثبيت صفته الصناعية، إذ أن القوة التي كانت تتحكم بهذا التحول كانت قوة، في جوهرها وفي مظهرها، أجنبية وغربية، ولذلك فان البورجوازية الوحيدة الموجودة بقوة لم تكن تتحداهم قومياً فحسب، بل أيضاً كانت تعتنق ثقافة لا تمت بصلة إلى ثقافتهم ولا إلى مطامحهم الثقافية.
وفي الريف كان الفلاح الفلسطيني الذي رزح قروناً طويلة تحت أثقال القهر الطبقي والقومي، وجرى تحويله عبر ذلك إلى القدرية المفرطة باسم الولاء الديني، قد أنشأ لنفسه عالماً “ثقافياً” مسوراً بالتقاليد التي فرضتها الطبقة السائدة، والتي عبرت عن نفسها بالأمثال الشعبية، هذه الأمثلة التي كان لها سطوة القانون، وهي سطوة معروفة في كل مكان وخصوصاً في الأرياف الخاضعة لعلاقات الإنتاج الإقطاعية “فهي ليست شكلاً من أشكال الفولكور… بل هو عمل كلامي يؤدي إلى أقوى أنواع التأثير على مجرى الأمور وعلى السلوك الإنساني”(52).
إن الفقر، والانسحاق، وتعاقب قرون مديدة من القهر القومي والطبقي، قد أدت مجتمعة إلى إنشاء “مؤسسة كاملة” للاستسلام والقدرية والخنوع عكست نفسها بالأمثلة الشعبية السائدة(*). وكان على المثقفين الفلسطينيين، وخصوصاً على الشعراء الشعبيين في الريف، مهمات عظيمة لزحزحة تلك الثقافة الخاملة، دون أن يكونوا هم أنفسهم قد تخلصوا جذرياً من تأثيراتها. وصحيح أن قطاعاً من المثقفين الفلسطينيين قد شرعوا يفعلون ذلك منذ وقت مبكر في تاريخ النضال الفلسطيني، وقد لعبوا دوراً بارزاً في بلورة وعي متقدم: إن العلاقة التي نشأت بين الأدب الشعبي الفلسطيني، وكذلك الأدب الفصيح في المدن، وبين حركة النضال الفلسطينية لم تكن علاقة وصفية أو تسجيلية، ولكنها كانت علاقة جدلية من طراز عميق.
إن الشاعر اللبناني الأصل، وديع البستاني، الذي كان قد تخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1907 وهاجر إلى فلسطين واستقر فيها، لعب دوراً رائداً في عملية التوعية هذه: فقد حذر من وعد بلفور في نفس الشهر الذي صدر فيه الوعد عام 1917 بوضوح يبدو لنا الآن وكأنه كان نظراً في مرآة. ومن المفيد تتبع حقبة من الزمن يمثلها البستاني ستزدهر في الثلاثينيات، حين نضحي على أبواب الثورة المسلحة، طليعة قوية من الشعراء والقوالين الذين ألهبوا النضال المسلح وجعلوه، أيضاً، جزءاً من التراث الثقافي للجماهير التي كانت ترى في “كلب الأمير أميراً”. ففي 29 كانون الأول 1920 وجهت حكومة الانتداب البريطاني إلى رئيس تحرير مجلة الكرمل الثقافية التي كانت تصدر آنذاك في حيفا رسالة رجت فيها نشر قصيدة كان قد أهداها شاعر العراق الشهير معروف الرصافي، الذي كان يزور فلسطين آنذاك، إلى المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل، وفيها يمجد خطيباً يهودياً اسمه “يهودا” ويكيل مديحاً لا حد له للمندوب السامي. ولكن صاحب “الكرمل” لم يجد من اللائق نشر تلك القصيدة التي لا يمكن أن توصف إلا بالخسة دون رد عليها تطوع لكتابته الشاعر وديع البستاني:
خطاب (يهودا)؟ أم عجاب من السحر؟
وقول الرصافي؟ أم كذاب من الشعر،
قريضك من در الكلام فرائد
وأنت ببحر الشعر أعلم بالدر
ولكن هذا البحر بحر سياسة
إذا مد فيه الحق آذن بالجزر
أجل! عابر الأردن كان ابن عمنا
ولكننا نرتاب في عابر البحر..
إن هذه القصيدة الطويلة التي اشتهرت آنذاك كثيراً هي في الحقيقة وثيقة سياسية فذة، فالمناقشة فيها لا تسفه الرصافي فحسب، بل تثبت معطيات سياسية على غاية الأهمية في ذلك الوقت المبكر، منها، بالإضافة إلى هجرة يهود أوروبا وخطرها، دور بريطانيا في التجزئة العربية، ووعد بلفور وآفاته… الخ. وقبل ذلك بفترة وجيزة (28/3/1920) كان وديع البستاني نفسه على رأس مظاهرة، يقودها ويردد أمامها نشيداً نظمه بنفسه، وقد استدعي الشاعر إلى التحقيق، وجاء في ضبط التحقيق الإداري الذي قام به النائب العام:
“النائب العام: وردت بيانات على أنك كنت مرفوعاً فوق الرؤوس، وأنت تقول ووراءك الجمهور: يا نصارى ويا إسلام!
المتهم: نعم.
النائب العام: )وقلت أيضاً) لمين تركتوا البلاد؟
المتهم: نعم.
النائب العام: (ثم قلت) اذبحوا اليهود والكافرين ..
المتهم: لا. هذا اخلال بالوزن والقافية، وما قلته كان مقفى موزوناً، وذا معنى ويقال له الشعر”!(53).
إن الفترات اللاحقة ستشهد بروزاً متعاظماً لدور الشعر على وجه الخصوص، ليعبر في مختلف المناسبات. عما كان يعتمل في صدور الجماهير المغلوبة على أمرها، فحين حضر بلفور من لندن ليشهد احتفال افتتاح الجامعة العبرية في 1925 جاء إلى الحفلة نفسها أحمد لطفي السيد مندوباً عن الحكومة المصرية، ويقول الشاعر اسكندر الخوري البيتجالي يومها موجهاً حديثه لبلفور:
من لندن هرولت تضرم
نار هدي الواقعة
يا لورد ما لومي عليك فأنت أصل الفاجعة
لومي على مصر تمد
لنا اكفا صافعة (54)
إن إبراهيم طوقان و أبو سلمى (عبد الكريم الكرمي) وعبد الرحيم محمود يمثلون منذ بدء الثلاثينات تتويجاً لجيش من الشعراء الوطنيين الذين ألهبوا فلسطين طولاً وعرضاً بالتوعية والتحريض(*):
إسعاف النشاشيبي، وخليل السكاكيني، وإبراهيم الدباغ، ومحمد حسن علاء الدين، وبرهان العبوشي، ومحمد خورشيد، وقيصر الخوري، والخوري جورج بيطار، وبولس شحاده، ومطلق عبد الخالق.. إلخ.
وفي رؤى هؤلاء الثلاثة، طوقان والكرمي ومحمود، قدرة خارقة على استشفاف ما كان يحدث، لا يمكن تفسيرها إلا بأنها استيعاب عميق لذلك الذي كان يحتدم في أوساط الجماهير. أن ما يبدو في قصائد هؤلاء الثلاثة وكأنه نبؤة لا تفسير لها، وتكهن يشبه الرجم بالغيب ليس في الحقيقة إلا قدرتهم على التعبير عن هذه العلاقة الجدلية التي كانت تربط نتاجهم الفني بحركة المجتمع.
يقول إبراهيم طوقان مثلاً تعليقاً على إنشاء “صندوق الأمة” عام 1932 لإنقاذ أراضي فلسطين من البيع لليهود (وهو الصندوق الذي أنشأته وقتذاك القيادة الإقطاعية – الاكليركية بحجة عدم تسرب أرض فقراء الفلاحين إلى اليهود): “إن ثمانية من القائمين على مشروع صندوق الأمة كانوا سماسرة على الأراضي لليهود”:
حبذا لو يصوم منا زعيم
مثل غاندي عسى يفيد صيامه
لا يصم عن طعامه، في
فلسطين يموت الزعيم لو لا طعامه
ليصم عن مبيعه الأرض يحفظ
نفعة تستريح فيها عظامه (55)
إن تركيزنا على الدور الذي لعبه الشعر ولعبه الشعر الشعبي، لا يعني أن المظاهر الأخرى من الإنتاج الثقافي في فلسطين لم تلعب أي دور أو أن دورها كان يسيراً: فالصحف والمقالات الأدبية والقصص وحركة الترجمة لعبت مجتمعة دوراً طليعياً لافتاً للنظر. ففي مقال افتتاحي- مثلاً- نشره يوسف العيسى عام 1920 في النفائس نقرأ: “فلسطين عربية، عربية بمسلميها، عربية بمسيحييها، عربية بيهودها الوطنيين أيضاً، فعلام يبيع حماها الأجنبي الصهيوني … إن زوابع فلسطين لا تهدأ إذا فصلت عن سوريا وجعلت وطناً قومياً للصهيونية..”
إن انطلاقات من هذا النوع، منذ مطالع العشرينات، هي التي شكلت المد الثقافي الثوري في الثلاثينات، الذي لعب دوراً مهماً في تنمية الوعي وتفجير الثورة: أقلام مثل قلم عارف العارف وخليل السكاكيني (الناثر الحاد، الساخر، الجريء، ابن معلم النجارة) وإسعاف النشاشيبي (البورجوازي الكبير الذي تأثر بالسكاكيني وتينى الكثير من آرائه) وعارف العزوني، ومحمود سيف الدين الإيراني ونجاتي صدقي (الصوت اليساري المبكر الذي، في 1936، مجد مادية ابن خلدون وأعلن احتقاره للمثالية – وربما كان هو أول من أرخ للحركة الوطنية العربية منذ بدء عصر النهضة عبر تحليل مادي للأحداث، ونشر بحوثه في “الطليعة” خلال 1937-1938) وعبد الله مخلص (الذي أخذ منذ أواسط الثلاثينات يدعو إلى الإدراك بأن الاستعمار ظاهرة طبقبة، وإلى أن الإنتاج الفني يجب أن يكون موجهاً) ورجا الحوراني، وعبد الله البندك، وخليل البديري، ومحمد عزة دروزة، وعيسى السفري (الذي مجد استشهاد القسام تمجيداً له معناه الثوري العميق) ذلك الاحتدام في الجو الثقافي الفلسطيني، الذي وصل إلى ذروته في الثلاثينات، أخذ كما نرى أشكالاً متعددة في التعبير، ومع ذلك فقد ظلت أولوية التأثير- لاعتبارات عديدة منها تاريخ الأدب العربي نفسه- للشعر وللشعر الشعبي الذي كان بدوره تعبيراً، أيضاً، عن ذلك الجو.
إن هذا وحده هو الذي يفسر ذلك الدور الذي كاد أن يكون وعظاً سياسياً مباشراً، الذي انتدب الشعر نفسه ليلعبه في تلك الفترة. ففي 1929على سبيل المثال كان إبراهيم طوقان يكشف، في وقت مبكر، ذلك الدور الذي كان يلعبه الملاكون الكبار في مسألة الأرض:
باعوا البلاد إلى أعدائهم طمعاً
بالمال، لكنما أوطانهم باعوا
قد يعذرون لو أن الجوع أرغمهم
والله ما عطشوا يوماً ولا جاعوا
كان إبراهيم طوقان قد أطلق في العام نفسه ملحمته عن أحكام الإعدام التي أصدرتها حكومة الانتداب على الشهداء الثلاثة: فؤاد حجازي من صفد، ومحمد جمجوم وعطا الزير من الخليل، وهي القصيدة التي أضحت شهيرة للغاية، وأضحت تعتبر جزءاً من تراث الثورة، مثلها مثل قصيدة عبد الرحيم محمود في 14/8/1935، التي خاطب بها الأمير سعود الذي جاء يومذاك يزور فلسطين: المسجد الأقصى، أجئت تزوره
أم جئت من قبل الضياع تودعه؟
سوف يستشهد شاعرنا هذا في 1948 في معركة الشجرة في فلسطين، ولكنه قبل ذلك يلعب دوراً بارزاً مع أبو سلمى وطوقان في إرساء دعائم الشعر الفلسطيني المقاوم الذي سيضحي فيما بعد، تحت الاحتلال الإسرائيلي، من أبرز مظاهر صمود الجماهير الفلسطينية.
لقد رافق الشعر والشعر الشعبي التحرك الجماهيري منذ أوائل الثلاثينات بصورة رئيسية، وعبر عن انفجار الثورة وعن دقائقها وغناها: إن قصيدة أبو سلمى “انشر على لهب القصيد” التي أرخ فيها لثورة 1936 تكشف بجرأة تلك الخيبة المرة التي نشأت عن خذلان الأنظمة العربية للثورة:
يا من يعزون الحمى
ثوروا على الظلم المبيد
بل حرروه من الملوك
وحرروه من العبيد …
ويذكر بالشاعر الشعبي “عوض” الذي كتب على جدران زنزانته في عكا ليلة إعدامه في 1937 قصيدة رائعة كانت نهايتها:
ظنيت النا ملوك
تمشي وراها رجال
تخسا الملوك أن
كان هيك الملوك أنذال
والله تيجانهم ما
يصلحوا النا نعال
إحنا اللي نحمي
الوطن ونبوس جراحو(*)
أن الغضبة التي كانت تنصب في وقت واحد على العدو المثلث: الغزو الصهيوني والانتداب البريطاني والرجعية العربية المحلية وغير المحلية، كانت تنمو باطراد أمام نمو المأزق. في ذلك الوقت كان الريف يطور، مع تصاعد التناقضات وانفجار الانتفاضات المسلحة، وعيه الجديد من خلال احتكاك عناصره “المثقفة ” بالمدن وتدفق عوامل التوعية:
يا ناس شو هالسخمة صهيوني مع غربي(56).
ثم:
طلت البارودة والسبع ما طل
يا بوز البارودة من الندى منبل
وكذلك:
بارودتو بيد الدلال اريتها
لا عاش قلبي ليش ما شريتها
وبارودتو لقطعت صدى عقرابها
لقطعت صدى واستوحشت لصحابها
وحتى في الأعراس:
والعريس هو منا – يا ويل اللي نحاربو، بالسيف نقطع شاربو، هز الرمح بعود الزين – وأنتو يا نشامى منين؟ واحنا شباب فلسطين، والنعم والنعمتين – يا أبو العريس لا تهتم، واحنا شرابين الدم، في بلعا ووادي التفاح(**) صارت هجمة وضرب سلاح … يا بيض يا ملاح، بالله تزغرتنا، يوم وقعة بيت أمرين، تسمع شلع المراتين، طلي علينا من البلكون(57).
بل تصل الدعوة التحريضية للثورة إلى مداها بصورة مدهشة، فبعد كل الأمثال الموروثة التي تنصح بالاستكانة، وتشكل قيداً له سطوة التقاليد وعصمتها، تضحي الأهزوجة الشعبية فجأة، قادرة على أن تقول:
يا عربي يا ابن المجرود ة
بيع أمك واشري بارودة
والبارودة خير من أمك
يوم الثورة تفرج همك …(58)
إن”البارودة” تضحي، بتراكم التناقضات واحتدامها، الأداة التي تحطم ذلك السور العريق من الدعوة للاستكانة، وفجأة يصير بوسع هذه “البارودة “أن تصل إلى قلب المسألة، وتصبح الثورة كوعد للمستقبل – أفضل من أكثر ما في الماضي من دفء: الأم، العائلة. ولكن فوق هذا الاحتدام كله كان الإقطاع الاكليركي يتكلس بقيادته العاجزة وسطوته وحلفه مع الماضي.
وسط هذه التناقضات المركبة، المحتدمة، المتزايدة الاتساع والعمق، والتي كانت تنصب على الفلاحين والعمال العرب بالدرجة الأولى، ولكنها أيضاً تجثم بثقل على البرجوازية الصغيرة والمتوسطة في المدن والفلاحين المتوسطين بالأرياف، كان المأزق يتصاعد باطراد، معبراً عن نفسه بانفجارات مسلحة بين الفينة والأخرى (1928-1933):
كان الإقطاع الفلسطيني الاكليركي، من الجهة الأخرى، يشعر بأن مصالحه هو الآخر مهددة من قبل قوة اقتصادية صاعدة هي الرأسمالية اليهودية المتحالفة مع الانتداب. ولكن مصالحه كانت مهددة أيضاً من الجهة المعاكسة: من الجماهير العربية الفقيرة التي لم تعد تعرف أين يتعين عليها أن تتجه، فالبورجوازية العربية المدينية كانت ضعيفة غير قادرة على قيادة مرحلة التحول الاقتصادي التي كانت تجري بسرعة لا مثيل لها، وقسم صغير من هذه البورجوازية تحول إلى طحلب متسلق على هامش النمو الصناعي اليهودي وأخذ طريقه، بقدر ما كانت ظروفه الذاتية والظروف الموضوعية المحيطة بوجوده، تتخذ مجرى معاكساً للحركة التي كانت تحتدم في المجتمع العربي، وانفرد المثقفون الشبان الذين انحدروا عائلات ريفية ومدينية غنية بلعب دور بارز في التحريض الثوري فقد عادوا من جامعاتهم إلى مجتمع يرفضون فيه صيغة العلاقات القديمة التي أضحت متخلفة، وترفضهم فيه الصيغ الجديدة التي أخذت تبلور نفسها وسط التحالف الصهيوني – الإمبريالي.
وهكذا امتزج، بتلاحم لا نظير له، النضال الطبقي بالمصلحة القومية بالمشاعر الدينية، وتفجر هذا المزيج وسط الأزمة الموضوعية والذاتية التي كان يعيشها المجتمع العربي في فلسطين، وظل أسير القيادات الإقطاعية – الاكليركية لهذه الأسباب كلها مجتمعة. فأمام العسف الاجتماعي والاقتصادي الذي كان يلحق بالفقراء العرب في المدن والقرى لم يكن من الممكن للحركة الوطنية إلا أن تأخذ أشكالاً متقدمة من النضال وإلا أن ترفع شعارات وتتبع مسالك طبقية، وأمام الحلف المتين المعبر عن نفسه يومياً بين مجتمع الغزو الذي بناه الصهيونيون في فلسطين وبين الإمبريالية البريطانية لم يكن من الممكن تغييب أولوية السمة القومية لذلك النضال، وأمام الحمى الدينية المهولة التي ارتكز عليها الغزو الصهيوني لفلسطين والتي التصقت بكل مظاهره كان من المستحيل ألا يتمترس الريف الفلسطيني المتخلف وراء التعصب الديني، كمظهر من مظاهر معاداة الغزو الإمبريالي والصهيوني(*).
ولقد تقدمت القيادات الإقطاعية – الاكليركية للتربع على رأس حركة الجماهير، مستفيدة من ضمور البورجوازية العربية المدينية، ومن الحد المعين من التناقض الذي كان يحتدم بينها وبين الإمبريالية البريطانية التي كانت ترسي نفوذها عبر حلفها مع الحركة الصهيونية، ومن صفاتها الدينية، ومن صغر حجم البروليتاريا العربية وضمور حزبها الشيوعي الذي لم يكن فقط تحت هيمنة الزعامة اليهودية ولكن الذي تعرضت عناصره العربية إلى بطش وإرهاب القيادات الإقطاعية منذ أواخر العشرينات. أمام هذه الخلفية المركبة، التي تحتدم فيها تناقضات متداخلة شديدة التعقيد، خطت ثورة 1936 إلى الصف الأمامي في تاريخ فلسطين.
الثورة
يتسابق الكثير من المؤرخين في اعتبار حادث معين وقع في مكان معين هو السبب في انفجار ثورة 1936: يعتقد يهودا بويير أن الحادث الذي “يعتبر عموماً بداية اضطرابات 1936” حدث في19 نيسان 1936 حين “هاجمت حشود من العرب في يافا المارين اليهود”(59). ويعتبر عيسي السفري(60) وصالح مسعود أبو يصير(61) وصبحي ياسين(62) أن الشرارة الأولى إنما كانت قيام عصابة عربية مجهولة (يقول صبحي ياسين أنها كانت عصابة قسامية منها فرحان السعدي ومحمود ديراوي) بنصب كمين لسيارات كانت تعبر بين عنبتا وسجن نور شمس، بلغ عددها 15، فسلبت الركاب اليهود والعرب على السواء أموالهم، وألقى أحد الأفراد الثلاثة من العصابة خطبة موجزة في الركاب العرب الذين كانوا أكثرية الركاب، كما يقول السفري، تضمنت القول بأن الثورة قد بدأت و”أننا نأخذ أموالكم لكي نستطيع أن نحارب العدو وندافع عنكم”(63). ويرى الدكتور عبد الوهاب الكيالي(64) أن الشرارة الأولى انفجرت قبل ذلك، أي في شباط 1936، حين تألفت حامية من العمال العرب طوقت إحدى المدارس التي كان مقاولون من اليهود يقومون ببنائها بواسطة أيد عاملة يهودية فقط في يافا. إلا أن جميع المصادر تعتبر عن حق أن الانتفاضة القسامية التي فجرها الشيخ عز الدين القسام كانت هي البداية الحقيقية لثورة 1936. على أن تقرير اللجنة الملكية البريطانية (اللورد بيل)(65)، وهو التقرير الذي يعتبره يهودا بويير من أنضج ما كتب عن المسالة الفلسطينية حتى الآن، يقفز فوق هذه التعابير المباشرة عن الانفجار، ويرد الأسباب في انفجار الثورة إلى سببين رئيسيين هما: رغبة العرب في نيل الاستقلال القومي، وكرههم لإنشاء الوطن القومي اليهودي وتخوفهم منه. وهذان السببان، كما نلاحظ بسهولة، هما في الواقع سبب واحد، وتبدو العبارات التي صيغ بها فضفاضة ولا تقود إلى أي معنى واضح. ولكن اللورد بيل يضع ما يسميه بـ”عوامل ثانوية ” ساعدت على نشوب “الاضطرابات “وهي : 1- انتشار الروح القومية العربية خارج فلسطين. 2- ازدياد هجرة اليهود منذ سنة 1933. 3-الفرصة المتاحة لليهود بالتأثير على الرأي العام في بريطانيا. 4- عدم ثقة العرب في إخلاص حكومة بريطانيا. 5- فزع العرب من استمرار شراء الأراضي من قبل اليهود. 6- عدم وضوح المقاصد النهائية التي ترمي لها الدولة المنتدبة. أما قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية آنذاك، فإن فهمها لأسباب الثورة يمكن استنباطه من الشعارات الثلاثة الأساسية التي كانت تتوج بها مجموع مطالبها، وهي: 1- الوقف الفوري للهجرة اليهودية. 2- حظر نقل ملكية الأراضي العربية إلى اليهود. 3- إقامة حكومة ديمقراطية يكون النصيب الأكبر فيها للعرب وفقاً لغالبيتهم العددية(66). على أن هذه الشعارات، بالصيغ الفضفاضة التي كان يجري من خلالها تردادها، ظلت غير قادرة على التعبير عن حقيقة الموقف، والواقع أنها كرست إلى حد بعيد هيمنة القيادة الإقطاعية على الحركة الوطنية.
إن الأسباب الحقيقية للثورة، في الواقع، هي وصول حدة التناقض في عملية انتقال المجتمع الفلسطيني من الاقتصاد الزراعي – الإقطاعي- الاكليركي، العربي إلى الاقتصاد الصناعي البورجوازي اليهودي (الغربي) إلى ذروتها، كما رأينا في الصفحات السابقة، أن عملية تعميق حالة الاستعمار وتجذيرها، ونقلها من حالة الانتداب البريطاني إلى حالة الاستعمار الإسكاني الصهيوني، وصلت إلى ذروتها، كما رأينا، في منتصف الثلاثينات، والواقع أن قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية قد أرغمت على تبني شكل الكفاح المسلح لأنه لم يعد بوسعها أن تظل متربعة على سدة هذه القيادة في وقت وصل فيه التناقض إلى شكل صدامي حاسم. وقد لعبت عوامل متناقضة ومختلفة في دفع القيادة الفلسطينية آنذاك إلى تبني شكل الكفاح المسلح: أولاً: حركة عز الدين القسام. ثانياً: سلسلة الإخفاقات التي منيت بها هذه القيادة طيلة فترة تكلسها فوق رأس الحركة الجماهيرية، حتى فيما يتعلق بالمطالب الجزئية الصغيرة التي لا يتردد المستعمرون عادة في تلبيتها لغرض امتصاص النقمة (وقد أدرك البريطانيون متأخرين هذه الإمكانية التي خفف من إلحاحها بالنسبة لهم وجود العميل الصهيوني الأكفأ) ثالثاً: العنف اليهودي (الحاميات- شعار اليد العاملة اليهودية فقط – الخ) مضافاً إلى العنف الاستعماري (الطريقة التي قمعت فيها انتفاضة 1929).
إن الحديث عن ثورة 36-1939 يستلزم وقفة خاصة عند الشيخ عز الدين القسام، فبالرغم من الكثير الذي كتب عنه إلا أنه بوسعنا أن نقول بأن هذه الشخصية الفريدة ما تزال، وربما ستظل، شخصية مجهولة في الحقيقة. أن معظم الذي كتب عنه قد مسه من الخارج فحسب. وبسبب هذه السطحية في دراسة شخصيته لم يتردد عدد من المؤرخين اليهود في اعتباره “درويشاً متعصباً”، فيما أهمله الكثيرون من المؤرخين الغربيين، وفي الواقع يبدو أن الإخفاق في إدراك العلاقة الجدلية بين الدين والنوازع الوطنية في العالم المتخلف هو المسؤول عن التقليل من أهمية الحركة القسامية. ولكن مهما كان الرأي في أفكار القسام، فمما لا ريب فيه أن حركته (12/11/1935 – 19/11/1935) كانت نقطة انعطاف لعبت دوراً مهماً في تقرير شكل متقدم من أشكال النضال، إذ أنها وضعت زعامات الحركة الوطنية الفلسطينية التقليدية، التي كانت قد انشقت على نفسها وتشتتت وتشرذمت، أمام امتحان لا يمكن الفرار منه.
ولعل شخصية القسام تشكل في حد ذاتها نقطة التقاء رمزية لمجموعة هائلة من العوامل المتداخلة التي تشكل في مجموعها ما صار يسمى تبسيطاً بالقضية الفلسطينية: فـ “سوريته” (هو من مواليد جبلة، قضاء اللاذقية، 1871) تمثيل للعامل القومي العربي في المعركة. و”أزهريته” (فقد درس في الأزهر) تمثيل للعامل الديني – الوطني الذي كان يمثله الأزهر في بداية القرن. و”نضاليته” ( فقد اشترك في ثورة جبل حوران السورية ضد الفرنسيين من 1919-1920 وحكم بالإعدام) هي تمثيل لوحدة النضال العربي.
وقد جاء القسام مع الشيخ محمد الحنفي (المصري) والشيخ علي الحاج عبيد إلى حيفا في 1921 وبدأ لتوه العمل في إنشاء حلقات سرية. إن ما يلفت النظر في النشاط القسامي عقله التنظيمي المتقدم، وصبره الحديدي: فقد رفض عام 1929 الاندفاع في الإعلان عن وجوده المسلح، وبالرغم من أن هذا الرفض قد أدى إلى انشقاق في تنظيمه، إلا أنه استطاع أن يظل متماسكاً وسرياً . ويقول أحد القساميين المعروفين(67) أن القسام برمج ثورته في أربع مراحل: الإعداد النفسي ونشر روح الثورة، إنشاء حلقات سرية، تشكيل لجان لجمع التبرعات ولجان لشراء السلاح، ولجان تدريب، ولجان أمن وتجسس، ولجان دعاية وإعلام، ولجان اتصالات سياسية. ثم الثورة المسلحة.
إن معظم العارفين بالقسام يقولون أن خروجه إلى تلال يعبد مع 25 من رجاله ليل 12/11/1935 لم تكن غايته إعلان الثورة المسلحة، ولكن نشر الدعوة للثورة، إلا أن اشتباكاً عرضياً أدى إلى افتضاح أمر وجوده هناك، وبالرغم من استبساله مع رجاله فقد قضت قوة بريطانية على مجموعته بسهولة، ويبدو أن الشيخ القسام، حين شعر بأنه لم يعد بوسعه توسيع الثورة مع رفاقه، رفع شعاره المشهور: “موتوا شهداء”. ومن حق القسام أن نفهم شعاره هذا فهماً “غيفاريا” إذا جاز التعبير، ولكن على المستوى الوطني العادي، إن سلوك القسام من خلال الشهادات القليلة التي نملكها عنه تدل على أنه كان يدرك أهمية دوره كمفجر لبؤرة ثورية أمامية. وما لبث هذا الشعار أن أثمر على التو: فقد شيعت الجماهير جثمان شهيدها مشياً على الأقدام إلى قرية ياجور مسافة 10 كيلو مترات، على أن أهم ما في الأمر كان افتضاح القيادات التقليدية أمام التحدي الذي مثله الشيخ القسام. وقد شعر هؤلاء القادة بهذا التحدي بنفس المقدار الذي شعر فيه الانتداب البريطاني. ويقول أحد القساميين أنه قبل أن يصعد القسام إلى الجبال بشهور قليلة أرسل إلى الحاج أمين الحسيني بواسطة الشيخ موسى العزراوي يطلب منه التنسيق لإعلان الثورة في جميع أنحاء البلاد، إلا أن الحسيني رفض، بحجة أن الظروف لم تنضج بعد(68).
وعندما استشهد القسام لم يسر في جنازته إلا الفقراء، واتخذ الزعماء موقفاً فاتراً ما لبثوا أن أدركوا خطأه، فقد شكل استشهاد القسام حدثاً بارزاً لم يكن بوسعهم تجاوزه بالتجاهل، والدليل على ذلك أن ممثلي الأحزاب الفلسطينية الخمسة قاموا بزيارة المندوب السامي البريطاني بعد ستة أيام فقط من استشهاد القسام، وقدموا له مذكرة لعلها من أندر المذكرات صفاقة، فقد اعترفوا بـ “أنهم إذا لم يتلقوا عن مذكراتهم هذه جواباً يمكن اعتباره بصورة عامة مرضياً، فإنهم سيفقدون كل ما يملكونه من نفوذ على أتباعهم، وعندئذ تسود الآراء المتطرفة غير المسؤولة، وتتدهور الحالة سريعاً”(69). فمن الواضح أنهم كانوا يريدون توظيف ظاهرة القسام لتحقيق خطوة إلى الوراء. على أن الشهيد القسام كان قد فوت عليهم، بالشكل النضالي الذي قرره، فرصة التراجع، وهذا في الواقع ما يفسر اختلاف موقف الزعماء الفلسطينيين من استشهاد الشيخ القسام فور حدوثه عن موقفهم في الاحتفال الأربعيني باستشهاده، فقد اكتشفوا خلال هذه الأيام الأربعين أنهم إذا لم يحاولوا ركوب الموجة الشامخة التي فجرها القسام، فإنها ستطويهم، ولذلك قفزوا من الفتور في جنازته، إلى المهرجانات والخطابات في اليوم الأربعين لاستشهاده.
ويبدو أن الحاج أمين الحسيني سيظل فيما بعد شاعراً بهذه الثغرة، وحتى بعد أكثر من عشرين سنة ستظل مجلة “فلسطين” الناطقة بلسان الهيئة العربية العليا، تحاول الإيحاء بأن الحركة القسامية إنما كانت جزءاً من نشاط الحركة التي كان يقودها المفتي، وأن هذا الأخير والقسام، كانا “أصدقاء شخصيين”(70).
أما البريطانيون فقد رووا قصة القسام في تقريرهم السنوي الذي جرى تقديمه إلى لجنة الانتدابات في جنيف عن وقائع 1935 كما يلي: “انتشرت في الجو إشاعات عن عصابة للإرهاب تألفت بوحي من عوامل سياسية دينية، وفي يوم 7 تشرين الثاني 1935 كان جاويش ونفر من البوليس يقتفيان أثر سرقة في هضاب قضاء الناصرة فأطلق مجهولون النار فقتلوا الشاويش … وسرعان ما أدى هذا الحادث إلى اكتشاف عصابة كانت في ذلك الجوار تحت قيادة عز الدين القسام، وهو لاجئ سياسي من سوريا، وهو ذو مكانة ليست بالقليلة كرجل من رجال الدين، وقد اشتبه به اشتباهاً قوياً قبل ذلك ببضع سنوات، وقيل أن له ضلعاً في أعمال إرهابية. ولقد حضر جنازة الشيخ القسام في حيفا جمع غفير جداً، وبالرغم من الجهود التي بذلها كبار المسلمين في توطيد النظام أثناء الجنازة إلا أنه وضعت مظاهرات وقذف أحجار، وبعثت وفاة القسام موجة قوية من الشعور في الدوائر السياسية وغيرها في البلاد، واتفقت آراء الصحف العربية على تسميته بالشهيد فيما كتبته عنه من المقالات ..”(71).
وقد شعر البريطانيون بدورهم بالتحدي الذي مثله استشهاد القسام، وحاولوا بدورهم شد عقارب الساعة إلى الوراء، ولذلك كان رأي المندوب السامي البريطاني الذي كتبه لوزير المستعمرات في تلك الفترة بأنه ما لم تلب مطالب الزعماء العرب “فإنهم سيفقدون ما يملكونه من نفوذ وتختفي بالتالي إمكانات تهدئة الحالة الحاضرة بالوسائل المعتدلة التي اقترحتها”(72). ولكن إعادة عقارب الزمن إلى الوراء كانت مستحيلة، فحركة القسام كانت تعبيراً في الواقع عن الشكل الطبيعي القادر على معالجة ازدياد التناقض وحسمه، وسرعان ما انعكست في عدد من اللجان والتجمعات، وصار يتعين على القيادة التقليدية أن تختار بين الوقوف في وجه ذلك التصاعد في إرادة القتال لدى الجماهير، أو في امتصاص هذه الرغبة والتكلس فوقها. وبالرغم من أن البريطانيين تحركوا بسرعة، فعرضوا فكرة إقامة مجلس تشريعي وفكرة الحد من بيع الأراضي إلا أن ذلك جاء متأخراً، وأسهمت الحركة الصهيونية التي بدأت في تلك الفترة تبلور إرادتها بصورة قوية في إضعاف فاعلية العرض البريطاني، ومع ذلك فإن قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية لم تكن قد حسمت موقفها بعد، وكان تذبذبها بارزاً بصورة تدعو للدهشة، وحتى 2 نيسان 1936 كان ممثلو الأحزاب الفلسطينية مستعدين لتشكيل وفد للذهاب إلى لندن لطرح وجهة نظرهم أمام الحكومة البريطانية.
وقد انفجر الموقف قبل أن تقرر قيادة الحركة الوطنية تفجيره. فحين اندلعت شرارة شباط 1936 في يافا كان زعماء الحركة الوطنية الفلسطينية يعتقدون أنه ما زال بوسعهم أن يكسبوا من بريطانيا مطالب جزئية عن طريق المفاوضات. ولكن الأحداث التالية فاجأتهم: إن جميع المقربين من أحداث نيسان 1936 يعترفون بأن اندلاع العنف، والعصيان المدني، كان عفوياً، وإذا استثنينا الأعمال التي حركها بقايا القساميين، فإن كل ما حدث كان تعبيراً عفوياً عن المستوى الحرج الذي وصله التناقض. وحتى عند إعلان الإضراب العام في 19 نيسان 1936 كانت زعامة الحركة الوطنية متخلفة عنه، ولكنها سرعان ما تعلقت بالقطار فبل أن يفوتها، ونجحت – للأسباب التي ذكرناها في تحليل الوضع الاجتماعي السياسي في فلسطين آنذاك – بالسيطرة على الحركة الوطنية.
كانت الحركة الوطنية الفلسطينية ممثلة، من الناحية التنظيمية، في عدد من الأحزاب هي في مجملها الإفرازات التي تبقت عن الحركات التي نشأت ضد العثمانيين منذ أوائل القرن، وهذا يعني أنها – من جهة – لم تكن متمرسة بالنضال الاستقلالي (مثلما كان الحال في مصر مثلاً) ويعني-من جهة أخرى – أنها كانت إطارات عامة، دون مبادئ محددة، تحكمها شلل من الوجهاء، وتعتمد على ولاءات منحدرة إليها من نفوذها الديني أو الإقطاعي أو الوجاهي، ولكنها لم تكن أحزاباً لها قواعد منظمة. وفيما عدا القسام نفسه (والشيوعيون طبعاً) فإن أحداً من زعماء الحركة الوطنية الفلسطينية في هذه الفترة لم يكن مسلحاً بعقل تنظيمي. أما الحاج أمين الحسين، الذي كان يمتلك قدرات إدارية نادرة فقد كان عقله بعيداً عن العقل التنظيمي بالمعنى النضالي. وإن المسؤوليات التنظيمية ظلت في معظم الوقت مواهب فردية في اللجان الفرعية والكادر الأوسط، وغالباً ما كانت تعجز عن تحول كفاءاتها إلى قوانين.
عشية الثورة كان وضع ممثلي الحركة الوطنية في فلسطين كالتالي: فمع انحلال اللجنة التنفيذية العربية في آب 1934 برزت 6 مجموعات:
1- الحزب العربي الفلسطيني آيار 1935، يرأسه جمال الحسيني، وهو ممثل تقريباً لسياسة المفتي ويمثل الإقطاعيين وكبار تجار المدن.
2- حزب الدفاع الوطني، يرأسه راغب النشاشيبي، وتأسس في كانون الأول 1934، وهو يمثل البرجوازية المدينية الناشئة، وكبار الموظفين.
3- حزب الاستقلال الذي كان قد تأسس عام 1932 برئاسة عوني عبد الهادي، وهو يجمع المثقفين والبرجوازية الوسطى وبعض قطاعات البرجوازية الصغيرة، وساعد ذلك على بروز دور خاص للجناح اليساري فيه.
4- حزب الإصلاح الذي أسسه الدكتور حسين الخالدي في آب1935، وهو ممثل لعدد من المثقفين.
5- حزب الكتلة الوطنية الذي يرأسه عبد اللطيف صلاح.
6- حزب الشباب الفلسطيني الذي يرأسه يعقوب الغصين.
إن هذا التعدد في فصائل العمل الوطني كان شكلياً، ولم يكن يعبر تعبيراً واضحاً وحاسماً عن الخارطة الطبقية في البلاد، فالأكثرية الساحقة من الجماهير لم تكن ممثلة فيه (يقول نيفيل باربور أن 90 بالمائة من الثوار كانوا فلاحين يعتبرون أنفسهم متطوعين). وإذا نظرنا إلى التوزيع الطبقي في فلسطين في 1931 نرى أن 59 بالمائة من العرب كانوا فلاحين (19.1 بالمائة من اليهود) و 12.9بالمئة من العرب يعملون في البناء والصناعة والتعدين ( 30.6 بالمائة من اليهود) و 6 بالمائة من العرب يعملون في المواصلات، و 8.4 بالمائة بالتجارة، و 1.3 بالمائة في الإدارة ..الخ (73).
إن ذلك يعني بأن الغالبية الساحقة من السكان لم تكن ممثلة في هذه الأحزاب التي بالرغم من أنها تمثل الإقطاع ورجال الدين والكومبرادورية المدينية وقطاعات معينة من المثقفين فقد كانت دائماً خاضعة في تحالفها لزعامة المفتي وطبقته، هذه الطبقة التي مثلت الإقطاع – الاكليريكي والتي كانت أكثر وطنية من الزعامة التي مثلت البرجوازية المدينية.
أما البرجوازية المدينية فقد مثلها الأفندية في فترة كانوا يتجهون فيها نحو توظيف أموالهم في الصناعة والأعمال ( وقد تبلور هذا الاتجاه بعد هزيمة ثورة 36-1939 ). وكانت البرجوازية الصغيرة بالإجمال، (التجار الصغار وأصحاب الدكاكين والمعلمون والموظفون وأصحاب الحرف) دون زعامة، وكانت، كطبقة، غير ذات نفوذ وغير ذات أهمية تحت الحكم التركي الذي اعتمد على طبقة الأفندية التي أعطاها الأتراك حق الحكم المحلي بصفتها نمت حول الأرستقراطية الإقطاعية. أما الحركة العمالية فقد كانت ضعيفة وناشئة، ومع ذلك تعرضت إلى عسف السلطة من جهة أولى، والمنافسة الساحقة للبروليتاريا والبرجوازية اليهودية من جهة ثانية، ولاضطهاد زعامة الحركة الوطنية العربية من جهة ثالثة.
وقبل تشكيل اللجنة العربية العليا في 25 نيسان1936 برئاسة الحاج أمين الحسين ، كان جمال الحسيني زعيم الحزب العربي مستاء من نمو اعتقاد لدى الناس بأن الإنكليز هم العدو الحقيقي، وكان حزب الدفاع الوطني الذي يمثل بالدرجة الأولى الكومبرادور المديني النامي غير ميال أصلاً للصدام مع البريطانيين صداماً مفتوحاً. قبل ذلك بيومين اثنين فقط، أي في 23 نيسان 1936، ألقى وايزمان، زعيم الحركة الصهيونية آنذاك، خطاباً في تل أبيب وصف فيه الصراع العربي – الصهيوني، الآخذ في التفجر، بأنه صراع بين عناصر الهدم وعناصر العمران، واضعاً بهذا الوصف القوي الصهيونية في مكانها من الآلة الاستعمارية عشية الصدام المسلح. كان ذلك هو الموقف على طرفي الميدان عشية الثورة!
في الريف اتخذت الثورة طابع العصيان المدني والعصيان المسلح، وتقاطر المئات من المسلحين للالتحاق بالعصابات التي أخذت تنتشر في الجبال، وكان الامتناع عن دفع الضرائب قد أقر في مؤتمر 7 أيار 1936 الذي عقد في كلية روضة المعارف الوطنية في القدس وحضره حوالي 150 مندوباً يمثلون عرب فلسطين، وإن استعراضاً بسيطاً لأسماء المؤتمرين كما أوردها عيسى السفري(74) يدل بأنه قد تم في هذا المؤتمر بالذات تكريس قيادة الحركة الجماهيرية لحلف واه بين الزعامات الإقطاعية الدينية وبين البورجوازية التجارية المدينية وبين عدد محدود من المثقفين، وكان القرار الذي اتخذ في هذا المؤتمر موجزاً، ولكنه يعبر تعبيراً واضحاً عن المدى الذي كانت قيادة من هذا النوع قادرة على الذهاب إليه:
“قرر المؤتمر بالإجماع إعلان الامتناع عن دفع الضرائب اعتباراً من يوم 15 أيار 1936 الحالي، إذا لم تغير الحكومة البريطانية سياستها تغييراً أساسياً تظهر بوادره بوقف الهجرة اليهودية”.
لقد وجه البريطانيون ضربتهم، في الرد على العصيان المدني والعصيان المسلح، نحو مفصلين:
الأول الكادر التنظيمي الذي كان بالإجمال أكثر ثورية من القيادة، والثاني الجماهير الفقيرة المشتركة في الثورة والتي لم تكن تتمتع في الحقيقة إلا بحماية سلاحها ذاته. ذلك يفسر إلى حد بعيد أن العنصرين الوحيدين اللذين يتمتعان بكفاءة تنظيمية نسبية في قيادة الثورة، وهما عوني عبد الهادي ومحمد عزة دروزة، قد جرى اعتقالهما، فيما لم يتعرض الآخرون إلى اعتقال أو مضايقة تصل إلى حد الشل الكلي، ويدل على ذلك أنه تم اعتقال 61 مناضلاً عربياً من المسئولين عن تنظيم الإضراب (الكادر الوسط)، وذلك في 23 أيار، إلا أن هذا الاعتقال لم يمنع بريطانيا من منح تأشيرة سفر إلى أربعة من زعماء الثورة، هم جمال الحسيني وشبلي الجمل وعبد اللطيف صلاح والدكتور عزت طنوس للسفر إلى لندن ومقابلة وزير المستعمرات وذلك في 12 حزيران. ومثل هذا الحادث الذي سيتكرر بإطراد طيلة الأشهر والسنوات التالية ليس غريباً، فقد كان المندوب السامي البريطاني يلاحظ بارتياح شديد أن “خطب يوم الجمعة قد اقترنت بدرجة من الاعتدال تفوق بكثير ما كنت أتوقعه، في وقت بلغت فيه حدة المشاعر عمقاً كبيراً، والفضل في ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى المفتي”(75).
لقد تبلور الموقف منذ البدء بأن اعتبرت قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية الثورة الجماهيرية مجرد ضاغط يهدف إلى تحسين أوضاعها كطبقة لدى الاستعمار البريطاني، وقد أدرك البريطانيون هذا الواقع إدراكاً عميقاً وتصرفوا وفقه، ولكنهم مع ذلك لم يكلفوا أنفسهم عناء منح تلك الطبقة الامتيازات التي تطمح لها، فقد كانت لندن مصرة على تلبية التزاماتها إزاء تسليم الإرث الاستعماري في فلسطين للحركة الصهيونية، وعلى العكس تماماً، فان سنوات الثورة 36-39 كانت السنوات التي رمى الاستعمار البريطاني بثقله،خلالها، لإنجاز مهمة تصليب الوجود الصهيوني وإيقافه على قدميه كما سنرى فيما بعد. وقد نجح البريطانيون في تحقيق ذلك خلال وسيلتين: الأولى هي ضرب فقراء الفلاحين الثائرين بعنف لا مثيل له، والثانية استخدام نفوذهم الواسع لدى الأنظمة العربية، التي لعبت دوراً كبيراً في تصفية الثورة:من الجهة الأولى لعب قانون الطوارئ البريطاني دوره بفعالية، ويورد السفري مجموعة أحكام صدرت آنذاك للتدليل على عسف هذا القانون: “ست سنوات حبس لحيازة مسدس – 12 سنة لحيازة قنبلة – خمس سنوات مع الأشغال الشاقة لحيازة 12 رصاصة – 8 أشهر بتهمة تضليل فريق من الجند عن الطريق – تسع سنوات بتهمة حيازة مفرقعات – 5 سنوات لمحاولة شراء ذخيرة من الجنود – أسبوعان حبس لحيازة عصا” …الخ (76). ووفق تقرير بريطاني قدم إلى عصبة الأمم فان عدد القتلى العرب خلال ثورة 1936 يبلغ حوالي الألف، هذا عدا عن الجرحى والمفقودين والمعتقلين. واستخدم البريطانيون سياسة نسف البيوت على نطاق واسع، فبالإضافة إلى عملية نسف وهدم جزء من مدينة يافا (18 حزيران 1936) ويقدر عدد البيوت التي نسفت فيها بـ 220 وعدد الذين شردوا نتيجة النسف بـ 6 آلاف نسمة، نقول، بالإضافة إلى ذلك جرى هدم مائة تخشيبة في الجبالية و 300 في أبو كبير، و 350 في الشيخ مراد و 75 في عرب الداودي، ومن الواضح أن سكان الأحياء التي هدمت في يافا، والتخشيبات في ضواحيها هم من فقراء الفلاحين الذين هجروا الريف إلى المدن، أما في القرى فقد عدد السفري حوالي 143 بيتاً جرى نسفها لأسباب تتعلق مباشرة بالثورة(77). وهذه البيوت تخص فقراء الفلاحين وبعض الفلاحين المتوسطين وعدداً يسيراً جداً من العائلات الإقطاعية. ومن الجهة الثانية بدأ الأمير عبد الله أمير شرق الأردن، ونوري السعيد، نشاطهما للتوسط لدى الهيئة العربية العليا، إلا أن هذه الوساطات لم تفلح بالرغم من استعداد الزعامات لتلبيتها، ولكن الحركة الجماهيرية كانت حتى ذلك الوقت (آب 1936) غير قابلة للتدجين بعد، على أن هذه الاتصالات أثرت تأثيراً سلبياً على الثورة، وتركت في الجو شعوراً بأن التناقض القائم هو تناقض قابل للتسوية، وبالفعل فإن هذه البداية التي بدت فاشلة ستحقق نجاحاً كاملاً في تشرين الأول من العام نفسه، أي بعد حوالي ستة أسابيع فقط!
على أن هذه الصلات لم تكن الشكل الوحيد لجدلية العلاقات بين فلسطين والبلدان العربية المجاورة، فقد كانت هذه الجدلية أكثر تعقيداً، وتعكس مجمل التناقضات المركبة، وكنا قد لاحظنا ما مثله القسام في هذا المجال، والواقع أن الظاهرة القسامية بهذا المعنى استمرت بالحدوث، فقد تدفق إلى فلسطين عدد كبير من المناضلين العرب مثل سعيد العاص (الذي استشهد في تشرين الأول 1936) والشيخ محمد الأشمر وغيرهما الكثير، على أن التدفق هذا شمل أيضاً عدداً من الضباط الوطنيين المغامرين، وأبرز هؤلاء كان فوزي القاقوجي الذي ما لبث بعد دخوله إلى فلسطين في آب1936، على رأس عصابة صغيرة، أن أعلن نفسه قائداً عاماً للثورة وبالرغم من أن هؤلاء قاموا بتحسين تكتيكات الثوار وتوسيعها إلا أن العبء الأكبر من العنف الثوري في الريف، والعمل الفدائي في المدن، ظل يتحمله الفلاحون المعدمون بالدرجة الأولى.
والواقع أن”الضباط” الذين بزغوا من صفوف الفلاحين أنفسهم ظلوا هم الذين يلعبون الدور الرئيسي، ولكن معظمهم كان يخضع لقيادة المفتي، ومع ذلك فهم الذين يمثلون البطولة الأسطورية للجماهير في هذه الثورة.
وبالرغم من أن الموظفين البريطانيين في فلسطين لم يكونوا يوافقون تماماً على سياسة لندن، المستميتة في دعم الحركة الصهيونية، والذين كانوا يرون أن هناك متسعاً لزعامة طبقية عربية ليست مرتبطة المصلحة بالثورة، للتعامل مع الاستعمار، إلا أن بريطانيا قررت كما يبدو، نهائياً، في19 حزيران 1936 “أهمية الارتباط العضوي بين سلامة المصالح البريطانية وبين نجاح الصهيونية في فلسطين”(78). وقررت بريطانيا دعم قوتها في فلسطين، وزيادة إجراءاتها القمعية هناك.
و قد تزعزعت قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية وفقدت أعصابها وانتابها الخوف في أعقاب ذلك القرار، وسارع الحاج أمين الحسيني وراغب النشاشيبي وعوني عبد الهادي لمقابلة المندوب السامي البريطاني، ويبدو من تقارير بعث بها المندوب المذكور آنذاك إلى حكومته أن هؤلاء هم الذين شددوا بالإحياء بأنهم مستعدون لإنهاء الثورة”إذا طلب منهم ملوك العرب ذلك”. إلا أن هؤلاء لم يجرءوا قط على الاعتراف أمام الجماهير بأنهم هم أصحاب تلك الفكرة الملتوية بل كرروا نفيها عدة مرات وإثر ذلك تدفقت أعداد كبيرة من الجنود البريطانيين تقدر بعشرين ألف جندي إلى فلسطين، وفي 30أيلول 1936 بعد استكمال وصول القوات البريطانية، صدر مرسوم بالأحكام العرفية، وضاعفت سلطة الانتداب خطها القمعي المتصلب.
وقد شهد أيلول وتشرين الأول أعنف المعارك، وهي المعارك الأخيرة في الواقع التي شملت جميع أنحاء فلسطين تقريباً آنذاك، وفي 11/10/1936وزعت اللجنة العربية العليا بياناً يطلب إنهاء الإضراب، وبالتالي الثورة، “ولما كان الامتثال لإرادة أصحاب الجلالة و السمو ملوك العرب، والنزول على إرادتهم، من تقاليدنا العربية الموروثة، وكانت اللجنة العربية تعتقد اعتقادا جازماً أن أصحاب الجلالة والسمو لم يأمروا أبناءهم إلا لما فيه مصلحتهم وحفظ حقوقهم، لذلك فاللجنة العربية العليا، امتثالاً لإرادة أصحاب الجلالة والسمو الملوك والأمراء، واعتقاداً منها بعظم الفائدة التي تنجم عن توسطهم ومؤازرتهم، تدعوا الشعب العربي الكريم إلى إنهاء الإضراب والاضطراب إنفاذاً لهذه الأوامر السامية التي ليس لها من هدف إلا مصلحة العرب”(79).
بعد ذلك بشهر واحد بالضبط (في 11/11/1936) تعلن “القيادة العامة للثورة العربية في سوريا الجنوبية-فلسطين” في بلاغ وقعه فوز الدين القاقوجي، أنها “تطلب توقيف أعمال العنف تماماً، وعدم التحرش بأي شئ يفسد جو المفاوضات التي تأمل فيهم الأمة العربية الخير، ونيل حقوق البلاد كاملةً”(80).
وبعد عشرة أيام تصدر القيادة المذكورة بيانا آخر يعلن “ترك الميدان اعتمادا على ضمانة الملوك والأمراء العرب وحفظاً لسلامة المفاوضات”(81).
ويقول جميل الشقيري: “فطوعاً لأوامر الملوك والأمراء انحل الإضراب، وأوقفت أعمال الثورة بظرف ساعتين على إعلان النداء”!(82).
ورغم أن بريطانيا قامت في تلك الفترة بتحدي القيادات الفلسطينية بالضبط في النقطة التي خدعوا فيها الجماهير، وهي المتعلقة بموضوع الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وأن هذه القيادات قررت مقاطعة اللجنة الملكية (لجنة بيل) إلا أن الملوك والأمراء العرب أرغموا هذه القيادات مرة أخرى في أقل من ثلاثة شهور، على الطاعة فقد كتب الملك عبد العزيز آل سعود والملك غازي رسائل إلى الحاج أمين الحسيني تقول”… وبالنظر لما لنا من الثقة بحسن نية الحكومة البريطانية لإنصاف العرب، فقد رأينا أن المصلحة تقضي الاتصال باللجنة الملكية”. على أن هذا الحادث، الذي يبدو جزئياً، مزق ذلك التحالف في قيادة الحركة الوطنية، إذ أن القوى التي كانت تقف إلى يمين الحاج أمين الحسيني، والتي يتزعمها حزب الدفاع سارعت إلى معارضة قرار مقاطعة لجنة بيل، وأبدى الحزب عدة دلائل تشير إلى رغبته في قبول مشروع التسوية التي كانت بريطانيا ستعرضه، وقد استند زعماء هذا الحزب، الذي كان يمثل بالدرجة الأولى أفندية المدن، إلى التذمر الذي أصاب كبار التجار العرب في المدينة نتيجة الإضراب، وإلى التخلخل الذي طرأ على مصالح البرجوازية المدينية التي كانت تعتمد على علاقات اقتصادية وطيدة ممثلة بوكالاتهم عن الصناعة البريطانية وأحياناً اليهودية.
وساندت الأنظمة العربية، خصوصاً نظام شرق الأردن، موقف هذا اليمين بكل قوة، ولم يكن عند الحاج أمين الحسيني وما يمثله أي حافز للميل إلى جهة اليسار الذي كان عملياً قد بدأ يعمل على تصفيته، وهكذا شرع موقفه يزداد تذبذباً وتردداً، وبدا أنه أضحى في موقع لا يستطيع معه المضي بالثورة ولا حتى خطوة إلى الأمام، كما أن التراجع إلى الوراء لم يعد يفيده، ومع ذلك فحين اعتقد البريطانيون أن تصفية المفتي سياسياً أضحت ممكنة خلال فترة الهدوء التي أعقبت إنهاء الإضراب اكتشفوا أن ذلك ليس صحيحاً، وأن يمين المفتي ما زال أضعف بكثير من أن يضبط الموقف، واستمر المندوب السامي البريطاني، بخبث، يدرك ضخامة الدور الذي يستطيع المفتي لعبه وهو محصور بذلك الموقف بين حزب الدفاع عن يمينه وحزب الاستقلال (جناحه اليساري) وحركات الشبيبة المثقفة عن يساره، كان هذا المندوب السامي يدرك قدرة بريطانيا على الاستفادة من الهامش الواسع القائم بين “صلابة القرويين الذين قاومونا ستة أشهر وهم يتلقون أجوراً ضئيلة ولا يقدمون على النهب” وبين “ضعف أو انعدام الصفات القيادية العظيمة لدى أعضاء اللجنة (العربية العليا) العشرة “(83).وقد اتضحت صحة نظرة المندوب السامي إلى الدور المحدود الذي يستطيع يمين المفتي أن يلعبه حين عجز حزب الدفاع عن الوقوف بوضوح أمام تقرير لجنة بيل الذي صدر في تموز1937 والذي اقترح التقسيم وإنشاء دولة يهودية.وقد اتضحت في الوقت ذاته،ضغط أولئك الذين يقفون على يسار المفتي إلى إفقاده اعتداله لم تكن خشية بلا أسباب، على أن ذلك الضغط لم يحدث من قبل الجهة التي توقعها المندوب السامي، بل من قبل الكادر الأوسط الذي كان ما يزال ممثلاً في اللجان القومية، والذي كان يمثل يومياً بأفواج من الفلاحين المعدمين والعمال العاطلين عن العمل في المدن والأرياف.وهكذا لم يكن أمام المفتي إلا أن يهرب إلى الأمام، فقد تجنب الاعتقال بأن اعتصم في الحرم الشريف، ولكن الأحداث دفعته إلى موقع لم يكن ليستطيع الوقوف فيه قبل ذلك بعام.ففي أيلول 1937أطلق أربعة من الفدائيين المسلحين النار على أندورز، حاكم الجليل فيما كان يخرج من الكنيسة الانغليكانية في الناصرة فأرادوه قتيلاً، “لقد كان أندروز الرسمي الوحيد الذي أدار الانتداب وفق ما كان يعتبره الصهاينة صحيحاً، وقد فشل في كسب ثقة الفلاحين العرب”.كان العرب يعتبرونه صديقاً لليهود، وأن مهمته هي تسهيل انتقال لواء الجليل إلى الدولة اليهودية التي حددها مشروع التقسيم، كان الفلاحون العرب يكرهونه ويتهمونه بتسهيل بيع أراضي الحولة، أما الفدائيون الذين صرعوه فمن المعتقد أنهم ينضمون لإحدى خلايا السرية التي كانت للقساميين(84).
ومع أن اللجنة العربية العليا استنكرت هذا الحادث في الليلة ذاتها، إلا أن الموقف، تماماً كما كان الأمر عند استشهاد القسام كان قد خرج من بين أيدي المفتي وجماعته، وكان عليهم إذا ما أرادوا البقاء على رأس الحركة الوطنية، اللحاق بها وركب موجتها كما حدث في نيسان 1926.إلا أن هذه المرة كانت الاندفاعة الثورية عند الجماهير أشد عنفاً, ليس فقط بسبب الخيرات التي اكتسبوها أثناء تجربة العام الماضي, ولكن أيضا بسبب ازدياد وضوح التناقض القائم أمام أعينهم, ومن المؤكد أن هذه المرحلة من الثورة قد اتجهت بصورة جوهرية, أن لم نقل كلية, ضد البريطانيين وليس ضد الصهيونيين, وقد أفرز نمو التناقض المواقف إفرازاً اكثر حسماً:هيمن الفلاحون كلياً تقريبا على الثورة, وتراجع دور البرجوازية المدينية قليلاً إلى الوراء, وأخذ أثرياء الريف وكبار الفلاحين المتوسطين يترددون في مساندة الثوار, وانتقلت القوى الصهيونية إلى حالة هجومية فعالة.
مسألتان هامتان
إن مسألتين هامتين في هذه المرحلة من الثورة، ينبغي التوقف عندهما: الأولى:أن “العرب اتصلوا باليهود مقترحين التوصل معهم إلى نوع من الاتفاق على أساس قطع العلاقات مع بريطانيا قطعاً تاماً، ولكن اليهود رفضوا ذلك على الفور لأنهم يعتبرون علاقاتهم ببريطانيا مسألة جوهرية”(85). وقد ترافق ذلك مع ارتفاع عدد اليهود الذين يخدمون في البوليس في فلسطين من 365 عام 1935إلى 682 عام 1936، وفي أواخر ذلك العام أذنت الحكومة بتجنيد 1240 يهودياً كبوليس إضافي مسلح ببنادق حربية، وارتفع العدد بعد شهر إلى 2863مجنداً (86). ولعب ضباط بريطانيون دوراً بارزاً في قيادة مجموعات يهودية للهجوم على قرى عربية. والثانية:أن وجود زعامة الثورة خارج فلسطين (في دمشق) قد جعل دور القيادات المحلية المنحدرة من أصل فلاحي فقير في معظمها دوراً أكبر مما كان في الحقبة المنصرمة، وكان هؤلاء يرتبطون مع الفلاحين ارتباطاً وثيقاً، وذلك يفسر، إلى حد بعيد، المدى الأبعد الذي كان بوسع الثورة أن تصله.لقد برز في هذه الحقبة، على سبيل المثال، عبد الرحيم الحاج محمد كقائد محلي، ويقول الشيوعيون أنهم كانوا يتصلون به ويزودونه بالمعلومات(87). وكان من الممكن أن يشكل هذا التطور نقطة انعطاف تاريخية في الثورة لولا ضعف “اليسار”، بمعناه النسبي ومعناه الحقيقي، ولولا اضطرار هذه القيادات المحلية للاحتفاظ بصلتها التنظيمية إلى حد معين مع”اللجنة المركزية للجهاد” في دمشق، وذلك ليس فقط بسبب الولاء التقليدي لها، ولكن أيضاً بسبب اعتمادها بدرجة من الدرجات على تمويلها. في تاريخ النضال الفلسطيني برمته لم تكن الثورة الشعبية المسلحة أقرب إلى الانتصار مما كانت عليه في تلك الشهور التي امتدت بين أواخر1937وأوائل1939. لقد ضعفت في هذه الفترة سيطرة القوات البريطانية على فلسطين ووصلت هيبة الاستعمار إلى الحضيض، وأصبحت سمعة الثورة ونفوذها هما القوة الأساسية في البلاد. إلا أن ما حدث في هذا الوقت أيضاً هو ازدياد قناعة بريطانيا بأن عليها الاعتماد على القوى الصهيونية إن هي أرادت سيطرة طويلة الأمد على الوضع، وقد أعطاها الصهاينة حالة فريدة لم تكن لها في أي من مستعمراتها.هذه الحالة هي توفر قوة محلية لها مع الاستعمار البريطاني قضية مشتركة، ومشحونة حتى أقصى الحالات ضد السكان المحليين.
في تلك الفترة بدأت بريطانيا تخشى من اضطرارها لتحويل جزء من قوتها العسكرية لمواجهة المأزق الأوروبي المتصاعد الحدة، ولذلك أخذت تميل باطراد نحو “الإسراع في تنظيم قوة دفاع يهودية متطوعة، بالإضافة إلى القوة القائمة وعددها6500 مسلح”(88). وقد مضت قدماً في سياسة الاعتماد على القوة المحلية الصهيونية وتسليمها جزءاً كبيراً من واجبات القمع الذي كان يتسع، ومع ذلك فإنها لم تقطع ذلك الجسر الذي كانت تتركه دائماً قائماً بينها وبين قيادة الطبقات التي كان يتزعمها المفتي، وقد لعب البريطانيون في هذا المجال بالذات، وفي هذه الفترة بالتحديد، دوراً بارزاً في إبقاء المفتي بمثابة الممثل غير المنازع لعرب فلسطين، فقد كان إحتياطيهم من القيادة الواقفة على يمين المفتي من اعتباره الزعيم الأوحد إلا عملية “لا تبقى من يستطيع تمثيل العرب سوى قادة الثورة في الجبال”(89)، على حد قول المندوب السامي البريطاني لفلسطين، ولاشك أن ذلك من بين أسباب أخرى ساعد على إبقاء الحاج أمين الحسيني على قمة قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية رغم أنه كان قد غادر مكان اختفائه في الأقصى، بأسلوب مثير، وظل في دمشق منذ أواخر تشرين الأول1937.
إن العسف البريطاني الذي تصاعد بصورة غير متوقعة، وتصاعد عمليات المداهمة والاعتقال الجماعي والإعدام طوال 1937و1938 أنهكت الثورة، ولكنها لم تضع حداً لها، وقد أدرك البريطانيون أن الثورة هي في جوهرها ومادتها وقياداتها المحلية ثورة فلاحية، وحين حاولت نتيجة ذلك، أن تمايز في تعاملها مع المدينيين أدت الروح الثورية المهيمنة في فلسطين بأجمعها إلى تعميم لباس الرأس الفلاحي (الكوفية والعقال) في المدن، كي لا يخضع الريفي النازل إلى المدينة لعسف السلطة، وبعد ذلك منع الجميع من حمل هوياتهم الشخصية كي لا تكتشف السلطة الفلاح من المدينى0
إن هذا الواقع يشير إلى طبيعة الثورة وإلى نفوذها في تلك المرحلة إشارة واضحة للغاية، كان الريف، بصورة عامة، هو رحم الثورة، وكانت عمليات احتلال المدن المؤقتة في 1938 أثر هجمات يشنها الفلاحون(90) من الخارج، وهذا يعني أن الفلاحين والقرويين بصورة عامة هم الذين كانوا يدفعون الثمن الأكبر. ففي عام 1938 أعدم عدد من الفلاحين لمجرد حيازتهم على أسلحة، وأن استعراضاً سريعاً لجداول أسماء أولئك الذين أرسلوا إلى السجن أو إلى المشنقة ترينا أن الغالبية الساحقة كانوا من فقراء الفلاحين، وعلى سبيل المثال فقد “حكم على جميع سكان قرية عين كارم، وعددهم ثلاثة آلاف، أن يسيروا عشرة كيلومترات يومياً ليثبتوا وجودهم لدى مركز البوليس”(91) وفي تلك الفترة كانت بريطانيا قد أصدرت أحكامها بالسجن، مدداً طويلة على حوالي 2000 عربي، وهدمت أكثر من 5آلاف بيت، وإعدام شنقاً في سجن عكا 148 شخصاً، وبلغ عدد المعتقلين لمدد مختلفة أكثر من خمسين ألفاً (92).
كانت بريطانيا، التي عدلت في تشرين الثاني 1938 عن التقسيم الذي أوصى به تقرير لجنة بيل، أخذه في محاولة كسب الوقت، وهنا يجيء مؤتمر المائدة المستديرة الذي عقد في لندن في شباط 1939 نموذجاً لتلك الصفقة المشبوهة التي كانت تجري طوال الوقت بصمت بين قيادة الثورة الفلسطينية وبين البريطانيين الذين كانوا يعرفون يقيناً استعداد تلك القيادة للمساومة في أية لحظة، وبالطبع لم يذهب جمال الحسيني وحده إلى المائدة المستديرة في لندن، بل ذهب معه ممثلو الدول العربية “المستقلة” آنذاك، وهكذا فقد قدر للأنظمة العربية التي كانت خاضعة للاستعمار أن تملي إرادتها مرة ثانية في أقل من عامين على عرب فلسطين، بوساطة ذلك الالتقاء (الكامن والمحتمل) في مصالح جميع الذين كانوا جالسين حول تلك المائدة المستديرة في لندن.
أن الكلمات التي ألقاها جمال الحسيني، والأمير فيصل (ممثل السعودية) والأمير حسين (ممثل اليمن) وعلي ماهر(ممثل مصر) ونوري السعيد (ممثل العراق) – الذي أعلن أنه يتكلم “كصديق حميم لبريطانيا العظمى والذي لا يرغب بقول كلمة واحدة تجرح شعور أي بريطاني لأنه يشعر بصداقته نحوهم من أعماق قلبه”(!)(93). أن تلك الكلمات لم تؤكد إلا نجاح خطة بريطانيا التي احتفظت بها بدقة طوال عقد من الزمن إزاء قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية: فهي لم تفرط بها، وأبقتها دائماً على طرف جسر مفتوح، وكان البريطانيون واثقين من أن العراق والسعودية مستعدتان لاستخدام نفوذهما لدى زعماء فلسطين لوضع نهاية للثورة وتهيئة أسباب النجاح للمؤتمر”. ومع ذلك فان الثورة في فلسطين لم تكن قد هدأت (حصيلة شباط 1939 كانت، رسمياً:110 قتلى و 112 جريحاً في 12 معركة ضد البريطانيين. تفتيش 39 قرية _ منع التجول في 3 مدن 3مرات. اعتقال حوالي 200 قروي، حرائق في 5دوائر حكومية، إعدام 10 عرب بتهمة حمل سلاح. هجمات على 10 مستعمرات يهودية. نسف أنابيب النفط مرة، تفجير قطار حيفا واللد، إنشاء نقطة تفتيش داخل المسجد الأقصى). وأن الأرقام البريطانية التي يقدمها وزير المستعمرات البريطاني تشير إلى أنه “بين 20 كانون الأول و20 شباط (أي في شهرين) وقع 348 حادث اغتيال و140 حادث تخريب و190 حادث خطف و32 سرقة وانفجار 9ألغام و32 قنبلة وخسر الجنود 18 قتيلاً و39 جريحاً وخسر الأهالي 83 قتيلاً و124 جريحاً، ولا تشمل هذه الأرقام ما أصاب الثوار..(94)
وقد استمر الأمر على هذا المنوال حتى الشهر الذي نشبت فيه الحرب العالمية الثانية (أيلول 1939) تكبد خلالها الفلسطينيون العرب خسائر لم يكن من الممكن تعويضها:كانت القيادة، بالإضافة لكل روح المساومة التي تعيشها، موجودة خارج البلاد، أما القيادات المحلية الناشئة فقد أخذت تسقط واحدة وراء الأخرى في ميادين القتال، وكان العسف البريطاني قد وصل إلى ذروته، وبدأ العنف الصهيوني يصعد باضطراد منذ أواسط 1937، ولا شك أن التركيز البريطاني والإصرار الذي رافقه في الساحة الفلسطينية قد أنهك الثوار الذين باتوا، مع تراوح قياداتهم، غير عارفين على وجه الدقة من كانوا يحاربون ولماذا؟ فتارة كانت القيادة تتحدث عن الصداقة التقليدية والمصالح المشتركة، مع بريطانيا، وتارة تصل إلى حد قبول منح إدارة ذاتية لليهود في المناطق التي يتواجدون فيها، ولا شك أن تذبذب القيادة ورخاوتها وعدم قدرتها على تحديد هدف واضح للقتال قد أسهم في إنهاك الثورة. ولكن ذلك يجب ألا يدفعنا إلى إهمال العامل الموضوعي. فقد استخدم البريطانيون فرقتين عسكريتين وعدداً من أسراب الطائرات والبوليس وقوة حرس الحدود الأردني بالإضافة للقوة اليهودية المساعدة المؤلفة من 6آلاف، ورموا ذلك كله للهيمنة على الموقف، (وكانت لجنة بيل قد اعترفت أن نفقات الأمن في فلسطين ارتفعت من 862ألف جنيه لعام 1935إلى 2.223.000عام 1936). إن حملة الإرهاب هذه وخصوصاً المحاولات التي بذلت لقطع الصلة بين الثوار وبين القرى، أدت إلى إنهاك الثورة. وجاء استشهاد عبد الرحيم الحاج محمد في آذار من 1939 بمثابة ضربة قاصمة للثورة إذ فقدت واحداً من أكثر القادة الشعبيين الثوريين شجاعة وحكمة واستقامة، و أخذت القيادات المحلية، بعد ذلك، تنهار وتغادر ميادين القتال، ولا شك أن التقارب الفرنسي البريطاني عشية الحرب الثانية قد لعب دوره في محاصرة الثوار. فقد استسلم عارف عبد الرزاق مع بعض أتباعه للفرنسيين بعد أن أنهكه التشرد والجوع، و ألقت القوات الأردنية القبض على يوسف أبو دره وسلمته للبريطانيين فاعدموه. وأدى الإرهاب في القرى إلى خشية من دعم الثوار ومدهم بالذخائر والطعام ولا شك أن انعدام الحد الأدنى من التنظيم قد حال دون القدرة على تجاوز هذه العراقيل.
لقد أرجح الحزب الشيوعي الفلسطيني آنذاك أسباب فشل الثورة إلى خمسة أسباب رئيسية (95). غياب القيادة الثورية، فردية قادة الثورة وانتهازيتهم، عدم وجود قيادة مركزية لقوات الثورة، ضعف الحزب الشيوعي الفلسطيني، عدم ملائمة الوضع العالمي. وهذه الأسباب مجملها صحيحة، ولكن يجب أن يضاف إليها تقرب الحزب الشيوعي إلى زعامة الحاج أمين الحسيني الذي كان يراه “منتمياً إلى أكثر أجنحة الحركة الوطنية تطرفاً في العداء للاستعمار” ويرى أعداءه “إقطاعيين خونة “(96). مع العلم أن جماعة المفتي لم تتوقف على الإطلاق في تصفية عناصر اليسار التي كانت تحاول التغلغل في أوساط العمال. وكان اليسار الشيوعي، بالإضافة إلى ضعفه, غير قادر علي الوصول إلى الريف. كان متمركزاً في بعض المدن، وكان قد أخفق في تعريب الحزب كما أوصى مؤتمر الكومنترن السابع، ولم يكن هو الآخر قد قرر أهدافاً واضحة للقتال، وكان ما يزال ضحية للنظرة القاصرة لمسألة الوحدة العربية، ولعلاقات النضال القومية في الوطن العربية التي كان لها انعكاسات تنظيمية. ويبدو أن الخلل الرئيسي في هذه الهزيمة كان يكمن في تلك الثغرة الكبيرة الناشئة عن الحركة السريعة للمجتمع في فلسطين، الذي كان ينقلب بعنف شديد كما قلنا، من مجتمع زراعي عربي إلى مجتمع صناعي يهودي، فذلك كان على وجه التحديد السبب الذي غيب البورجوازية الوطنية والبورجوازية الصغيرة العربية عن لعب دورها التاريخي في الحركة الوطنية الفلسطينية آنذاك، وأتاح للزعامات الإقطاعية الدينية فرصة تزعم هذه الحركة لفترة طويلة دون منازع. ويضيف الدكتور عبد الوهاب الكيالي أسباباً أخرى مهمة بقوله: “إن التعب من القتال والضغط العسكري المتواصل والأمل في أن تحقق بعض جوانب الكتاب الأبيض، بالإضافة إلى معاناة العجز في الأسلحة والذخائر، كل ذلك قد أسهم في عرقلة استمرار الثورة، ثم أن اقتراب العالم من حافة الحرب العالمية الثانية حمل الفرنسيين على قمع مقر رئاسة الثوار في دمشق قمعاً تاماً”(97). ويمكننا أن نضيف إلى ذلك كله عاملين هامين متداخلين يمكن الحديث عنهما معاً لأنهما لعبا دوراً بارزاً في إجهاض الثورة، وهما موقف شرق الأردن ممثلاً بموقف النظام العميل الذي كان يتزعمه الأمير عبد الله آنذاك, والنشاط الذي قام به عملاء الثورة المضادة في الداخل على هامش النشاط الإرهابي الذي شنته القوات البريطانية والقوات الصهيونية.
كان حزب الدفاع الذي يتزعمه راغب النشاشيبي يلعب دور الممثل الشرعي لنظام شرق الأردن العميل داخل الحركة الوطنية الفلسطينية، ولعل هذا الارتباط كان نوعاً من التمويه بسبب عدم قدرة ذلك الحزب على كشف علاقة العمالة التي كانت تربطه عملياً بالاستعمار البريطاني وسط معركة كانت موجهة بالأساس ضد ذلك الاستعمار ولذلك فقد كان الارتباط بالنظام الشرق أردني نوعاً من التمويه المقبول من الطرفين. كان حزب الدفاع عبارة عن حشد صغير من أفندية المدن يمثلون بالدرجة الأولى مصالح البورجوازية الكومبرادورية الصاعدة والتي بدأت تكشف أن وجودها ونموها رهن بارتباطها ليس فقط بالاستعمار البريطاني ولكن أيضاً بالحركة الصهيونية التي كانت تسيطر على عملية التحول الصناعي للاقتصاد الفلسطيني, وهذا الموقع الطبقي هو الذي جعل تاريخهم يتلخص بأنهم “تعاونوا مع الاحتلال إدارياً، ومع الصهيونية تجارياً، وباعوا الأراضي إلى اليهود وسمسروا وزرعوا الشكوك وعرقلوا النشاط الوطني وأحكموا الخطة بين عبد الله والحسين وبين الصهيونيين في 1923-1924وأيدوا الهجرة والانتداب في العشرينات، والتقسيم في الثلاثينات، ودعوا لوطن قومي يهودي في جزء من فلسطين، وتسليم الجزء الآخر إلى شرق الأردن … الخ “(98).
وفي الوقت الذي كان الأمير عبد الله، أمير شرق الأردن، يقمع حركة الجماهير الشرق أردنية التي كانت قد قررت بمبادرتها الذاتية، منذ حزيران 1936، في المؤتمر الشعبي الذي عقد برئاسة مثقال الفائز في قربة أم العمد، دعم ثورة فلسطين بالرجال والعتاد، كان البريطانيون قد قرروا اعتبار شرق الأردن ميداناً متصلاً للقتال ضد الثوار الفلسطينيين في تحركاتهم. ولم يقتصر الدور الذي لعبه النظام الشرق أردني العميل على ذلك فحسب، بل أغلق الطرق المؤدية إلى العراق ليمنع وصول أي إمداد، وأخذ يعرقل حركة القادة الفلسطينيين الذين اضطروا لزيادة حركتهم من شرق الأردن بعد بناء الأسلاك الحاجزة على حدود فلسطين الشمالية، وتوج هذا النظام نشاطه المضاد حين ألقى القبض على اثنين من القادة الفلسطينيين في 1939، أحدهما يوسف أبو درة، وسلمهما إلى البريطانيين حيث تم إعدامهما بعد ذلك بشهور قليلة، كما سبق وذكرنا. في ذلك الوقت بالذات كانت قوات النظام الأردني تنشط جنباً إلى جنب مع القوات البريطانية والعصابات الصهيونية في مطاردة الثوار والاشتباك معهم، ولا شك أن هذا الدور الذي لعبه نظام شرق الأردن قد شجع عناصر الثورة المضادة الداخلية على رفع مستوى أعمالها، فقد أسهم عدد من قادة حزب الدفاع في إنشاء ما أسموه بـ “فرق السلام”، وهي قوات صغيرة مرتزقة “تكونت بالتعاون مع الإنكليز وساهمت في مطاردة الثوار والاشتباك معهم، وزحزحتهم عن بعض المواقع التي كانوا يسيطرون عليها، وكان فخري النشاشيبي ممن كانوا ساهموا في تكوين هذه الفرق، وتسليحها، وتوجيه نشاطها… مما أدى إلى مقتله بعد انتهاء الثورة بعدة أشهر”(99) وقبل ذلك كانت الحملة البريطانية الشرسة لنزع السلاح من جميع أنحاء فلسطين قد اعتمدت على “تشجيع العناصر المعادية للمفتي على تزويد (البريطانيين) بالمعلومات والتعريف عن أشخاص الثوار”(100).
ولم يكن موقف العراق والسعودية، آنذاك، أفضل كثيراً من موقف النظام الأردني، وكانا يبديان منذ مؤتمر لندن استعدادهما “لاستخدام نفوذهما لدى زعماء فلسطين لوضع نهاية للثورة”(101) ولكن ذلك كله لم يكن قادراً على أن يجعل من زعماء الثورة المضادة عملاء الإنكليز قوة لها وزنها الجماهيري، وعلى العكس، كان يعزز من قوة المفتي وزعامته، ولكن تشجيع عناصر الثورة المضادة كان يهدف، من جملة ما يهدف إليه، ضبط المفتي وإبقاءه ضمن حظيرة يمكن السيطرة عليها في نهاية الأمر، فقد تصرف البريطانيون طوال الوقت وفق قناعتهم بأن النشاشيبي لا يستطيع أن يكون بديلاً للمفتي. أما الهامش الصغير الذي استخدمته قيادة المفتي، والناشئ عن التناقضات الجزئية التي كانت قائمة بين الاستعمار الفرنسي في سوريا ولبنان والاستعمار البريطاني، فلم يكن ليستطيع أن يؤدي إلى تغيير جذري في ميزان القوى، وما لبث هذا الهامش أن ضاق إلى حد الاختناق عشية الحرب الثانية.
إن مجمل هذه الحقائق يشير إلى أن الثورة الفلسطينية في 1936-1939 ضربت على مفاصلها الثلاثة: المفصل الذاتي، بمعنى عجز وتذبذب وضعف وذاتية وفوضى قيادتها المتخلفة. والمفصل العربي، بمعنى تواطؤ الأنظمة العربية على إجهاضها في وقت لم تتفاعل الحركة الوطنية العربية الشعبية (الضعيفة) مع الثورة الفلسطينية إلا بصورة انتقائية وذاتية وهامشية. والمفصل العالمي، بمعنى الخلل الضخم في ميزان القوى الموضوعي، والناشئ عن تحالف مجموع المعسكر الاستعماري فيما بينه، وكذلك فيما بينه وبين الحركة الصهيونية التي صارت تتمتع منذ ذلك الوقت بقوة محلية ضاربة لا يستهان بها عشية الحرب العالمية الثانية.
الخسائر البشرية
إن افضل تقدير للخسائر البشرية العربية في ثورة 1936-1939 هو ذلك التقدير الذي يقول أن الخسائر في السنوات الأربع هذه قد بلغت 19.792 ما بين قتيل وجريح، وهذا التقدير يتناول الإصابات التي أصيب بها العرب على أيدي العصابات الصهيونية في هذه الفترة. ويستند هذا التقدير على الاعترافات الأولية المتحفظة التي كانت تتضمنها التقارير الرسمية البريطانية مع امتحانها على صعيد وثائق أخرى(102) ويثبت هذا الإحصاء أنه في عام 1936 قتل 1200عربي وقتل 120 في 1937 و1200 في 1938 و1200 في 1939، كما تم إعدام 112 عربياً وقتل 1200 عربي في عمليات إرهابية مختلفة، وذلك يجعل عدد القتلى العرب في ثورة 1936 –1939 حوالي 5032 قتيلاً وعدد الجرحى في الفترة نفسها 14،760 عربيا ً (*). أما أعداد المعتقلين فقد بلغت في 1937 حوالي 816 وفي 1938 حوالي 2463 معتقلاً وفي 1939 حوالي 5679 معتقلاً. ويمكن فهم المعنى الحقيقي لهذه الأرقام من خلال المقارنات. فبالنسبة لعدد السكان فإن خسائر الفلسطينيين البشرية بين 36- 39 توازي خسارة البريطانيين لـ 200 ألف قتيل و600 ألف جريح ومليون و224 ألف معتقل، أما بالنسبة للأميركيين فإنها توازي مقتل مليون أميركي واصابة 3 ملايين بجروح واعتقال مليون و120 ألف مواطن!
على أن الخسائر الحقيقية، والأكثر خطراً، كانت في ذلك النمو السريع لأسس الوجود الاستيطاني الصهيوني في فلسطين، عسكرياً واقتصادياً. وليس من المبالغة بشيء القول بأن ذلك الوجود الاقتصادي والعسكري، والذي تزايد ارتباطه بالإمبريالية وعبر عن نفسه بكثافة في 1948 كان قد أرسى قواعده الرئيسية في هذه الفترة الممتدة بين 1936 و1939.
ويذهب أحد المؤرخين الإسرائيليين إلى حد الإقرار بأن “ظروف الانتصار في 1948 كانت قد خلقت إبان فترة الثورة العربية (1936)”(103).
إن السياسة العامة التي اتبعها الصهاينة في هذه الفترة يمكن رؤيتها في قرارهم العميق بتجنب إنشاء أي تناقض بينهم وبين سلطة الانتداب البريطاني، حتى حين كان هذا الانتداب، تحت وقع ضربات الثوار العرب، يضطر إلى تجاهل بعض المطالب الحيوية للحركة الصهيونية. وكان الصهاينة يعرفون كما يبدوا أنهم إذا هيأوا للبريطانيين، الذين كانوا يقودون في تلك الفترة أقوى وأعتى جيش استعماري في العالم، إذا هيأوا له فرصة سحق الثورة العربية في فلسطين، فإنه يكون قد قدم لهم تلقائياً أكبر خدمة يمكن لمخططاتهم أن تحلم بها. وهكذا فقد سارت المخططات الصهيونية الرئيسية على حطين متوازيين: من جهة: التحالف إلى أقصى حد مع البريطانيين، حتى أن المؤتمر العشرين للحركة الصهيونية الذي عقد في صيف 1937 أبدى استعداده لقبول التقسيم من خلال المهادنة مع بريطانيا والإصرار على تجنب الصدام معها، وذلك ليتيح للإمبراطورية الاستعمارية قمع الثورة العربية التي تجددت في ذلك الصيف. ومن جهة أخرى تعبئة التجمع الصهيوني الاستيطاني داخلياً تعبئة متواصلة، تحت الشعار الذي أطلقه بن غوريون آنذاك، والذي ينادي بـ “لا بديل”، وإرساء قواعد المجتمع العسكري، و أدواته الحربية والاقتصادية.
وقد كانت مسألة الإصرار على مهادنة البريطانيين إلى أقصى مدى، بالرغم من أن هؤلاء قاموا بخطوات خفضوا فيها الهجرة اليهودية مثلاً، مسألة مركزية في تاريخ السياسة الصهيونية في تلك الفترة، ورغم أنه كان يوجد في داخل الحركة الصهيونية جهات ترفض ما كان يسمى بـ “ضبط النفس”، إلا أن أصوات الأقلية هذه لم تستطع أن تؤدي إلى نتيجة، فقد كان القانون الذي يسوق خطوات الحركة الصهيونية في تلك الفترة هو ذاك الذي لخصه وايزمن بقوله: “هناك تماثل مصالح تام بين الصهيونية وإنجلترا في فلسطين”. وخلال هذه الفترة أدى التعاون والتداخل بين هذين الخطين، التحالف مع الانتداب إلى أقصى مدى وتعبئة التجمع الاستيطاني اليهودي، إلى نتائج خطيرة للغاية: فقد انتهزت البورجوازية اليهودية انتشار الثورة العربية لتنجز الكثير من المشاريع التي لم يكن بوسعها أن تنفذها في ظروف مغايرة. وإذ تحررت هذه البورجوازية، فجأة، من منافسة المنتوجات الزراعية العربية التي كانت رخيصة الثمن(*) فقد راحت تنصرف إلى تنمية وجودها الاقتصادي، ومن الطبيعي أنه لم يكن من الممكن تنفيذ ذلك دون البركة البريطانية. ففي فترة الثورة نجح الصهاينة وسلطات الانتداب في بناء شبكة من الطرق بين المستعمرات الرئيسية والمدن شكلت فيما بعد جزءاً أساسياً من الهيكل التحتي للاقتصاد الصهيوني، وبالإضافة لهذه الطرق، تم تعبيد الطريق الرئيسي بين حيفا وتل أبيب، وجرى توسيع ميناء حيفا وتعميقه وبناء ميناء تل أبيب الذي قضى فيما بعد على حيوية ميناء يافا، وانفرد الإسرائيليون بتعهد تزويد القوات البريطانية التي أخذت تتدفق على فلسطين بالمؤن وبالمعدات. وقد تأسست خمسون مستعمرة إسرائيلية في الفترة الممتدة بين 1936 و1939، ففي الفترة من 1936-1938 وظف اليهود مليوناً و268 ألف جنيه لأعمال البناء في 5 مدن يهودية مقابل 120ألف جنيه فقط وظفها العرب في البناء في 16 بلدة عربية في نفس الفترة! وانهمك اليهود بالعمل في مشاريع الأمن البريطانية التي نشطت في تلك الفترة لمحاصرة الثورة العربية، وبينها مشروع بناء حاجز من الأسلاك الشائكة على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية لفلسطين الذي “وظف البريطانيون عمالاً يهوداً بـ 100ألف جنيه فلسطيني ليتموا بناءه”(104) بالإضافة لعشرات من المشاريع الأخرى. وتعطينا أرقام نشرات صدرت فيما بعد فكرة أدق: فقد ازدادت قيمة الصادرات من البضائع المصنوعة محلياً من 478،807 جنيهات فلسطينية عام 1935 إلى حوالي الضعف ( 896،875 ج. ف.) في 1937 رغم أحداث الثورة(105) . ولا يوجد تفسير لذلك إلا النشاط المضاعف الذي طرأ على الاقتصاد اليهودي.
وقد اتسع نطاق هذه التعبئة من المجال الاقتصادي المتحالف مع الانتداب، إلى المجال العسكري المتواطئ معه(*)، فقد شعر البريطانيون بأن حليفهم الصهيوني مؤهل للعب دور لا يمكن لغيره أن يلعبه بنفس الجودة، وفي الواقع فان بن غوريون لا يذكر إلا جزءاً من الحقيقة حين يعترف بأن عدد المجندين اليهود في البوليس الإضافي المسلح بالبنادق قد ارتفع إلى 2863 في أيلول 1936. فذلك لم يكن إلا جزءاً من القوة اليهودية التي كان تعدادها، في الهاغاناه، 12 ألف رجل عام 1937 بالإضافة إلى ثلاثة آلاف من أتباع جابوتنسكي (التنظيم العسكرية القومي)(106). وقد أدى تحالف هؤلاء، كممثلين حقيقيين للحركة الصهيونية، مع الاستعمار البريطاني إلى ولادة فكرة “قوة البوليس الإضافي” في ربيع 1936 وهي الفكرة التي خدمت كتغطية للوجود الصهيوني المسلح المتمتع ببركة الاستعمار وتشجيعه. وقد خدمت هذه القوة كفترة انتقالية لمدة شهور، هيأت خلالها الهاغاناه للانتقال في بداية 1937 إلى مرحلة جديدة لم يكن البريطانيون غير غافلين عنها فحسب، بل كانوا مساعدين في بلورتها، وهي مرحلة تسيير دوريات والقيام بعمليات محدودة ضد العرب، هدفها الرئيسي أشغالهم وتشويشهم. وكان من غير الممكن الانتقال إلى هذه المرحلة والحفاظ على “الهدنة” (التحالف) مع سلطة الانتداب، دون أن يكون ذلك نتيجة خطة مشتركة. ويقر بن غوريون بأن قوة البوليس الإضافي اليهودية شكلت “إطاراً” ممتازاً لتدريب الهاغاناه”(107).
في صيف 1937 أطلق على هذه القوة اسم “الدفاع عن المستعمرات اليهودية” ثم تغير إلى “بوليس المستعمرات” وجرى تنظيمها برعاية الانتداب البريطاني في طول البلاد وعرضها. وتعهد البريطانيون بتدريب عناصرها. وفي 1938 جرى تعزيزها بثلاثة آلاف آخرين. ولعب جميعهم دوراً مباشراً في أعمال القمع المسلح ضد الثوار العرب، خصوصاً في الشمال. وفي حزيران 1938 قرر البريطانيون أنه لابد من شن عمليات هجومية ضد الثوار. وأنشأوا دورات دراسة في هذا المضمار تدرب فيها عدد كبير من إطارات الهاغاناه التي شكلت فيها بعد إطارات الجيش الإسرائيلي(108).
وفي أوائل 1939 نظم الجيش البريطاني عشر مجموعات من بوليس المستعمرات في مجموعات حسنة التسليح، وأعطيت أسماء عبرية، وسمح لأفراد هذه القوة بتغيير “القلبق”، لباس الرأس الرسمي بقبعة أسترالية لتعزير التمايز، وقد بلغ عدد هؤلاء 14411 رجلاً، يتزعم كل مجموعة منهم ضابط بريطاني يساعده وكيل تعينه الوكالة اليهودية، وفي ربيع 1939 صار عند اليهود 62 وحدة آلية، كل واحدة تحوي من 8 إلى 10 رجال.
وفي حزيران 1938 قررت القيادة البريطانية تكليف العناصر اليهودية هذه بحماية خطوط السكة الحديدية بين حيفا واللد التي نسفها الثوار العرب مراراً، وقد أرسلت 434 عنصراً لتنفيذ هذه المهمة، إلا أنه بعد ستة شهور فقط نجح رجال الوكالة اليهودية في رفع هذا العدد إلى 800. إن هذا التطور لم يخدم فقط عملية بناء القوة الصهيونية العسكرية، بل ساعد أيضاً على امتصاص وتوظيف أعداد كبيرة من العمال اليهود العاطلين عن العمل والذين كانت أعدادهم تتزايد باضطراد في المدن، وهكذا جرى تحويل هذه البروليتاريا نحو العمل في مؤسسات القمع، ليس فقط في مشاريع الأمن البريطانية المضادة للثورة ولكن أيضا في القوة العسكرية الصهيونية الصاعدة.
كانت أسس الجهاز العسكري الصهيوني ترسى برعاية البريطانيين، وإذا كانت القوة اليهودية قد كلفت بحماية خطوط السكة الحديدية بين حيفا واللد، فقد جرى تكليفها بحماية خط أنابيب النفط في سهل بيسان، الذي كان قد بني حديثاً 1934 لنقل الزيت من كركوك إلى حيفا والذي نسفه الثوار العرب عدة مرات. ولعل قيمة ذلك بالذات، هنا، قيمة رمزية مثيرة للدهشة: أن الثوار العرب الذين أدركوا قيمة هذا النفط بالنسبة للمستغل البريطاني قد نسفوا الأنبوب لأول مرة في 15 تموز 1936 قرب أربد، وبعد ذلك جرى نسفه عدة مرات قرب قرية كوكب الهوا ومحنة إسرائيل واكسال وبين العفولة وبيسان، وفي تل عدس، والبيرة، وأرض المرج، وتمرة، وكفر مصر، وجسر المجامع، وجنجار وبيسان وعين دور.
وقد عجز بهذا العجز البريطانيون عن حماية هذا الخط الحيوي واعترفوا بهذا العجز عدة مرات، وفي الوقت نفسه دخلت “الماسورة” كما كان يسميها الفلاحون العرب في صلب الفولكلور الذي يمجد البطولات الشعبية.
وعلى أي حال، فقد توصل البريطانيون إلى تأمين حد أدنى من الحماية للأنابيب هذه عن طريقين: أعطوا لعصابات اليهود مهمة حمايتها في الداخل، أما في الأراضي الأردنية فقد أوكلوا مهمة حراستها إلى “الشيخ تركي بن زين، رئيس فخذ الزين من عشيرة بني صخر، وقد خولته الشركة حق التجوال في الصحراء بأية واسطة كانت” (109).
إن هذا الأمر مهم للغاية، ذلك أن هذا الحادث بالذات عزز القناعات البريطانية بأن إنشاء قوة ضاربة يهودية يحل الكثير من الإشكالات بالنسبة لحماية المصالح الإمبريالية عموماً. أن بن غوريون يكاد يكشف هذه الحقيقة بمباشرة لا حد لها حين يتحدث عن الجهد البريطاني في إنشاء قوة يهودية مسلحة مهمتها حماية هذه المصالح. وفي هذا المجال لعب الضابط البريطاني شارلز أورد وينغيت دوراً بارزاً في ترجمة التحالف البريطاني- الصهيوني إلى واقع عملي، وبالرغم من أن المؤرخين الصهانية يحاولون الإيحاء وكأن جهد وينغيت كان نتيجة مزاج شخصي وولاء “مثالي”، إلا أنه من الواضح أن ضابط الاستخبارات هذا، الذي أرسله رؤساؤه إلى حيفا في خريف 1937، كان مكلفا بمهمة محددة وهي إنشاء النواة الضاربة للقوة اليهودية المسلحة التي كانت موجودة قبل ذلك بستة شهور على الأقل ولكن التي كانت تحتاج إلى بلورة وإعداد. وقد جعل هذا الضابط البريطاني، الذي يعتبره العسكريون الإسرائيليون المؤسس الفعلي للجيش الإسرائيلي، مسألة حماية أنبوب النفط همه الأساسي. إلا أن هذه المهمة كانت مدخلاًًًًًً لسلسلة عمليات إرهاب وقتل أخذ هذا الضابط على عاتقه مهمة تعليم تلامذته في عين دور- ومن بينهم دايان- أجادتها. ولا شك أن وينغيت كان يتسلح بالإضافة لكفاءته كضابط استعماري متمرس، بكراهية عنصرية غير محدودة للعرب، ويبدو من سيرة حياته كما أرخها الذين عملوا معه أنه كان يجد متعة في قتل الفلاحين العرب أو تعذيبهم أو ممارسة أي شكل من أشكال الاحتقار لهم(110).
وتؤكد دراسة لأميل توما عن كتاب لييجال آلون حول هذا الموضوع أن وينغيت وشراذمه كانوا يساعدون القوات البريطانية على إرهاب السكان العرب في الريف خلال ثورة 36- 1939.
وبواسطة رجال مستعمرين من طراز وينغيت، وقادة رجعيين من طراز الأمير عبد الله وأفراد طبقته الحاكمة، كان البريطانيون يهيئون للحركة الصهيونية فرصة أن تصبح عسكرياً واقتصادياً المخفر الأمامي الذي يحمي مصالحهم، وكان ذلك كله يجري من خلال قناعة هؤلاء جميعاً بأن قيادة الحركة الوطنية الفلسطينية ليست في حالة من الثورية تؤهلها للوقوف في وجه هؤلاء الأعداء المتكاتفين.
لقد اهتدى البريطانيون في وقت مبكر إلى الإستراتيجية التي أطلق عليها الأميركيون بعد ذلك بثلاثين سنة اسم “الفيتنمة”. ووسط ذلك كله وصلت الحركة الوطنية الفلسطينية، التي شلتها، بالإضافة للعوامل الذاتية التي ذكرناها، الهجمات العنيفة التي شنها البريطانيون من جهة والصهيونيون من جهة أخرى، إلى موقف حرج عشية الحرب الثانية.
إن ادعاءات بعض المؤرخين بأن العرب “أوقفوا” ثورتهم ليتيحوا لبريطانيا، مرة أخرى، فرصة خوض حربها العالمية ضد النازية هي ادعاءات ساذجة لا ينفيها واقع الحال فحسب، ولكن ينفيها أيضا كون الحاج أمين الحسيني نفسه قد لجأ إلى ألمانيا النازية طوال سنين الحرب.
سبب الركود
إن مجمل هذه الصورة هي التي توضح حقيقة الخارطة السياسية والاجتماعية التي هيمنت طوال الأعوام الممتدة بين 1936 و 1939 وذلك كله، بعلاقته الجدلية فيما بينه، هو الذي يفسر ذلك الركود الذي خيم على الواقع الوطني الفلسطيني طوال سنين الحرب، وقد انتهت الحرب العالمية الثانية ليجد البريطانيون أن الحركة الوطنية الفلسطينية قد دجنت بصورة تكاد تكون نهائية: فقد كان رأسها محطماً ومشتتاً وكانت قاعدتها قد أنهكت واهترأ نسيجها الاجتماعي وتفتتت نتيجة للتحول العنيف الذي كان يجرى في المجتمع، ونتيجة إخفاق قياداتها وأحزابها في تنظيمها وتعبئتها، ونتيجة، أيضاً، لضعف اليسار وحيرته وميوعة الحركة الوطنية في الأقطار العربية المجاورة. وهكذا دخلت الحركة الصهيونية الأربعينات لتجد الميدان أمامها فارغاً تقريباً، وليكون الجو العالمي ملائماً للغاية في أعقاب جو التعاطف النفسي والسياسي الذي عممته الذابح الهتلرية ضد اليهود، ولتجد في الأنظمة العربية المحيطة أنظمة بورجوازية واقعة في مأزق تاريخي، ولا قوة حقيقية لها. ولم تكن توجد داخل المجتمع اليهودي في فلسطين، آنذاك، آية حركة يسارية لتضغط باتجاه معاكس، فقد كان المجتمع هذا، في مجمله تقريباً، مجتمع غزو إسكاني. أما اليسار الفلسطيني فقد بدأ، منذ الحرب العالمية الثانية، يفقد الجذوة التي كانت قد بدأت تسيره منذ أواسط الثلاثينات، وكان هذا الفقدان نتيجة لتغير في استراتيجية الكومنترن رافقه فشل في تعريب الحزب، يضاف إلى ذلك أن هذا اليسار الشيوعي تعرض أكثر فأكثر إلى قمع القيادة العربية المهزومة (مثلاً: قيام رجال المفتي باغتيال النقابي اليساري سامي طه في حيفا في 12 أيلول 1947 – وقبل ذلك اغتيال النقابي ميشيل متري في يافا، وهو الذي لعب دوراً مهماً في تعبئة العمال العرب قبل انفجار الأحداث في 1936).
وهذا كله يسر للحركة الصهيونية في أواسط الأربعينات رفع درجة تناقضها الجزئي مع الاستعمار البريطاني في فلسطين بعد سنوات مديدة من التحالف. وهكذا، وما أن جاء عام 1947حتى كانت الظروف ناضجة كلياً لقطف ثمار الهزيمة التي منيت بها ثورة 1936، والتي أخرت الحرب العالمية الثانية موعد حصادها، ولذلك فان الفترة التي استغرقها الفصل الثاني في الهزيمة (من أواخر 1947 إلى أواسط 1948) كانت فترة مذهلة بقصرها، وذلك أنها كانت مجرد تتمة لفصل دموي طويل كان قد استمر من نيسان 1936 إلى أيلول 1939.
-انتهى-
المراجع:
1- النظام الاقتصادي في فلسطين – تحرير سعيد حمادة ، نشر جامعة بيروت الأميركية-بيروت1939ص32.
2- Moshe Menuhin,The Decadenece of Judaism in our Time, Institute of Palestine Studies,Beirut,1969,p.92.
3- Nathan Weinstock,Le Sionisme Contre Israel, Maspero, Paris, 1968.
4- فاينشتوك، المصدر ذاته.
5- حمادة، المصدر ذاته، ص26وص27
6- فاينشتوك، المصدر ذاته.
7- حمادة، المصدر ذاته، ص373.
8- حمادة، المصدر ذاته، ص376.
9- مجموعة شهادات العرب في فلسطين أمام اللجنة المكية البريطانية – مطبعة الاعتدال – دمشق- 1938- ص54.
10- المصدر ذاته، ص55.
11- حمادة، المصدر ذاته، ص15 (وقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل بعد1936 إلى أربعة آلاف في يافا وحدها كما يقول المصدر رقم 9 ص55 ).
12- مجموعة شهادات، ص55.
13- المصدر ذاته، ص55 .
14- ” دافار” العدد 3462 – ذكرها المصدر السابق – ص56.
15- شهادات، ص59 .
16- المصدر ذاته، ص56.
17- المصدر ذاته، ص59.
18- ‘Yehuda bauer’, the arab revolt of 1936, New out look, vol.9 No.6 (81), Tel Aviv, 1996,p.50.
19- المصدر ذاته، ص 51.
20- في 1930 انخفض عدد عمال البناء العرب في القدس من 1500 إلى 500 وارتفع عدد اليهود من 550 إلى 1600.
21- حتى عام 1931 كان الصهاينة قد طردوا 20 ألف فلاح عربي بعد أن استولوا بالشراء على أملاكهم أو على الأرض التي كانوا يعملون فيها.
22- Haim Hanegbi, moshe Machover, Aciva Orr, “The Class Nature of Israel” New left Review(65), Jan.-Feb.1971,p.6.
23- Theodor Herzl, Selected Works, Newman Ed., Vol. 7, Book1, Tel Aviv, p.86. (ذكرها المصدر السابق)
24- Esco Foundation for Palestine Inc., Palestine, A Study of Jewish, Arab and British Policies, Vol.1, Yale University Press, 1947, p. 61.
25- تاريخ فلسطين الحديث – الدكتور عبد الوهاب الكيالي – المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1970، ص174.
26- وثائق المقاومة الفلسطينية العربية (1918- 1939) نشر مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت، ص22، 23، 24، 25.
27- “العمل بين الفلاحين والنضال ضد الصهيونية” – موضوعات الحزب الشيوعي الفلسطيني لعام 1931 – وثيقة في كتاب” الأممية الشيوعية والثورة العربية” دار الحقيقة، بيروت – ص54.
28- المصدر ذاته، ص122و121.
29- المصدر ذاته، ص124و125.
30- المصدر ذاته، ص162.
31- حمادة، المصدر ذاته، ص39.
32- الأممية الشيوعية، ص135- 145.
33- فاينشتوك، المصدر ذاته.
34- مجموعة شهادات، ص34.
35- كان الباب العالي قد منح هذه الأرض لعائلة سرسق اللبنانية لقاء خدماتها- ( راجع سامي هداوي: فلسطين تحت الانتداب، 1920-1948، دراسات فلسطينية، جمعية الخريجين الكويتية. ص34 وص36) وكذلك كان الصهاينة في 1934 قد كسبوا امتياز تجفيف حوض الحولة من عائلة سلام البيروتية، بمساعدة الانتداب.
36- مجموعة شهادات، ص34( شهادة جمال الحسيني).
37- المصدر ذاته، ص39.
38- هداوي، المصدر ذاته، ص29.
39- مجموعة شهادات، ص25( شهادة عوني عبد الهادي).
40- مجموعة شهادات، ص56( شهادة جورج منصور).
41- مجموعة شهادات، ص58.
42- حماده، المصدر ذاته، ص376.
43- مجموعة شهادات، ص 60( شهادة جورج منصور).
44- مجموعة شهادات، ص62-63( شهادة فؤاد سابا).
45- المصدر ذاته، ص62.
46- المصدر ذاته، ص44.
47- المصدر ذاته، ص63.
48- Rony E. Gabbay, A Political Study of the Arab –Jewish Conflict, Librairie de Droz, Geneve ,1959, P.29.
49- الأممية الشيوعية، ص143-144.
50- مجموعة شهادات، ص82.
51- حماده، المصدر ذاته، ص45.
52- “المجتمع العربي”- الدكتور علي أحمد عيسى، ص99 ذكرت في كتاب يسرى عرنيطة، الفنون الشعبية في فلسطين، بيروت، مركز الأبحاث، م.ت.ف، ص187.
53- حياة الأدب الفلسطيني الحديث –الدكتور عبد الرحمن ياغي–المكتب التجاري بيروت – ص232(عن: ديوان الفلسطينيات، ص113-114).
54- المصدر ذاته، ص237.
55- المصدر ذاته، ص283.
56- أغانينا الشعبية- نمر سرحان،وزارة الثقافة والإعلام الأردنية،ص157
57- المصدر ذاته، ص299-300.
58- المصدر ذاته، ص301.
59- يهودا بويير، المصدر ذاته، ص49.
60- فلسطين العربية بين الانتداب والصهيونية – عيسى السفري، مكتبة فلسطين الجديدة، يافا 1937- الكتاب 2ص10.
61- جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن – صالح مسعود بويصير –دار الفتح – بيروت – ص180.
62- الثورة العربية الكبري في فلسطين- دار الهنا – دمشق – صبحي ياسين، ص30.
63- بويصير، المصدر ذاته، ص181.
64- الكيالي، المصدر ذاته، ص302.
65- مجموعة شهادات، ص96.
66- هداوي: المصدر ذاته، ص38.
67- صبحي ياسين، المصدر ذاته، ص22 و23.
68- المصدر ذاته، ص22.
69- الكيالي ، المصدر ذاته، ص296.
70- راجع “فلسطين” – بيروت (الهيئة العربية العليا ) – العدد 94(1/1/69) والعدد 95(1/2/69).
71- المصدر ذاته، العدد 94 ص 19.
72- الكيالي، المصدر ذاته، ص 296.
73- Palestine’s Economic Future, Percy Lund H., London, 1946, p. 61.
74- سفري، المصدر ذاته، ص 39 و40.
75- الكيالي، المصدر ذاته، ص 311.
76- السفري، المصدر ذاته، ص 60.
77- المصدر ذاته، ص 93.
78- الكيالي، المصدر ذاته، ص 319.
79- الوثائق، ص 454.
80- المصدر ذاته، ص 457.
81- المصدر ذاته، ص 458.
82- مجموعة شهادات، ص 8.
83- الكيالي، المصدر ذاته، ص 326.
84- Neville Barbour, Nisi Dominus, London, pp. 183-193.
85- الكيالي، المصدر ذاته، ص 338.
86- بن غوريون في Jewish Observer, London, 20 Sept.1963,pp.13-14
87- عبد القادر ياسين- الكاتب، القاهرة، نيسان 1971، العدد 121 حول تاريخ الحزب الشيوعي الفلسطيني، ص 114.
88- الكيالي، المصدر ذاته، ص 346 عن رسالة من مكمايكل.
89- المصدر ذاته، ص 346.
90- في أيار 1938 أحتل الثوار الخليل، وقبلها احتلوا القدس القديمة، وفي 9أيلول احتلوا بئر السبع وأطلقوا سراح السجناء وفي تشرين الأول احتلوا طبريا، وفي أوائل آب داهموا نابلس وسيطروا علي بعض أحيائها.. الخ.
91- بويصير ، المصدر ذاته، ص247.
92- المصدر ذاته،ص247.
93- المصدر ذاته، 258.
94- الأهرام، القاهرة – 1/3/1939.
95- ياسين، المصدر ذاته، ص115.
96- المصدر ذاته، ص114.
97- الكيالي، المصدر ذاته، ص359.
98- أنيس صايغ، الهاشميون وقضية فلسطين – نشر “المحرر” بالاشتراك مع المكتبة العصرية بيروت 1966-ص150.
99- المصدر ذاته – وكذلك راجع: الياقوري – الطليعة المصرية العدد 4/ س 7 نيسان 1971ص 98.
100- الكيالي، المصدر ذاته، ص348.
101- من رسالة لوزارة الخارجية البريطانية من بغداد (31/10/938) ذكرها الكيالي، المصدر ذاته، ص349.
102- Walid Khalidi, ed, from haven to conquest, I.P.S. Beirut, 1971, pp. 836-849.
103- بويصير، المصدر ذاته، ص21.
104- باربور ، المصدر ذاته، ص 193.
105- حماده، المصدر ذاته، ص323.
106- بويصير, المصدر ذاته، الصفحة ذاتها.
107- بن غوريون، المصدر ذاته، ص372.
108- المصدر ذاته، ص373.
109- السفري، المصدر ذاته، ص131-132.
110- الخالدي، المصدر ذاته، ص375-378