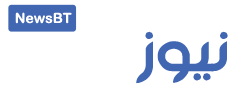4-5-2007
كل متابع للمجال السياسي العربي في العقود الثلاث الأخيرة سيلمس بروز حركتين متفقتين من حيث رفض الواقع بمكوناته السياسية الرسمية والاقتصادية ،ولكنهما مختلفتان في نظرتهما للماضي وللمستقبل وفي مناهج التفكير وأدوات التنفيذ المتبعة للتغيير، مع ما يترتب على ذلك من إرباك للحركية السياسية في الحاضر وغموض لآفاق المستقبل.ونقصد هنا جماعات الإسلام السياسي الجهادية (التي تمارس العنف المسلح تحت شعار الجهاد) من جانب، وقوى المعارضة الديمقراطية والليبرالية والتقدمية من جانب آخر،فكلتا الحركتان تتفقان على معارضة الأنظمة السياسية القائمة وترغب بتغيير الأنظمة والواقع ،ولكنهما تختلفان في مبررات الرفض كل منهما من منطلقه الإيديولوجي الخاص به ،مع الإشارة إلى أن التوحد الظاهر في النهج وفي المرجعية لكل منهما لا يخفي وجود تشرذم تنظيمي وخلافات قد تصل لمرحلة القطيعة والعداء بل الاحتراب بين مكوناتها وخصوصا بالنسبة للجماعات الجهادية .
القوى الديمقراطية والتحديثية تبرر رفضها للواقع باستبداد الأنظمة السياسية وعدم انفتاحها على الديمقراطية الحقيقية والحداثة فكرا وممارسة وتمركز المصالح والقرارات المصيرية بيد نخبة قوة، إما عائلية أو طائفية أو حزبية، مرتبطة كليا برأس النظام السياسي التابع بدوره لمراكز القرار الامبريالية ،هذه القوى الديمقراطية المعارضة وإن كانت تعارض النظام إلا أنها تجاوزت المفاهيم وأنماط السلوك لقوى المعارضة التي سادت سنوات ما بعد الاستقلال مباشرة أي القوى الثورية والانقلابية المؤمنة بالتغيير الجدري ،فثقافة الديمقراطية للقوى الجديدة تفضل خيار الإصلاح المتدرج وانتزاع الحقوق بشكل متدرج ،وهذا ما يوجد نقاط تقاطع بينها وبين النظام السياسي في بعض المجالات الأمر الذي يجعلها أحيانا موضع شبهة قوى التغيير الجدري.أما جماعات الإسلام السياسي فتعارض النظم السياسية القائمة لعدم أخذها بناصية الدين الصحيح وخروجها عن نهج السلف الصالح وعدم الأخذ بالقرآن دستورا أو عدم الحكم بما أنزل الله ،ومجاراة الغرب الكافر في ثقافته ونظمه السياسية الخ،وحيث أن مواقف هذه القوى تؤسس على منطلقات دينية تكفيرية فهي لا ترى مجالا للتعايش مع هذه الأنظمة وبالتالي فهي لا تؤمن بالمشاركة بل بإقصاء ما هو قائم والحلول محله ،وحيث أنها لا تؤمن بالديمقراطية وأدواتها للتغيير فلم يكن أمامها إلا العنف المسلح أو الجهاد ضد الأنظمة (الكافرة).
هذا التباين في مبررات ومنطلقات الرفض نتج عن وأنتج اختلاف في الرؤية للماضي وللمستقبل ،فالقوى الديمقراطية لا تعير اهتماما للماضي وللتراث وللسلف الصالح لأنها تُحمل هذا الماضي المسؤولية عن رداءة الحاضر ،فاستبداد اليوم هو إعادة إنتاج لاستبداد الماضي الذي رسخ برادغم الطاعة والخنوع تحت مبدأ طاعة أولى الأمر من طاعة الله،وتعتبر التراث المضفي عليه صفة التقديس سببا في حالة التخلف الراهن ، فإن كان في التراث رموز مشتركة تساعد على الحفاظ على الهوية ففيه أيضا ما يعيق التقدم والانفتاح على قيم العصر ،وترى أن السلف الصالح كان صالحا في زمان غير هذا الزمان وتراثهم لا يعني مجتمعات الحاضر إلا كروايات تُستخلص منها الدروس والعبر ،وهذه القوى تنظر للدين كعلاقة بين الإنسان وربه ولا مجال لاعتماد النص المقدس بشكل حرفي كمرجعية لسوس مجتمعات أو إدارة نظم معاصرة.أما جماعات الإسلام السياسي فعلى عكس ذلك ،فالماضي هو فخر الأمة وتَنَكُر الأمة العربية الإسلامية لهذا الماضي :تراث وتاريخ وسلف صالح، هو السبب في تخلفها ،فتخلف الأمة وتراجعها يعود لخروجها عن الدين الصحيح الذي يصلح كمرجعية لسوس الأمة وبناء دولة إسلامية قادرة على قهر أعدائها الخ.
في مواجهة هاتين الحركتين المعارضتين والمتعارضتين أو فلنقل توظيفا لهذا التعارض بين الحركتين وتعارضهما مجتمعتين معها، تحاول النظم العربية الحفاظ على وجودها بنهج سياسات جديدة وإن كانت لا تأخذ بخيارات كلا طرفي المعارضة إلا أنها لا تقطع معهما كليا ،فتسعي لسحب ورقة الدين من الجماعات الجهادية بتدين شكلاني أو بالتقرب الحذر والمشروط من الإسلام المعتدل والسماح له بنصيب من مغانم السلطة دون إمكانية امتلاكها بأي شكل من الأشكال ،كما جرى في المغرب والأردن ومصر والجزائر وفلسطين والأنظمة تجد في هذا المسعى دعما من واشنطن والغرب عموما .وفي نفس الوقت تسعى الأنظمة لسحب ورقة الديمقراطية وحقوق الإنسان من يد القوى الديمقراطية والتحديثية من خلال نهج هذه الأنظمة لديمقراطية شكلية وموجهة،فتطبق سياسات إصلاحية هي خليط من ليبرالية مشوهة وديمقراطية موجهة وتعديلات دستورية شكلية ،وبالتالي تحاول أن تُسوِق نفسها لجميع التيارات الجماهيرية باعتبارها تمثل الوسطية والاعتدال وبالتالي تمثل كل الأمة وتُسوق نفسها خارجيا كدولة ديمقراطية من جانب وحكومات قادرة على الوقوف بوجه التيارات التخريبية والإرهابية المعادية لقيم الغرب ومصالحه من جانب آخر. وهكذا نلاحظ بأن حكامنا اليوم أول من يؤم المسلمين في المساجد ويكونوا على رأس الاحتفالات الدينية ويبدءوا خطاباتهم السياسية وينهوها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ويُشيدوا المساجد ويؤسسوا جمعيات لمساعدة الفقراء والمساكين،وهم أنفسهم قادة الانتقال الديمقراطية والداعون للانتخابات النزيهة والتعددية السياسية والحزبية والمدافعون عن حقوق الإنسان ورواد الانفتاح الاقتصادي والعولمة وحلفاء أمريكا في مواجهة الإرهاب والتطرف الخ.هذه السياسة الرسمية أطالت من عمر الأنظمة حيث مكنت غالبيتها من الاستمرار في السلطة لأكثر من ثلاثة عقود سواء في مصر أو تونس أو اليمن أو في الأنظمة الملكية التي لم تستمر على عروشها لأن الناس يؤمنون بقدسية المؤسسة الملكية بل لأن هذه الملكيات استطاعت توليد شرعية جديدة تجمع ما بين الوراثية والديمقراطية والدينية في ظل قبضة حديدية للمؤسسة الأمنية.
هذه المستويات الثلاث من العمل السياسي بالإضافة للمحددات الخارجية الضاغطة أخرجت الحالة السياسية من حالة أشبه بالموات السياسي وأوجدت حالة من الحراك سواء على مستوى البنية الفوقية –فكر ونظم سياسية- أو على مستوى البنية التحتية – علاقات إنتاج وعلاقات اجتماعية –فالعالم العربي في بداية القرن الواحد والعشرين ليس هو في منتصف القرن العشرين ، وهي تحولات وإن كانت صغيرة وليست في المستوى المطلوب ، إلا أنها مهمة لكونها نتيجة نضالات حقيقية للقوى التقدمية والتحديثية دفع تمنها عشرات الآلاف من الشهداء والمعتقلين السياسيين والمفقودين الذين لم يعرف أهلهم عن مصيرهم شيئا بالإضافة للملايين الذين أجبرتهم أنظمة القمع وثقافة التخلف للعيش في المنافي،وليست منحة من النظام السياسي،مع أن النخب الحاكمة مسها أيضا شيئا من عدوى الديمقراطية الإكراهية لأنها لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن العالم ،ولأنها شعرت بأنه من الأفضل لها التنازل عن بعض صلاحياتها وامتيازاتها أفضل من أن تُجبر على ترك السلطة كليا .
كان من الممكن لمسيرة الإصلاح تحت الضغط التي فرضتها القوى التقدمية والديمقراطية الحقيقية على أنظمة الحكم إلى ما قبل عقدين من الزمن أن تتوج بمزيد من الإنجازات لولا مقاومات جماعات المصالح التي تولدت في بنية النظام وتجدرت حتى داخل النسيج الاجتماعي حيث أوجدت لنفسها بني طائفية أو قبلية أو جهوية تشاركها في المغانم وبالتالي لديها استعداد للقتال لدرجة تفجير حرب أهلية من اجل مصالحها التي ارتبطت بمصالح خارجية إقليمية أو دولية. كانت أنظمة الحكم في حالة إحراج وتحت ضغط شديد من قوى المعارضة السلمية ،حيث كانت كل محاولة لقمع المعارضة يرتد سلبا على النظام ،صحيح أن الجماهير المؤمنة بالتغيير والملتفة حول المعارضة دفعت ثمنا كبيرا ،وصحيح أن أنظمة الحكم مارست كل وسائل القمع والإبعاد والتهميش لقوى التغيير إلا أنها اضطرت في النهاية لتعيد النظر في موقفها تجاه المعارضة وفي آلية ممارستها للسلطة ،ومن هنا لاحظنا شيوع نوع من الديمقراطية الإكراهية- أن صح التعبير- أو ديمقراطية الالتقاء وسط الطريق لجأت إليها الأنظمة، أهم مؤشراتها إعلان العفو عن قادة المعارضة والسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات وبالتالي في السلطة ضمن شروط وقيود معينة، وإعادة النظر في بعض النصوص الدستورية والقوانين وشيوع ثقافة المشاركة والديمقراطية بدرجة ما وتقييد حرية أجهزة الأمن في الاعتقال والتعذيب الخ .
واجهت عملية الحراك السياسي باتجاه الإصلاح الديمقراطي تحديا جديدا منذ منتصف الثمانينات تقريبا ، فالثورة الدينية الإيرانية عززت من قوة الحركات الدينية في العالم العربي من حيث منحها نموذجا لإمكانية إسقاط انظمه مستبدة عن طريق الثورة،وبشكل ما عززت أيضا حركة المجاهدين الأفغان ضد الاحتلال السوفييت من قوة الحركات الدينية العربية،وإن كان الطابع الفارسي الشيعي للثورة الإيرانية وتحول حركة المجاهدين الأفغان إلى جماعات متقاتلة مع بعضها البعض افقد الثورتين الصلاحية لتكونا نماذج يحتذي به ،إلا أنهما من جهة أخرى أنتجتا مفاعيلهما بطريقة غير مباشرة من خلال تعزيز وتقوية الثقافة الدينية الأصولية والارتداد للماضي وتعزيز الانقسامات الداخلية ما بين المتدينين والعلمانيين وما بين أصحاب الملل من مسلمين ونصارى وغيرهم.
ظهور الجماعات الإسلامية الجهادية أعاق عملية الإصلاح وأعطى للأنظمة الفرصة للنكوص عن الوعود والانجازات الديمقراطية المتواضعة التي تحققت،فتمت العودة مجددا لمصادرة الحريات العامة والتضييق على أنشطة الجماعات المعارضة ،كما أن العمليات العسكرية للجماعات الإسلامية أحيت النزعة الدموية لأنظمة الحكم لتقمع ليس فقط المسئولين عن التفجيرات بل كل من يعارض النظام،كما أن أنظمة الحكم استفادت من حالة التعارض والتصادم داخل صفوف المعارضة ،ذلك أن الجماهير انقسمت في ولائها ما بين تيار يدعم الجماعات الإسلامية بخطابها وثقافتها ونهجها، وتيار يدعم قوى الحداثة والديمقراطية والعلمانية ،والأولون يكفرون أصحاب التيار الثاني ويكيدون لهم ويضعونهم أحيانا في سلة واحدة مع النظام مصنفين الجميع بالعدو القريب الأولى بالجهاد من العدو البعيد ،فيما أصحاب التيار الثاني يتهمون الإسلاميين بالظلاميين والإرهابيين،وبدلا من أن تتكاتف جهود كلا الطرفين باعتبارهم قوى معارضة لمواجهة عدو مشترك وهو النظام القائم ،أصبحت نضالات كل طرف تهدم وتخرب نضالات الطرف الثاني أو تشكك بها ،وهو الأمر الذي أضعف من قوة الطرفين في مواجهة الأنظمة الحاكمة ورد الاعتبار لهذه الأنظمة ومنحها مزيدا من الأمل بالحياة .
نعتقد بأنه لا داع للتأكيد بأننا لا نتحدث عن الإسلام كدين ولا عن الجهاد من حيث المبدأ
ولكنه موقف من جماعات تنسب نفسها للإسلام وتنصب نفسها ناطقة باسمه دون أن نعرف مَن فوضها بذلك ومن أين تستمد شرعيتها ؟ لو كنا أمام جماعة إسلامية جامعة وموحدة لكل التيار الديني لهان الأمر لأننا آنذاك نعرف مع من نتحدث؟ولكن عندما يكون في البلد الواحد عدة جماعات دينية لكل منها نهجها واجتهادها وموقفها من النظام والمجتمع ومن أصحاب الديانات الأخرى ،بل تتقاتل هذه الجماعات مع بعضها البعض أحيانا ،وعندما نكون أمام بعض الجماعات الأقل عددا وحضورا داخل المجتمع وبين الجماعات الدينية المتعددة ولكنها تتقن التدمير والقتل باسم الدين وفرض الجهاد دون أن تتوفر هذه القلة على رؤية للمجتمع الجديد والنظام السياسي الجديد أو فهم للواقع والمتغيرات الدولية والإقليمية أو عندها رؤية قاصرة لهذه الأمور … ،في هذه الحالة من حق كل مسلم ومواطن أن يتساءل لمصلحة مَن تصب أعمال هذه الجماعات ؟.
نعم ما زال هناك فسادا وتعثرا في مشاريع الإصلاح وارتهان الأنظمة لأجندة خارجية وسوءا في توزيع الثروة الخ ،أيضا ندرك بان قوى الاعتدال من ديمقراطيين وليبراليين لم يحالفهم كبير حظ في زعزعة المرتكزات الثقافية والمادية لقوى الهيمنة والاستبداد، وندرك أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية معنية في إبقاء هيمنتها على المنطقة وتحكمها في سيرورة تقدم النظم والمجتمعات العربية لضمان صيرورتها . أيضا نحن نؤمن بالتغيير ولكن التغيير الممنهج والمعقلن والمؤسَس على رؤية واضحة للحاضر وللمستقبل،حيث جربت مجتمعاتنا محاولات التغيير المغامِرة عن طريق الانقلابات والثورات التي لا تملك من الثورة إلا اسمها،والتي أدت إلى مزيد من تكريس الواقع بدلا من تغييره ،بإحلالها مستبدين جدد ببزات عسكرية أو شعارات ثورية. فهل يمكن إصلاح حال الأمة بأدوات غير ديمقراطية ولا جماهيرية ولا تملك أية رؤية للمستقبل،أو أن المستقبل بالنسبة لها هو العيش في الماضي أو جنات عدن في الآخرة ؟.
المشكلة تكمن في أن هذه الجماعات لا ترتكز في طرحها ومحاولاتها التحدث باسم الأمة لا على مبررات دينية مقنعة ولا مبررات ديمقراطية مقنعة. فمن ناحية دينية فإن قول هذه الجماعات بان الإسلام هو الحل أو بالحكم بما انزل الله ، قول انتُزع من سياقه الديني والزمني ويريدون إقحامه في سياقات مغايره ،فعن أي إسلام يتحدثون ؟أإسلام أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة ؟أم إسلام جماعة الإخوان المسلمين ؟أم إسلام التكفير والهجرة ؟أم إسلام العدالة والتنمية في تركيا ؟أم إسلام الأزهر ومفتي الجمهورية ؟أم إسلام ملالي إيران ؟أم إسلام شيوخ المساجد والزارات وجلسات النصب باسم العلاج بالقرآن؟. وما هو مفهوم الحكم بالإسلام؟ الخ، عندما تكون هوة الاختلاف بين هذه الجماعات وبعضها البعض بهذه الدرجة من الاتساع تصبح المقولات السابقة قولا بدون معنى و هم الذين افقدوها المعنى.أيضا القول بدولة الخلافة الراشدة لا معنى له،فنظام الخلافة أولا هو نظام دنيوي وليس نظاما دينيا ،بمعنى أن كل جماعة سياسية تقرر طبيعة نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي حسب الشروط التاريخية والموضوعية التي تعيشها بما لا يتعارض مع روح الإسلام وبما يحقق العدل للجميع (فحيث يكون العدل فثمة شرع الله ) كما يقول احد فقهاء الإسلام وهو ابن عقيل الحنبلي ،وثانيا من لا يستطيع استيعاب مستجدات العصر وعلومه ومن لا يستطيع التعايش مع أبناء وطنه ودينه في دولة وطنية تؤمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة هو غير مؤهل للحديث عن دولة الخلافة التي تجمع أمة إسلامية متناثرة عبر عدة قارات وتعيش في مجتمعات سياسية متعددة النظم والعادات واللغات ووجدت ضمن شروط تاريخية لا علاقة لها بزمن نزول الوحي !وحتى داخل المجتمع الواحد فإن تكفير المجتمع أو بعضه باسم قدسية موهومة هو نوع من الإرهاب الفكري.ومن ناحية ديمقراطية وعقلانية ،كيف يمكن تسليم مقاليد الأمة لأقلية فيما الشعب ومن خلال صناديق الانتخاب اختار ممثليه ؟وحتى مع التشكيك بالانتخابات أو عدم وجود انتخابات أصلا ،ففي كل بلد عديد من الجماعات الإسلامية الأكثر عددا وانتشارا والتي لها خيارها السلمي والمعتدل في التعامل مع الواقع ،فكيف يتم تجاوز هؤلاء ويلغى وجودهم لصالح قلة ميزتها الوحيدة بأنها الأكثر عنفا فقط؟ أينسى هؤلاء قول الرسول الكريم (ما اجتمعت أمتي على ضلال)فلا يمكن أن تكون الأمة على ضلال وهذه القلة المكفِرة للمجتمع على صواب.
نحن نعيش اليوم في عالم أكثر تعقيدا وتشابكا وتداخلا للمصالح ،نعيش في عالم أصبحت حياة المواطن والمجتمع رهينة للتطور العلمي والتكنولوجي والاقتصادي والثورة المعلوماتية وهذه الأمور ليست ترفا يمكن تجاوزه وتجاهله والقول بالعودة للعيش في مجتمع البساطة والتقشف،لم يعد اليوم مجالا لان تساس مجتمعات من طرف جماعات سرية . فكيف يمكن لمجتمع أن يُُرهن حاضره ومستقبله بجماعة تعمل بالخفاء ولا يعرف من يمولها؟ ولا أين مقرها؟ ومن قادتها الحقيقيون ؟وما فلسفتها ونظامها السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي ستقيم على أساسها دولة الخلافة الراشدة الموعودة؟كيف يمكن لمجتمع أن يقبل بان تسيره جماعة تخاطبه قيادتها المزعومة عبر رسائل الكترونية قد يكون مشكوك في صحتها؟كيف يقبل مجتمع بان تكون صلة الوصل بينه وبين قيادة هذه الجماعة المفترض بأنها قيادة الأمة مجرد عمليات تفجيريه يوظف فقر وجهل أفراد من أحزمة الفقر والأحياء المهمشة للقيام بها ؟هذا الغموض وهذه السرية هو الذي يثير شكوكا عند البعض حول إمكانية قيام القوى المعادية أو النظام السياسي نفسه بزرع بعض الجماعات أو الأشخاص وتكليفهم بالقيام بأعمال إرهابية ضد المدنيين تحت مسميات جماعات دينية وذلك لتشويه صورة الإسلام ومفهوم الجهاد والمقاومة وتبرير التدخل الخارجي في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب أو منح السلطة المبرر لقمع المعارضة أو الحد من الإنجازات الديمقراطية المنتزعة من النظام والتي باتت يهدد مصالح الفئات المنتفعة .
لقد تجنبنا وتجنب كثير من الكتاب والمفكرين ، نعت الأعمال المسلحة التي تقوم بها الجماعات الإسلامية بالعمليات الإرهابية،لان الأنظمة تنعتها بهذه الصفة ولان صفة الإرهاب أصبحت تهمة ترمي بها الولايات المتحدة وإسرائيل ومن يدور في فلكهم كل حركة أو جماعة تناصبهم العداء،أيضا لأنه وقر بالعقل وبالثقافة السائدة تقدير واحترام للبندقية ولكل فعل موجه ضد الأنظمة ،وخوفا من تهمة التلاقي في المواقف مع إسرائيل والغرب والأنظمة في التشهير بأعمال المقاومة المسلحة ،كنا حذرين في وصف هذه الأعمال بالأعمال الإرهابية،إلا انه بعد أن استشرى وباء هذه الجماعات وأصبحت تضرب هنا وهناك بارتجالية غالبا فلا تفرق بين مدنيين وعسكريين وظالم ومظلوم وأصبحت نتائج أفعالها تخدم أعداء الأمة أكثر مما تخدم الأمة،لم يعد مجالا للصمت لان الصمت نوع من التواطؤ،وبطبيعة الحال نحن نتحدث عن الجماعات التي تمارس أعمال داخل المجتمعات وضد مؤسسات وأفراد المجتمع وليس الجماعات الجهادية في مواجهة الاحتلال الأجنبي .
ما دفعنا للكتابة مجددا في هذا الشأن هي التفجيرات الانتحارية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء المغربية ،فمع أن عددا من المدن العربية عرفت مثل هكذا تفجيرات إلا أن حالة المغرب لها خصوصية،فلو كان نهج الجماعات الإسلامية الجهادية حقق نجاحا في الدول الأخرى كالجزائر ومصر والأردن وتونس والسعودية واليمن الخ السباقة للتعرض لهذا النهج ألعدمي من العنف السياسي المتشح بلباس الدين ،لكان من الممكن القبول بتعميم تجربة ناجحة ،ولكن عندما تكون نتائج هذا النهج مزيدا من الدمار والخراب ومزيدا من قمع الأنظمة والتضييق على الحريات العامة ودفع هذه الأنظمة لمزيد من التحالف مع واشنطن والغرب في إطار ما يعتبرونه خطرا مشتركا وهو الإرهاب،وفوق كل ذلك مزيدا من الرفض الشعبي لهذه الجماعات ،إذن عندما يعمم الدمار ويتكرر نهج وتجارب فاشلة ،آنذاك لا بد من طرح أكثر من سؤال حول هذه العمليات ومن يقف وراءها،ومن جهة ثانية فقد عرف المغرب في السنوات الأخيرة من حكم الملك الحسن الثاني تقدم ملفت للانتباه في عملية الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان وكانت أهم مرتكزاتها نهج سياسة التوافق والتراضي بين المكونات السياسية للدولة والعفو عن المعارضين السياسيين المقيمين في الخارج وإجراء انتخابات ديمقراطية أفسحت المجال لمشاركة حزب التقدم والاشتراكية وقوى اليسار وقوى إسلامية معتدلة كحزب العدالة والتنمية في السلطة بل ترأس السيد عبد الرحمن اليوسفي لحكومة توافق وطني، و في عهد محمد السادس تعززت عملية الانتقال الديمقراطي بإغلاق ملف المعتقلين السياسيين بل وفتح ملفات انتهاكات حقوق الإنسان في عهد والده من خلال لجنة الإنـصاف والعدالة وتعزيز ملف حقوق الإنسان ومحاربة الفقر الخ . هذه التحولات التي خلقت استقرارا للمغرب قد أثارت حفيظة قوى داخلية وخارجية ترفض أن يكون المغرب مثلا للاستقرار ولنجاح عملية الانتقال الديمقراطي السلمي فقررت ضرب هذا النموذج .
ويبدو أن هذه الأعمال الإرهابية قد حققت بعضا من أهدافها المشبوهة ،حيث لاحظنا انه بعد تفجيرات مايو 2006 تعززت القبضة الأمنية للسلطة وعادت الاعتقالات السياسية والحد من الحريات والتضييق على جماعات الإسلام المعتدل سواء المشارك في السلطة من خلال مشاركته بالمؤسسة التشريعية أو الذي فضل البقاء خارج النظام الرسمي وهي جماعة العدل والإحسان.ولذا وحتى يتم قطع الطريق على هذه الجماعات فيجب عدم الاقتصار على المعالجات الأمنية،المعالجة الأمنية لهذه الأعمال مهمة ولا شك ولكنها غير كافية ،فعلى النظام السياسي إعادة النظر في توزيع الثروة وفي الإستراتيجية الثقافية والإعلامية،والاهم من ذلك أن يضع حدا لأوجه الفساد التي تثير حفيظة المواطن العادي الذي يقارن ما بين وضعيته المزرية وحالة الغنى الفاحش لنخبة تتعامل معه كمجرد مواطن من درجة ثانية أو دون ذلك ،أيضا على القوى السياسية أن تتوقف مليا عند هذه الأعمال ففي هذه الأعمال إدانة لها من حيث عجزها عن استقطاب هذه الشرائح المهمشة أو على الأقل فشل هذه الأحزاب في خلق ثقافة وطنية تنويرية ترد فيها على ثقافة الجماعات التي توظف الدين لأغراضها المشبوهة ،سبب حنين البعض للماضي هو أن هؤلاء يجدوا في السلف الصالح وفي بعض الحقب التاريخية ما يعوض إحساسهم بالنقص تجاه الغرب المتفوق ولأنهم غير مؤمنين بان دولهم تؤسس لحاضر أفضل من الماضي ،ومن هنا فهم يفضلون العيش في ماض ميت وموهوم خير من العيش في واقع يعيشون فيه حالة غربة ولا يستفيدون من خيراته ـوعليه يجب إقناع الجيل الجديد وخصوصا الفقراء بان الحاضر والمستقبل سيكون أفضل من الماضي.