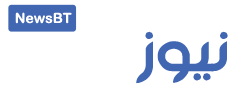د.إبراهيم أبراش
مقدمة
عام 1905 كتب نجيب عازوري(1) في كتابه [يقظة العرب]: “هناك حادثان هامان من طبيعة واحدة ولكنهما متعارضان، وهما يقظة الأمة العربية والجهد اليهودي الخفي لإنشاء مملكة إسرائيل القديمة من جديد وعلى مقياس أوسع، إن مصير هاتين الحركتين هو الصراع المستمر إلى أن تغلب إحداهما الأخرى” (2).
وفي أكتوبر 1991 عقد مؤتمر مدريد الذي دشن ما يسمى السلام في الشرق الأوسط بمشاركة كل الدول العربية المعنية مباشرة بالصراع، وفي سبتمبر الماضي بدأت المفاوضات على الوضع النهائي ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والتي حدد لها سبتمبر 2000 لحل المشاكل العالقة، ومنذ مؤتمر مدريد إلى اليوم اعترفت غالبية الدول العربية بإسرائيل، اعترافاً رسمياً أو اعترافاً واقعياً.
إذن، قرن مر على ما أصطلح على تسميته الصراع العربي الصهيوني، وها نحن على أبواب القرن الواحد والعشرين وإسرائيل دولة قوية، بل أقوى دول الشرق الأوسط، ومعترف بها من كل دول العالم، فيما هناك اثنان وعشرون كيان سياسي عربي وفلسطين بكاملها ما زالت تحت الاحتلال. فمن الذي أنتصر؟ هل هو المشروع القومي الوحدوي التحرري العربي أم هو المشروع الصهيوني؟
لن نكون متشائمين ولا يائسين، ولكن الواقع يقول أن المشروع الصهيوني إن لم يحقق أهدافه الاستراتيجية بإقامة إسرائيل التوراتية، فإنه حقق من الإنجازات ما يفوق كثيراً ما حققه المشروع القومي [العربي] الوحدوي، وهذا لا يعني نهاية المعركة أو أن المشروع الصهيوني أنتصر نهائياً وأن المشروع القومي الوحدوي العربي انهزم نهائياً، فمصائر الأمم وحقوقها التاريخية لا تحسم في معركة ولا بهزيمة جيل أو حتى أجيال، ولنأخذ العبرة من الأعداء أنفسهم، حيث حول الصهاينة أحلام أسطورية وخرافات دينية تعود لآلاف السنين إلى واقع بالمثابرة واستغلال الفرص والتمسك بما يعتبرونه حق توراتي، ولنأخذ العبرة أيضاً من شعوب كانت مغيبة لمئات السنين ثم انتفضت من وسط تحولات دولية وأعادت وجودها القومي إلى الخريطة السياسية الدولية، الأرمن والشيشان والأكراد والصرب والبوسنة.. إلخ.
ولكن هذا لا يعني عدم الاعتراف بالحقيقة حتى وإن كانت مرة، حقيقة أننا انهزمنا في غالبية المعارك التي خضناها، معاركنا ضد العدو الصهيوني أوفي معاركنا ضد الجهل والتخلف ومن أجل الوحدة والتنمية والديمقراطية (3)، والاعتراف بهذه الحقيقة يتطلب وقفة مساءلة وتقييم وإعادة ترتيب سلم الأولويات، وسيكون من العبث ومن باب خداع الذات أن نحمل كل المسؤولية للأعداء ونوظف بتطرف نظرية المؤامرة، نعم هناك تآمر أجنبي ولكن عمر المشروع القومي العربي قرن من الزمن، فماذا فعلنا في مواجهة التآمر والمؤامرة؟ وهل يعقل أن قرن من الزمان كله تآمر في تآمر؟
لا تسمح لنا صفحات المقال المحدودة بتقييم شامل لمسيرة المشروع القومي العربي بشقيه الوحدة العربية وتحرير فلسطين، ولذا سنقتصر هنا على تناول موضوع من شقين وهو يعكس نمط التفكير وأسلوب التعامل مع قضايانا المصيرية وهو ما نعتبره كذلك من أهم أسباب تعثر المشروع القومي العربي، الشق الأول هو هيمنة نظرية المؤامرة على تفكيرنا بحيث نزهنا أنفسنا عن الخطأ وتعاملنا مع كل ما يحدث وكأنه مؤامرة خارجية وخصوصاً فيما يتعلق بفشل تجاربنا الوحدوية، والشق الثاني من الموضوع سنحاول من خلاله أن نبين أن ليس كل ما جرى لنا نتيجة مؤامرة بل هناك أخطاء ارتكبناها وارتجالية صاحبت طريقة تعاملنا مع قضايانا المصيرية وخصوصاً القضية الفلسطينية.
أولاً: نظرية المؤامرة السياسية بين التحليل العلمي والتهويل السياسي
الحديث عن وجود مؤامرة تستهدف الأمة العربية والإسلامية، ليس بالأمر الجديد، فمنذ محادثات حسين- مكماهون عام 1915 واتفاقية سايكس بيكو1916 ووعد بلفور 1917 والخطاب السياسي لقوى سياسية عربية قومية واشتراكية وإسلامية، تتحدث عن وجود مؤامرة استعمارية صهيونية تستهدف تفتيت الأمة العربية والعالم الإسلامي بافتعال حروب أهلية وإثارة صراعات بين شعوب المنطقة تطبيقاً لمبدأ فرق تسد وعملاً على إضعاف شعوب المنطقة لتنشغل بمشاكلها وحروبها الأهلية، ليعيش الكيان الصهيوني بسلام وتتمكن القوى الأجنبية من فرض سيطرتها ونهب ثروات المنطقة.
واعتبرت الحركة الصهيونية هي العقل المدبر وراء هذه المخططات لتخوفها من وحدة العرب في مواجهتها وحتى لا تبقى إسرائيل وحدها الكيان الطائفي الغريب في منطقة توحدها الثقافة والدين والمصالح المشتركة.
وتجدد الحديث عن المؤامرة، وخصوصاً بعد انهيار المعسكر الاشتراكي المتزامن مع حرب الخليج الثانية، إن ما يلاحظ هو أنه بعد كل فشل أو هزيمة تصيبنا يروج الفاعلون السياسيون مقولة المؤامرة الأجنبية بحيث بات الآخر، القدر أو الاستعمار أو أمريكا أو الشيوعيون أو الصهيونية أو الشركات المتعددة الجنسية والمؤسسات المالية الدولية، هو المسؤول عن تعثر مشروعنا القومي الوحدوي! (4). فما هي حقيقة نظرية المؤامرة؟
لا سياسة دون تآمر
هناك مستويات يمكن الانطلاق منهما لمقاربة ما يمكن تسميته بنظرية المؤامرة: مقترب التحليل السياسي العلمي، ومقترب التهويل السياسي.
على المستوى الأول: كل مطلع وملم بعلم السياسة يعرف أن السياسة هي سعي لتحقيق المصالح، فالمصلحة هي الهدف الأول الذي تسعى إليه الدول والأنظمة في سلوكها السياسي الداخلي والخارجي، وتحقيق المصلحة الوطنية لدولة ما يتم بإحدى الطريقتين إما بالسلم وحسب قواعد القانون والأعراف الدولية أو بالحرب والصراع وما يصاحبهما من خداع ومناورة وتآمر. والوسيلتان معا هما السياسة أوهما وجها عملة واحدة هي السياسة، والقول أن السياسة لا تعرف الصراع والتآمر لا يستقيم مع فهم السياسة على حقيقتها كسياسة بشر لا سياسة ملائكة.
فمنذ ميكافللي، إن لم يكن قبل ذلك، جردت السياسة من الأخلاق أو فلنقل أصبح للسياسة أخلاقياتها الخاصة بها، ومن أخلاقياتها الحرب والخداع أو التآمر، فتحقيق المصالح أو الأهداف الوطنية في عالم تتناقض فيه المصالح يبرر للدول نهج ما تراه ضرورياً من وسائل وهذا هو توصيف نظرية (السياسة الواقعية) للسياسة،والسياسة الواقعية هي السائدة اليوم، إنها سياسة تقوم على قاعدة (الغاية تبرر الوسيلة)، وأن السلم والحرب وجها عملة واحدة، وأن ما لا يمكن تحقيقه بالقانون وبالسلم يجوز تحقيقه بالحرب والخداع والتآمر، وقد عرف أحد علماء السياسة وهو جوليان فروند، السياسة بالقول: إنها تشبه كيس سفر فيه ما شئت من الأشياء، القانون، والحرب، الأخلاق، الخداع، المناورة، والإرهاب.. إلخ.(5)
ومن هنا يمكن القول إن التآمر قلب السياسة، ونقصد به أن ما لا تستطيع السياسة تحقيقه بالمكشوف وعن طريق القانون والاتفاقيات، تسعى لتحقيقه عن طريق الحرب والخداع والمناورة، وكل دولة من دول العالم لها سياستان: سياسة معلنة مزينة بشعارات ومبادئ أخلاقية وقانونية، وسياسة سرية أو خفية يرسمها استراتيجون وأجهزة المخابرات تطبقها في الخفاء، أو يلجأون إليها وقت الحاجة، في الولايات المتحدة مثلاً هناك التآمر ضد كوبا، وفضيحة ووترجيت وإيران جيت وغيرها، وهي وجه تآمري من السياسة. والسياسة الذكية هي التي تأخذ بكل الاحتمالات، فتعمل علنا ضمن القانون والشريعة والمبادئ الإنسانية، ولكنها لا تسقط من حساباتها التآمر والخديعة لأن مواقف وسلوكيات الطرف الآخر في العلاقة السياسية ليست مضمونة دائماً، ولأن المصالح غالباً في حالة تضارب.
المستوى الثاني: التهويل السياسي لنظرية التآمر
مما سبق يمكننا القول إن لا سياسة تخلو من التآمر، والقول بأن الولايات المتحدة والدول الغربية يتآمرون على الأمة العربية والإسلامية ليس بالشيء المثير أو المستهجن أو حتى بالشيء الجديد، ولكن السؤال لماذا تثار مجدداً فكرة التآمر؟ وما هو الهدف من إثارتها؟ وكيف يمكننا التمييز بين المؤامرة كحقيقة، وبين القول بالمؤامرة كذريعة للتهرب من المسؤولية عن الأخطاء؟ وهذا ما يدفعنا للتساؤل هل أن مجمل تاريخنا الحديث بما عرفه من ترتيبات وعلاقات وأشكال النظم والسياسات ومن هزائم وانتصارات كله بفعل مؤامرات خارجية؟
إذا كان من المقبول والمعقول الحديث عن وجود مؤامرة أجنبية ضد الأمة العربية والإسلامية، فإن غياب الإرادة والاستراتيجية الواضحتان للتعامل مع هذه المؤامرة والاكتفاء بالحديث عنها وتضخيمها يتحول بدوره إلى مؤامرة ولكنها في هذه الحالة مؤامرة من الذات ضد نفسها.
وللأسف فإن بعض القوى والأنظمة السياسية توظف القول بوجود مؤامرة خارجية لتخفي عجزها وفشلها ولتتهرب من تحمل المسؤولية عن الأوضاع المتردية التي تعيشها شعوبها، وكأنها بذلك تريد أن تبعد الأنظار عن مسؤوليتها عن تردي الأوضاع بالزعم أن الخارج هو المسؤول، ويصبح بذلك الحديث عن المؤامرة المشجب الذي تعلق عليه كل الأخطاء والتجاوزات وأوجه القصور والخلل في مجتمعاتنا. وطبيعة بنية العقل العربي المنغلق أمام الديمقراطية والرافض لمبدأ النقد والنقد الذاتي، والمتلبس بحال من الاستعلاء والاستغلاق وحب السلطة أو الخضوع لمن هو في السلطة، يجعل فكرة المؤامرة مقبولة وسريعة الانتشار، فهو عقل يرفض الاعتراف بالخطأ ومراجعة حساباته، ويرفض أن يضع أقانيم أضفى عليها طابع القدسية موضع التساؤل، فالذات دائماً لا تخطئ والخلل دائماً سببه خارجي وقد صدق الشاعر عندما وصف هذا النمط من التفكير بالقول:
نعيب زماننا والعيب فينا وما في الزمان من عيب سوانا.
وهكذا استراح العقل العربي إلى مقولة المؤامرة الخارجية وتبرئة الذات من الخطأ، منذ بداية القرن إلى اليوم والعقل العربي يعتبر كل ما أصابنا هو تآمر أو أمر لا إرادة لنا فيه، وهكذا استسهلنا توظيف الدين للتهرب من المسؤولية، فكل شيء قضاء وقدر “وقل لن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم”. ولا قدرة لنا على الرد على إرادة الله، وكل ما يمكن فعله التوجه إلى الله ليرفع عنا البلاء، وينقذ العباد والأرزاق، حتى أنه في أحد خطب الجمعة وفي دولة عربية إسلامية وقف الخطيب ومن على شاشة التلفزة يرفع يديه إلى السماء طالباً من الله تعالى أن يحسن مناهج التعليم في البلاد، وكأن الله هو المسؤول عن فشل مناهج التعليم أو هو الذي قام بوضعها وبالتالي نطالبه بتغييرها بما نشتهي ونريد.(6)
وتحت غطاء هذا المنطق، وهو منطق يقوم علي مسلمات المؤامرة الخارجية، قبلنا بأنظمة دكتاتورية وعشائرية متخلفة، وسكتنا عن نهب ثرواتنا وخيراتنا من طرف الأجانب وقلة من المواطنين، وسكتنا علي أكل القوى للضعيف، وعلى انتهاك الحقوق ودوس الكرامة والمقدسات، ولم نبذل إلا أقل الجهود لإعادة النظر في نمط تفكيرنا وتصورنا وفي طبيعة العلاقات والمؤسسات التي نعيش فيها، فما دمنا مسيرين لا مخيرين، ومادام كل ما يجرى هو من إرادة الله ومشيئته أو عقابا منه علي أخطائنا، فلنجلس وننتظر الفرج والرحمة.
وفي مرحلة لاحقة عندما أصبح لدينا دول وحكومات وتبنينا شعارات وأيديولوجيات، انتقلت فكرة المؤامرة لتأخذ طابعاً سياسياً أيديولوجياً، فعندما عجزت الأنظمة العربية عن تحقيق ما تطمح إليه الجماهير من حرية وحياة كريمة، وعندما بدأت الجماهير تستفيق من خدر الأيديولوجيات وتتذمر من حكامها وتوجه أصابع الاتهام إلى النخبة السياسية الحاكمة وظفت هذه الأخيرة نظرية المؤامرة للتهرب من المسؤولية ولشغل الجماهير بالخطر الخارجي عن الانشغال بالأسباب الحقيقية للفقر والتخلف وسوء الأوضاع، وهكذا اعتبرت الأنظمة الثورية والقومية أن ما يحول دون تحقيقها للأهداف التي وعدت بها الجماهير هو التآمر الصهيوني الاستعماري(7)، واعتبرت الأنظمة المحافظة أن سبب تعثرها في مسيرتها التنموية وفي تحقيق الاستقرار هو تآمر الشيوعيين والمرتدين، ففكرة المؤامرة وتوظيفها بشكل مضخم هي أقصر طريق وأفضلها للتهرب من المسؤولية ولإلهاء الجماهير وخصوصاً إذا كانت هذه الجماهير أمية وجاهلة.(8)
ولكن هل سبب فشل المشروع الحضاري العربي يعود لوجود مؤامرة خارجية؟
إذا تجاوزنا المؤامرة كحالة مرضية يمكنها أن تصيب الفكر السياسي لأي نظام غير ديمقراطي لا يريد أن يتحمل المسؤولية عن أفعاله، ونظرنا للعلاقات العربية الإسلامية من جهة والغربية الأمريكية الصهيونية من جهة أخرى، فإن طبيعة هذه العلاقات تاريخياً وطبيعة المصالح الاستراتيجية للطرف الثاني في المنطقة العربية تجعلنا لا نستبعد وجود تآمر وخصوصا عندما دخل الكيان الصهيوني كمكون رئيس في هذه العلاقة.
وكما سبق الذكر فإن أية علاقة كالعلاقة بين الغرب الاستعماري والعالم العربي والإسلامي لا بد أن تستدعي وجود جانب من التآمر لاعتبارات الجغرافيا والتاريخ والدين والمصالح الاقتصادية، ولو نظرنا إلى تاريخ العلاقة بين الطرفين منذ الأندلس إلى اليوم لوجدناها علاقات حرب وصراع واستعمار متبادل، أو سلم مشوب بالحذر.
ولن نذهب بعيداً في التاريخ للتدليل على وجود تآمر على الأمة العربية والإسلامية، ولكن سنأخذ بعض المحطات أو المؤشرات الدالة على وجود سياسة تآمرية هي جزء من السياسة الاستعمارية الإمبريالية، ففي عام 1907 طلب رئيس الحكومة البريطانية كامبل بنرمان من لجنة من الاستراتيجيين والخبراء وضع تصور عن المخاطر التي قد تتعرض لها الإمبراطورية البريطانية والحضارة المسيحية، وكانت خلاصة التقرير الذي سمي بتقرير ـ كامبل بنرمان ـ أن الخطر يكمن في الشعوب التي تقطن السواحل الجنوبية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط، نظراً لما يجمعها من تاريخ مشترك ودين وثقافة، ونصح التقرير بتقسيم المنطقة وتفتيتها إلى دويلات طائفية متناحرة، كما نصح بزرع جسم غريب يفصل شرقها عن غربها ونصح التقرير بريطانيا بإسكان اليهود في فلسطين (9)، وفي عام 1915 وأثناء الحرب العالمية الأولى دخلت بريطانيا في مفاوضات مع العرب لتشجيعهم على التمرد على الإمبراطورية العثمانية مقابل إقامة دولة عربية موحدة في المناطق العربية من الدول العثمانية، وقد سميت هذه المباحثات بمحادثات حسين ـ مكماهون، ولكن في نفس الوقت الذي كانت تجري فيه هذه المحادثات كانت بريطانيا تجري محادثات سرية مع فرنسا من جهة والحركة الصهيونية من جهة أخرى، وهي مفاوضات تمثل قمة التآمر، فمع فرنسا وقعت اتفاقية سايكس ـ بيكو 1916 لتقسيم المنطقة العربية إلى مناطق نفوذ بين الدولتين، ومع الحركة الصهيونية توجت المفاوضات بإعلان وعد بلفور الذي أعطى اليهود وطناً في فلسطين، أما العرب الذين تحالفوا مع بريطانيا وفرنسا فقد تحولوا إلى شعوب مستعمرة (10).
وتواصل مسلسل التآمر، حيث وضعت الدول الأوروبية والولايات المتحدة كل ثقلها لإقامة الكيان الصهيوني وضمان تفوقه، وعملت على إثارة الصراعات والحروب الأهلية في المنطقة، بدءاً من سياسة الأحلاف خلال الخمسينات، إلى تغذية الحرب الأهلية في لبنان، ودعم متمردي جنوب السودان، والعمل على فصل جنوب وشمال العراق عن الدولة المركزية، ودعم كل الحركات والجماعات الطائفية والعرقية المعارضة للدول العربية والإسلامية باسم حقوق الإنسان والديمقراطية، واحتضان جماعات معارضة عربية وإسلامية لا تخفي استعمالها للعنف ضد بلدانها، ولا ننسى في هذا السياق أحدث تآمر صهيوني أمريكي وهو التآمر على القضية الفلسطينية باسم التسوية السلمية، حيث أوقعت أمريكا الفلسطينيين والعرب في المصيدة الصهيونية باسم التسوية والسلام وتركتهم لمصيرهم.
أما أعظم تآمر ضد الأمة العربية الإسلامية فهو الذي يجري في الخليج العربي باسم الشرعية الدولية، فمع عدم تجاهل أخطاء أنظمة المنطقة ومسؤولياتهم في نشوب الأزمة فإن الولايات المتحدة وبريطانيا والحركة الصهيونية وظفوا الأزمة بشكل تآمري مكنهم وتحت شعارات الشرعية الدولية وأمن المنطقة تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه طوال عشرات السنين من التآمر على شعوب المنطقة.
إن المتفحص للخريطة السياسية العربية والإسلامية يجد أن كل دولة من دول المنطقة منشغلة بمشكلة إما داخلية تهدد وحدتها واستقرارها وإما مع جيرانها تستنزف خيراتها وموارده وتحول دون إقامة علاقات سوية، فبالأحرى توحيد المنطقة، وفي جميع الحالات نجد الدور الاستعماري الأمريكي أو الأوروبي أو الصهيوني أو جميعهم، متجسداً في دعم طرف ضد طرف أو في دعم الطرفين المتنازعين، في العلن أو في السر.
إذا كانت هذه هي الأشكال السياسية للتآمر فالأوجه الاقتصادية والثقافية لا تقل خطورة، فالعلاقات الاقتصادية غير المتكافئة والنهب الذي تمارسه الشركات متعددة الجنسيات، وربط اقتصاديات البلدان العربية بالمركز الرأسمالي من خلال وسطاء محليين هم الشريحة الفاسدة في المجتمع، وفرض وترويج نمط الاستهلاك الرأسمالي، كل هذه أمور تدخل في باب التآمر وإن أخذت أشكالاً قانونية، لأنها في النهاية تضعف الاقتصاديات الوطنية وتلحقها بالاقتصاد الرأسمالي الغربي، وتأتي سياسة العقوبات والحصار كنوع جديد من التآمر، وعلى المستوى الثقافي والإعلامي، فإن هيمنة وسائل الإعلام المسيطر عليها من طرف الصهيونية العالمية ومؤيديها في الغرب، هيمنتها على شبكات صناعة ونقل المعلومات والأخبار يعمل على تشويه الحقيقة ونقل صورة مغرضة عن الشعوب العربية والإسلامية، فتحول المسلم أو العربي إلى إرهابي لمجرد دفاعه عن حقوقه المشروعة، والثقافة العربية تتحول إلى أساطير شعب بدائي وهمجي والدين الإسلامي يتحول إلى تعاليم تحض على العنف وتحتقر المرأة ولا تعترف بحقوق الإنسان، الأمر الذي ينتج عنه تعميق العداء بين شعوب العالم من جهة والشعوب العربية الإسلامية من جهة أخرى، ومن خلال حالة العداء هذه التي تصنعها وسائل الإعلام يمرر الغرب وأمريكا والصهيونية مؤامراتهم ضد العرب والمسلمين.
ولكن ما العمل وكيف تعاملنا ونتعامل مع التآمر الخارجي؟
لا يمكن لمؤامرة خارجية أن تنجح إذا لم تتوفر لها شروط داخلية أو أدوات محلية تسهل عليها الأمر، ونجاح الغرب في تمرير مؤامراته ضد العرب والمسلمين، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أو فيما يتعلق بحرب الخليج ونتائجها المدمرة على الأمة العربية، أو على مستوى إثارة النعرات الطائفية والإثنية، أو إضعاف الاقتصاديات الوطنية، نجاح الغرب في هذا ما كان له أن يكون دون المساعدات التي يتلقاها من أطراف مسؤولة في البلدان المعنية، حتى يجوز القول إن تآمرنا الداخلي على أنفسنا هو الذي يسهل عملية تآمر الأجنبي علينا.
فلو كانت هنا وحدة عربية حقيقية أو تضامن إسلامي فعال لتحطمت على صخرتيهما كل مؤامرات الأعداء، وفي هذا السياق يجب الإشارة إلى أن تآمر الغرب الاستعماري والصهيونية العالمية ليست دوافعه فقط تخوفات من واقع العرب والمسلمين اليوم، بل انهما، يتآمران تخوفاً من المستقبل، فلا الوضع العربي ولا الوضع الإسلامي اليوم هما محل تخوف الغرب، بل هو ما يمكن أن يكون عليه العرب والمسلمون إذا ما اتحدوا وسيطروا على ثرواتهم وتحكموا بمصيرهم.
إن المخطط التآمري الأمريكي البريطاني الصهيوني، كما أنه يسعى إلى تثبيت واقع التجزئة والفرقة بضرب كل توجه وحدوي أو تضامن بين العرب والمسلمين فإنه يعمل على مزيد من تفتيت المنطقة، حيث أن هناك مخططات جاهزة لكل دولة عربية وإسلامية لتحويلها إلى دويلات متطاحنة على أسس طائفية أو إثنية، وهو في هذا المضمار يدعم قوى وعناصر التفرقة والطائفية والإقليمية من أحزاب وقوى سياسية وأنظمة وأصحاب مصالح، وللأسف فإن الولايات المتحدة لا تجد صعوبة في إيجاد أعوان لها يساعدونها على تنفيذ مخططاتها، تحت ذريعة حقوق الإنسان أو تقرير المصير أو مقاومة الاستبداد. (11)
وتبقى الوحدة العربية هي الحل للخروج من الأزمة لأنه بالوحدة نفقد الأعداء مبرر استغلال التناقضات والخلافات، والقائلون بوهم تحقيق الوحدة العربية هم نفسهم المستفيدون من الوضع القائم، من حالة التجزئة والتخلف والصراع، إنهم أدوات الغرب الاستعماري الذي يوظفهم في تنفيذ مخططاته في المنطقة، فليس معقولاً أنه في الوقت الذي يتجه فيه العالم المتحضر في أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا نحو الوحدة والتكتل ودول هذه المناطق لا تربطها لا رابطة القومية ولا رابطة الدين ولا التاريخ المشترك، بينما نحن الشعوب العربية حيث التاريخ والدين واللغة والتجاور الجغرافي نتجه نحو مزيد من الفرقة والتناحر، الأولون يعيشون في عصر وحدة وتكتلات الكبرى ونحن نعيش في عصر التحول إلى شعوب وقبائل متناحرة.
وإذا كانت القاعدة تقول ابحث عن المستفيد، فإن ما يعيق تحقيق الوحدة العربية هم المستفيدون من واقع تجزئتها وهم الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة والصهيونية العالمية وأدواتهما في المنطقة، والمستفيدون من الوحدة هم الشعوب العربية، وبالتالي فهذه الشعوب هي التي تتطلع للوحدة، وبالتالي لا ننتظر أن تتحقق الوحدة إلا إذا أصبح للجماهير دور في اتخاذ القرار السياسي أي في ظل الديمقراطية.
ولكن هذا لا يعني العودة إلى فكر التآمر وتحميل الآخرين المسؤولية عن فشل الوحدة، فأنظمتنا السياسية وكذا مثقفونا وقادة الحركات القومية يتحملون مسؤولية ليس فقط عدم تحقيق الوحدة بل مسؤولية فشل إحداث تقدم ونماء حقيقي في ظل واقع قطري. إن ما يعيق تحقيق الوحدة العربية بالإضافة إلى العوامل الخارجية، هو غياب إرادة حقيقية في الوحدة عند النخبة السياسية العربية، وتخلف الفكر القومي العربي الكلاسيكي والأدوات التنفيذية البشرية المشتغلة عليه، حيث لم يتمكن القوميون العرب من إعطاء الفكر القومي العربي بعداً حضارياً يتجاوز مفهوم العرق والخصوصية ليجعل من العروبة انتماءً حضارياً ثقافياً يشعر المنتمون إليها من عرب وغير عرب أن بقاءهم في حظيرة العروبة أفضل لهم من الخروج منها، وأن العروبة لا تعني إلغاء ثقافتهم بل إغناء لها وتلاقح معها، كما أن القوميين الوحدويين العرب من أحزاب وأنظمة سيطرت عليهم لغة الشعارات والأيديولوجيا بدل لغة المصلحة المتبادلة لجميع الأقطار العربية في عالم أصبحت المصالح المادية هي عصب الحياة ومحرك السياسة. (12)
وعليه يمكن القول إن الرد على التآمر لا يكون إلا بالوحدة والوحدة العربية ممكنة التحقق بإعادة النظر في الأسس التي يقوم عليها الخطاب الوحدوي العربي، ليؤسس على المصالح المتبادلة لأنها لغة اليوم، مع الابتعاد عن النظرية الثورية الانقلابية التي طبعت الحركة الوحدوية العربية، حيث كانت تقوم علي تجاوز ورفض الواقع القطري، من علاقات وهويات وأنظمة، متجاهلة أنه ليس كل الأقطار العربية وليدة اتفاقية سايكس ـ بيكو فبعضها له هويته المتميزة منذ مئات السنين وتمتزج في هذه الهوية العروبة مع ثقافات أخرى لا يمكن تجاهلها، ومن هنا تصبح الوحدة هي عملية توفيق بين خصوصيات وهويات ولو في المرحلة الأولى، وهذا التوفيق هو الذي سيؤدي إلى هوية قومية لا عرقية تقوم على المصلحة المشتركة والأهداف المشتركة.
هذا التصور للوحدة الذي يقوم على أسس براغماتية واقعية يحتمه واقع أننا كعرب لم نعد اليوم سادة العالم ومحور الكون ولا حملة رسالة سماوية حتى نفرض مشيئتنا وإرادتنا على الآخرين، فالأسباب التي بمقتضاها خضع غير العرب للعرب في صدر الإسلام وازدهاره لم تعد قائمة اليوم، الأمر الذي يتطلب نسج علاقة جديدة بأسس جديدة مع الابتعاد عن التعامل مع كل من يطالب بإعادة النظر في أمر هذه العلاقة وكأنه يتآمر على العروبة. (13)
ومن هنا يمكن القول أن استلهام التجربة الأوروبية بالوحدة مفيد، ويمكن من واقع التجربة الأوروبية ومن التجارب الفاشلة للوحدة العربية وضع الأسس التالية لمسار وحدوي عربي:
1- نشر الثقافة الديمقراطية وقيمها في مجتمعاتنا.
2- الاعتراف المتبادل على أساس المصالح المشتركة.
3- السير بالوحدة على خطوات ومراحل.
4- البدء بالاقتصاد لأنه أكثر جلباً للفائدة وبالتالي أكثر إقناعاً بفوائد الوحدة.
5- تسوية كل الخلافات بين الدول المشاركة في الوحدة حتى لا تكون مبعث صراع مستقبلي يهدد الوحدة في سنواتها الأولى.
6- إن الوحدة لا تلغي الهويات والثقافات الخاصة بكل شعب من الشعوب، بل يترك أمر الاندماج الثقافي للزمن.
7- إزالة الفوارق الكبيرة بين النظم السياسية وخصوصاً على مستوى الخيارات الأيديولوجية والاقتصادية.
8- اعتبار الوحدة عملاً جماهيرياً لا يخص القادة وحدهم وبالتالي عرض كل خطوة وحدوية على استفتاء شعبي.
9- التعامل مع الوحدة باعتبارها هدف مستقبلي يتطلب إنجازه سنوات وتأتي عبر إنجازات وخطوات تدريجية، وبالتالي الابتعاد عن التفكير الارتجالي الذي يعتبر أن الوحدة تتحقق بقرار وبين ليلة وضحاها.
إن أسوأ ما يمكن أن يصيب أمة من الأمم هو اليأس والإحباط، وأمة كالأمة العربية في عراقتها وتاريخها الحضاري، يفترض أن لا تستسلم للأمر الواقع، إنه لا شك واقع رديء وسلبي، والتآمر الخارجي موجود ولاشك ولكن بقوة إرادة الشعوب وحكمة قادتها المخلصين يمكن التغلب على الصعاب للتخلص أولاً من أوهام تعيق قدرتنا على التعامل مع العالم وأهمها وهمان الأول: أن العالم من غير العرب والمسلمين يشكل وحدة واحدة وبالتالي يتحالف في مخطط استعماري ضدنا، الوهم الثاني: التعامل مع العرب والمسلمين وكأنهم عالم حقيقي قائم ويشكل وحدة واحدة وتناسي بالتالي أننا دول عربية ـ إسلامية ـ متصارعة ـ متباعدة وأن علاقات بعضها مع من نعتبرهم بالمتآمرين هي أقوى بكثير من علاقاتها مع بقية الدول العربية والإسلامية.
وعليه إذا كان الأساس الذي تقوم عليه فكرة التآمر هو الصراع حول المصالح، فإن التناقض في المصالح لا يمس فقط ما هو قائم بين الأمة العربية الإسلامية والدول الاستعمارية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، بل كل دول العالم تتصارع وتتنافس، والوجه الآخر هو التعاون، على المصالح، ومن هنا لا يجوز أن نضع في سلة واحدة كل دول العالم من غير العرب والمسلمين ونقول أنهم يتآمرون على العروبة والإسلام، ونضخم فكرة المؤامرة لتصبح مؤامرة ضد العروبة والإسلام.
إن الحكمة ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين تستدعي وضع مقولة وجود مؤامرة ضد العرب والمسلمين في سياقها الصحيح وحجمها الصحيح، فهناك دول ذات شأن كالصين وروسيا واليابان وفرنسا وغيرها يمكن أن تكون عونا للعرب والمسلمين في تحقيق نهضتهم ووحدتهم بل يمكنهم أن يكونوا ومن خلال خلق مصالح متبادلة عوناً في إفشال التآمر الأمريكي ـ الصهيوني على ودول المنطقة، فهذه الدول ذات ثقافات عريقة وأسس حضارية تجعلها ذات وزن دولي يحول دون إلحاقها بالغرب الاستعماري، بل هناك مصلحة استراتيجية تجمع هذه الدول والعالم العربي والإسلامي، وهي مواجهة التطلع الأمريكي للهيمنة على العالم. والمطلوب عربياً وإسلامياً التمييز بين خطاب التحريض السياسي وبين الواقع السياسي، ففي ظل وحدة عربية أو عربية ـ إسلامية ذات مصالح مشتركة قائمة وأهداف مشتركة مجمع عليها، وفي ظل تناقض المصالح والأهداف بين الدول العربية ـ الإسلامية وبعضها البعض يصبح الحديث عن وجود مؤامرة ضد (أمة عربية ـ إسلامية) هو كلام غير علمي، وعليه يمكن القول أن الرد الصحيح على المؤامرة هو أن نوقف تآمرنا على بعضنا البعض أولاً ثم نتجه لوقف تآمر الآخرين علينا، أي أن نفقد المتآمرين الأدوات والمبررات المحلية التي تسهل عليهم مخططاتهم التآمرية.
ثانياً: مأزق القضية الفلسطينية يعكس مأزق المشروع القومي ـ الوحدوي
بعد قرن من انطلاق المشروع القومي ـ العربي لم يقتصر تعثر هذا المشروع في تحقيق أهدافه على موضوع الوحدة العربية بل فشل أيضاً في موضوع هو من صميمه ويعد توأم الوحدة العربية ألا وهو تحرير فلسطين، فهل كان للمشروع الوطني الفلسطيني أن ينجح حيث فشل المشروع الوحدوي العربي؟
من المعلوم أن المشروع الوطني الفلسطيني ولد في أحضان المشروع القومي العربي، واختلاف التصورات ما بين الوطنيين الفلسطينيين والوحدويين العرب حول أيهما له الأسبقية، الوحدة أم التحرير، أي هل التحرير طريق الوحدة أم الوحدة طريق التحرير لم يمنع تلازم المشروعين واعتماد كل منهما على الآخر.(14)
وكان من البديهي أن ينعكس تعثر المشروع الوحدوي ـ القومي ـ العربي سلباً على المشروع الوطني ـ الفلسطيني الهادف لتحرير فلسطين، وهذا ما نلمسه من تحول المرجعية التي تتعامل على أساسها منظمة التحرير الفلسطينية مع القضية الفلسطينية، فمن الحقوق الشرعية التاريخية إلى الحقوق المستمدة من الشرعية الدولية، ومن مرجعية الشرعية الدولية إلى المرجعية التفاوضية وهي المرجعية التي تعمل إسرائيل من خلالها على تصفية القضية الفلسطينية. فهل كان من الممكن أن ينجح المشروع الوطني الفلسطيني في ظل انهزام المشروع القومي الوحدوي العربي؟ وكيف انعكس سلباً تعثر المشروع الوحدوي القومي على المشروع الوطني الفلسطيني؟ وما هي آفاق القضية الفلسطينية على أبواب القرن الجديد؟
مما لاشك فيه أن الحقوق القومية للشعوب ليست محل مساومة، وأن يصل الأمر بقيادة شعب من الشعوب بأن تبحث لشعبها عن مرجعية بديلة للمرجعية التاريخية والحقوق القومية لتسند تحركها السياسي المطالب بالاستقلال وتقرير المصير، إنما هو مؤشر خطير، ليس علي عدم شرعية الحقوق القومية التاريخية بل علي واحد من أمرين أو كليهما، الأول، حدوث تحولات دولية وإقليمية تتعارض مع الحقوق القومية للشعب المعني، والثاني، فشل القيادة السياسية للشعب المعني بالأمر بالارتقاء بأدائها السياسي أو العسكري إلى المستوي المطلوب مع التعامل، وذلك لوجود أزمة في القيادة، أزمة أشخاص أو أزمة ممارسة.
كان من سوء حظ الشعب الفلسطيني أنه عانى من الأمرّين/ الأمرين معا، حيث كانت الأحداث والتحولات الإقليمية والدولية تعمل باستمرار ضد حقوقه المشروعة وضد أن يكون صاحب القرار الأول فيما يخص قضيته الوطنية. فبالنسبة للأمر الأول أي التحولات الإقليمية والدولية، فإن المتابع للشأن الفلسطيني سيلاحظ أن تحولات النظام الدولية والأحداث الكبرى كانت تعمل لمصلحة الحركة الصهيونية المتحالفة مع الحركة الاستعمارية والمصالح الإمبريالية في المنطقة، وهذا ليس كلام شعارات أو ترديد للخطاب السياسي القومي والثوري العربي بل حقائق مستمدة من التاريخ والواقع، حيث أنه ومنذ بداية القرن كان كل حدث دولي أو حرب عالمية أو نظام دولي جديد يؤسس، إلا ويعمل ضد المشروع القومي العربي وبالتالي ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. فأثناء الحرب العالمية الأولى حدث التحالف الأول ما بين الحركة الصهيونية والدول الاستعمارية وخصوصاً بريطانيا العظمى، وكانت نتيجة هذه الحرب لمصلحة حلفاء الحركة الصهيونية، وجنى الصهاينة المكاسب قبل أن تضع الحرب أوزارها وذلك بصدور وعد بلفور 1917، وكان هذا الوعد على حساب الشعب الفلسطيني بطبيعة الحال. وكان النظام الدولي لما بعد الحرب الأولى في خدمة الحركة الصهيونية حيث وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني، أي تحت إشراف من أعطى وعداً لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين!
وتكرر الأمر في الأحداث التي سبقت وواكبت وأعقبت الحرب العالمية الثانية، فقبل الحرب وضعت بريطانيا كل إمكاناتها لإنجاح المشروع الصهيوني في فلسطين، وأثناء الحرب تم توظيف الاضطهاد النازي لليهود لحل مشكلتهم على حساب الشعب الفلسطيني، حيث شرعت بريطانيا المنتدبة على فلسطين الأبواب أمام مئات الآلاف من المهاجرين اليهود للاستيطان في فلسطين، وما بعد الحرب حيث انتصرت دول الحلفاء التي كانت تتعاطف وتدعم المشروع الصهيوني، عملت بريطانيا ودول الغرب على صدور قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يعطي الحق لليهود بإقامة دولة في فلسطين.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث رفضت الدول العربية هذا القرار ودخلت في حرب شكلية وارتجالية مع الحركة الصهيونية، وكانت نتيجتها استحواذ اليهود على أكثر مما أعطاهم قرار التقسيم، وتحول الفلسطينيون إلى جموع لاجئين أو إلى خاضعين للاحتلال. وتوالت النكبات على الشعب الفلسطيني التي لم يكن له يد فيها. فمنذ الخمسينات برزت بقوة الحركة القومية العربية وتسلمت السلطة في أكثر من دولة عربية، ودخلت في مواجهات مع الدول الصهيونية ومع الاستعمار وكانت أسوأ هذه المواجهات هي حرب يونيو 1967 وما نتج عنها من احتلال إسرائيل لبقية فلسطين التي كانت تحت سيادة الأردن ومصر، ودفع الشعب الفلسطيني الثمن. وكان من ضمن هذه التحولات والأحداث الدولية، تحالف الحركة القومية والثورية العربية وحركة المقاومة الفلسطينية مع المعسكر الاشتراكي الذي انهار وترك حلفاءه وجهاً لوجه أمام الحركة الصهيونية وحليفها الغرب المنتصر بدون حرب.
أما الأمر الثاني، فهو يرتبط بشكل ما بالأول، حيث أن الشعب الفلسطيني ومنذ بداية المخطط الصهيوني في بداية القرن، كان غالباً مساساً بقيادة غير فلسطينية، (15) حيث من المعروف أنه لم يعترف له بقيادة وطنية فلسطينية متحررة من الوصاية الرسمية العربية إلا عام 1974، حين تم الاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً، وهو العام الذي شهد الاعتراف لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، ومع ذلك فهذا التمثيل كان معنوياً في حقيقته، لأن المنظمة لم تكن لها السيادة على الشعب ولا على الأرض.
لقد ورثت القيادة الفلسطينية إرثا ثقيلاً ومع أنها قادت حركة تحرر وطني منذ منتصف الستينات، حيث الشرعية الدولية تعترف بحركات التحرر وتتبنى سياسة تصفية الاستعمار، إلا أن خصوصية الوجود الصهيوني في فلسطين والعلاقات الخاصة ما بين إسرائيل والغرب المتحكم بالعالم وبالنظام الدولي، والعلاقات الخاصة ما بين اليهودية والمسيحية وتعثر وتبعثر الحركة القومية العربية، كل ذلك جعل استناد حركة التحرر الفلسطينية على الشرعية التاريخية والحقوق القومية في المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني، لا تجد استجابة من المنظمات الدولية وحتى من الحلفاء الاستراتيجيين ـ المعسكر الاشتراكي ـ ومن بعض الأنظمة العربية.
القضية الفلسطينية.. قضايا في قضية
في القضية الفلسطينية تداخل الوطني مع القومي، الديني مع السياسي، الإقليمي مع الدولي، والماضي مع الحاضر، وبفعل هذا التداخل وتشابك المصالح والقوى فإن تحديد المسؤولية القومية ومفهوم قومية القضية شابهما الغموض، كما أن الشعب الفلسطيني، ومنذ أن وجدت القضية الفلسطينية كقضية كفاح من أجل الاستقلال وحق تقرير المصير، لم يكن هو الفاعل الوحيد في رسم إطار الصراع وتحديد أهدافه وأبعاده، بل كان طرفاً ضمن أطراف متعددة عربية ودولية. لاشك أن الشعب الفلسطيني هو المعني أكثر من غيره بالصراع بفعل وقوعه مباشرة في بؤرة الحدث وبفعل كونه الأكثر تضرراً من مجريات الأحداث، إلا أن دوره كفاعل كان مقيداً ومحكوماً بالفاعلين الآخرين وبموازين القوى التي يصنعونها، وكنتيجة لذلك أيضاً، فإن النكسات والهزائم التي تعرضت لها القضية الفلسطينية خلال مسيرتها الطويلة وعبر محطاتها المأساوية البارزة 1948و1967و1970و1982و1990 لم تكن نتيجة لتقاعس أو تقصير الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية بل كان للأطراف الأخرى العربية والدولية المصنفة ضمن معادلة الصراع دور رئيس في حدوثها وتحمل مسؤوليتها، كذلك الأمر بالنسبة للإنجازات السياسية التي تحققت، فلم يكن مرجعها فقط النضال الفلسطيني بل لعبت الأطراف الأخرى دوراً في تحقيقها أو في تضخيمها. ويمكن القول أن القضية وطوال القرن الماضي اختزنت في ثناياها أربع قضايا أو مشاريع أو هي حصيلة لهم:
المشروع الأول: المشروع الوطني الفلسطيني الرافض للوجود الصهيوني في فلسطين والمتطلع للاستقلال، إنه المشروع الذي يقف في الصدارة عند الحديث عن القضية الفلسطينية فهو عمادها وجوهرها وعمودها الفقري، ويعتبر الميثاق الوطني الفلسطيني المرجع الوحيد المعبر عن تطلعات الشعب الفلسطيني والملزم له. (16)
المشروع الثاني: المشروع القومي الوحدوي العربي وهو مشروع الشعب العربي الذي يسعى إلى الوحدة القومية والتحرر من الهيمنة الأجنبية، والملاحظ أن ظهور المشروع القومي الوحدوي تساوق مع بداية ظهور الحركة الصهيونية والأطماع الاستعمارية في المنطقة العربية، وليس بالمصادفة أن يتزامن ظهور الثورة العربية الكبرى 1915 واتفاقية سايكس ـ بيكو 1916 ووعد بلفور 1917، وهكذا أصبح الخطر الصهيوني وما يشكله من تهديد للأمة العربية ووحدتها جزءاً لا يتجزأ من فكر الحركة القومية وأهدافها النضالية، وأصبحت القضية الفلسطينية قاسماً مشتركاً بين كل الحركات والتنظيمات والأنظمة القومية العربية، وأصبح تحرير فلسطين هو الهدف المشترك لها (على مستوى الشعارات والبرامج المعلنة).
المشروع الثالث: المشروع النهضوي الإسلامي، فقد جمعت فلسطين والقدس الشريف بما تمثلانه من رموز دينية لدى المسلمين كافة، كل المسلمين عرب وغير عرب، أصوليين محافظين أو ثوريين جهاديين، حيث رفعت كل الحركات الإسلامية شعار تحرير فلسطين والقدس الشريف، وتضمن خطاب الأنظمة الإسلامية ما يؤكد التزامها بعروبة القدس ورفض تهويدها.
المشروع الرابع: المشروع التحرري العالمي: حيث كانت حركة التحرر العالمية تلتقي مع كل من المشاريع الثلاث على قاعدة معاداة الصهيونية والإمبريالية ومحاربة الاستعمار بكل صوره وأشكاله، هذا المشروع الذي ظهر منذ انتصار الثورة الاشتراكية في روسيا 1917، وتقوي بعد الحرب العالمية الثانية في مرحلة الحرب الباردة بين المعسكرين الاشتراكي والغربي، وأصبح يحسب له حساب ويأخذ امتداداً عالمياً منذ الستينات مع ظهور سياسة تصفية الاستعمار والتحرر من نفوذه.
هذه المشاريع الأربعة كانت تتداخل مع بعضها البعض، تقترب من بعضها أحياناً فتعطي للقضية دفعة إلى الأمام، أو تتنافر وتتصادم فتنتكس القضية الفلسطينية، في مقابل ذلك فإن الشعب الفلسطيني الذي هو رأس حربة والحلقة المركزية لهذه المشاريع وجوهر القضية، لم يكن يواجه قوة عادية أو عدواً ضعيفاً، بل كان وما يزال يواجه تحالفاً عدوانياً جباراً، يواجه المشروع اليهودي الديني الأسطوري الداعي للعودة إلى (أرض الميعاد)، يواجه مشروع الصهيونية السياسية المتطلعة إلى إقامة إسرائيل الكبرى المهيمنة على المنطقة العربية بل وعلى منطقة الشرق الأوسط، ويواجه المشروع الاستعماري الإمبريالي الهادف إلى السيطرة على المنطقة العربية لما تحتويه من مواقع استراتيجية وخيرات يختزنها باطن الأرض، ويواجه مشروعاً صليبياً مضمراً حاقداً على الإسلام والمسلمين.
وبالرجوع للميثاق الوطني الفلسطيني الذي حدد أهداف الشعب الفلسطيني، نجد أن تحديد الشعب الفلسطيني لأهدافه الاستراتيجية، تحرير كامل التراب وتصفية الوجود الصهيوني في فلسطين، لم يكن اعتماداً فقط على قوة وقدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية بل كان يأخذ بعين الاعتبار القوى الحليفة المكونة للمشاريع الثلاث التي كان يعتقد أنها في خندق المواجهة، فالثورة الفلسطينية اعتبرت نفسها طليعة الأمة العربية وحركة التحرير العالمية.
فلا غرو إذن أن الحركة الوطنية الفلسطينية كانت تدرك أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توفر الشروط الأربعة، الوطني والقومي والإسلامي والأممي، وإن أي إخلال بشرط من هذه الشروط أو تراجع أي طرف عن التزامه سينعكس سلباً على القضية الفلسطينية. فكان لغياب الشرط الفلسطيني قبل 1964 أثراً سلبياً على مسار القضية، وغياب الشرط القومي العربي وتراجعه بعد توقيع اتفاق كامب ديفيد أثر بشكل خطير على القضية الفلسطينية، كما أن تراجع مكانة حركة التحرر العالمية وانهيار المنظومة الاشتراكية شكل ضربة قاسية للشعب الفلسطيني.
كان توازن هذه المشاريع الأربعة وتوافقها ولو على قاعدة الحد الأدنى هو الذي يحكم القضية الفلسطينية خلال العقود الأربعة الماضية، سواء في حالات احتدام الصراع والحرب أو في مرحلة البحث عن حلول سلمية للصراع، حيث كان لكل طرف مصلحة في استمرارية (التحالف) أو التنسيق فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني إما من منطلق المصلحة المشتركة في مواجهة عدو مشترك أو لمصلحة خاصة لكل طرف، وكانت الثورة الفلسطينية معنية أكثر من غيرها في الحفاظ على الترابط والتنسيق بين المشاريع الأربعة ولو على قاعدة الحد الأدنى وكانت تسعى إلى تعويض أي نقص في فاعلية أداء أي بعد من الأبعاد الأربعة بتقوية وتعزيز فاعلية الأبعاد الأخرى. فغياب وانتكاسة المشروع القومي بعد حرب 67 تمت محاولة تعويضه بتقوية المشروع الفلسطيني وتصعيد الكفاح المسلح ضد العدو الصهيوني وانتكاسة المشروع الوطني الفلسطيني بعد أحداث أيلول 1970، تم تداركه بتقوية الوجود الفاعل للقضية على المستويين العربي والدولي، كما أن انتكاسة المشروع القومي العربي بدءاً من توقيع اتفاقية كامب ديفيد جرت محاولة التقليل من مخاطره بتقوية المشروع الوطني الفلسطيني وبتفعيل دور المشروع التحرري العالمي سواء على مستوى تعزيز مكانة القضية الفلسطينية بين دول العالم أو تفعيل قرارات الشرعية الدولية ومكانة م.ت.ف. داخل الأمم المتحدة وفي المنظمات الدولية الأخرى، إلا أن ما لم يخطر على بال المخططين الفلسطينيين أن تحدث الانتكاسة على كافة المستويات، انتكاسة المشروع القومي الوحدوي العربي أو وصوله إلى طريق مسدود، وانهيار ما سمي بحركة التحرر العالمية تحت قيادة ما كان يسمى بمنظومة الدول الاشتراكية وما رافق هذا الانهيار من تغير في موازين القوى داخل هيئة الأمم المتحدة لغير مصلحة الشعب الفلسطيني، والمشروع النهضوي الإسلامي بالرغم من استماتته في وضع حد لحالة السلبية والانحطاط واليأس التي يتخبط فيها الإنسان العربي، إلا أن حالة التناحر والتشتت داخل القوى الإسلامية وعدم وضوح برنامجها السياسي، وقوة المعارضة التي جوبهت به سواء من داخل العالم العربي أو من خارجه، جعل المشروع النهضوي الإسلامي أمام اختيار عسير(17) وما نتج عن كل ذلك من تضييق على الكفاح المسلح باسم مكافحة الإرهاب.
ونتيجة لكل ذلك انتاب الارتباك المشروع الوطني الفلسطيني وأفقدت شدة الضربات الحركة الوطنية الفلسطينية. ووجد الفلسطينيون أنفسهم وحدهم في ميدان المواجهة، في ظل اختلال بين في موازن القوى، اختلال هائل ما بين قدرات الشعب الفلسطيني المحتلة أرضه والمشرد في بلاد الغربة والمحاصر داخل الأرض المحتلة وخارجها، وبين قدرات العدو الصهيوني. وجد الشعب الفلسطيني أن إمكاناته وقدراته وحتى في ظل إبداعات وتضحيات وعظمة الانتفاضة، أعجز من أن تحقق أهدافه الوطنية، وهي الأهداف التي وضعت وخطط لها اعتماداً على تضافر وفاعلية الشروط الأربعة، الوطني الفلسطيني والقومي العربي، والنهضوي الإسلامي والتحرري العالمي، وليس اعتماداً على قدرات الشعب الفلسطيني وحده.
في مقابل ذلك كان الحلف المعادي يكتسح المواقع ويضخم قدراته، فاليهودية تستعيد سطوتها واحترامها في الغرب وفي العالم، والصهيونية تتقوى وتتعزز مكانتها بفعل التفاف اليهود حولها وسقوط مقولة (اليهودية غير الصهيونية) التي روج لها بعض العرب حتى اعتقد البعض أن حقوق الشعب الفلسطيني ستعاد على أيدي اليهود غير الصهاينة، وعلى يد دعاة السلام، وتتقوى الصهيونية بفعل سطوتها المادية والاقتصادية والإعلامية في العالم، والمشروع الاستعماري الإمبريالي يستعيد أمجاده الغابرة وتفرض الدول الغربية سطوتها وسيطرتها على دول العالم الثالث ضمن أشكال جديدة من تحالفات بريئة المظهر واستعمارية الجوهر، والصليبية عادت لتحشد حولها أحقاداً تاريخية ودينية لعنصريين ومهووسين وحاقدين، ولتعمل طعناً في الإسلام والمسلمين تحت شعارات ومشاريع تدعي أنها إنسانية وأخلاقية وهي أبعد ما تكون من الإنسانية والأخلاق.
جاهدت الدبلوماسية الفلسطينية خلال عقد الثمانينات أن تحافظ ولو على الحد الأدنى من دعم حلفائها التقليديين، ولكن دون جدوى، وكانت مضطرة أن تتعامل مع المشكلة في إطارها الوطني الفلسطيني فقط وفي حدود الإمكانات الفلسطينية مع ما يعنيه وضع الشعب الفلسطيني في مواجهة إسرائيل وإمداداتها العالمية من اختلال هائل في موازين القوى. وجاءت حرب الخليج الثانية والدعوة إلى مؤتمر مدريد ومسلسل التسوية ليكرسوا حقيقة مرة وهي أن القضية الفلسطينية لم تعد رسمياً قضية العرب الأولى ولا شغلهم الشاغل وأن كل دولة عربية أصبحت تتعامل مع القضية انطلاقاً من الجانب الذي يهم مصالحها القطرية.
الاعتراف بالحل السلمي وبقرارات الشرعية الدولية اعتراف بفشل الحل القومي لو أردنا أن نمرحل القضية الفلسطينية أو الصراع العربي الإسرائيلي حسب الفكر السائد حول استراتيجية حل الصراع، لصنفت الحقبة الممتدة منذ تشرين الأول 1991، مؤتمر مدريد، إلى اليوم بأنها مرحلة التسوية السياسية، والفكر الغالب فيها هو فكر التسوية على قاعدة الحلول الانفرادية، بكل ما تحمله الكلمة من إقصاء ناتج عن فشل أو تعثر المشاريع الثلاثة، المشار إليها، التي كانت تدعم وتحتضن المشروع الوطني الفلسطينية.
لقد تراجعت إلى الوراء قومية القضية واستراتيجية التحرير الكامل، وحرب الشعب وأصبح الفكر الذي كان يعتبر التسوية ونهج التسوية بمثابة الخيانة الوطنية والقومية، ضرباً من الخوض في المحرمات جزءاً من فكر متخلف تجاوزه الزمن، في منظور دعاة التسوية اليوم. فالحديث اليوم عن قومية القضية وعن استراتيجية التحرير الكامل، بل أي حديث عن خيار الحرب لمواجهة العدو واستعادة الحقوق الفلسطينية والعربية المشروعة، يعتبره دعاة التسوية اليوم مظهراً من مظاهر التخلف الحضاري والجمود الفكري ورمزاً من رموز حقبة عربية حملوها السبب في ما وصل إليه الوضع العربي بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص!
كان من الواضح أن تحولين استراتيجيين يبدوان متناقضين استجدا على القضية الفلسطينية منذ منتصف القرن وأثرا على نهج التعاطي معها: الأول هو تصاعد الوطنية الفلسطينية بمستلزماتها ونتائجها كالتأكيد على الهوية الوطنية واستقلال القرار الفلسطيني مع ما صاحب ذلك من تبلور لشكل من الكيانية الفلسطينية، والثاني هو تراجع البعد القومي للقضية بمفهومه الكلاسيكي الذي يجعل الوحدة وتحرير فلسطين شرطان متلازمان، وتوالي المؤشرات الدالة على أن القضية الفلسطينية لم تعد هي الشغل الشاغل للحكومات العربية ولا حتى للشعوب العربية. وما بين الوطنية الفلسطينية الصاعدة كحقيقة فرضت نفسها على العالم من جهة وأفول البعد القومي وما يترتب عليه من استحالة قيام حرب تحرير عربية تقضي على إسرائيل من جهة أخرى، انبثق فكر التسوية السلمية، تسوية حاولت أن تستثمر تراجع البعد القومي والعجز الرسمي العربي وفي نفس الوقت تلاحظ دوراً هامشياً للوطنية الفلسطينية الصاعدة، تسوية لا تمانع في تجاوز التعامل السابق مع الفلسطينيين كمجرد لاجئين ولكنها في نفس الوقت تحد من طموحاتهم وأهدافهم الوطنية وتحاصر فكر ونهج الثورة، كانت التسوية التي تعتمد على قرارات الشرعية الدولية هي الإطار المناسب لتقريب مواقف مختلف الأطراف.
ومع ذلك لم تكن عملية الانتقال من الشرعية التاريخية الوطنية والقومية إلى الشرعية الدولية والحقوق المستمدة من موازين القوى بالأمر الهين، لأن الاعتراف بنهج التسوية السلمية يعني الاعتراف بعجز بل فشل استراتيجية حرب الشعب وفشل المراهنة على الحل القومي- العربي كما يعني الاعتراف بالعدو القومي، كما تعني إعادة النظر بمرحلة برمتها من شعارات ومواقف وسياسات وأفكار بل ورموز وقيادات، لأن منطق التسوية السلمية يفرض تقديم تنازلات وإعادة النظر بما كان يعتبر بالثوابت والمقدسات، كانت التسوية تعني الاعتراف بأن الصراع لم يعد صراع بين الأمة العربية من جهة وإسرائيل من جهة ثانية، بل صراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وأن ما يعني العرب هي قضايا الحدود بالنسبة لمصر وسوريا والأردن، وأما غيرهم فدورهم في أحسن الحالات هو التعاطف مع الموقف الفلسطيني.
كان الواقع يؤكد تحول القضية إلى قضية صراع فلسطيني إسرائيلي وقضية صراع على الحدود بالنسبة للدول المحيطة بإسرائيل، وقضية تعاطف بالنسبة لبقية الدول العربية، إلا أن الخطاب السياسي الرسمي العربي استمر يتحدث عن قومية القضية الفلسطينية وعن تحرير فلسطين وعن العدو الصهيوني إلخ، ولم يكن المخلصون والعاقلون في الأمة العربية قادرين على كشف كل الأوراق والبوح بالحقيقة، حقيقة أن الثورة الفلسطينية أعجز من أن تحرر فلسطين، وأن الدول العربية عاجزة أو غير راغبة في محاربة إسرائيل وأن واقع النظام الدولي لم يعد يسمح بشطب دولة (إسرائيل) من الخريطة السياسية الدولية، كانت القيادة الفلسطينية، وخصوصاً قيادة المنظمة، تعرف أن البوح بالحقيقة معناه الدخول في صدام مباشر مع أكثر من نظام عربي، وقد حدث ذلك أحياناً، كما قد يؤدي إلى إحباط الجماهير عندما تعلم هذه الأخيرة حقيقة أن العرب تخلوا عن فلسطين وأن الثورة عاجزة عن تحرير فلسطين وأن الواقع الدولي لا يجيز القضاء على إسرائيل، أيضاً كانت المنظمة تعرف أنها وإن أسقطت المراهنة على الجيوش العربية فإنها بحاجة إلى أموال العرب وإلى دعمهم السياسي والدبلوماسي وإلى أموالهم لدعم المشروع الوطني الفلسطيني في إطار دولة في الضفة والقطاع، ولاستمرارية وجود مؤسسات المنظمة وجهازها البيروقراطي، أي أن القطيعة مع الواقع العربي لم تكن تخدم لا القضية الفلسطينية ولا مصالح المتنفذين في المنظمة والمنظمات. وهكذا كان الفلسطينيون يتقدمون ـ ينحدرون نحو الحل السلمي والتفاوضي مع إسرائيل بقدر ما كانت الأنظمة العربية تبتعد عن فلسطين وتتخلى عن التزامها القومي وبقدر ما يترهل جسم المنظمة ويخفت الحس الثوري، وكانت كل خطوة تقترب القيادة الفلسطينية من التسوية وتجعلها مقبولة أمريكياً وإسرائيلياً، خطوة تراجعية في نفس الوقت عن مفهوم قومية القضية وعن استراتيجية الكفاح المسلح.
لقد بات واضحاً أن م.ت.ف التي تنهج الكفاح المسلح وتدعو لحرب التحرير الشعبية العربية أو حتى الفلسطينية أصبحت مرفوضة ومحاربة علناً من إسرائيل وأمريكا وسراً من طرف عديد من الأنظمة العربية، نعم كانت مقبولة من طرف الجماهير الفلسطينية والعربية، (18) ولكن في زمن الحروب الحديثة وحيث تملك إسرائيل أقوى جيش في الشرق الأوسط بما في ذلك أسلحة نووية، وفي ظل إغلاق الحدود العربية أمام من يطلب الشهادة في سبيل فلسطين، وفي ظل غياب ثقافة حرب الشعب ومتطلباتها، لم تعد شعارات حرب الشعب أو القيام بعدة عمليات فدائية قادرة على القضاء على إسرائيل، القضاء على إسرائيل أصبح يحتاج إلى جانب ذلك إلى جيوش حديثة وعصرية تتوفر على أسلحة نووية أو ما يعادلها أو تعمل تحت مظلة نووية لحليف استراتيجي مع وجود مناخ دولي لا يمانع بالقضاء على إسرائيل، وواقع الحال أن الجيوش العربية في وضعيتها الحالية غير مؤهلة، عسكرياً وسياسياً، لدخول حرب ضد إسرائيل تكون احتمالات كسبها مضمونة، كما أنه من المستبعد في ظل الوضع الدولي الحالي السماح بتدمير إسرائيل حتى وان كان ذلك في مكنة العرب.
لقد بينت أحداث وتعاملات ما بعد حرب أكتوبر، أن الصراع انتقل من صراع وجود، صراع حول مبدأ التسوية السلمية، إلى صراع على الحدود، صراع على شكل التسوية السياسية، وبينت الأحداث أن التقدم على مسار التسوية يتزايد بقدر التخلي عن مفهوم البعد القومي للقضية الذي تختزله مقولة أن الصراع مع الكيان الصهيوني هو صراع وجود (إما نحن أو هم)، كما أكدت الأحداث أنه كلما تمسك الفلسطينيون بمفهوم استقلالية القرار وعملوا على إبراز الهوية الفلسطينية كلما تراجع البعد القومي معنى هذا أن تحول الصراع إلى صراع فلسطيني إسرائيلي يتفق مع منطق التسوية السلمية لأن الفلسطينيين وحدهم لا يمكنهم أن يقضوا على العدو الصهيوني.
الهوامش:
1- نجيب عازوري عربي مسيحي من فلسطين، عمل كمسؤول في الإدارة العثمانية في متصرفية القدس ما بين 1898-1904.
2- ورد في: أسعد رزوق، إسرائيل الكبرى: دراسة في الفكر التوسعي الصهيوني، ط 2، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1973، ص 145.
3- هذا الحكم لا يدخل في سياسة جلد الذات أو أنه مجرد مبالغة، بل تؤكد الإحصاءات أن معدل الأمية في العالم العربي تفوق الـ 50% وأن كل الدول العربية مديونة بما في ذلك دول النفط وأن دولاً من العالم الثالث كانت في نفس وضعية الدول العربية قبل أربعة عقود وأصبحت اليوم متفوقة في كافة المجالات، وهذا ما بينه تقرير للبنك الدولي حيث جاء فيه أن كوريا الجنوبية والمغرب كانتا في نفس المستوى في بداية الستينات وأن الأولى أصبحت مما يسمى بالنمور الآسيوية بينما وضعية المغرب لم تتحسن إلا قليلاً، وعلى مستوى الديمقراطية والتي تعتبر اليوم مقياساً للتنمية السياسية لا توجد دولة عربية محكومة بزعيم منتخب ديمقراطياً والتحولات الديمقراطية ما زالت دون المستوى المطلوب.
4- من مستجدات مقولة المؤامرة تصريح لمسؤول إماراتي أن الصهيونية تعمل على تدمير الاقتصاد الإماراتي، وكذا ما نشرته صحف مصرية حول محاولات إسرائيلية لترويج أطعمة سامة ومواد تقتل خصوبة الرجال.. إلخ.
5- جوليان فروند، ما هي السياسة، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ص124.
6- لا نشكك هنا بأي حال من الأحوال بالقدرة الإلهية على فعل كل شيء، ولكننا نقصد تلك الحالة من التوظيف السيئ للدين والتي تحل بالمطلق إرادة الله محل إرادة الإنسان وقدرته على الفعل ومسؤوليته عن أفعاله، فكثير من الإخاء والمصائب الكبرى التي تحل بنا هي من فعل البشر وخصوصاً أصحاب القرار، وأن يدفع الناس للتوجه للسماء لتغيير الأوضاع أو لرفع البلاء معناه التهرب من المسؤولية، فهل يعقل أن الرب مسؤول عن الأخطاء بينما المنجزات هي من صنع الحكام ويجب التوجه لهم بالشكر والعرفان بالجميل.
7- كل الثورات- الانقلابات العسكرية التي قامت في عالمنا العربي كانت تبرر قيامها بالرد على المؤامرات الخارجية وتبرر استمرارها في الحكم باستمرارية التآمر الخارجي وتقوم بتصفية معارضيها باسم المؤامرة الخارجية.
8- من المعروف في علم الاجتماع السياسي أن المجتمعات التي تسود فيها الأمية والجهل لديها قابلية لتفسير الأمور غيبياً أو أسطورياً أو اعتماداً على الإشاعات أكثر من استعدادها لتفسير الأمور موضوعياً واعتماداً على قرائن وأدلة.
9- شفيق الرشيدات، فلسطين: تاريخاً.. وعبرة.. ومصيراً، القاهرة: 1968، ص 44.
10- جورج انطونيوس، يقظة العرب، بيروت: 1962، ص 234 وما بعد.
11- واهم من يعتقد أن الغرب يحتضن المعارضات العربية والإسلامية من منطلق دفاعه عن حرية الرأي والتعبير أو عن حقوق الإنسان، فهو يحتضنهم لتوظيفهم لخدمة مصالحه في المنطقة وهو على استعداد للتخلص منهم حالما يشعر أن وجودهم يتناقض مع مصالحه، كما أنه عندما يثير قضية حقوق الإنسان أو حقوق الأقليات في دولة ما فإنما هدفه تبليغ رسالة إلى الدولة المعنية بأنه قادر على خلق فتنة داخلية إن لم تخضع لسياسته، وهو يستعمل هذه الورقة حتى مع دول تعتبر صديقة له- مصر ومشكلة الأقباط-.
12- العرب كشعب وكحكومات عليهم اليوم التعامل بعقلانية مع القوميات والطوائف التي تعيش وسطهم، ليس فقط حتى لا يستعملوا كأدوات من طرف الأعداء بل لأن حالة انبثاق القوميات والهويات الثقافية التي يشهدها العالم انتقلت عدواها إلى منطقتنا وشجعت الأقليات- أكراد، امازيغ، مسيحيين، زنوج إلخ- عندنا لتطالب بأن يعترف لها بالخصوصية الثقافية أو بحرية ممارسة الشعائر الدينية وهذا يتطلب إعطاء مفهوم جديد للقومية العربية وللوحدة العربية.
13- عندما قامت الثورة الإسلامية الإيرانية انتقلت المرجعية الدينية من العرب إلى إيران وترتب على ذلك هيمنة الأيديولوجية الإسلامية على الأيديولوجية القومية، وحدث انتقال من تفكير بوحدة عربية إلى تفكير بوحدة إسلامية. والسؤال المطروح هو إذا خرجت المرجعية الدينية من يد العرب فماذا سيبقى من الهوية والثقافة العربية؟ أو بصيغة أخرى ما هو محتوى الحضارة العربية دون الإسلام؟
14- إبراهيم ابراش، فلسطين بين القومية العربية والوطنية الفلسطينية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1987.
15- كانت فلسطين جزءاً من الإمبراطورية العثمانية وأثناء الحرب العالمية الأولى دخلت تحت إشراف الملك فيصل الذي نصب نفسه ملكاً على سوريا الطبيعية بما فيها فلسطين، وبعد الحرب وقعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني وبعد الحرب العالمية الثانية خضع جزء من الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي والضفة الغربية ضمت للأردن وقطاع غزة خضع لإدارة عسكرية مصرية وعاش باقي الشعب في الشتات.
16- بالرغم من عقد المجلس الوطني الفلسطيني أكثر من دورة لتغيير بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تعتبرها إسرائيل متناقضة مع متطلبات السلام فإن غالبية الشعب الفلسطيني لا تعترف بهذه التغييرات وتعتبرها غير شرعية، وبالتالي تعتبر الميثاق الوطني هو المرجعية الوحيدة في تحديد الحقوق الوطنية الفلسطينية.
17- الإجراءات التي قامت بها السلطات الأردنية ضد حركة حماس، وزعمها أن المنظمة منظمة غير شرعية وتمارس أعمالاً غير شرعية، مؤشر خطير جداً لأنه يضع حداً للقول بالبعد الإسلامي للقضية، حيث تؤكد حيثيات القضية أن السلطات الأردنية تعتبر كل من يقوم بأعمال ضد إسرائيل أو يدعو لذلك يعد خارجاً عن القانون ويجب أن يعاقب، حتى وإن كانت هذه الأعمال تدخل تحت شعار الجهاد. ومن جهة أخرى لم يجد قادة حماس المبعدين دولة عربية تستضيفهم إلا دولة قطر التي اشترطت عليهم عدم ممارسة أي نشاط سياسي.
18- إثارة إسرائيل لموضوع التطبيع في جميع اللقاءات وحالة المقاطعة والعداء التي تواجه به في العالم العربي يؤكد أن ما حدث هو تسوية ما بين إسرائيل وأنظمة عربية، أما الشعب العربي فما زال مؤمناً بعروبة فلسطين.