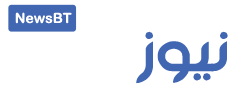إبراهيم أبراش
الأنظمة السياسية ودساتيرها وقوانينها كما الأحزاب وبرامجها وإيديولوجياتها ،كلها كيانات اجتماعية سياسية ،تخضع للسياسة وقوانينها وللبشر وطبيعتهم المتنوعة والمتقلبة ،ولموازين القوى وتغير الظروف والأحوال وطنياً ودولياً ،وهذا ما يميزها عن الديانات المقدسة المُنزلة من السماء والأقانيم المستمدَة من مخيال جمعي قاهر ،وبالتالي فالحكم على الأنظمة والكيانات السياسية ينطلق من مدى تفاعلها مع المجتمع والتجاوب مع احتياجاته بدءاً من حاجات الناس العاديين من مأكل ومشرب ومسكن إلى بناء المؤسسات الاجتماعية الكبرى ومؤسسات الدولة حسب خصوصية كل مجتمع والتحديات التي يواجهها ، وحماية الحريات الدينية للمواطنين جزء من مسؤولية الدولة ،كل ذلك في إطار الشرائع القانونية الوضعية التي تعبر عن إرادة الأمة ويخضع له الجميع ،ومن هنا تسمى الدولة الديمقراطية والحديثة بـ(دولة القانون) .
هذه الرؤية للعمل السياسي وفن إدارة المجتمعات هي ما توصل له علم السياسة في الغرب وهو السائد في غالبية الدول الديمقراطية . إنه (العقد الاجتماعي) الذي حدد ونظم وضبط علاقة الشعب بمن يحكمونه ، ونزَّل السياسة من السماء إلى الأرض وحررها من هيمنة أدعياء الإلوهية والمفوضين من الرب ليحكموا باسمه كما يزعمون ،وحافظ على الدين كعلاقة بين الإنسان وربه دون وسيط ،كما أن (العقد الاجتماعي) أعلى من شأن القوانين والدساتير الوضعية التي يتوافق عليها البشر ليس لمواجهة الشرائع الدينية بل لوضع حد لفوضى فتاوى وقوانين تُنسب للدين تم تحريفها وتحويرها ممن نصبوا أنفسهم نواب الله في الأرض لخدمة مصالحهم الشخصية ولتبرير تسلطهم على البشر .
جاءت القوانين الوضعية المعبرة عن إرادة الأمة لتضع حداً لشريعة الغاب وحالة الفوضى الناتجة عن ممارسة الحقوق الطبيعية والحريات الشخصية بلا حدود وضوابط ،ولتضع حداً أيضا لفوضى وسوء فهم واستخدام الشرائع الدينية من طرف رجال الدين أو كهنوت حل نفسه محل الله في التحليل والتحريم وفي الثواب والعقاب وأصبحت أقوال هؤلاء أهم من القوانين التي تجمع عليها الأمة ،كما أن القوانين الوضعية المعبرة عن إرادة الأمة جاءت لتصحيح اعوجاج الحكام ووضع حد للاستبداد والدكتاتورية ،وفي كل المجتمعات والدول الديمقراطية تحترم القوانين الوضعية حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية .
عندما يصبح الإسلام كما تمارسه جماعات الإسلام السياسي وكما يجري عندما يتم إضفاء طابع ديني على الدولة أو الحكام لتبرير الاستبداد والتغطية ،عندما يصبح سبباً للفُرقة والحروب الأهلية بسبب التعصب أو تعدد الاجتهادات والتفسيرات فإن إعمال القانون الوضعي وفرضه على الجميع يصبح ضرورة ومصلحة وطنية حتى وإن اصطدم بفتاوى واجتهادات بعض مدعي وتجار الدين ،لأن رسالة الديانات السماوية وفلسفتها تهذيب الأخلاق والسلوك وتوفير حياة كريمة للبشر ،وعندما تؤدي ممارسات دينية إلى ما هو عكس ذلك ، آنذاك يجب تغليب المصلحة الوطنية كما يعبر عنها القانون الوضعي ،والتعامل مع الدين كما التعامل مع الوطن كملكية مشتركة لا يحق لأحد مصادرة أي منهما أو التصرف المتفرد بأي منهما .
المشهد السياسي أو السياسة بشكل عام في عالمنا أو عوالمنا العربية والإسلامية تسير في سياق مغاير ،فكلما اجتهد البعض من حكام ومفكرين وحاولوا الولوج إلى عالم الديمقراطية والحداثة إلا وحدثت ارتكاسة تُعيد الأمور إلى ما كانت عليه إن لم يكن أسوأ مما كانت عليه ،باستثناء حالات محدودة نتمنى صمودها وتغلبها على ما تواجه من تحديات .
مع تلمسنا لانجازات تحققت ونضال لا يتوقف من أجل التغيير والديمقراطية في بعض البلاد العربية والإسلامية ،إلا أن المشهد العام يشي بما يلي : غياب المنظومة القانونية الموحدة الحاكمة والناظمة للنظام السياسي ،غياب أو تشوه المنظومة الأخلاقية والهوية الوطنية الجامعة ، القرار الوطني غير وطني بل مُسير من الخارج ويخضع لحسابات قوى خارجية ،من يملك المال والسلاح هم سادة البلاد وسلاطينها ،استبعاد ومحاصرة المتنورين على يد حكام الأمر الواقع الذين سيَّدوا أنفسهم بقوة السلاح والمال وبالدعم الخارجي وأضفوا على أنفسهم شرعية موهومة ،الحركات التي تطلق على نفسها حركات مقاومة أو ثورات وهبات شعبية تتحول في غالبيتها إلى تجارة ومصدر رزق للجياع والعاطلين و لظاهرة ارتزاق ثوري وجهادي ولتمرير أجندة ومصالح دول خارجية ،محاربة كل من يقول كلمة حق في وجه سلطان جائر و يتم تهميشه وتشويهه إلى أن يصبح فاسداً وينساق مع منظومة الفساد ،التاريخ المُصطنع والملفق عبئاً على الحاضر وقيداً على العقل ،أقوال المتحدثين باسم سلف صالح ـ لا يوجد ما يثبت أنه كان صالحاً أو حتى كان لهم وجود أصلاً وإن وجد بعضهم فصلاحهم وصحة أقوالهم كان في زمانهم وليس لكل زمان ـ تعلو على أصوات العلماء والمثقفين وعلى كل منظومة قانونية ويصبح السلف ومن ينطق باسمهم قدوتنا ومنهم نستلهم سلوكنا وننمط تفكيرنا ، حلت تفسيرات وتأويلات دينية لرجال دين جهلة بالدين بقدر جهلهم بالسياسة محل القرآن نفسه والسنة الصحيحة ومحل الفهم العقلاني للدين ، الخيانة تصبح وجهة نظر ،تكفير الخصم لدرجة تبرير قتله أصبح من مستلزمات حماية الجبهة الداخلية وفي سياق التضحية بالقلة الكافرة والمنحرفة لصالح الأغلبية المؤمنة وتنفيذ إرادة الرب بحماية الدين .
في هذه الحالة أين نحن من السياسة وعلمها ومن الحضارة وتطورها ؟وما هي أوراق المحاججة التي نتسلح بها للرد على أمريكا وإسرائيل والغرب إن احتقروا العرب أو اتهموهم بأنهم شعب أو أمة عالة على البشرية وأنهم خارج سياق التطور الحضاري ،واتهموا المسلمين بالإرهاب والإسلام كمعيق للتطور والحضارة ؟.