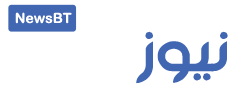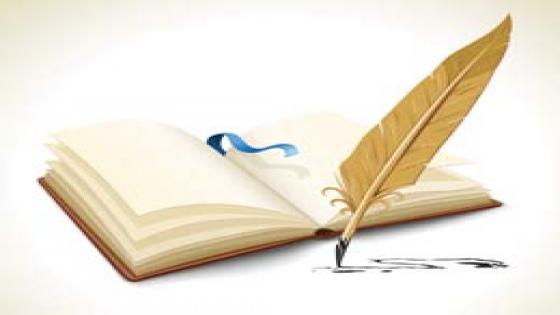العقل السياسي العربي وتداخل الهويات
(المشهد السياسي الفلسطيني نموذجا)
مقدمة
كتب كثير من المفكرون حول العقل العربي، بعضهم مؤيد لفكرة وجود عقل عربي والبعض متحفظ عليها،ومع إننا نميل للقول بوجود عقل كوني أو كما قال ديكارت في مؤلفه (مقال حول المنهج):”العقل هو أكثر الأشياء توزيعا عادلا بين الناس” مما ينفي وجد عقل عربي وعقل هندي وعقل أمريكي الخ, إلا أنه في زمان ما وفي مجتمع ما توجد انشغالات وشروط ذاتية تجعل المفكرين والفلاسفة منكبين ومنشغلين عليها وبها أكثر من انشغالهم بغيرها وهذا ما يؤدي إن امتد الزمن بهذه الانشغالات لتبلور نمط من التفكير أو العقلانية يميز هؤلاء عن غيرهم.من هذا المحدد الزمكاني يمكن تجاوزا الحديث عن عقل عربي وقياسا الحديث عن عقل سياسي فلسطيني.
ليس موضوعنا مقاربة موضوع العقل والعقلانية بشكل عام ولكن التحديات والانشغالات التي تواجه إعمال العقل والعقلانية في المشهد السياسي العربي والفلسطيني فيما هو مشترك بينهما ،والربط بين المشهدين ليس عبثيا ولكنه نابع من خصوصية القضية الفلسطينية. معاناة المثقف أو رجل الفكر الذي يعيش في مناطق السلطة الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة معاناة مزدوجة أو مركبة،فمن جهة يعاني ما يعانيه المواطن العادي من حصار وحدّ من الحرية واستفزاز بسبب ممارسات الاحتلال بل لمجرد الإحساس بأنه يعيش في وطن محتل حتى وإن لم يحتك بجيش الاحتلال مباشرة،فإن تعش تحت الاحتلال معناه الإحساس المتواصل بعدم الأمان وبامتهان الكرامة وبالعجز عن فعل شيء ذي جدوى،ولكن بجانب هذه المعاناة التي يتقاسمها المثقف مع بقية المواطنين هناك معاناة خاصة به معاناته كرجل فكر تجبره وطأة الحياة اليومية وواقع الاحتلال على الغرق الفكري بالسياسة اليومية:بالمواجهات المسلحة والاغتيالات والاستيطان والصراع بين القوى السياسية الفلسطينية وبعضها البعض بحالة الفتنة والتحريض بالخلاف حول الانتخابات والسلطة وحتى بالبحث عن رغيف الخبز وأنبوب الغاز ووقود السيارة الخ،وطأة اليومي والمباشر تحد من شساعة الفكر وتألق العقل،هذه الهموم والانشغالات اليومية تهدر أو تستنزف العقل وتجعله أسير انشغالات المشهد اليومي والمباشر ولا تتيح له كثير وقت للتعمق بالقضايا الفكرية الكبرى التي تتعدى حدود الوطن.
ولكن ولان الأمر يتعلق بفلسطين والفلسطينيين، فإن لم ينشغل المثقف بالخارج فالخارج يقتحم عليه جوانيته وخصوصيته،.وهكذا حتى يكون المثقف الفلسطيني مثقفا والمفكر مفكرا حقيقيا عليه كسر القيود التي تحاصر العقل،فلا يمكن فهم ما يجري في فلسطين إلا إذا فهمنا ما يجرى في ومع إيران والعراق و جورجيا،وفهم مجريات مكافحة الإرهاب وتذبذبات أسعر النفط والدولار الخ،لا يمكن فهم والحديث عن الهوية والثوابت الوطنية الفلسطينية إلا وتبرز أمامك الهوية والثوابت القومية والهوية والثوابت الإسلامية الخ. فلأنها قضية قومية فالبعد القومي يفرض نفسه ولأنها قضية إسلامية فالبعد الإسلامي يفرض نفسه ولأنها قضية دولية فالبعد الدولي يفرض نفسه،ولان العرب مختلفون حول مفهوم العروبة و القومية، والمسلمون مختلفون حول مفهوم الدين وعلاقته بالسياسة والدولة، والعالم منقسم حول مفهوم الشرعية الدولية وحدودها،فهذه الأبعاد بدلا من أن تعمل على مساعدة الفلسطينيين على حل قضيتهم، تزيدها تعقيدا وتزيد المشهد السياسي الفلسطيني تشتتا.
ومن جهة أخرى فإن قضية الموضوعية والتي تميز التفكير العقلاني عن غيره وكذا علاقة المثقف بالسلطة تأخذا خصوصية في الحالة الفلسطينية وفي كثير من الحالات يستهجن مثقفون عرب وأجانب مواقف سياسية لمثقفين فلسطينيين حيث ينتظرون منهم نهجا في التعامل مع السلطة والحالة السياسية بشكل عام متوائمة مع الصورة النمطية السائدة في العالم العربي متجاهلين خصوصية الحالة الفلسطينية،فلا الدولة هي الدولة ولا المجتمع هو المجتمع ولا السلطة هي السلطة ولا الثورة هي الثورة ولا المقاومة هي المقاومة الخ.
سنحاول مقاربة هذه الإشكالات من خلال المحاور التالية:-
أولا: العقل والخطاب السياسي والايدولوجيا
ثانيا:السياسة بين عقل الواقع ووطأة الايدولوجيا
ثالثا:الخطاب السياسي العربي بين الواقع و الايدولوجيا
رابعا: سؤال الهُوية بين معقولية الانتماء و أوهام الايدولوجيا
خامسا: الثوابت الوطنية :نتاج للعقل الجمعي أم للأيديولوجيات المهيمنة.
سادسا:(الثوابت الوطنية): أيديولوجيا أم مهام نضالية؟
سابعا: صعوبة الحياد ومزالق الانحياز في الحياة السياسية الفلسطينية
أولا: العقل والخطاب السياسي والايدولوجيا
من أولويات حق العقل علينا أن نُعمله لتدبير أمور حياتنا الخاصة والعامة،فلا حضارة أو تقدم إلا بالعقل، فالحضارة هي إعمال العقل في حياة الشعوب سواء على مستوى تدبر الإنسان لشؤون حياته اليومية أو تدبر الدولة لشؤونها العامة ،بالعقل أسس الإنسان الحضارات وشيد وعمر البلدان،حتى أصبحت كلمة حضارة أو مدنية ترتبط ارتباطا كليا بالعقل والعقلانية. بالعقل تنفتح آفاق المعرفة وبالمعرفة يتم التمييز بين الخطأ والصواب وبين الصالح والطالح، وحيث أن العقل هو أداة العلم والمعرفة فقد ظهرت العلوم العقلية التي أصبحت اليوم مناط الحكم على مدى تقدم المجتمعات أو تخلفها،فكانت العلوم القانونية والسياسية والاقتصادية والبيولوجية والزراعية والهندسية الخ.
وحق العقل من الإيمان،فما كان للإنسان أن يهتدي للإيمان إلا بالعقل،فلا نعتقد بوجود تناقض ما بين الدين والعقل، ذلك أن الله عز وجل عندما خلق الإنسان ميزه بالعقل،فالعقل ليس مجرد عضو بيولوجي كاليد واللسان والمعدة الخ ،بل عضو فاعل ومفكر وموجه وبدون العقل ما اختلف الإنسان عن الحيوان، وقد ورد ذكر العقل سواء باسمه وفعله، أو مترادفاته في القرآن الكريم (العقل والقلب والفؤاد تدل على نفس الشيء كما يذهب كثير من العلماء والفقهاء) حوالي خمسين مرة، ذلك أن الاستخلاف بالأرض وعمارة الكون والحياة لا يتأتيا إلا بالعقل،و العقل اليوم يعني العلم والمعرفة وبالتالي فإن الاستخلاف في الأرض وأعمارها لا يكونا إلا بالقدرة على استيعاب هذه العلوم والتفوق بها.المسلمون لم يقيموا حضارة إلا عندما انفتحوا على معارف وعلوم الحضارات الأخرى اليونانية والفارسية ،هذه الحضارة الإسلامية أصابها الوهن ثم الانهيار عندما بدأ المسلمون يخرجون عن مجال العقل والإيمان الحقيقي ويتصارعون على السلطة والجاه ويوظفون الدين عن طريق التأويل والتلوين والتفسير بما يُخرجه عن أصله ويجعله أداة لخدمة السلطان والسلطة القائمة،حيث كان لكل سلطة علماؤها وأئمتها من المنافقين الذين يحرفون الكُلم عن مواضعها ،وعندما أصبح الدين أداة لخدمة السلطة والسلطان ،وعندما أصبحت السلطة(الإمارة والخلافة) هدفا بحد ذاته خسر المسلمون الدين والدولة.
وفي مجال السياسة فإن الديمقراطية ومشتقاتها كحرية الرأي والتعبير والحريات الخاصة واحترام حرمة المسكن الخ، هي تتويج للعقل السياسي أو خلاصة تطوره ومآل نضجه،والحجّر على العقل وانتهاك الحريات أمور لا تتوافق مع الزعم لا بالعقل والعقلانية ولا بالديمقراطية ولا تستقيم مع القول بالاستخلاف بالأرض وأعمارها حيث لا يمكن أن تعمر الأرض بالجور والاستبداد وانتهاك الحريات والحرمات.بالنسبة لحركات الإسلام السياسي التي قد غيرت مواقفها، أو هكذا يبدو، فحللت الانتخابات والديمقراطية بعد طول عهد من التحريم.
إذن العقل الذي هو مناط ومرجعية الحكم على الأمور له علينا حق،و من حق العقل علينا كفلسطينيين نتعرض لتهديدات تمس وجودنا أن نوقف حالة العبثية والتخبط التي أصبحت تحكم وتُسير كل مناحي حياتنا حتى ثوابتنا ومرجعياتنا الوطنية، نتعرض لتهديدات سياسية وإستراتيجية تحتاج مواجهتها للعقل والعقلانية وليس الهروب نحو شعارات وتوظيفات دينية،فالشعب الفلسطيني كان دوما متصالحا مع دينه الإسلامي ،وغالبية القيادات التاريخية للشعب الفلسطيني من الحاج أمين الحسيني حتى أبو عمار كانت مرجعيتهم دينية ولكنهم دمجوا ما بين الدين والوطنية .نعم المواجهة مع العدو الصهيوني لها بعد ديني يجب أن نستحضره دائما وخصوصا أن هذا العدو لا يُنكر انه يريد دولة يهودية خالصة،ولكن خلافاتنا الداخلية هي خلافات سياسية حول السلطة والحكم وقيادة الشعب ويجب ألا نقحم الدين في هذه الخلافات فكل الشعب الفلسطيني يعتز بإسلامه حتى مسيحييه هم في حالة مصالحة وانسجام مع المسلمين والدين الإسلامي..إن إقحام الدين في السياسة الداخلية سيولد فتنة داخليه وسيحرف صراعنا الرئيس عن مساره بحيث سيخلق أعداء داخليين سيحلون محل الأعداء الخارجيين ،وللأسف أدى عدم قدرة الجماعات الإسلامية على حسم الصراع لصالحها مع العدو الخارجي إلى استسهال تسجيل نقاط نصر على أعداء داخليين مفترضين أو موهومين،وكثير من المؤشرات تدل على حدوث هذا الانحراف من الجزائر إلى قطاع غزة.
ثانيا:السياسة بين عقل الواقع ووطأة الايدولوجيا
محطات كبرى شكلت معلما أو منعطفا في سيرورة العقل الإنساني ومن ضمن هذه المحطات بداية عصر النهضة في أوروبا ،فالانتقال من العصور الوسطي لعصر النهضة فالتنوير ارتبط بتحرر العقل من المعيقات التي تكبله وأهمها اللاهوت والأسطورة والأحكام المسبقة.هذا التحرر العقلي فتح المجال لصيرورة المعارف الإنسانية علوما ،وبطبيعة الحال نالت السياسة نصيبها. وهكذا استقر الحال للسياسة لتصبح علما و العلم هو معرفة الشيء بحقيقته ،وانه المعرفة الممنهجة والمنسقة، مما دفع البعض للاعتقاد بأن صيرورة السياسة علما معناه أنها أصبحت خاضعة للعقل العلمي وللحقيقة العلمية من حيث صحة مقولاتها وموضوعية تحليلاتها وابتعادها عن الذاتية والايدولوجيا..إلا أن واقع السياسة كممارسة وحتى كعلم لم تصل لهذه الدرجة من الضبط والعقلانية.لقد أظهرت الأحداث السياسية المحلية و الدولية أخيرا، كم ابتعدت السياسة عن كونها علما نظرا لقوة حضور الايدولوجيا والدين وكم أصاب العقل الشقاء وهو يبحث عن المعقولية لما يجري من أحداث حيث بعض الممارسات السلطوية والسياسية لا تختلف كثيرا عما كانت عليه السلطة والحكم في عصور الظلمات بل في مجتمعات ما قبل الدولة والتي تحدث عنها توماس هوبس وقال بأنها محكومة بشريعة الغاب.
لا غرو أن المجال السياسي فكرا وممارسة في الدول الديمقراطية مختلف نسبيا عما هو عليه الحال في الأنظمة العربية،ونقول نسبيا لأنه في السنوات الأخيرة عادت الايدولوجيا والدين تغزو معاقل علمانية وعقلانية الغرب ،إلا أن السياسة يشكل عام سواء كانت سياسة دول كبرى أم صغرى ،متقدمة أم متخلفة، لا يمكن أن تُحال للعلم وإخضاعها للعقل والعقلانية المؤسسة على العلم إلا بتخليصها من حزمة من الأوهام التي أقحمت عليها وأهمها وهمين:-
الوهم الأول:
الاعتقاد بأن كل من يتكلم في السياسة هو عالم أو خبير سياسي أو أن السياسة هي فضاء بلا حدود أو ضوابط يمكن لكل من هب ودب أن يفتى في قضايا الأمة، محللا ومحرما، مخونا للبعض ومانحا صكوك غفران ووطنية لآخرين، وخصوصا في القضايا المصيرية للأمة. هذا الوهم أكثر حضورا في مجتمعاتنا العربية حيث الجميع يتحدث ويفتي بالسياسة وعشرات الفضائيات متخصصة بالسياسة أو تخصص الجزء الأكبر من ساعات بثها للأمور السياسية مستعينة بجحافل ممن ينعتون بالمحللين السياسيين.والملفت للانتباه في هذا السياق إنه بالرغم من أن لدينا من المحللين السياسيين أكثر مما لدى الصين، فإن المشهد السياسي العربي – فكرا وممارسة -هو الأكثر بؤسا في العالم.إن عقلنة الحياة السياسية ا تتطلب العودة لتنظيم العلاقة بين المجال الديني والمجال السياسي وبين سلطة الدين وسلطة الدولة،بين المنظر والعالم السياسي من جهة والداعية الديني من جهة أخرى،والحيلولة دون ارتماء أو تدخل احدهما على وفي شؤون الآخر.الواقع الذي نعيشه عربيا وفلسطينيا يؤكد أن ركوب رجال السياسة موجة المد الأصولي ودخول الجماعات الدينية المجال السياسي دون ضوابط وثوابت وطنية أوجد سياسيين فاشلين وجماعات إسلام سياسي فاشلة.
الوهم الثاني:
الاعتقاد بأنه يمكن التعرف على السياسات العليا للدول وأهدافها الإستراتيجية من خلال التقارير والمؤتمرات الصحفية والتصريحات الرسمية أو من خلال النقاشات العلنية في المؤسسات التشريعية أو حتى من خلال تقارير لجان التحقيق كلجنة بيكر -هاملتون أو فينو غراد أو بترايوس وكروكرأو اللحان التي تشكلها الحكومات العربية للبحث في قضايا تمس الأمن القومي كاللجنة التي شكلتها السلطة الفلسطينية لتقصي الحقائق حول أحداث يونيو 2006 الخ.السياسي المحنك لا يكشف عن كل أوراقه وإلا سيكون سياسيا ساذجا أو فاشلا والسذاجة تؤدي للفشل، كذا الأمر مع الدول فلا دولة تكشف كل أوراقها وخصوصا في زماننا هذا حيث تؤسس العلاقات الدولية على السياسة الواقعية القائمة على المصالح والقوة، والمصالح الدولية متضاربة والقوة لا تخضع لضوابط أخلاقية دائما، وهذا ما دفع بعض علماء السياسة (جوليان فروند) للقول بأن السياسة تشبه كيس سفر به عديد من الأشياء:القانون والأخلاق والعنف والإرهاب الخ.
الاعتقاد بأن السياسات العليا أو استراتيجيات الدول صفحة مكشوفة ومقروءة للجميع وان على رجل الفكر التسليم بما تقول به الحكومات وهم لأنه في زمن السياسة الواقعية السائدة اليوم في العالم فأن لكل سياسة دولة وجهان أو خطابان:-
1 – الأول :خطاب مشرق موجه للرأي العام الداخلي والخارجي، به كثير من الأخلاقية والإنسانية والالتزام بالقانون والقيم السامية الخ، حتى ليخال الناظر وكأن الدولة هي جمهورية أفلاطون المثالية أو المدينة الفاضلة ورجالاتها مجموعة من الملائكة الذين لا يأتيهم الباطل من أمامهم أو خلفهم ولا يقولون إلا الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة.
2 -أما الوجه الثاني فهو السياسة العليا للدولة أو الأهداف الإستراتيجية التي تحدد المصالح العليا والوسائل المختلفة لتحققها، وحيث إن مصالح الدول متباينة وأحيانا معادية لبعضها، فالمخططون الإستراتيجيون يتوسلون كل الطرق لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك الحروب والأعمال البوليسية والتجسسية وانتهاك القانون الدولي إن لزم الأمر. هذا الوجه للسياسة غير متاح لكل الجمهور، فمن جانب فالجمهور لا يفهم أو غير معني بكل أمور السياسة، ومن جانب آخر فلو صارحت الحكومات جمهورها بمخططاتها الإستراتيجية فستوظف قوى المعارضة الأمر لنقد الحكومة – مع أن المخضرمين في المعارضة وخصوصا الذين سبق لهم تولي السلطة، يدركون صحة وواقعية هذا النهج من السياسة المستترة – كما أن كشف السياسات العليا والأهداف الإستراتيجية سيخدم الأعداء والخصوم، وعليه يمكن القول إن إدراك المراقب أو المحلل السياسي لِكُنه سياسة ما، لا يتأتى من خلال ما هو معلن فقط بل يجب الغوص إلى ما بين السطور وتوظيف قدرات تحليلية معمقة تقوم على التشبيك بين مستويات متعددة أو على التحليل النسقي، بحيث يتم الربط بين الاقتصاد والسياسة والدين وبين المحددات الوطنية والبيئة الإقليمية والدولية والتعرف إلى آليات صنع القرار في الدولة المعنية، بالإضافة إلى وضع المحلل لنفسه في موقع الطرف الخصم ومفترضا أن الخصم على درجة عالية من الذكاء وعلى درجة من الواقعية السياسية بحيث يمكنه اللجوء لأي وسيلة للدفاع عن مصالحه.
إذا انتقلنا من التجريد النظري إلى الممارسة أو السياسة الواقعية، فالولايات المتحدة مثلا تتحدث عن الديمقراطية والسلام ومكافحة الإرهاب ويكاد مسئولوها يذرفون الدمع وهم يتحدثون عن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة الشعوب، ولكن حقيقة السياسة الأميركية تقوم على مصالحها الإستراتيجية وخصوصا السوق الخارجي واستمرار تدفق المواد الخام وخصوصا النفط والتحكم بها أيضا، أيضا تقوم على نزعة هيمنة إمبريالية لا تخلو من مؤثرات دينية، ولأن هذه المصالح الإستراتيجية تتعارض مع مصالح الدول الأخرى كما أن آليات تحققها قد تتعارض مع الشرعية الدولية، لذا فإن واشنطن تحتاج للخطاب الأول، خطاب الأخلاق والقيم السامية والقانون الدولي، لتخفي حقيقة أهدافها الإستراتيجية، هذه الأهداف تترجم بممارسات لا تتورع عن توظيف قوة رادعة لا تلتزم بأي معايير أخلاقية أو قانونية لمواجهة من يحتج على تناقض الخطاب مع الممارسة ويكشف حقيقة النوايا الأميركية، أو يهدد هذه المصالح.
لو أخذنا مثلا تعامل واشنطن مع قضايا الشرق الأوسط وخصوصا العراق، نلاحظ أن الممارسة في الواقع لا علاقة لها بالسياسات الأميركية المعلنة منذ بداية العدوان الأميركي عام 1991، الخطاب المعلن يقول بالدفاع عن حقوق الإنسان وإقامة نظام ديمقراطي والحفاظ على وحدة الدولة العراقية، إلا أن الممارسة تتناغم مع إستراتيجية سياسية غير معلنة وهي تدمير الدولة العراقية كقوة عربية في المنطقة وتوظيف وتعزيز النزعات الطائفية والعرقية، أيضا استعمال التهديد المزعوم لنظام صدام لدول المنطقة وللسلام العالمي، للهيمنة على الخليج العربي وزرع قواعد عسكرية هي أقرب لجيوش الاحتلال. الأمر نفسه الأمر بالنسبة لإسرائيل التي تتحدث عن الأمن والسلام في خطابها الرسمي المعلن وتُظهر للعالم وكأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة المغلوبة على أمرها والمهَددة بوجودها من جيران يريدون تدميرها ويصمون آذانهم عن كل دعوة للسلام والعقلانية السياسية الخ، فيما ممارساتها على الأرض لا تتطابق البتة مع هذا الخطاب بل هي ممارسات تنفذ سياسة عليا وخطة إستراتيجية غير معلنة، جوهرها الاستمرار باحتلال الأرض الفلسطينية والعربية ومزيد من الاستيطان وعمل كل ما من شانه منع قيام دولة فلسطينية مستقلة.
هذا التحليل لمفهوم وواقع السياسات الدولية صالح لمقاربة كل السياسات الدولية بما فيها السياسات العربية، ففي الحالة الفلسطينية مثلا، لا يمكن الحكم على، وفهم، حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة سواء من حيث ملابسات نشوئها أو من حيث أهدافها، من خلال حديثها المعلن عن المقاومة أو الإسلام أو أنها حكومة شرعية جرى التآمر عليها الخ، بل هناك ما هو خفي ولا يعرفه حتى غالبية المنتسبين لحركة حماس أو المتعاطفين معها بما فيهم قيادات من الحركة، والأمر لا يتعلق بسياسات عليا لحركة حماس فقط بل سياسات عليا لأطراف إقليمية ودولية، عدم الوضوح في السياسات العليا موجود نسبيا عند القيادة السياسية للسلطة ولمنظمة التحرير، فمن المعلوم أن اتفاقية أوسلو بدأت بمفاوضات سرية، ولم تتوقف سرية المفاوضات حتى يومنا هذا، والغموض ما زال يلف المفاوضات مع الإسرائيليين.
السياسات الدولية والداخلية اليوم هي أبعد ما يكون عن الوضوح والشفافية، وإن مفاهيم نشر الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والشرعية الدولية والمصلحة والثوابت الوطنية ، ما هي إلا أدوات توظف لخدمة مصالح واستراتيجيات عليا، لا يتم الإفصاح عنها غالبا، وهذا يتطلب تخليص السياسات العربية من أوهام السياسة المشار إليها، وفهم واقع السياسة الواقعية التي تحكم عالم اليوم، الأمر الذي يحتم على الساسة والمثقفين إعادة النظر في نظرتهم للعالم وفي ممارساتهم وخطابهم السياسي.
ثالثا:الخطاب السياسي العربي بين الواقع و الايدولوجيا
________________________________________
انطلاقا مما سبق يمكن القول بأنه ليس كل ما يقوله السياسيون للإعلام وفي الجلسات العلنية صحيحا، وليس كل ما لا يصرحون به غير موجود.الخطاب السياسي –مكتوبا كان أم مسموعا – غير النص الأدبي، فقيمة هذا الأخير تكمن في ذاته، في جمالية الكلمة واتساق النص وفي المُتَخيل الذي يولده ، حيث القارئ لا يحتاج لمقارنة النص بالواقع ليحكم على قيمته وصدقيته الأدبية والفنية، أما الخطاب السياسي فقيمته لا تكمن في ذاته، لا في جماليته ولا في اتساق مفرداته (فيما عدا الايدولوجيا والفلسفة السياسية )، بل في الرسالة التي يريد توصيلها والتي كثيرا ما لا تكون ضمن مفردات الخطاب بل بين سطوره أو في تأويله وفي علاقته بالواقع وقدرته على التأثير على مجريات أمور الواقع.وعليه فمن يريد فهم سياسة كيان سياسي ما -خصوصا في بعده الاستراتيجي-، سواء كان نظاما سياسيا أم حزبا أو زعيما، فعليه ألا يُشغل نفسه كثيرا بالخطابات أو التقارير الرسمية ولا حتى بجلسات المؤسسات التشريعية ولجان التحقيق التي تعلن نتائجها للجمهور ولا بالمؤتمرات والمقالات الصحفية، نعم، عليه أن يتابع ويحلل كل ذلك ولكن لا يصدر حكما نهائيا من خلال ذلك فقط، بل يجب البحث عن الأهداف الحقيقية للسياسة والسياسيين في مكان آخر، يبحث عنها في السياسة عندما تتحول إلى ممارسات حقيقية على أرض الواقع، السياسة بما هي تحالفات وصراعات على المصالح، السياسة بما هي توازنات طائفية وطبقية ونخبوية،يبحث عنها ويتعرف عليها من خلال البحث عما إذا كان لكل طفل مقعد دراسي أم أن الأطفال يتسولون في الشوارع ،سيتعرف على السياسة عندما يعرف إذا كان لكل مواطن بيت يؤويه أم أن آلاف الآسر تعيش في الشوارع والمقابر وفي بيوت الصفيح ،سيتعرف على السياسة إذا ما عرف إن كان لكل مريض سرير في المستشفى وقدرة على شراء الدواء أم أن الناس يموتون لعجزهم عن دفع أجرة طبيب وثمن مبيت في مستشفى أو شراء دواء من صيدلية،الواقع هو المحك العملي للحكم على السياسة والسياسيين.من جانب آخر يجب التمييز بين النص الفلسفي والأيديولوجي ، والخطاب السياسي، الفلسفة أو الأيديولوجيا حتى وإن كانتا سياسيتين هما مجالات نظرية قائمة بذاتها ومكتفية بذاتها،مجالات لا تبحث عن ممارسة تمنحها المصداقية أو تؤكد مقولاتها، فمصداقيتها مستمدة من اتساقها النظري، مع نفحة إيمانية، وبالتالي لا تحتاج لدليل من خارج النص، بينما السياسة كعلم- والعلم هو معرفة الشيء بحقيقته – شيء مختلف ومقاييس الحكم عليه مختلفة. المشكلة تطرح عندما يحاول البعض إقحام المقولات الفلسفية والأيديولوجية بما فيها الدينية بما هي مجال ملتبس، على ميدان الممارسة السياسية، على مستوى السلطة والدولة.وقد لاحظنا كيف أن نهضة الدول الأوروبية بداية ثم اليابان وعديد من الدول الديمقراطية المستقرة، ما كان لها أن تكون لولا الفصل ما بين الدولة والممارسة السياسية من جانب، ومتاهات التاريخ والفلسفة و اللاهوت من جانب ثان،دون أن يعني ذلك إقصاء هذه المجالات الأخيرة من حياة الشعوب وثقافتها.
إذا ما تحدثنا عن الخطاب السياسي الرسمي العربي سنلاحظ حدوث تحول في هذا الخطاب في العقدين الأخيرين نتيجة هبوب رياح الديمقراطية على المنطقة ونتيجة الثورة المعلوماتية والتقنية التي حطمت جدران العزلة التي كانت تفرضها النظم على شعوبها. الخطاب السياسي الرسمي تغير وأصبح يوظف مفردات ومصطلحات غير معهودة فيه،وأصبح له متعهدون، من المثقفين والإعلاميين ومؤسسات تُصنف نفسها كمؤسسات مجتمع مدني ومراكز أبحاث ،يتفننون في صياغة شعاراته وأشكال التعبير عنه.أحبانا لا نجد اختلافا كبيرا ما بين مفردات الخطاب الرسمي العربي سواء كانت مدونات رسمية مدونة كالدستور والقوانين أو ما تقوله الصحف والفضائيات والنشرات الرسمية من جانب،وما يحتويه الخطاب الرسمي للأنظمة الديمقراطية الحقيقية من جانب آخر، إلا أنه شتان بين الواقع العربي والواقع الذي تعيشه المجتمعات الديمقراطية،حيث الواقع في مجتمعاتنا يسير باتجاه متعارض مع مصالح الأمة وأهدافها الحقيقية بالحرية والاستقلال،أي باتجاه معاكس لمنطوق الخطاب. في مجتمعاتنا هوة واسعة ما بين الخطاب السياسي وخصوصا الرسمي والواقع الذي يعيشه المواطن ، حيث يتحدث الخطاب عن كل قيم الديمقراطية كالحرية والمساواة والمواطنة وحقوق الإنسان والتعددية السياسية والتداول على السلطة والحق بالتعليم والسكن والعلاج فيما تتَشكل حياة الناس وطبيعة العلاقة بينهم وبين الطبقة الحاكمة في مسارات بعيدة ومتعارضة مع مفردات هذا الخطاب، وكأن الأنظمة السياسية تمارس الخطاب المعلن مع إضافة غير معلنة لأداة النفي (لا)، أو أنها تعتقد أن الجماهير على درجة من الغباء أو السذاجة بحيث تبهرها لغة الخطاب وصاحب الخطاب مما يغنيها عن فهم الواقع وتلمس مصالحها الحقيقية من خلاله.
ملاحظة ثانية، هي أن الأنظمة العربية لم تعد تمارس سياسة المنع والحجر على الأفكار والأيديولوجيات،بل توجد تخمة في هذا المجال، بل لا تتورع الأنظمة عن فتح فضائيات تابعة لها أو تسهل لفضائيات خاصة عملها وتسمح لهذه الفضائيات بالتحدث عن كل شيء وتنتقد كل شيء حتى الأنظمة نفسها.وهذا مختلف كليا مع ما كان يجري في الستينيات والسبعينيات مثلا عندما كانت تُمنع الكتب والمجلات من المرور عبر الحدود أو تخضع لرقابة مشددة،وكان الكُتَّاب والمثقفون يطاردون على كتاب كتبوه أو قصيدة أو حتى أغنية ،وكان يجري التشويش على الإذاعات الخارجية الخ .الخطاب السياسي لم يعد معيارا للحكم على شرعية وأهلية أي نظام سياسي ،ويمكن أن نظيف حتى الخطاب السياسي لقوى المعارضة ،لقد حولت الأنظمة والنخب السياسية الخطاب السياسي لأيدولوجيا وخصوصا عندما تضفى على هذا الخطاب مسحة دينية ، أو لمجرد نصوص على ورق لا تثير اهتمام احد، بدلا من أن يكون مرشدا وأداة للتغيير،وعليه فشرعية النظام يجب أن تستمد من شرعية الإنجاز،من القدرة والإرادة في تلبية الاحتياجات الأساسية للجمهور،في توفير حياة كريمة وأمل بالمستقبل .
رابعا: سؤال الهُوية بين معقولية الانتماء و أوهام الايدولوجيا
من ضمن الاختلاطات التي شابت العقل السياسي العربي تأتي مسالة الهوية ،اختلاطات الهوية على مستوى العقل والايدولوجيا تركت أثرها على المواطن وكيفية تعريفه لهويته ،وطنية أم قومية أم إسلامية؟كما أن سؤال الهوية أثار مسألة الثوابت والمرجعيات التي يُفترض أن تؤطر العمل السياسي للدولة والأحزاب،فلا ثوابت ومرجعيات إلا إذا تم التفاهم على مسألة الهوية،حيث أصبحت الهوية أهم عوامل الاستقطاب والتعبئة والحشد بعد تراجع الأيديولوجيات إن لم تتحول الهوية بحد ذاتها لأيديولوجيا.وحيث أن الواقع العربي مأزوم بالفكر والفكر مأزوم بالواقع،فإن أهم تجليات الأزمة الطافية على السطح هي مسألة الهوية ،سواء تعلق الأمر بالعراق أو السودان أو فلسطين أو لبنان،وإن كانت مسالة الهوية أخذت طابعا صداميا ودمويا أحيانا في هذه البلدان،فهي كامنة ومحرضة وقابلة للتفجر في بلدان أخرى.
وعليه فإن سؤال الهوية يُطرح اليوم من باب الإشكال أو الأزمة وإن تزين بزى التحول الديمقراطي وما افرز من حريات تتيح لكل الجماعات التعبير عن نفسها،وهو إشكال مزدوج ،فهناك التهديد الخارجي الذي يواجه الهوية العربية والإسلامية من طرف العولمة الثقافية،وهناك التهديد الداخلي الناتج عن التعارض والتصادم ما بين الهويات وبعضها البعض حتى داخل الدولة القطرية (الوطنية). إن كانت العولمة الثقافية تشكل تهديدا حديثا و لا يقتصر على الهوية العربية أو الإسلامية بل كل الهويات والثقافات الوطنية عبر العالم ،فإن التعدد الهوياتي سواء اخذ طابع التعايش السلمي أو الإكراهي، أو اخذ طابع التصادم ، قديم في عالمنا العربي ،ويمكن القول بأن اتفاقية سايكس- بيكو لعام 1916 هيأت الجغرافيا السياسية التي أفسحت المجال لظهور الدولة العربية القَُطرية والتي سُميت فيما بعد بالدولة الوطنية ،هذه بدورها أنتجت هوية وطنية تمايزت من جانب عن الهوية القومية العربية ،المتعثرة نشأة، والمصادَرة سياسيا سيرورة، وتمايزت أيضا عن الهوية الإسلامية المسيسة ، الضعيفة آنذاك والصاعدة حديثا.
كانت مسألة الهوية وطوال أكثر من خمس عقود كامنة وراء كثير من الإشكالات التي شغلت العقل السياسي العربي. تجلت مسألة أو إشكالية الهوية خلال هذه المرحلة في التنازع بين مكونات (الرباعية) : الهوية القومية والهوية الأممية الاشتراكية والشيوعية والهوية الإسلامية والهوية الوطنية ،مع اختلاف الترتيب حسب الأهمية والأولوية لكل منهم من بلد لآخر ومن فترة زمنية لأخرى.مثلا الهوية الدينية السياسية والتي كانت ممثلة بجماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير شكلت رؤية مغايرة للهوية ،إلا أن الحضور السياسي لهذين الحزبين كان محدودا،وحتى بالنسبة للهوية الأممية فقد كانت غير واضحة المعالم وفي كثير من الحالات كانت أوهاما أو حلما عند بعض الناشطين في الأحزاب الشيوعية ،وللمفارقة فان كثيرا من الشيوعيين العرب حاولوا إيجاد حالة من المصالحة ما بين الشيوعية والدين بل كان بعضهم يوظف آيات دينية في خطبه ويبدأ بالبسملة ،أما الهوية الوطنية فقد كانت تُلعن علنا وتُؤسس وتُغذى فكريا خِفيَة ،وأحيانا كان الفكر والمفكرون المعبرون عن الهوية الوطنية القطرية يصنفون كأعداء للوحدة والتحرر وأحيانا كعملاء للاستعمار . مع أنه في الوقت الذي كانت ترتفع فيه شعارات الوحدة العربية والهوية القومية كانت الأنظمة الثورية والقومية ترسخ الإقليمية من حيث تدري أو لا تدري .
أدى انحراف الفكر القومي والثوري ،وخصوصا الحاكم، لترسيخ مركزية الدولة القطرية ونظام الحزب الواحد وتضخيم الأجهزة الأمنية وتشديد الرقابة على الحدود والحد من حرية تنقل الأفراد بين الأقطار العربية وقمع حرية الفكر الخ ،الأمر الذي أدى لتعزيز مكانة القطرية ، بل وما هو أكثر خطورة أن هذه الأنظمة والحركات أحيت وعززت الهويات الطائفية والعرقية، أي هويات ما قبل الدولة وما قبل الوطنية،ذلك أنه عندما ينكشف زيف الايدولوجيا والشعارات التي اعتمد عليها الحاكم للوصول للسلطة ،ويفقد الحاكم شعبيته ،يلجا لطلب الحماية من أبناء طائفته أو قبيلته ،وهذا لا يكون بدون مقابل ،فيغدق عليهم الهبات والامتيازات والمناصب الرفيعة وخصوصا في المؤسسة العسكرية والأمنية الأمر الذي يستثير المكونات الأخرى للمجتمع ،فتكون الطائفية .ما جعل مسألة الهوية إشكال هو أن الدولة العربية- ويشاطرها في ذلك كثير من دول العالم الثالث- لمرحلة ما بعد الاستقلال وُلِدت ولادة قيصرية ومأزومة في شرعيتها حيث جاءت خارج التطور الطبيعي للمجتمعات السياسية كما يُعرفه علم السياسة وكما شهدته المجتمعات الأخرى ،فلا هي دولة/ أمة ولا هي وريثة لدولة الخلافة ولا هي دولة عقد اجتماعي ولا هي دولة طبقة مهيمنة بالمفهوم الماركسي ،بل أُقحمت مؤسسة الدولة إقحاما لاعتبارات ومصالح استعمارية .لكل ذلك كانت المنطقة العربية مجالا خصبا لتوالد الأفكار والنظريات لتأطير مجتمعات لا تجربة سابقة لها بحكم نفسها بنفسها . ومن جهة أخرى وحيث أن عددا من الدول العربية عاشت مرحلة حركة التحرر ضد الاستعمار ومن يواليه من قوى داخلية، بما هيمن على هذه الحركات من فكر (ثوري) فقد حاول القوميون السياسيون في هذه المرحلة بأن يكونوا توفيقيين –بالإكراه تارة وبالصمت تارة أخرى- يجمعوا ما بين الفكر القومي والفكر الاشتراكي والفكر الديني أحيانا دون وضوح الخطوط الفاصلة لكل منهم ،فالمرحلة الناصرية كانت بدايتها ذات صلة بالإخوان المسلمين ثم قطعت معهم لصالح الفكر القومي ثم تحولت أو مزجت الفكر القومي بالفكر الاشتراكي،والأنظمة والحركات التي عرفتها سوريا والعراق واليمن والسودان الخ، كانت خليطا ما بين الفكر القومي والفكر الاشتراكي مع توظيف للدين بشكل أو آخر وحركة التحرر الوطني الفلسطيني (فتح) كانت أصولها إسلامية.من المعروف أن كل هذه المحاولات التوفيقية قد فشلت،ليس لأن فكرة المزج خاطئة ،فهي ما يجب أن يكون ،بل لعدم قدرة تلك القوى السياسية على خلق الترابط الجدلي الحقيقي بين هذه الهويات فكريا ،وعدم قدرتها أو عدم رغبتها في تفعيل مبدأ المساواة بين مكونات المجتمع على أساس ديمقراطي .وهكذا ونظرا لهيمنة الأيديولوجيا أو الاستبداد أو كليهما لم يَُفصح إشكال الهوية عن ذاته دائما كخلاف هوياتي محض، بل أخذ تجليات سياسية وحزبية وطائفية، و في أحايين كان كامنا وراء عديد من الخلافات والصدامات التي استنزفت جهد المفكرين وإمكانيات الأمة وعكست ما يمكن أن نسميه أزمة الدولة القطرية (الوطنية).وعندما هبت رياح الديمقراطية من الغرب أضيفت إشكالات الأخذ بديمقراطية موجهة إلى إشكالات الهوية ،وتداخلت الأمور بحيث ركب متطرفو بعض الهويات و الثقافات المضادة موجة الديمقراطية وأرادوا أن يحققوا بأدوات تُنسب للديمقراطية ما لم يستطيعوا تحقيقه بوسائل أخرى ،ووجد الديمقراطيون الحقيقيون أنفسهم أمام مهمة معقدة ومزدوجة وهي حل مشكلة التصارع الهوياتي من جانب وبناء أسس الديمقراطية التي تقوم على مفهوم المواطنة والتعددية الثقافية والاعتراف بالآخر وتخفظ وحدة الوطن والشعب،من جانب آخر. ونعتقد انه لو وجدت الديمقراطية مكانا لها خلال العقود السابقة في ثقافة أصحاب الهويات المتعددة ونجحت المجتمعات العربية في تأسيس أنظمة ديمقراطية حقيقية لحلت إشكالات الهوية.
في الوقت الذي كان فيه المفكرون العرب منشغلين بالإشكالات المرتبطة بالدولة والحكم والهوية، دهمتهم العولمة وشكلت تحديا غير مسبوق،وعملت الولايات المتحدة على توظيف الديمقراطية الموجهة كإحدى أدوات العولمة الثقافية،هذه الأخيرة التي أدت لتفجر النزاعات الإثنية والطائفية من حيث كان يُفترض أن تؤدي لتذويب الهويات وجسر الفجوة بين الثقافات .من الملاحظ أن تأثير العولمة على الهويات لم يكن واحدا ،ففي الوقت الذي شعرت فيه الثقافات القوية -والهوية جزء من الثقافة – بتهديد العولمة الثقافية الموجهة أمريكيا ،فإن الهويات الصغيرة والتي كانت مهمشة وخصوصا في العالم العربي استقوت بالعولمة وبمن يقف وراءها ،والسبب انه تم تسييس العولمة الثقافية بشكل كبير واستعملتها أمريكا كعصا ضد أصحاب الهويات التي يمكنها تهديد مصالحها وثقافتها ،وحيث أن العالم العربي بهويته وثقافته وتاريخه وموقعه وخيراته كان في بؤرة الاهتمام الأمريكي ،فقد عملت أمريكا على تعزيز الثقافات الفرعية والهويات الصغيرة ليس حبا بها بطبيعة الحال ولكن لإضعاف الهوية العربية والإسلامية كهوية موحدة أو قادرة على توحيد الأمة العربية .
هناك بعد آخر وهو تحول مكونات ومصادر الثقافة وبالتالي الهوية.فمن التبسيط ألمتناهي للأمور التعامل اليوم مع مفهوم الهوية انطلاقا من التعريف أو السمات الكلاسيكية لها،هذا التعريف كان كافيا بحد ذاته عندما كانت المجتمعات تتحكم بالتنشئة الاجتماعية،ولم يكن للمؤثرات الخارجية كبير تأثير على البنية الثقافية،كما ان وسائل التعبير عن الهوية اليوم ليست هي وسائل عصر ما قبل العولمة ،ففي ظل الثورة المعلوماتية ،وهذا التدفق الهائل للأفكار والقيم وأنماط السلوك عبر الفضائيات وشبكات الانترنيت بأساليب مشوقة ومغرية وسهلة الوصول إليها، لم تعد لا النظم السياسية والاجتماعية ولا البني التقليدية ولا الموروث بقادرين على التحكم بنقاء الهوية،وبالمقابل فإن هذه التقنيات الحديثة مكنت الهويات من التعبير عن نفسها بشكل أفضل من السابق، وعليه يمكن أن نزعم أن مشتملات الهوية، والحفاظ عليها، والتعبير عنها ،لم يعد خاضعا لمحددات وطنية ومحلية خالصة.
لا محاجة اليوم بأن المجتمع العربي :ثقافة وقومية ودول قطرية ،يشهد إعادة نظر شاملة إن كانت العوامل الخارجية لها نصيب الأسد فيها ،فإن عجزه خلال عقود عن حل إشكالاته ،كان له دورا مهما في مأزقه الحالي ،إعادة النظر هذه وخصوصا ما يمس منها الهوية (التوازنات الطائفية والعرقية) أو ما يتعلق بالتوازنات السياسية،يحتاج لفكر سياسي متجدد لا يقطع مع تراثه ولكنه يستوعب المستجدات ،وفي هذا السياق فإن تصادم الهويات المتواجدة في العالم العربي لا يصب في مصلحة الأمة العربية ولا في مصلحة الدولة الوطنية،وهو بطبيعة الحال يتعارض مع روح الإسلام كدين تعايش وتسامح ،والحل هو تثاقف الهويات وهناك كثير من نقاط الالتقاء بينها وخصوصا إنها تعايشت لقرون على نفس الأرض وتشاطرت الآلام المشتركة،ولو تم قطع الطريق على التدخلات الخارجية فإن إمكانية الالتقاء بين الوطني والقومي والإسلامي أمر ممكن ،التثاقف الهوياتي يصبح ضرورة ومصلحة لمواجهة التهديد الخارجي من جانب وتجنب نار الحرب الأهلية من جانب آخر.
خامسا: الثوابت الوطنية :نتاج للعقل الجمعي أم للأيديولوجيا المهيمنة.
قي سعي العقل لتلمس موقع قدم وسط الايدولوجيا والشعارات التي تمسك بتلابيب الواقع العربي الراهن، أصطدم بحقيقة أن ما كانت تعتبرها الأمة ثوابت ومرجعيات حتى على المستوى الوطني هي ليس كذلك. فلم يعد المواطن يعرف الفرق بين النصر والهزيمة ،بين المناضل وغير المناضل،بين الثوري والرجعي ،بين أنظمة الثورة وما يُفترض أنهها نقيضها ،بين الاستقلال والتبعية ،بين الحرية والاستبداد ،بين الديمقراطية والفوضى،بين الدولة والقبيلة ، بين الجهاد والإرهاب ،بين الإسلام كدين تسامح وجماعات دينية تذبح وتقتل أصحاب نفس الديانة،بين الشرعية الدولية وشريعة الغاب ،بين السلام والاستسلام ،بين الحليف والعدو الخ .
اصطدم العقل بأن المواطن العربي منقسم على ذاته ،متردد حائر، ضائع،لم يعد فيه الوطن بالنسبة له إلا محل إقامة إجبارية، لو فُتحت أمامه أبواب الهجرة ما تردد بالهجرة ،في هذا الزمن تغيرت الأولويات وتداخلت المهام النضالية :الوحدة الوطنية أولا أم الوحدة العربية أم الوحدة الإسلامية؟ النظام السياسي أم الدولة؟التحول الديمقراطي أم مواجهة الاستعمار الجديد والهيمنة؟ رغيف الخبز أم الحرية ؟ فلسطين أولا أم السلطة أولا؟الخ. في هذا الزمن ،كيف يمكن جمع كلمة الأمة(بالمفهوم الوطني أو القومي أو الإسلامي) حول أهداف أو مصلحة مشتركة، ما دامت الأمة منقسمة وغير متفقة على الثوابت والمرجعيات ؟غير متفقة على مفهوم الهوية الوطنية ومفهوم المصلحة الوطنية ومفهوم الدولة ومفهوم الدين ؟والانقسام ليس فقط بين سلطة ومعارضة بل داخل المعارضة انقسامات وعداوات أكثر مما بين أي منها و السلطة،عندما تختلف الأمة على الثوابت والمرجعيات يصبح ُ مِن المباح لكل من هب ودب أن يتحدث باسم الأمة أو الشعب ليمارس ما يريد باسم مصلحة الأمة .
في ظل هكذا أجواء يُفصَل الوطن ويُصاغ حسب مشيئة وإيديولوجية كل حزب أو جماعة أو حتى شخص ،وباسم المصلحة الوطنية الموهومة تخرج مظاهرات و تحدث ثورات وانقلابات ،وباسم المصلحة الوطنية الموهومة يُمارس العنف الدموي تجاه أطراف من الخارج أو من داخل البلد يصنفهم النظام الحاكم كأعداء للوطن وللمصلحة الوطنية،وباسم المصلحة الوطنية الموهومة يُصادر القرار الوطني الحقيقي لمصلحة ارتباط بهذه الجهة أو تلك، سواء كانت إسلامية أو عربية أو أجنبية،وباسم المصلحة الوطنية الموهومة تُبدِد النخبة الحاكمة ثروة الوطن على شراء أسلحة لدعم أجهزتها الأمنية وجيشها لمحاربة مَن تصنفهم أعداء الوطن، فيما هي أسلحة لمحاربة المواطنين ومن يمثل تمثيلا صحيحا المصلحة الوطنية الخ.
عندما تصبح ما كانت تعتبر مسلمات طوال عقود أي الثوابت والمرجعيات :الهوية والوطن والدولة ومفهوم المصلحة الوطنية، محل تساؤل ونقاش، فهذا معناه وجود أزمة عميقة تتعدى كونها أزمة سياسية عادية نتاج للحراك الاجتماعي والسياسي الناتج عن ملامسة رياح الديمقراطية ،و تتعدى كونها أزمة ناتجة عن التحولات في مصادر شرعية النظم السياسية،جمهورية أو ملكية ،عسكرية أو ديمقراطية الخ،بل هي أزمة أعمق من ذلك وجدت مع ولادة الدولة (الوطنية الحديثة) ، دول سايكس- بيكو والدول التي أنتجتها موجة التحرر من الاستعمار .ولأنها أكثر من كونها أزمة سياسية كالتي تشهدها كثير من دول العالم فأنها تأخذ طابعا عنفويا وطائفيا وقبليا وتضع (مؤسسة) الدولة في مهب الريح .
حالة العنف غير المسبوقة وإطلالة الثقافات المضادة برأسها،من قبلية وطائفية، وتهديدها لوحدة الشعب والدولة، وإضعافها الولاء للوطن وتقوية الارتباط بمرجعيات خارجية الخ، كلها أمور تتجاوز كونها تعبيرا عن حرية الرأي والتعبير أو حق الاختلاف، لتندرج في سياق آخر وهو أزمة الدولة الوطنية بنظمها السياسية ونخبها وعقلها السياسي ،أزمة تتبدى في أن ما دُرج على تسميتها بالثوابت والمرجعيات الوطنية ليست ثوابت ومرجعيات الأمة بل هي ثوابت ومرجعيات النظام السياسي أو الدولة التي أقحمت على المجتمع وشُكلت دون رضاه ،واستمرت لعقود تُسخَر لمصلحة النظام السياسي التي هي مصلحة النخبة الحاكمة،القبضة الحديدية للنظام السياسي والايدولوجيا المهيمنة والمخدرة ،أخفت لعقود أزمة الدولة العربية القُطرية،ولكن ومع تأزم وتآكل شرعية الأنظمة ،ومع الإفقار المتزايد للجماهير اكتشفت هذه الأخيرة أن ما يسمى بالمصلحة الوطنية ليست مصلحتها وما تسمى بالثوابت والمرجعيات ليس ثوابتها ومرجعياتها ،أو كانت كذلك في البداية قبل مصادرتها ثم تحريفها من قِبل الأنظمة السياسية .اكتشاف هذا التخارج أو التضاد ما بين ما يفترض أنها ثوابت ومرجعيات الأمة من جانب وواقع الممارسة السياسية للأنظمة من جانب آخر، تزامن مع رياح الديمقراطية التي مست النظم العربية من ناحية ومع تراجع بريق وإمكانيات التغيير الثوري الانقلابي بعد أن جربت الجماهير هذا النمط من التغيير ولم يؤد إلا لتعميق الأزمة ،وتزامنت أيضا، وهو الأمر الأخطر، مع التوجه الأمريكي المكشوف لإعادة صياغة الخريطة السياسية للشرق الأوسط والمقصود العالم العربي بعد انهيار المعسكر الاشتراكي.
ولأن انكشاف أزمة الدولة القطرية (الوطنية) ونظامها السياسي المزمن(ما طرا على أنظمة الحكم من متغيرات لم تؤثر على البنية العميقة للدولة فالتغييرات كانت شكلانية فقط) تزامنت مع رياح الديمقراطية والتي هي نخبوية إن لم تكن مستوردة وموجهة من الخارج،فقد انساقت الجماهير وراء دعوات الديمقراطية وهي مأزومة ثقافيا ومشتتة فكريا ،فحدث التداخل والخلط ما بين النضال الديمقراطي الذي له أدواته وثقافته وضوابطه من جانب وإشكالات أزمة الدولة من جانب أخر،قبل إعادة بناء الثوابت والمرجعيات على أسس صحيحة، فركبت الحركات: الانفصالية ،الطائفية ،الدينية ،التكفيرية ومن يشتغل لحساب أجندة أجنبية موجة الديمقراطية، وحدث ما نشاهده اليوم من ضياع وتشتت واختلال البوصلة.
في الوضع الطبيعي فأن الديمقراطية بمستلزماتها وتوابعها :التعددية الحزبية والثقافية ،الانتخابات ،المجتمع المدني ،التداول على السلطة ،المواطنة، الخ ،لا تغير من الثوابت والمرجعيات مع كل جولة انتخابية ،وإلا ما كان للأمة ثوابت ومرجعيات وطنية والتي هي أساس التعامل الدولي وموئل استراتيجيات العمل الوطني وبناء الثقافة الوطنية والناظم لكل عمل وطني على قاعدة مفهوم المواطنة.ولنتصور أنه يعود لكل حزب سياسي أو جماعة صياغة الثوابت والمرجعيات الوطنية حسب عقيدته وأيديولوجيته،فتصبح لدينا ثوابت ومرجعيات دينية وثوابت ومرجعيات ماركسية وثوابت ومرجعيات قومية وثوابت ومرجعيات وطنية وثوابت ومرجعيات طائفية بعدد الطوائف وثوابت ومرجعيات إثنية بعدد الأعراق الموجودة بالدولة الخ ، وبالتالي سيسعى كل حزب فائز بالانتخابات لتطبيق تصوره للمصلحة الوطنية حسب تعريفه للثوابت والمرجعيات ،فكيف سيكون حال الأمة ؟وكيف سيحدث التداول السلمي على السلطة؟ بالتأكيد لن نكون أمام دولة ثابتة ومستقرة بل أمام حالة سياسية متسيبة تمزقها الحروب والصراعات الداخلية ،بمعنى أن الديمقراطية تنتج نقيض فلسفتها ونقيض المتوخى منها.
الخلل بطبيعة الحال ليس بالديمقراطية من حيث المبدأ وليس بالقوى الديمقراطية الوطنية المناضلة ،ولكن بمن ركب موجة الديمقراطية ووظف مبدأ التعددية وحرية الرأي والتعبير للانقلاب على الأمة،ومن جهة أخرى بولوج التجربة الديمقراطية قبل وجود توافق وطني حول الثوابت والمرجعيات ،أو بمعنى آخر قبل توطين الإيديولوجيات الحزبية والثقافات الفرعية في إطار ثوابت تمثل المشترك الوطني بين هذه الإيديولوجيات والثقافات،لو تم التوافق والتراضي على الثوابت قبل ولوج الممارسة الديمقراطية وخصوصا العملية الانتخابية ، لكان التنافس الانتخابي ليس بين متناقضات إيديولوجية بل بين برامج سياسية في إطار الكل المشترك.ولأن ذلك لم يحدث فلم يحدث تبعا لذلك أي تداول سلمي حقيقي على السلطة ،وهذا ما شاهدناه في الجزائر وفي فلسطين .أما النماذج الناجحة ولو نسبيا للتداول على السلطة فهي التي تم فيها الاتفاق على الثوابت والمرجعيات مسبقا.
إن كانت الأمة منقسمة حول الثوابت والمرجعيات ومفهوم المصلحة الوطنية ،وإن كانت آليات العمل الديمقراطي وخصوصا إن كانت موجهة أمريكيا، لا تعطي ضمانة بالتوصل لثوابت ومرجعيات وطنية تعبر عن مصالح الأمة وتطلعاتها … فالحل في نظرنا هو التوافق والتراضي بين القوى السياسية الرئيسة على هذه الثوابت بما يضمن مبدأ التعددية الثقافية ألا طائفية وألا عرقية التي تحترم التمثيل الصحيح لكل فئات المجتمع على أساس مفهوم المواطنة.ترسيخ مبادئ المواطنة والاعتراف بالآخر والتعددية الثقافية هي مدخل الديمقراطية وليست نتاجا لها ،الديمقراطية لا تصنع الوحدة الوطنية بل هي نتاج لها .
سادسا:(الثوابت الوطنية) الفلسطينية: أيديولوجيا أم مهام نضالية؟
________________________________________
أصبح مصطلح الثوابت الفلسطينية اللازمة لكل خطاب سياسي فلسطيني، خطاب أحزاب السلطة وخطاب أحزاب المعارضة- مع التباس مفهوم السلطة والمعارضة فالقوى الحاكمة في الضفة تشكل معارضة في غزة والعكس صحيح -، لازمة خطاب الذين يتحدثون عن السلام والمفاوضات وخطاب الذين يتحدثون أو يمارسون المقاومة والجهاد.كلما أقدمت القيادة الفلسطينية على خطوة نحو التسوية أو حضرت مؤتمرا أو جلست لتفاوض إسرائيل …. إلا وارتفعت الأصوات محذرة من التفريط بالثوابت ، وكلما قام فصيل بعملية عسكرية، ناجحة أم فاشلة، إلا وبرر ذلك بالدفاع عن الثوابت الوطنية.الذين يجلسون على طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين والذين يطلقون الصواريخ ويتهمون المفاوضين بالخيانة، جميعهم يبررون ما يقومون به بالدفاع عن الثوابت الوطنية !، حتى الاقتتال الداخلي ثم انقسام ما كان يُفترض أن تكون أرض المشروع الوطني تم تبريرهما بالدفاع عن الثوابت الوطنية ، الذين استشهدوا أو أسروا أو جرحوا كان ذلك دفاعا عن الثوابت والذين كدسوا الثروات وعاثوا فسادا هم من القائلين بالتمسك بالثوابت الوطنية !.فما هي هذه الثوابت الوطنية التي تستوعب كل هذا التناقض بين القائلين بها ؟ وما العلاقة بين خطاب الثوابت والواقع الذي ما وجدت الثوابت والمشروع الوطني إلا لتغييره ؟. الثوابت موضوع الحديث ومحل التداول هي حتى الآن شعارات تعبر عن أهداف و تطلعات شعب تحت الاحتلال- وهي نقطة خلافية أيضا أو هي ثوابت غبر ثابتة،وسنتحدث عن الموضوع في موضع آخر-، إنها حقوق سلبها الاحتلال و الشعب منح ثقته وفوض زعامات وقوى سياسية قيادة العملية النضالية لإنجاز هذه الأهداف أي لتحقيق المشروع الوطني، لتحويل الثوابت من مشروع لواقع مُجسد بدولة مستقلة ذات سيادة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعودة اللاجئين، و يفترض أن يكون الحكم على شرعية هذه القيادة وجدواها هو مدى التقدم الملموس نحو الحرية والاستقلال وليس مجرد الحديث عن التمسك بالثوابت وإدعاء عدم التفريط بالحقوق.
شرعية القيادة السياسية مستمدة من قدرتها على تحقيق الأهداف الوطنية وليس من خطاب التمسك بها، فالشرعية يجب أن تكون شرعية الإنجاز وليس شرعية الخطاب أو شرعية مستمدة من كثرة عدد الجنازات وبيوت العزاء واستعراض أشلاء الأطفال وعويل النساء بعد كل عدوان صهيوني.ماذا ينفعنا خطاب التمسك بالثوابت أو القول بعدم الاعتراف بإسرائيل ما دامت الأرض تضيع من يدنا شبرا شبرا والشهداء يتساقطون يوميا والشباب والكفاءات يتسربون من الوطن ليضافوا لجموع اللاجئين في الشتات، والشعب يتحول لجموع تعيش على الصدقات والمساعدات الخارجية المشروطة بشكل مهين؟وماذا ينفع خطاب التمسك بالثوابت وعدم الاعتراف بإسرائيل فيما هذه الأخيرة تواصل عمليات الاستيطان وتعزز حضورها دوليا وتكتسب مزيدا من الدعم والاعتراف حتى من دول عربية وإسلامية ودول كانت تصنف كحلفاء استراتيجيين لنا قبل سنوات ؟ماذا يفيد خطاب التمسك بالثوابت الوطنية أو عدم الاعتراف بإسرائيل فيما مَن يُفترض أنهم يتمسكون بالثوابت يتصارعون ويتقاتلون مع بعضهم بعضا؟ما قيمة خطاب عدم الاعتراف بإسرائيل فيما إسرائيل توظف هذا الخطاب لكسب مزيد من الاعتراف والتأييد الدولي ؟ما قيمة خطاب التمسك بالثوابت ونحن غير فادرين على التمسك بـما هو متاح بيدنا من أرض أو إدارتها؟.بعد كل ذلك ما الذي سيتبقى من الثوابت لنتمسك به إلا الشعارات، وتاريخ نضالي وقبور شهداء نبكي على أطلالها؟.
لقد بات خطاب التمسك بالثوابت أو ترديد خطاب عدم الاعتراف بإسرائيل مجرد أيديولوجيا وخصوصا عندما يضفى عليه طابعا دينيا، تحول خطاب التمسك بالثوابت لأيديولوجية مخدرة لجماهير فقيرة ومحبطة ومحاصرة. بات الانشغال بخطاب الثوابت والمرجعيات يشغل الحيز الأكبر من الاهتمام على حساب العمل على تحقيق هذه الثوابت، حتى باتت شرعية السلطة والأحزاب تستمد من الخطاب والشعارات وليس من الإنجاز إلا عمليات مسلحة محدودة واستعراضية وأحيانا عبثية للقول بان هذا التنظيم أو ذاك ما زال يسير على درب التحرير.
كل مكونات الطبقة السياسية الفلسطينية تدعي أنها تتمسك بالثوابت الوطنية وأنها لم ولن تفرط بها ولن تعترف بإسرائيل، وعدم التفريط في نظرها يمنحها شرعية الوجود والحكم بل والصراع للوصول لسلطة تحت نير الاحتلال، وحسب هذا المنطق لم يعد الانجاز والتقدم نحو تحقيق الأهداف الوطنية هو المقياس لشرعية القيادة بل مجرد التمسك اللفظي بهذه الحقوق، بغض النظر هل هذه الحقوق في مِلكنا وتحت تصرفنا أم هي حقوق محتلة، ولا ندري بأي منطق يفكرون؟ فهل الشعب جاء بهم أو قَبِل بتسيٌِدهم عليه من أجل أن يتمسكوا بشعارات ؟أم ليحولوا الشعارات واقعا ؟فإن لم يكونوا هم من يتحمل المسؤولية عن عدم التقدم نحو الإنجاز فمن يتحمل المسؤولية ؟بل وصل الأمر لأن تعتبر الأحزاب السياسية أن كثرة عدد الشهداء والجرحى والأسرى مقياس لانتصاراتها ودالة على أنها متمسكة بالثوابت، وهو مقياس يؤدي لنتيجة أن مقتل كل الشعب يصبح قمة الانتصار! وأصبحت هذه الأحزاب تعتبر إنهاء عمر الزعيم السياسي دون أن يتخلى عن الثوابت هو قمة الإنجاز الذي يستحق الافتخار به، ويصبح الأموات مصدرا إضافيا للشرعية كما هو التاريخ الموهوم.مع كامل التقدير والاحترام للقادة الذين قضوا دون التفريط بالحقوق، إلا أننا لا نريد أن يصبح خطاب عدم التفريط ايدولوجيا ومصدر شرعية لكل متنطع لقيادة الأمة وبالتالي يغيب مبدأ المحاسبة على السلوك والإنجاز. يقينا، المشكلة لا تكمن في حق الشعب الفلسطيني أن تكون له ثوابت وطنية أو مشروع وطني بل في الاختلاف حول الثوابت ،المشكلة بطبقة سياسية عجزت وفشلت في الاتفاق حول المشروع والثوابت وهو فشل أدى لغياب إستراتيجية وطنية للتعامل مع القضية، فشلت في الاتفاق على إستراتيجية مقاومة وفشلت في الاتفاق على إستراتيجية سلام وفشلت في الاتفاق على إستراتيجية توفق ما بين المقاومة والسلام حيث لا تناقض بين الاثنين.نلمس المشكلة اليوم في ارتباك المواطن في محاولة معرفته مَن يمثل الثوابت الوطنية وله حق التفاوض والتصرف باسم الأمة؟هل هي الحكومة في رام الله؟ أم حركة حماس وحكومتها؟ أم حركة فتح؟ أم منظمة التحرير؟ أم أن الشعب بدأ يفقد ثقته بكل هذه الأطر؟ عندما تختلف امة من الأمم على الثوابت فهذا مؤشر بان الأمة تعيش مأزقا وجوديا خطيرا .
سابعا: صعوبة الحياد ومزالق الانحياز في الحياة السياسية الفلسطينية
لا يبدو بالأفق بوادر لما اصطلح على تسميته بـ(الحل المشرف) وهي تسمية أريد بها التغطية على التخلي عن ثلثي الوطن التاريخي،وعلى كل حال فقد ارتضت غالبية الشعب التعامل هذا الحل رضاء مشروطا بقيام الدولة المستقلة في الضفة وغزة عاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين،أيضا لا يبدو بالأفق أمل بالخروج قريبا من الأزمة المركبة التي تمر بها القضية الفلسطينية،أزمة التسوية والمفاوضات مع إسرائيل،وأزمة الحوار الداخلي وأزمة شاليط الأسير الذي تحول لآسر وأزمة معبر رفح الذي تراه حركة حماس الحل السحري لمعاناة الشعب الفلسطيني ولمجمل للفضية الفلسطينية.حتى تفاؤل رايس وزيرة الخارجية الأمريكية وبعض المسئولين الأوروبيين لا يُغيب الواقع المرير المناقض لكل مفردات التفاؤل.
نعم نستحضر ويستحضر آخرون مقولة تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة،إلا أن الإرادة لوحدها لا تغير الواقع فهي تحتاج للقوة وللعقل،ويبدو أن العقل الوطني الجمعي كمرشد وهاد لأولي أمر الشعب الفلسطيني ما زال مغيبا ومكبلا،العقل الجمعي مكبل بأغلال الرؤى الحزبية الضيقة والمصالح الذاتية والارتهان للخارج بكل مشاربه حتى وإن بدت متناقضة،عندما يرتهن العقل للخارج فإنه يتقاعس عن إبداع حلول وطنية للمسالة الوطنية ويستسهل ما يشير له به الخارج وخصوصا عندما تكون المشورة مرفقة بإغراءات مالية،هذا التشوه للعقل الجمعي هو الذي يفسر كيف أن القوى المتصارعة تُجيز لنفسها التحالف مع قوى خارجية أو التعايش مع دولة الاحتلال فيما هي غير قادرة ولا راغبة بالتحالف أو التعايش مع بعضها البعض.
استمرار وتزايد حالة العداء والقطيعة ما بين الطرفين المتقاتلين في الساحة الفلسطينية يجعل أية تسوية مشرفة مع العدو غير ممكنة وتجعل كل محاولة لتفعيل القرارات الدولية أو تشجيع القوى الخارجية للتدخل للضغط على إسرائيل ضربا من العبث حيث لا تعرف الأطراف الخارجية ماذا يريد الفلسطينيون الرسميون بالضبط ؟ومن هو الطرف الفلسطيني الذي سيتحدث باسم الفلسطينيين ما دامت حماس لا تعترف بمرجعية منظمة التحرير؟ وإن تم الاتفاق مع طرف فلسطيني على شيء مع الإسرائيليين أو غيرهم فلا ضمانات بأن يقبل الطرف الفلسطيني الآخر ما تم الاتفاق عليه؟. هذا لا يعني أن إسرائيل تريد السلام والحالة الفلسطينية هي المعيقة ،بل نريد القول بان الحالة الانقسامية الفلسطينية تمكن إسرائيل من رمي الكرة بالملعب الفلسطيني والتهرب من التزاماتها والزعم بأن الفلسطينيين غير مهيئين للسلام ولا لإدارة دولة وهو قول يجد تفهما في الخارج .
هذه الحالة الانقسامية سياسيا والمعززة بالفصل الجغرافي، لا تخدم فقط المخططات الإسرائيلية فهذا أمر لم يعد محل شك وخصوصا مع تزايد الاستيطان بشكل مريع خلال سنتي الاقتتال الفلسطيني الداخلي ومع تجرؤ إسرائيل على القول علنا وبوضوح لا لتقسيم القدس ولا لعودة اللاجئين ولا لوقف الاستيطان ولا للعودة لحدود 67،ولكنها حالة تولِّد مع الوقت حالة من الإحباط والشك وألا يقين بأي شيء عند الإنسان الفلسطيني،حالة من الشك بثوابته الوطنية وبتاريخه الوطني و النضالي وبإمكانياته الذاتية وهو يرى أن حصيلة ستين عاما من المعاناة وأربعين عاما من النضال المسلح وانتفاضتين وعشرات آلاف الشهداء … مزيد من البؤس وقليل من الكرامة الإنسانية وأخوة سلاح يتصارعون على سلطة وهمية على وطن افتراضي.
كل محاولاتنا لإعمال العقل فيما يجري عسى ولعل أن نجد معقولية لما تمارسه النخبة السياسية،معقولية تقنعنا بأن القوى السياسية ما زالت مؤتمنة على القضية الوطنية وان ما يفعلونه يخدم القضية الوطنية إن لم يكن عاجلا فآجلا،كل هذه المحاولات تذهب هدرا وتؤكد عبثية ما يجري.حتى ما تعتبره النخبة أوراق قوة ومساومة يمكن التلويح بها أمام العدو تنكشف بأنها أوراق من ألا شيء أو سراب يضحكون بها على شعبهم ويضحك عليها وعليهم العدو الذي يطلق لهم العنان ليستمروا في وهمهم بأنهم يملكون أوراق قوة يرتعب منها العدو.هذا لا يعني بأنه لا توجد لدى الشعب أوراق قوة لمواجهة العدو بل لأن النخبة تبحث عند الشعب عن أوراق قوة جزئية لدعم سلطتها وترجيح موقفها كأحزاب حاكمة وقوى نافذة في مواجهة بعضها البعض وليس عن القوة الحقيقية للشعب في مواجهة العدو الخارجي،هذه النخب تستثير عند الشعب وتوظف من الشعب أسوء ما فيه من نزعات وقيم رديئة ومن الأفراد الأسوأ الذين بلا أخلاق وطنية أو ضمير ليكونوا أدواتها في الحرب الأهلية،كما توظف حالة الفقر والجوع والبطالة والترعس الديني عند الشباب ليكونوا وقودا للحرب الأهلية ،قوة الشعب الحقيقية لا يمكن حشدها إلا خلف قيادة وحدة وطنية وفي إطار إستراتيجية عمل وطني.
قد تبدو هذه المقاربة التي تميع للمسؤولية والتي تطلق النار على الجميع و تُحمل المسؤولية لكل الأطراف السياسية … غير عقلانية بحد ذاتها لأنه يجب الانحياز للطرف الصواب الوقوف مع الفريق السياسي الأكثر توافقا وعملا للمصلحة الوطنية أو الأقرب فكريا وأيديولوجيا لما يؤمن به الإنسان لتدعيم مواقفه وتمكينه من الانتصار على الطرف الآخر وأن الحياد هروب من تحمل المسؤولية .الانحياز لحزب أو فريق سياسي على حساب بقية الأحزاب يكون أمرا محمودا عندما نكون أمام تعددية سياسية وحزبية في نظام ديمقراطي حقيقي ،حيث تتوافق كل القوى السياسية أو غالبيتها حول ثوابت وطنية وتختلف في البرامج المتعلقة بالتطبيق أو بالتفاصيل ، ولكن في الحالة الفلسطينية الأمر يختلف ،حيث طرفا المعادلة يختلفان حول الثوابت الوطنية من جانب وحقيقة خطابهم السياسي المعلن وشعاراتهم لا تعبر عن نواياهم الحقيقية وواقع ممارساتهم بالإضافة إلى أن الوضع الصحيح هو وحدة كل قوى العمل السياسي في مواجهة الاحتلال .
الظاهر للعلن وما يعتقد كثير من المراقبين وخصوصا في الخارج اعتمادا على الخطاب السياسي لكل طرف، أن تنظيم حركة فتح الحالي* وما تبقى من منظمة التحرير الفلسطينية و حكومة فياض يمثلون المشروع الوطني وخيار السلام و التسوية السلمية ، وان حركة حماس تمثل تهج المقاومة بما يستتبعه أو يوحى به من رفض الاعتراف بإسرائيل والعمل على تحرير فلسطين عسكريا من البحر إلى النهر ورفض التعايش أو التواصل مع دولة الاحتلال ومن يدعمها ويعترف بها من عجم وعرب الخ –مع أن مستلزمات التهدئة جعلت حركة حماس تستعمل مؤخرا مصطلح الممانعة بدلا من مصطلح المقاومة الذي يثير الشريك في الهدنة- ،ولكن هل بالفعل أن كل طرف يمثل ويجسد بسلوكه على أرض الواقع ما يقول به ويروجه للجمهور؟ هنا تكمن صعوبة الاختيار ومخاطر الانحياز.
ولكن هل أن واقع تنظيم حركة فتح اليوم بجسد الفكرة الوطنية والمشروع الوطني بالفعل ؟هل أن تنظيم حركة فتح اليوم بممارساته وتشرذمه واختراقه من أكثر من جهة خارجية يجسد الهوية والفكرة الوطنية وفكرة السلام العادل وسلام الشجعان الذي تحدث عنه الرئيس أبو عمار؟ هل أن حكومة الدكتور فياض تحمل وتُعبر عن المشروع الوطني ؟.
كل هذه التساؤلات تفرض علينا التمييز بين الفكرة و المبدأ من جانب والممارسة من جانب آخر،ومن هنا تأتي صعوبة الاختيار، كثيرون يؤمنون بالفكرة الوطنية وبالمشروع الوطني وبالسلام ولكن مَن يتحدثون عن هذه الأمور رسميا أو يفترض أنهم يمثلونها بعيدون عنها كثيرا بل يسيئون لها،حيث تمت عملية مصادرة لحركة فتح: الفكرة والمبدأ، من طرف أشخاص وجماعات مصالح وميليشيات مسلحة لا يعملون إلا لصالحهم ولخدمة أجندة وطنيتها مجروحة،والمخلصون لفتح الحقيقية محاصرون ومُبعدون عن الفرار أو قبلوا بإبعاد أنفسهم خوفا من قطع رواتبهم ومصدر رزقهم.وتمت مصادرة فكرة السلام من طرف أشخاص متسلقين وانتهازيين وظفوا فكرة السلام لخدمة مصالحهم حيث أسسوا مع الإسرائيليين ليس شراكة سلام بل شراكة مصالح اقتصادية بحيث باتوا من كبار أصحاب الأموال في الوطن وفي البلاد المجاورة وتمكنوا من شراء ذمم قوى سياسية ومؤسسات مجتمع مدني بل وقطاعات من المجتمع،وبات الرئيس أبو مازن مهندس التسوية ورجل السلام شاهد زور على عملية وأد السلام من طرف هؤلاء ومن طرف إسرائيل وعاجزا عن مواجهة الذين صادروا فكرة السلام .وبالتالي فنحن ننحاز للمشروع الوطني وللسلام ولفتح الفكرة والمبدأ وليس لجماعات تُنسب لحركة فتح ولا لحكومة تسيير الأعمال،ويكون اقترابنا من تنظيم فتح والمنظمة والحكومة بقدر اقترابهم من المشروع والفكرة والمصلحة الوطنية والسلام الحقيقي،فنثمن وندعم ما هو صواب وننقد ما هو خطأ.
في المقابل نجد أن حركة حماس وحكومتها في غزة بدأت اقتحامها للمجال السياسي الفلسطيني بميثاق وبرنامج بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية بكل ما كانت تمثله المنظمة من تحالفات وأيديولوجيا و برنامج سياسي ،فقالت حماس بالجهاد لتحرير كامل فلسطين ورفض التسوية والسلام وقرارات الشرعية الدولية ثم رفضت اتفاقية أوسلو وكل الاتفاقات التي وقعتها المنظمة ثم رفضت المبادرة العربية للسلام ،وحتى التهدئة التي كان يطالب بها الرئيس أبو عمار ثم أبو مازن حتى لا تعيق العمليات الاستشهادية والصواريخ المنطلقة من عزة عملية السلام والمفاوضات الجارية،هذه التهدئة رفضتها حركة حماس وطرحت بالمقابل تصورها للتهدئة حيث قالت بإمكانية عقد هدنة لمدة خمسة عشر ستة مع إسرائيل بعد انسحاب هذه الأخيرة من الضفة والقطاع وعودة اللاجئين وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف،وقد اعتبرت حركة حماس كل ما أقدمت عليه السلطة والمنظمة ضربا من الخيانة الوطنية حتى المشاركة في السلطة وفي الانتخابات الأولى لم تنج من التخوين الخ.
فأين حركة حماس اليوم من منطلقاتها وشعاراتها الأولى؟ ألم تثبت الممارسة الواقعية أنها كانت مقاومة وجهاد من اجل السلطة وليس في سبيل الله والوطن؟ ألا تعني التهدئة الواقعة اليوم وقف المقاومة ؟ ألا تعني التهدئة التخلي عن بقية فلسطين وحق العودة والقدس أو اعتبارها قضايا مؤجلة وهو ما تريده إسرائيل وترفضه السلطة الوطنية؟ ألا بعني حديث حماس عن كونها جزءا من جماعة الإخوان المسلمين تخليها عن المشروع الوطني والهوية الوطنية والثقافة الوطنية؟.قد يقول قائل،وهذا ما تقول به حركة حماس أبضا،بان التآمر على الحركة هو السبب في تقليص أهدافها وفي القبول بالتهدئة،وأن الحركة لم تتخل عن الثوابت بل هي مرحلية وتكتيك ومناورة لحين تغير الظروف والأوضاع الخ.!.ولكن متى كان الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وكل فصائل العمل الوطني غير معرضين للتآمر؟ألم تدمر إسرائيل مؤسسات السلطة واجتاحت الضفة وحاصرت الرئيس أبو عمار ثم اغتالته قبل أن تكون حماس بالسلطة؟ألم تحاصر إسرائيل مناطق السلطة عدة مرات قبل أن تكون حماس جزءا من السلطة؟الم تغتال إسرائيل مقاومين وقيادات من كل الفصائل الفلسطينية دون أن تحترم أو تحسب حسابا لوجود السلطة الوطنية؟ألم تكن حركة حماس متآمرة على حركة فتح والسلطة منذ تأسيس السلطة عندما رفضت المشاركة بانتخابات 96 وبالسلطة ومارست سياسة التخوين والتشكيك بكل ما تمارسه السلطة؟. التآمر الإسرائيلي ليس فقط على حماس وحكومتها بل هو سياسة متأصلة عند الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني وأي حكومة فلسطينية،كما أن التآمر الداخلي جزء من الحياة السياسية لكل دولة ، فلا سياسة تخلو من تآمر وخصوصا عندما يعيب التوافق الوطني وحكومة وحدة وطنية،وعليه لا يجوز تبرير التراجع بالأهداف وقبول ما قبلت به حركة حماس تحت ذريعة العدوان الصهيوني والتآمر السياسي.
إذن، نحن لسنا أمام مفاضلة أو اختيار ما بين تيار وطني واضح وتيار إسلامي عقلاني ،ولا بين نهج سلام وتسوية ونهج مقاومة حتى تحرير كل فلسطين،ولا بين سلطة ومعارضة،ولكننا أمام قوى سياسية تتصارع على سلطة وهمية تحت حراب وسيادة الاحتلال،وكل من هذه القوى تدعي أنها تمثل الشعب والقضية وموظفة الشرعيات الدينية والتاريخية والدولية.لو كان الموضوع هو مفاضلة ما بين الثنائيات المشار إليها لكنا بلا تردد مع المشروع الوطني سواء مثلته حركة فتح أو قوى العمل الوطني أو أية جهة أخرى ولكنا مع المقاومة،لأن المشروع الوطني لا يتعارض مع المقاومة، ولكنا مع السلام،والذين يقولون بالتعارض ما بين المشروع الوطني والمقاومة والسلام وحتى بين المشروع الوطني والتوجه الإسلامي هم أولئك الذين يريدون السلطة ومن اجلها بحثوا عما يميزهم عن الآخرين بالشعارات.
كم يحز بالنفس أن ننّشد بفكرنا وقلمنا و ننشغل وينشغل الكتاب والمفكرون والسياسيون بالحالة السياسية الداخلية فيما العدو يحتل الأرض ويهدد الوجود الوطني،كم يحز بالنفس أن نوجه النقد لأحزاب تمثل الطبقة و القيادة السياسية للشعب الفلسطيني وينظر ويتعامل معها العالم الخارجي على هذا الأساس وخصوصا عندما يقترن اسم هذه الأحزاب بشعارات المقاومة والجهاد والمشروع الوطني الفلسطيني… ولكن هل يمكن القفز على بؤس الحالة السياسية الداخلية التي آلت لاقتتال داخلي وتشويه صورتنا أمام العالم؟ هل يمكن القفز على هذا الواقع المرير أو نتجاهله ونقتصر في حديثنا وكتاباتنا عن الاحتلال وممارساته ؟نعتقد بان النضال بكل أشكاله ضد الاحتلال لا ينفصل عن النضال السياسي والفكري ضد كل أشكال الفوضى والفساد والجهل السياسي عند الطبقة السياسية ،بطبيعة الحال لا يمكن وضع الطرفين في سلة واحدة،فإسرائيل عدو يجوز مواجهته بكل أشكال النضال والمقاومة،فيما الطبقة السياسية الوطنية نواجهها بالحوار وبالكلمة الطيبة وبالنقد البناء وإحراجها إن احتاج الأمر بهدف لفت انتباهها لأخطائها ومحاولة تصويب سلوكها.
لو كانت الحالة هي حالة شعب تحت الاحتلال في مواجهة دولة الاحتلال كما كان الأمر قبل وجود السلطة الوطنية الفلسطينية،ما كان هناك مبررا لتوجيه النقد بنفس الحدة للطبقة السياسية ما دامت هذه الطبقة على رأس حركة تحرر وطني،ولكن اليوم هناك سلطتان وحكومتان لها مشاريع سياسية وتحالفات خارجية وداخلة مع الاحتلال بتفاهمات واتفاقات وتهدئة متعثرة ومثيرة للبس ،هناك سلطة وحكومات وبرامج سياسية ومصالح فئوية تتأسس وتتشكل وتتصارع على السلطة ومكاسبها وفي نفس الوقت تتفاوض وتساوم على حقوقنا الوطنية ومستقبل شعبنا،في هذه الحالة من حق كل مواطن أن يكون له موقف وان ينتقد ما يراه مسيئا للوطن ومن حق بل وواجب على كل صاحب فكر ورأي أن يتسامى عن الانتماءات الحزبية الضيقة ما دام المجتمع في حالة فتنة.
عندما يكون شعب تحت الاحتلال لا يمكنه مواجهة الاحتلال إلا بمشروع وطني بما تعنيه كلمة وطن من هوية وطنية وثقافة وطنية ودولة وطنية،كل الهويات والأيديولوجيات الأخرى يجب أن يتم توطينها، بمعنى إخضاعها للكل الوطني،في مواجهة الاحتلال لا مجال لإعمال الصراع الطبقي أو الديني أو تسبيق هذه الصراعات على الصراع مع العدو،الصراعات الطبقية والمذهبية أو الدينية قد يكون لها محل في المجتمعات المستقلة غير المهددة بوجودها الوطني،أما في الحالة الفلسطينية فإن هذه الصراعات تهدد الوحدة الوطنية وتربط القضية الوطنية بقضايا ومشاريع خارجية،وقد رأينا ما آلت إليه القضية الوطنية عندما دخلت حركة حماس النظام السياسي دون أن تكون مستعدة لتصبح جزءا من المشروع الوطني،فكان الاقتتال الداخلي والفتنة ورهن القضية الوطنية لمعادلات خارجية ستجلب وصاية على الشعب الفلسطيني قد تكون أسوء من الاحتلال.
خلاصة
لم تتعرض القضية الفلسطينية لخطر وجودي كما هو حالها اليوم ،فما يجرى يتجاوز كونه خلافا سياسيا أو صراعا على السلطة ،إنه منعطف سيحدد إما أن نكون كشعب وهوية ووطن وإما أن نُشطب من الخارطة السياسية الإقليمية والدولية،ولذا نتمنى أن تُحكم الطبقة السياسية الفلسطينية العقل في نهجها السياسي سواء داخليا أو خارجيا،وان تخرج النظام السياسي من عبثيته المدمرة، عبثية وتخبط المفاوضات والتسوية ،عبثية وتخبط المقاومة، عبثية وتخبط عمل مؤسسات المجتمع المدني،عبثية وتخبط علاقاتنا الخارجية،لم يعد اليوم شيئا في مناطق السلطة وفي السياسة الفلسطينية يخضع لعقل أو منطق ،إلا منطق المصالح والايدولوجيا والحسابات الضيقة للسلطة,فكيف يمكن لنخبة سياسية تعادي العقل وتسير حسب أهواء الساسة والأحزاب أن تنتصر على عدو خارجي أو تقنع العالم الخارجي بعدالة القضية التي تزعم أنها تدافع عنها؟.وفي نفس الوقت نتمنى من المثقفين والمفكرين الفلسطينيين ألا يمارسوا سياسية الهروب من الذات الوطنية محو إيديولوجيات قومية أم دينية أم إنسانية،ليس رفضا لهذه الأيديولوجيات ولكن خوفا على الوطن والهوية الوطنية،ما يتعرض له الوجود الوطني يتطلب توطين كل الإيديولوجيات أو خلق مصالحة بينها وبين الوطني وليس تغييب الوطني لمصلحة هذه الإيديولوجيات والانتماءات .