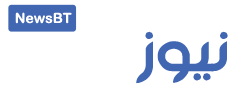الثورة في العالم العربي
كنتاج لفشل الديمقراطية الأبوية والموجهة
مقدمة
كسريان النار في الهشيم سيطر خطاب الثورة على الخطاب والعقل السياسي العربي مغيبا كل الخطابات الأخرى حتى الخطاب الإسلامي ،خلال شهر واحد اهتزت عروش الملوك وعروش الرؤساء العرب– في العالم العربي زالت الفوارق بين الملك والرئيس – نتيجة الثورتان المجيدتان في تونس ومصر. لا شك أن خطاب الثورة كان من المفردات السياسية التي ملأت فضاء الخطاب السياسي العربي و دول العالم الثالث خلال العقود الثلاثة الموالية للاستقلال بل و قبل الاستقلال حيث كانت تطلق على حركة الشعوب في مواجهة الاحتلال لأن كل حركة تحرر وطني تعتبر ثورة ،إلا أن مفردة الثورة أخرجت من ماهيتها ومن دلالتها اللغوية والاصطلاحية العلمية بحيث أخذت معان سسيولوجية وسياسية تبشيرية حينا وشعارا يوظفه كل شخص أو حزب يطمح بالسلطة أو قادر على تهييج الجماهير حينا آخر، أيضا تداخل مفهوم الثورة مع الانقلاب العسكري و مع الحرب الأهلية والفوضى والاحتجاجات والانتفاضات الشعبية المطلبية الخ .
لم يشهد العالم العربي ما بعد الاستقلال – باستثناء الحالة الفلسطينية – حراكا شعبيا واسعا لدرجة يجوز فيها توصيفه بالثورة الشعبية إلا ما جرى في تونس ومصر في يناير 2011 . فبعد شهر من خروج الجماهير التونسية للشارع في مواجهة نظام فاسد ودكتاتوري هرب الرئيس زين العابدين بن علي من البلاد وسقطت الحكومة وبدأت تونس عهدا جديدا من الإصلاحات ،وفي مصر التي شهدت إرهاصات الثورة والتمرد على النظام القائم منذ سنوات وتزايدت بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة التي اعتبرتها المعارضة نهاية المراهنة على التغيير من خلال النظام القائم ،خرجت الجماهير المصرية في كافة محافظات الجمهورية بمظاهرات تطالب برحيل الرئيس حسني مبارك وهو ما جرى يوم الحادي عشر من فبراير حيث تنحى الرئيس واستلم الجيش مسؤولية إدارة البلاد.الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للاجتهادات والتفسيرات،فهل ما جرى في تونس ومصر ثورة أنجزت أهدافها؟ هل ما جرى يعبر عن أزمة دولة ؟أم أزمة نظام سياسي؟أم أزمة ديمقراطية ؟ هل اختمرت شروط الثورة في العالم العربي ؟ وهل بمجرد خروج الناس للشارع وهروب الرئيس أو تخليه عن السلطة يمكن القول بأن الثورة حققت أهدافها؟ وهل تتشابه الحالة التونسية مع الحالة المصرية من حيث الأسباب والتداعيات؟.
ما جرى في تونس ومصر وما يجري من أحداث وتطورات في ليبيا والبحرين واليمن وسوريا ،يحتاج لقراءة موضوعية وعقلانية بعيدا عن العواطف والانفعالات لأن الآتي من الأحداث هو الأهم والأصعب وبه ستكتمل الصورة بحيث يمكننا أن نتحدث عن ثورة شعبية ناجحة أو عن شيء آخر.الأمر الذي يستدعي أيضا استقراء ما يجري انطلاقا من فقه الثورة الذي تراكم عبر التاريخ ومن تجارب الشعوب الأخرى ونضع ما جرى في سياق التحولات التي شهدها العالم العربي خلال العقود الثلاثة الماضية وخصوصا محاولة الأنظمة التحايل على فقدان شرعيتها من خلال تبني أشكالا من الديمقراطية الأبوية والموجهة تغرر بها الجماهير.
الفصل الأول
في فقه الثورة
أولا :مقاربة مفاهيمية لمصطلح الثورة
الثورة (Revolution ) من المصطلحات المخضرمة التي واكبت ظهور الدولة والحياة السياسية منذ ما قبل التاريخ،ومع أن مفهوم الثورة الذي ساد على غيره من المفاهيم هو ثورة الشعب ضد الاستعمار أو ضد أنظمة استبدادية ،إلا أن مفردة الثورة لغة لا تقتصر على هذا الجانب بل تشمل كل فعل يؤدي إلى تغيير الأوضاع تغييرا جذريا سواء كانت أوضاعا طبيعية أو سياسية او اقتصادية أو اجتماعية .ومن هنا تستعمل كلمة ثورة في سياقات مختلفة كالقول بالثورة الصناعية أو الثورة التكنولوجية الخ لوصف التغييرات الجوهرية التي تطرأ على حياة الشعوب وعلى الحضارة الإنسانية ،وفي هذا السياق العام يمكن الحديث عن أشكال متعددة من الثورات .
1- الثورات الحضارية
ونقصد بها التغييرات أو التحولات التي طرأت على الحياة الإنسانية وعلى مسار تطور البشرية وفي هذا السياق يمكن الحديث عن :
أ – الثورة الزراعية Agricultural revolution ،والمقصود بها التحولات التي حصلت في عصور ما قبل التاريخ، وتميزت بانتقال المجتمعات البشرية من حياة الترحال والصيد والالتقاط، التي سادت في العصر الحجري القديم إلى حياة الاستقرار مع اكتشاف الزراعة بالمحراث وتدجين الحيوانات التي ميزت العصر الحجري الحديث. فمع اكتشاف الزراعة وجدت الأسواق والطبقات الاجتماعية والمدن والإدارة الخ .
ب – الثورة الصناعية revolution Industrial
بدأت الثورة الصناعية في إنجلترا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر ثم انتقلت إلى بقية الدول الأوروبية ومن ثم إلى جميع أنحاء العالم .وسميت بالثورة الصناعية لان الإنسان بدا التخلي عن الآلات اليدوية التي تعتمد على قوته العضلية و يعتمد بدلا منها على الآلات البخارية ثم الكهرباء وتوظيف المواد الكيماوية وتطوير استعمال المعادن بكل أشكالها وأساليب التعدين.
ج – الثورة التكنولوجية Technological revolution
وتسمى أيضا الثورة الصناعية الثانية حيث تتداخل هذه الثورة مع الثورة الصناعية وتشكل امتدادا لها ويعتبرها البعض الموجة الثانية للثورة الصناعية واهم معالمها التوسع والتطور العلمي وخصوصا في مجال الصناعات الدقيقة المعتمدة على الطاقة الكهربائية والمحركات ذات الاحتراق الداخلي والمواد الكيميائية المستحدثة ، وتكنولوجيا الاتصال الأولى كنظم التلغراف والهاتف والبريد .
د – ثورة المعلوماتية Information revolution
ظهر هذا المصطلح في العقود الثلاثة الأخيرة متزامنا مع الحديث عن العولمة والتنمية الشمولية .والثورة المعلوماتية تعتمد على عالم تكنولوجيا المعلومات حيث المادة الأولية لتطور المجتمعات لم تعد الأرض الزراعية ولا المصانع ورؤوس الأموال بل المعلومة وسرعة تداولها عبر شبكات الاتصال بعيدة المدى كالانترنت والفضائيات وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة .وقد مكنت هذه الثورة الإنسان من سلع وخدمات معلوماتية لم تكن موجودة من قبل مما وسم مجتمع هذه الثورة بمجتمع المعرفة .
2 – الثورات السياسية /الاجتماعية
وهي تحرك الجماهير الحاشدة احتجاجا على أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية سيئة ومرفوضة ،وتتسم هذه الثورات بأنها تسعى لإحداث تحولات جذرية في حياة الشعوب وبعض هذه الثورات تحقق أهدافها وبعضها يفشل وأخرى يتم حرفها عن مسارها.عرفت البشرية كثيرا من هذه الثورات ،فقد تحدثت مخطوطات فرعونية وبابلية ويونانية قديمة عن ثورة اندلعت في تلك العصور وتم تدوين بعضها بالتفصيل ،ففي مصر القديمة تذكر بردية للحكيم ايبو – ور ترجع إلي أواخر الأسرة التاسعة عشر أو أوائل الأسرة العشرين أن ثورة وقعت في عهد الملك بيبي الثاني آخر ملوك الأسرة السادسة نحو 2380 ق.م وتبدأ هذه البردية بوصف الوضع قبل الثورة :حيث ساد الفساد وتباعدت الشقة بين الملك والشعب بسبب فساد المحيطين بالملك حيث إن “” الذين حوله كانوا يغذونه بالأكاذيب “” وصار الناس أشبه بقطيع لا راعي له ، وتضيف البردية ما آلت إليه أحوال الناس من ترد بسبب فساد الوضع ، حيث “” نفذت الغلال في كل مكان ، وتجرد القوم من الملابس والزيوت والعطور 000 وأصبح الصناع جميعا عاطلين وأفسد أعداء البلاد فنونها 000 وأصبح بناة الأهرام فلاحين 000 وأصبحت العاصمة في خوف من العوز ، وأصبح الناس يأكلون الحشائش ويبتلعون الماء ، وقد يأخذون الطعام من أفواه الخنازير 000 “”
وتنتقل بردية الحكيم إيبو – ور إلي وصف أحداث الثورة ، ” انظر لقد ارتفعت ألسنة اللهب ، وامتدت نارها ، وستكون حربا علي أعداء البلاد ، وقال حراس الأبواب فلننطلق وننهب ، وأبى الحمالون أن يحملوا أحمالهم وتسلح صيادو الطيور بأسلحتهم 000إن مخازن الملك أصبحت حقا مباحا للجميع 000 هوجمت الإدارات العامة ونهبت قوائمها 000 وفي الحق لقد ذُبح الموظفون وسُلبت دفاترهم ، ولم تعد لكبار الموظفين كلمة مسموعة “. .
شهدت غالبية المجتمعات عبر التاريخ تحركات شعبية واسعة إلا أنها تفاوتت سواء في الحوامل الاجتماعية للثورة أو من حيث درجة العنف المصاحبة للثورة أو من حيث نتائجها وقدرتها على تحقيق أهدافها ،كثير من التحركات الشعبية التي نعتها أصحابها بالثورة إما كانت محدودة الأهداف أو فشلت في تحقيق أهدافها وبعضها كان أقرب لحالات الفتنة والفوضى مما هي ثورة .دون التقليل من أهمية أي تحرك أو انتفاضة شعبية ودون الغوص بالجدل حول توصيف الحركات السياسية في التاريخ الإسلامي فإن أهم الثورات الناجحة ما بعد الحروب الدينية التي شهدنها أوروبا هي:-
أ- الثورة البريطانية 1688 وقامت ضد حكم آل ستيورت
ب- الثورة الأمريكية 1776 -1783 وهي ثورة اجتماعية وتحررية في نفس الوقت
ت- الثورة الفرنسية 1789-1799
ث- الثورة الإيطالية 1884
ج- الثورة البلشفية 1917في روسيا ضد الحكم القيصري
ح- الثورة الصينية بقيادة ماو تسي تونغ 1949 التي أطاحت بنظام شيانغ كاي شيك
خ- ثورة يوليو 1952 في مصر مع أن جدلا ثار وما زال إن كانت ثورة أم انقلاب عسكري
د- الثورة الكوبية 1959 التي قادها فيدل كاسترو ضد حكم الدكتاتور باتستا .
ذ- الثورة الإيرانية الخمينية 1979 التي أسقطت الشاه محمد رضا بهلوي
ر- ثورات شعوب أوروبا الشرقية بدءا من عام 1989 التي أطاحت بالأنظمة الشيوعية
ز- الثورة البرتقالية في أوكرانيا 2004
3: ثورات التحرر الوطني
والمقصود بها ثورة الشعب الخاضع للاحتلال ضد الجيوش المحتلة .في هذا النوع من الثورات يكون الفعل الشعبي موجها ضد عدو خارجي يهدد الأمة ،ومع أن هذا المصطلح حديث التداول إلا أن الفعل الموصوف كان حاضرا منذ القدم وكما بينا سابقا عرفت غالبية الشعوب حالات مناهضة لعدو خارجي.ظهر هذا المصطلح مع الحرب العالمية الأولى مع تفكك الإمبراطوريات وظهور مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ثم انتشر مع تبني الأمم المتحدة لمبدأ تصفية الاستعمار بعد الحرب العالمية الثانية وقد تم إطلاق صفة الثورة على كل حركة تحرر ضد الاستعمار .
شهدت أسيا وأفريقيا وأمريكا ألاتينية سلسلة من الثورات التحررية وإن كان أشهرها ثورة الشعب الجنوب أفريقي والثورة الجزائرية والثورة الفيتنامية والثورة الفلسطينية التي ما زالت متواصلة حتى اليوم إلا أن لكل شعب ثورته الخاصة به ،ففي الهند قامت ثورة سلمية قادها الماهاتما غاندي ضد الاحتلال البريطاني وامتدت من عام 1915 حتى اغتياله من طرف هندوس متطرفين في يناير 1948، كما قاد عمر المختار ثورة الشعب الليبي ضد الاحتلال الإيطالي من عام 1911 إلى حين إعدامه يوم 16 سبتمبر 1931،و في المغرب قامت ثورة عبد الكريم الخطابي الذي قاد عام 1921 ثورة في مناطق الشمال ضد الأسبان وانتصر على الأسبان في معركة أنوال وأقام جمهورية سميت بجمهورية الريف ،إلا أن الأسبان والفرنسيين تحالفوا ضده وانهوا الثورة، وقام الفرنسيون بنفي الخطابي إلى إحدى الجزر النائية في المحيط الهادي عام 1926 .وفي فلسطين قامت ثورة عز الدين القسام 1935 ثم الثورة الكبرى 1936 ،وفي مصر عُرفت ثورة أحمد عرابي 1881 وثورة مصطفى كامل 1889و ثورة سعد زغلول 1919 الخ .
ثانيا :مفهوم الثورة في الفكر الإسلامي
بالرغم من عالمية فكر الثورة من حيث كونها ظاهرة إنسانية سياسية و اجتماعية ،ومع أن الشعوب العربية تلتقي مع بقية الشعوب وخصوصا في دول العالم الثالث من حيث الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية الدافع الأساس للثورة ،إلا أن للحالة العربية خصوصية تجلت في السنوات الأخيرة وهي المد الأصولي بما يتضمن من تصورات للأوضاع القائمة وسبل الخروج عليها ،وهي تصورات مستمدة من مفاهيم دينية إسلامية.فمفهوم شرعية الحكم والحاكم ، مبررات وشرعية الثورة على النظام القائم ،تحديد معسكر الأصدقاء ومعسكر الأعداء ،سبل أو وسائل الثورة على الحاكم ،مستقبل النظام الذي يُراد تأسيسه بعد الثورة على الحاكم ،الخ ،كل هذه أمور لا تستمد من علم السياسة الوضعي ولا حتى من التجارب الثورية لشعوب العالم، بل من مرجعية النص المقدس – قرآن وسنة – ومن أقول الفقهاء ورجال الدين عبر التاريخ .
في تفسير وتحليل الثورة في الفكر والواقع الإسلامي يتداخل الدين مع السياسة كما يتداخل الماضي مع الحاضر ،وكما اختلف العلماء والجماعات الدينية في تفسير وتأويل كثير من النصوص المقدسة وخصوصا ذات العلاقة بالسلطة والسياسة وحكم البشر،فقد تباينت الرؤى والمواقف من الثورة منذ بداية ظهور الإسلام حتى اليوم ،مع الإشارة إلى تراجع مصطلح الثورة ليحل محله ويستوعبه مصطلح الجهاد والذي هو محل اختلاف بين العلماء والجماعات الإسلامية .ولذا سنحاول العودة لمعنى كلمة الثورة ومشتقاتها كما وردت في القرآن الكريم ثم في رؤية العلماء المسلمين ومن خلال التاريخ الإسلامي.
كلمة الثورة في الاصطلاح العربي الإسلامي تعني التغيير الشامل والجذري الذي يطرأ على الظواهر الطبيعية أو الإنسانية .وحسب هذا المعنى للثورة فإن الديانات السماوية ثورات ولكن موحى بها سماويا، إنها ثورات شاملة لا تقتصر على تغيير النظام السياسي بل تغيير منهج حياة الناس وتغيير طبيعة العلاقات التي تحكم البشر بعضهم ببعض.ولكن كلمة الثورة في القرآن لم ترد بالمعنى السياسي والاجتماعي المتداول اليوم بل وردت بمعنى الانقلاب في الأوضاع أو في الواقع القائم ،فثورة الأرض وتثويرها يعني قلبها بالحرث،فبقرة بني إسرائيل كانت لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ (البقرة:71) أي لا تقلبها بالحرث، أيضا جاء بالقرآن الكريم ، ومن الأمم السابقة من كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا (الروم:9) أي قلبوها، وبلغوا عمقها.كما ترد مشتقات كلمة الثورة بمعنى الانتشار والهيجان .
وفي الأحاديث النبوية وردت كلمة الثورة بما هو قريب من معناها السياسي المتداول اليوم ،ففي حديث شريف رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد و ترويه السيدة عائشة، رضي الله عنها، حول هياج الأوس والخزرج حيث تقول : “فثار الحيان، الأوس والخزرج، حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا وسكت” .وفي الحديث الذي يرويه مرة البهزي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم متنبئاً بفتنه عهد عثمان بن عفان: “كيف في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي – (قرون) –بقر” –رواه الإمام أحمد.
وفي التاريخ الإسلامي استخدمت أدبيات الفكر الإسلامي مصطلح الثورة بدلالتها المتعارف عليه اليوم ، فحركة عبد الله أبن الزبير في مكة سماها نافع بن الأزرق زعيم الخوارج بالثورة ودعا أصحابه بان يهبوا لنصرتها والدفاع عن بيت الله الحرام ،فيخاطبهم قائلا ::”.. وهذا، من قد ثار بمكة، فأخرجوا بنا نأت البيت ونلق هذا الرجل” الثائر”.
بالإضافة لمصطلح الثورة شاع عند المسلمين مصطلحات قريبة من مصطلح الثورة أو تصف أحداثا قريبة من الثورة منها : الفتنة ، الملحمة ، الخروج ،القومة ،وهذا المصطلح الأخير شاع استعماله عند جماعة العدل والإحسان المغربية حيث كتب شيخهم عبد السلام ياسين كتبا متعددة بهذا الشأن فارقا ما بين الثورة عند العلمانيين والقومة حسب النهج النبوي حيث يقول : إن ـ” ثورة كلمة استعملت لوصف الحركات الاجتماعية الجاهلية، فنريد أن نتميز في التعبير ليكون جهادنا نسجا على منوالنا النبوي، لا نتلوث بتقليد الكافر. على أن القومة نريدها جذرية تنقلنا من بناء الفتنة ونظامها، وأجواء الجاهلية ونطاقها، إلى مكان الأمن والقوة في ظل الإسلام، وإلى مكانة العزة بالله ورسوله، ولابد لهذا من هدم ما فسد هدما لا يظلم ولا يحيف، هدما بشريعة الله، لا عنفا أعمى على الإنسان كالعنف المعهود عندهم في ثوراتهم.
كما يستعمل بعض علماء المسلمين وجماعات إسلامية مصطلح”النهوض” و “والنهضة” ومصطلح “القيام” للدلالة على الخروج والثورة. .. لما فيهما من معنى الوثوب والانقضاض والصراع.كذلك استخدم القرآن الكريم، للدلالة على معنى الثورة، مصطلح “الانتصار”.. فالانتصار: هو الانتصاف من الظلم وأهله، والانتقام منهم. .. وهو فعل يأتيه “الأنصار” –الثوار- ضد “البغي” الذي هو الظلم والفساد والاستطالة ومجاوزة الحدود.
في السنوات الأخيرة تراجعت كل المصطلحات السابقة تقريبا لصالح مصطلح واحد ووحيد وممارسة واحدة ووحيدة تسمى الجهاد.ففي ظل حالة المد الديني الأصولي فإن كل من يريد محاربة قوى خارجية |أو يتمرد على حاكم وحكومة أو يواجه عدوا يختلف معه في الرؤية والمصالح الخ بات يلجا لاستعمال مصطلح الجهاد والممارسة الجهادية التي اختزلت بالعنف المسلح ،وهذا بطبيعة الحال بعد تكفير الطرف الآخر وإخراجه من امة الإسلام .حركة طالبان تجاهد ضد نظام كابول وضد القوات الغازية ،وتنظيم القاعدة يجاهد ضد أنظمة عربية وإسلامية يتهمها بالكافرة ،وحركة حماس تجاهد ضد الاحتلال الصهيوني وأحيانا تدعو للجهاد ضد السلطة الفلسطينية في رام الله،لقد حل مصطلح الجهاد محل كل المصطلحات السابقة ،ولكن ضمن حالة من عدم الاتفاق على مفهوم الجهاد ومن يجاهد وضد من ؟الخ .
نعتقد أن المشكلة في الفكر الإسلامي المتعامل مع الموضوع لا تكمن باللغة والمفردة إن كانت ثورة أم خروجا أم قومة ام جهادا، ،بل في مدى شرعية خروج المسلمين على الحاكم الجائر ،وفي من له الحق بالثورة أو الخروج ،هذا بالإضافة إلى اختلاف المسلمين في الحالة التي يمكنها وصفها بالجائرة او الظالمة وبالتالي يجوز الثورة او الخروج عليها .فمنذ بدايات الإسلام وحتى اليوم والمسلمون مختلفون حول هذه القضايا حيث شهد التاريخ الإسلامي كثيرا من الثورات وحالات الخروج على الإمام أو الحاكم، الفتنة الكبرى في عهد علي بن أبي طالب ،ثورة الخوارج ،ثورة الحسين ،ثورة الزبير،وثورة الزنج ،ثورة القرامطة الخ ،وكان كل طرف يكفر الطرف الآخر مما كان يؤدي لاقتتال بل ومجازر بشعة أساءت كثيرا للمسلمين وتاريخهم .
أختلف العلماء المسلمين حول مشروعية الثورة،،فمع اتفاقهم على رفض نظم الجور والضعف والفساد إلا انهم اختلفوا حول استخدام العنف – السيف –في تغيير هذه الأنظمة.وقد تم طرح الموضوع لأول مرة مع ثورة الخوارج الذين برروا وشرعنوا ثورتهم على الأمويين لأنهم رأوا أن الأمويين خرجوا على فلسفة الشورى .في نفس السياق ذهب المعتزلة ولكنهم اشترطوا (التمكين ) قبل القيام بالثورة حتى لا تؤدي هذه الأخيرة لحالة من الفوضى أو الفتنة ،كما اشترطوا وجود الإمام الثائر وان يوجد بديل جاهز ليحل محل النظام الجائر بعد الثورة .
في مقابل وجهة النظر المؤيدة للثورة وجدت وجهة نظر رافضة أو متحفظة على فعل الثورة ،عبر عنها الإمامين أبن حنبل وابن تيمية .فأحمد بن حنبل (164 – 241هـ – 780 – 855م) – و أهل الحديث فقد رفضوا سبيل الثورة، لأنهم رجحوا إيجابيات النظام الجائر على سلبيات الثورة.. فقالوا: “إن السيف – العنف – باطل، ولو قتلت الرجال، وسبيت الذرية، وأن الإمام قد يكون عادلاً ويكون غير عادل، وليس لنا إزالته وإن كان فاسقاً..” ومن أقوال ابن تيمية:”..فستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان”.أما الإمام الغزالي (450 – 505هـ – 1058 – 1111م)- من الأشعرية – فوقف موقف الموازنة . فقال عن الحاكم الجائر: “والذي نراه ونقطع به: أنه يجب خلعه إن قدر على أن يستبدل عنه، من هو موصوف بجميع الشروط، من غير إثارة فتنة ولا تهيج قتال. فإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتال، وجبت طاعته وحكم بإمامته.. لأن السلطان الظالم الجاهل، متى ساعدته الشوكة، وعسر خلعه، وكان في الاستبدال به فتنة ثائرة لا تطاق، وجب تركه، ووجبت الطاعة له..”.
ثالثا :الثورة نقطة تحول في تاريخ الشعوب
ما يعنيا في هذا البحث هو النوع الثاني من الثورات أي الثورات السياسية والاجتماعية ،ثورة الشعب ضد نظام الحكم ونخبة لتغيير الأوضاع الداخلية،ومع كامل إدراكنا بتداخل الثورة السياسية الاجتماعية مع الثورة التحررية وخصوصا في العالم الثالث حيث التداخل والترابط ما بين النخب الحاكمة والقوى الكبرى في العالم المعنية بالحفاظ على انظمة تابعة لها وخادمة لمصالحها ،إلا أن التحركات الشعبية الواسعة التي تأخذ شكل ثورة، لها قوانينه الخاصة وسيرورتها التي تميزها عن أشكال الثورات المشار إليها أعلاه ،وخصوصا بعد انتهاء زمن الاستعمار المباشر في كل العالم تقريبا – ما عدا فلسطين والعراق – .
مناط الحكم على التحرك الشعبي إن كان ثورة أم لا ليس فقط كثرة عدد المواطنين المشاركين به فقط ولا الشعارات المرفوعة فقط بل قدرة الثوار على إحداث التغيير المنشود حسب ثقافة ورؤية الشعب المعني بالأمر .كل الثورات السياسية /الاجتماعية المشار إليها استمدت أهميتها من قدرتها على التغيير الواسع في كل بنيات المجتمع ،ففرنسا بعد الثورة ليست فرنسا قبلها،وروسيا بعد الثورة ليست روسيا قبلها وفيتنام بعد الثورة ليست فيتنام قبلها الخ.أيضا فإن الثورة ليست مجرد تغيير رأس النظام السياسي كأن يكون هدف الثوار الإطاحة بالنظام الملكي وتحويله إلى نظام جمهوري،فكثير من الأنظمة الجمهورية أكثر سوءا من الأنظمة الملكية .
الأشكال أو الأنماط السابقة لا تستوعب كل الحالات الثورية التي عرفتها الشعوب،فثقافة وقيم كل شعب وأحيانا الأوضاع الدولية تلعب دورا في وصف التحرك الشعبي نحو التغيير بالثورة أو بالانتفاضة أو إطلاق تسميات أخرى عليه.فمثلا تباينت المواقف من الثورة العربية الكبرى 1915فيما إن كانت ثورة عربية أم تمردا على الخلافة العثمانية ونفس النقاش ثار وما زال حول ما عرفته بلاد الشيشان والبوسنة كردستان وجنوب السودان وجنوب اليمن وحركة طالبان وتنظيم القاعدة ،فهل هذه ثورات تحرر قومي؟ أو حركات تمردية انفصالية ؟ام حركات إرهابية ؟ أم حركات دينية جهادية؟ .ولننظر كيف تغيرات المفاهيم والقيم، فبعد أن كان المعسكر الاشتراكي رمز الثورة العالمية باتت كل حركة مناوئة له او تعمل لتحطيمه تعتبر ثورة حسب مفاهيم العصر وما الحدود الفاصلة بين هذه التصنيفات ؟ هل تحرك الجماهير في الاتحاد السوفيتي ولأوروبا الشرقية ضد الأنظمة (الشيوعية) التي كانت عنوان الثورة العالمية تعتبر ثورة ضد الثورة ؟.أين يمكن وضع الأحداث التي شهدتها البرتغال واليونان عام 1974 ،هل تعتبر ثورات ديمقراطية أم انقلابات عسكرية ؟ هل كان فرانكو في أسبانيا قائد ثورة أم انقلابي استبدادي؟.
نخلص مما سبق أن الثورة فعل جماهيري شامل، فحين تتأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتصبح أحوال الناس لا تطاق، وعندما تتباعد الشقة ما بين الحكام والجماهير وتغيب وسائل التعبير السلمي عن المطالب، لا تجد الجماهير أمامها إلا التحرك لتغيير الأوضاع تغييرا جذريا.أحيانا تُقاد الثورة من طرف حزب جماهيري أو قيادة تؤمن بالتغيير فتلهب حماس الناس وتحرضهم ضد الوضع القائم، وإذا ما كان الحزب أو القيادة المؤججة للثورة والمحرضة عليها تتبنى أيدلوجية ما – كالاشتراكية أو الشيوعية أو القومية أو الدينية -تنطبع الثورة بهذه الأيديولوجية فيقال ثورة اشتراكية أو شيوعية أو دينية أو قومية الخ.وحينا آخر تنطلق بشكل عفوي دون قيادة حزبية كما هو الحال مع الثورة التونسية الراهنة ،ولكن بعد انتشار الثورة وظهور مؤشرات انهيار النظام القديم تحاول الأحزاب حصد مكتسبات الثورة والزعم بمسؤوليتها عن اندلاعها .
سواء كانت ثورات دينية أو طبقية أو سياسية أو اقتصادية أو جمعا لها فإن الثورة تعتبر نقطة تحول في حياة الشعوب، تحول اجتماعي وسياسي واقتصادي، وبديهي أن يكون هدف الثورة تحقيق التحول إلى الأفضل لأن الثورة تعمل على الإطاحة بمن تعتبره الجماهير مسئولا عن بؤسها سواء كان ملكا أو رئيسا و كذا بالنخبة المحيطة به وبمرتكزات النظام السياسي، وإقامة نظاما بديلا يأخذ بعين الاعتبار المطالب الشعبية.وغالبا ما تصاحب الثورة بالعنف، فهي عمل عنيف ولكن تتفاوت درجات العنف ما بين التهديد اللفظي بالقتل والاغتيال والاعتقال والقيام بالمظاهرات والمسيرات الحاشدة أو اللجوء إلى العمل العسكري. فبعض الثورات تكون سلمية ولا يراق بها الدم فتنعت بأسماء دالة على ذلك كالقول بالثورة البرتقالية أو الثورة القرنفلية ،وثورات أخرى اتسمت بالدموية كالثورة الفرنسية التي أزهقت الآلاف من معارضيها ثم ارتددت على ذاتها ليقتل الثوار بعضهم بعضا حتى قيل بأنها أصبحت كالهرة التي تأكل أولادها،و أحيانا تستمر الثورة لعدة سنوات وتعجز في النهاية عن تحقيق أهدافها وتتحول إلى حرب أهلية.
رابعا : الثورة ليست انقلابا عسكريا ولا هيجانا شعبيا
تختلف الثورة عن الانقلاب العسكري، فهذا الأخير هو تحرك فوقي لنخبة عسكرية تكون متواطئة أحيانا مع بعض رموز السلطة لتغيير الحكومة أو النظام القائم، وبالتالي لا تشارك الجماهير بهذا الانقلاب وفي كثير من الأحيان لا تعلم الجماهير بالانقلاب إلا بعد وقوعه، ولكن كثيرا من الانقلابيين وخصوصا في العالم العربي يضفون طابع الثورة على انقلابهم العسكري لمنح تحركهم شرعية شعبية، وهذا ما يحدث في البلاد العربية ودول الجنوب،حيث يقتصر التغيير في حالة الانقلاب على تغيير الأشخاص والنخب الحاكمة دون أن تتغير أحوال الناس بل أحيانا تزداد أوضاع الشعب سوءا عندما يتحول الانقلابيون إلى أسياد مستبدين جدد. ويمكن القول بان ما عرفته غالبية الدول العربية ما بعد الاستقلال من تغيير لأنظمة الحكم كان يدرج ضمن الانقلابات العسكرية وليس الثورات، سواء تعلق الأمر بسوريا أو العراق أو ليبيا أو اليمن أو السودان حتى ثورة يوليو 52 في مصر صنفها البعض بالانقلاب العسكري.
وعليه يمكن القول بان مجرد تغيير رأس النظام لا يعني حدوث ثورة ،فهذه الأخيرة لا تكتمل ولا تأخذ معناها الحقيقي إلا إذا حققت الأهداف التي قامت من اجلها.أيضا الثورة ليست مجرد خروج الناس للشارع لتهتف وترفع الشعارات أو تخرب وتدمر مؤسسات السلطة ،الثورة عملية مركبة ومتعددة الأبعاد خروج الناس للشارع أحد شروطها أو فتيل اشتعالها ولكنه بحد ذاته ليس الثورة . ومن هنا كل الثورات تمر بمرحلتين: الأولى هي مرحلة الهدم حيث يتم إسقاط النظام القائم، وهذه مرحلة تنجح بها كل الثورات تقريبا، والمرحلة الثانية هي بناء نظام وأوضاع جديدة تتوافق مع الأهداف المُسطرة للثورة ومع الوعود التي قدمها الثوار للشعب، هذه المرحلة الثانية هي الأكثر صعوبة وفي كثير من الأحيان تتعثر الثورة في بناء أوضاع جديدة أفضل من سابقتها، حيث يجلس الثوار على أنقاض ما هدموه ويتحولون إلى مستبدين جدد مع استمرارهم بالتغني بشعارات الثورة فيما الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تزداد سوءا، مما يثير حنق الجماهير المتطلعة للتغيير، فتتلبد غيوم ثورة على (الثورة) ويبدأ الناس بالاحتجاج والخروج للشارع فيواجههم قادة النظام (الثورة ) بقمع أشد فتكا من قمع الأنظمة السابقة ،حيث صفة الثورة التي يسمون أنفسهم بها تعطيهم الحق من وجهة نظرهم لاتهام معارضيهم بأنهم أعداء الشعب وأعداء الثورة وعملاء للاستعمار الخ .
ما بين سقوط النظام القديم وقيام النظام الجديد توجد مرحلة انتقالية تعتبر المحك للحكم على نجاح الثورة في مرحلتها الأولى وقدرتها على الانتقال السلس والسلمي للمرحلة الثانية ،مرحلة بناء الجديد،في المرحلة الانتقالية يظهر كثيرون ممن يريدون سرقة الثورة وحرفها عن أهدافها الحقيقية سواء كانت أطراف خارجية أو أطراف داخلية قد يكونوا من بقايا النظام القديم أو من أحزاب سياسية تريد ان تركب موجة الثورة في آخر لحظة.سواء في تونس أو في مصر فإن الثورة قامت على يد شباب غاضب ولا ينتمون للأحزاب السياسية التقليدية ،إلا أن هؤلاء الشباب غير مؤهلين للحكم وبالتالي تظهر أحزاب وشخصيات سياسية تطرح نفسها كمنقذ وكقيادة مرحلية أو انتقالية ،ولكن لا ضمانة بان هؤلاء سيتجاوبون مع أهداف الثورة ولا ضمانة أيضا بأنهم سيتركون السلطة بعد المرحلة الانتقالية ،وأحيانا يتقدم الجيش ليملا الفراغ خلال المرحلة الانتقالية .في ظل الأحداث الجارية في مصر لا نستبعد أن يلعب الجيش دورا مركزيا تحت ذريعة حفظ امن البلاد بل وحماية الثورة من حالة الفوضى والنهب التي تصاحبها وهي أحداث قد لا تكون بعيدة عن تخطيط بعض عناصر النظام .
نجاح الثورة في عمليتها الأولى (مرحلة الهدم) قد لا تكلف أكثر من استيلاء على الإذاعة والتلفزيون أو رصاصة في رأس الحاكم الفاسد -الرجعي واليميني وعميل الاستعمار وسبب هلاك الأمة..الخ- أو خروج جماهير هائجة ومقهورة للشارع لتخرب وتُدمِر ثم خطاب حماسي يسمى البيان الأول، حتى يقال لقد نجحت الثورة.ولكن ماذا بعد ؟ كان البَعدُ بالنسبة لكثير من الأنظمة والحركات الثورية العربية تغييرات شكلية في النظام السياسي وإحلال نخبة سياسية واقتصادية محل النخب السابقة و الاستمرار بترديد شعارات الثورة ،ظن قادة الثورة أن شعارات الثورة ستُغني الجماهير عن فقرها وجوعها ،اعتقدوا أن كل مشاكل الجماهير قد حُلت بمجرد إسقاط رأس النظام السابق ووصول قادة (الثورة) إلى سدة الحكم ،ولكن ماذا بالنسبة للاقتصاد والمديونية والتعليم والتكنولوجيا ،هل يتم تطوير وتحديث المجتمع بشعارات الثورة ،هل يُقضى على الفقر والجهل والمديونية ببركات الثوار ودعواتهم ؟هل يُقضى على إسرائيل وأمريكا بمجرد تسيير المظاهرات المنددة بالصهيونية والامبريالية ؟.
إن عملية الهدم سهلة وقد يقوم بها ضابط مغمور في الجيش أو جموع هائجة وجائعة أو تكون بتحريض من قوى خارجية، ولكن عملية البناء هي الأساس وهي الحكم على نجاح الثورة . مرحلة البناء تحتاج إلى رجال مختلفين وعقلية مختلفة وأساليب عمل مختلفة .
الفصل الثاني
سسيولوجيا الثورة في العالم العربي
الثورة كحدث سياسي واجتماعي وثقافي يمنحها خصوصية ،وحيث لا مجتمع يتطابق مع مجتمع آخر فلا يجب أن نتصور ثورة تتشابه تمام التشابه مع ثورة أخرى .صحيح أن الفقر والبطالة من أهم أسباب الثورات ،ولكن الفقر والبطالة لا يشكلا دافعا للثورة إلا إذا أحس الناس بأنهم فقراء وان هناك أغنياء يستغلونهم وهنا يأتي دور الثقافة السياسية والوعي السياسي،أيضا سمعنا من وصف الثورة التونسية والثورة المصرية بأنها ثورة الفيسبوك والفضائيات وفي هذا تقليل من شأن الثورة ،لا شك ان تقنيات التواصل الحديثة سهلت الأمر على الشعب وعلى الثوار لتواصل أسرع وأوسع بعيدا عن رقابة السلطة ،ولكن تقنيات الاتصال الحديثة موجودة في كثير من البلدان وبنسبة انتشار أكثر من مصر وتونس ومع ذلك لم تحدث ثورة .
ما يجري في العالم العربي من ثورات أو إرهاصات ثورات يحتاج لمزيد من الاهتمام والدراسة ،فثورات اليوم ليست ثورات الأمس ،وثقافة الخضوع والطاعة التي تنسب للمجتمعات العربية الإسلامية يبدو إنها في طريق التلاشي،وثقافة الشباب أو جيل اليوم ليست ثقافة جيل الخمسينيات والستينيات .
أولا : في العالم العربي: (ثورات) بدون ثورة وانقلابات دون تغيير
عرف العرب في تاريخهم الحديث مصطلح الثورة في بداية القرن العشرين حيث أطلق أسم (الثورة العربية الكبرى) على الحركة السياسية والعسكرية التي قادها الشريف حسين والي مكة عام 1915 ضد الخلافة العثمانية في تحالف مع بريطانيا التي كانت تخوض آنذاك حربا ضد الدولة العثمانية .إلا أن هذه (الثورة) أجهضتها وتآمرت عليها بريطانيا حليفة الشريف حسين من خلال اتفاقات سايكس – بيكو 1916 و وعد بلفور 1917 ثم الاستعمار المباشر الذي اخذ اسم الانتداب. التجربة العربية مع الثورة ما بعد الاستقلال لم تكن موفقة كثيرا حتى أن قطاعات كبيرة من المجتمعات العربية شعرت بأنه غرر بها من طرف من قاموا بالثورات والانقلابات وباتت تحن لعهد الملكية لما كان يوفره من حرية واستقرار عير متوفرين في ظل أنظمة الثورة،وبات الجمهور يتساءل عن جدوى قيام الثورات ضد الأنظمة الملكية ما دامت أحوالهم لم تتغير كثيرا وما دام (الثوار) يفكرون بالتوريث لأبنائهم.
غالبية (الثورات) التي قام بها عسكريون كانت انقلابات فوقية لم تشارك الجماهير في حدوثها ولم تتحسن حياتهم كثيرا بعد قيامها.بعض المجتمعات العربية حكمها منذ الاستقلال حتى اليوم أنظمة حكم كلها جاءت عن طريق انقلابات أطلق عليها أسم الثورة ولم يتغير حال الشعب كثيرا إلا شكليا حيث يتم الانتقال أحيانا من النظام الملكي للنظام الجمهوري على مستوى المسمى والعلم والنشيد الوطني ،ويتم تحويل القصر الملكي لقصر رئاسي، وتحويل الحرس الملكي إلى حرس جمهوري،، ويتم إحلال نخبة بنخبة لا تقل فسادا عن سابقتها وإحلال أجهزة قمعية بأجهزة أكثر قمعا تحد من حرية الشعب باسم الثورة والمصلحة الوطنية ،المصلحة الوطنية كما يراها النظام وليس المصلحة الوطنية كما يراها الشعب .لم يشهد أي نظام من أنظمة الثورة تداولا على السلطة لا على مستوى الحزب الحاكم ولا على مستوى الرئيس وفي بعض الأنظمة تحول القائد الثوري إلى أكثر من ملك سواء على المستوى البروتوكولي أو على مستوى الترف والبذخ أو بالنسبة للرغبة بتوريث السلطة للأبناء.
لا يعني ما سبق التقليل من أهمية الهبات وحتى الانقلابات العسكرية أو تحميل الفكر العربي الثوري والقومي وزر مرحلة بكاملها . لا شك بوجود أمور إيجابية لبعض أنظمة الثورة والتقدمية وخصوصا ثورة يوليو 1952 في مصر، ولكن الخلل أن دعاة الثورة والثورية تعاملوا مع الثورة وكأنها حالة متواصلة غير مميزين ما بين الثورة كأداة ونهج لهدم أنظمة فاسدة من جانب ومرحلة البناء التي تحتاج إلى فكر وممارسات ليست بالضرورة هي فكر وممارسات مرحلة التهيئة للثورة والقيام بها من جانب آخر. الثورة مرحلة حيث لا يمكن أن يستمر شعب في حالة ثورة مستمرة ،مرحلة تتميز بدرجة عالية من العنف واستنفاذ الجهد الشعبي ورفع الشعارات الكبيرة لأنها وضع استثنائي لتحقيق غرض هو بالأساس إسقاط أو تغيير وضع قائم لا يرضى عنه الشعب ،هدفها الأساسي توظيف حالة التذمر الشعبي وحالة الكراهية والفقر والكبت التي تعاني منها الجماهير لتغيير وتدمير سبب شقاء الشعب أو من يعتبرهم قادة الثورة السبب ،الثورة في البداية تتعامل مع عواطف الجماهير أكثر مما تتعامل مع عقولهم ،ولكن لا يمكن للشعب أن يستمر في حالة ثورة مستمرة ، كل (الثورات )العربية نجحت في عملية الهدم لأنها عملية سهلة قد تقتصر على انقلاب عسكري أو اغتيال الملك أو الرئيس ثم يقال لقد نجحت الثورة -غالبية ما نسميها ثورات في مجتمعاتنا العربية هي في الحقيقة انقلابات أو مؤامرات عسكرية لان الشعب لا يعلم بـ (الثورة ) إلا بعد حدوث الانقلاب وتغيير نظام الحكم أو رأس النظام فقط وإذاعة البيان الأول عبر الراديو أو التلفزيون.
سواء كانت ثورة أو انتفاضة أو انقلابا فإنها في العالم العربي لم تكن واضحة من حيث حمولتها الطبقية باستثناء ثورة يوليو 52 في مصر التي رفعت شعارات القضاء على الإقطاع وأعادت الاعتبار لطبقة العمال والفلاحين والبرجوازية الصغيرة .الشعب كان يريد يريد التغيير ولكنه يريده تغييرا ملموسا في مستوى المعيشة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وليس تغييرا في الشعارات والأيديولوجيات فقط ،وقد رأينا كيف أن إيديولوجيات ثورية وقومية واشتراكية أسست لأسوء أشكال الاستبداد. إن شعبا جائعا فقيرا مهانا متخلفا لا يحتاج إلى كثير جهد حتى يَقذف نفسه في آتون الثورة ،إنه في حالة ثورة مستمرة حتى ضد نفسه ،وكم هم واهمون ومدعون أولئك الذين ينسبون إلى أنفسهم صفات الذكاء والعبقرية والقيادة الحكيمة لأنهم استطاعوا أن يصلوا إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري موظفين خطاب الثورة والتغيير ،إن من يدعون لأنفسهم فضيلة قيادة ثورة ما هم إلا الأكثر ديماغوجية والأكثر قدرة على التلاعب بعواطف جموع جاهلة فقيرة مقهورة ،لأن السؤال الذي يفرض نفسه ماذا بعد الفوضى والانقلاب المُسمى ثورة ؟ ماذا بعد إسقاط النظام القديم ؟ من يبني المجتمع الجديد سياسة واقتصادا وثقافة بشكل أفضل من المجتمع القديم ؟.
مع تحولات النظام الدولي بعد انهيار المعسكر الاشتراكي ، تعرض الفكر الثوري والحركات الثورية لنكسة، حيث أن الثورات التي شهدها العالم وخصوصا خلال القرن العشرين، كانت تحضا بدعم المعسكر الاشتراكي وحركة التحرر العالمية وكانت ترفع شعارات معادية للرأسمالية والإمبريالية ولكن الديمقراطية لم تكن هدفا لها أو على الأقل لم تكن على سلم اهتماماتها ونلاحظ ذلك من خلال تشكيل الإنقلابيون (الثوار ) مجلس عسكري للحكم يسمى مجلس قيادة الثورة يحتكر السلطة ومهمشا القوى السياسية الأخرى. مع انهيار المعسكر الاشتراكي وتسيد الولايات المتحدة على العالم أصبح ما تبقى من الحركات الثورية تعيش أزمة كبيرة، فمثلا الثورة الفلسطينية التي لم تستطع أن تنجز مشروعها التحرري في ظل الثنائية القطبية تتعرض اليوم لتحديات كبيرة وهي تواجه إسرائيل من جانب والولايات المتحدة من جانب آخر. ومن جهة أخرى فإن تراجع الأيدلوجية الثورية الاشتراكية والقومية أفسح المجال لحركات ثورية بمحتوى ديني، وهذا حال حركة طالبان الأفغانية وتنظيم القاعدة بقيادة أسامة أبن لادن والثورة الإيرانية بقيادة الخميني نهاية السبعينيات، وحزب الله في لبنان وحماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.بالرغم من أن البعض زعم بأن انهيار المعسكر الاشتراكي سيؤدي لنهاية الحركات الثورية وكل النظم المغايرة للرأسمالية، وهو ما وصفه فرانسيس فوكوياما صاحب هذا الطرح ب (نهاية التاريخ)، إلا أن منطق الأمور والطبيعة الإنسانية يؤكدا بأنه حيث يكون ظلم لا بد أن تكون ثورات وحروب بغض النظر عن المحتوى الإيديولوجي لهذه الثورات، وإن غابت الأسباب الأيديولوجية للثورة فستكون أسبابها اقتصادية أو قومية أو دينية.
إلى ما قبل الثورة التونسية والمصرية كانت جماعات الإسلام السياسي على رأس القوى المطالبة بالتغيير وهي جماعات وإن كانت تلتقي مع الثورة من حيث الرغبة في التغيير إلا أن غالبيتها تقوم على أيديولوجية لا تعترف بالآخر ولا تؤمن بالوطنية والمشروع الوطني ولا بالديمقراطية ، كما تستعمل أدوات عنيفة ودموية أحيانا، أيضا تفتقر لرؤية حضارية وواقعية لما بعد هزيمة الأنظمة القائمة.ومع ذلك فقد نجحت بعض الحركات الإسلامية في إحداث ثورة متصالحة مع متطلبات الحضارة والحداثة كما جرى مع ثورة الخميني ضد سلطة الشاه في إيران،في المقابل فبعض هذه الحركات ما زالت تثير كثيرا من النقش حول جدواها للأمة وحتى للرسالة السماوية التي تدعي تمثيلها ،وهذا هو حال تنظيم القاعدة والجماعات الجهادية في أفغانستان وبعض الجماعات في العراق الجزائر والمغرب ومصر. ولكن مع الثورتين التونسية والمصرية انكشفت حقيقة آن غالبية الشعب ليس مع الإسلام السياسي،جماعات الإسلام السياسي ولأنها تملك قوة الإعلام والتنظيم ولديها إمكانيات مالية ضخمة وبسبب لجوئها للعنف فإن صوتها هو الأعلى ،قد تكون اكبر الأحزاب في بعض الدول العربية ولكنها لا تمثل الأغلبية بأي شكل من الأشكال ،قوتها وانتشارها يعودان لضعف الأحزاب السياسية الوطنية والقومية ولفقدان الأنظمة شرعيتها .
ثانيا: الثورتان التونسية والمصرية :ثورتان وطنيتان بمضامين ديمقراطية
لأنهما لم تكونا بقيادة الجيش ولا بقيادة أي حزب سياسي،فإن الحراك الشعبي الذي جرى في تونس ومصر تحول لثورة حقيقية .ما جرى في تونس ومصر استحضر خطاب وفعل الثورة في العالم العربي، إلا أن هذا الاستحضار جاء في زمن مغاير وظروف مختلفة عما كانت عليه خلال العقود الماضية.سابقا كان كل حديث عن الثورة وكل فعل ثوري موجها ضد الاستعمار أو ضد أنظمة رجعية يمينية أو دكتاتورية استبدادية لا تؤمن بالديمقراطية ولا تأخذ بها بجدية،أما اليوم فالتحركات الشعبية تطالب بالديمقراطية وتجري في مواجهة أنظمة تقول بالديمقراطية وتزعم بأنها تستمد شرعيتها من صناديق الانتخابات ،سابقا كانت نخبة سياسية أو عسكرية تقوم بتحريض الجماهير على الثورة أو تنب عن الشعب في مواجهة النظام القائم أما اليوم فالشعب يتحرك بعيدا عن الأحزاب التقليدية والتاريخية،بل تضع الثورة الأحزاب في حالة من الإرباك مما يدفعها للهث لركوب موجة الثورة و محاولة جني ثمارها لصالحها.والجديد أيضا أن جيل الشباب على رأس الحراك المطالب بالتغيير ،الثقافة الديمقراطية مكنت الشباب من أخذ دور الريادية والثورة المعلوماتية وخصوصا الانترنت والفضائيات مكنت الشباب ومجمل الجماهير من التواصل مع بعضهم وتوجيه مجريات الثورة دون الحاجة للتنظيمات الحزبية التي كانت تلعب هذا الدور،أيضا العولمة الثقافية وتبني العالم أجمعه لمنظومة حقوق الإنسان وقيم وثقافة الديمقراطية جعل مطالب الشباب مفهومة ومقبولة وبالتالي تجد تجاوبا وتأييدا من العالم الخارجي.
ما جرى في تونس ومصر من أحداث دشن مرحة ثورية جديدة وهي الثورة الشعبية الديمقراطية .الثورة التونسية والمصرية أعادتا الاعتبار للوطن والوطنية .فعندما ناضلت الجماهير العربية ضد الاستعمار وضد أنظمة القمع والاستبداد، لم يكن واردا أن تُصادر نضالاتها ومعاناتها وتضحياتها ويتم تجييرها لنخب وأحزاب جديدة تتسيد عليها . ناضلت الجماهير من أجل استقلال الوطن وحريته باعتبار الوطن الفضاء الذي يوفر لهم الحرية والكرامة ،وعندما منحت الجماهير ولاءها للحركات والأحزاب التي قادت الثورة ضد الاحتلال إنما مراهنة منها على أن هذه الحركات ستواصل نضالها بعد الاستقلال لقيام وطن حر مستقل يوفر للمواطنين الحياة الكريمة ويقيم عدالة اجتماعية ،ما لم يخطر على بال الجماهير أن تتحول السلطة (الوطنية ) ،التي قامت بعد الاستقلال أو بعد إسقاط الأنظمة الملكية والرجعية، لهدف بحد ذاته وأن يتحول قادة الثورة لنخبة حكم تستبد بالسلطة ويورث القائد الثوري الحكم لأبنائه من بعده،أيضا لم يكن في الحسبان أن تؤدي الديمقراطية إلى تكريس سيطرة الحزب المهيمن والرئيس الأوحد .
في المجتمعات الديمقراطية العقلانية وحيث أن من يتبوأ مواقع السلطة منتخبون من المجتمع ويعبرون عن رغباته وتطلعاته ويستطيع الشعب التحكم في ممارساتهم ومراقبتهم وتغييرها بالانتخابات وبضغط الرأي العام الخ ،فإن علاقة تصالحية تربط ما بين السلطة والمجتمع وما بين السلطة والوطن،وبالتالي فإن الأحزاب والقوى التي تتنافس أو تتصارع للوصول إلى السلطة لا تخرج عن إطار المصلحة الوطنية حيث يبقى التنافس والصراع ضمن ثوابت ومرجعيات الأمة ،صحيح أن السلطة تمنح امتيازات وتحقق مصالح للنخب الحاكمة ولا تخلو أحيانا من فساد واستغلال نفوذ، ولكن هذه النخب في المقابل تعمل من أجل المصلحة الوطنية أو الوطن بما هو المشترك بين كل مكونات المجتمع من أفراد وجماعات وثقافات فرعية وأحزاب سياسية.
أما في العالم العربي، فقد فهم البعض أو أراد أن يُفهم الشعب أنه بالاستقلال وقيام الدولة انتهى النضال والعمل من اجل الوطن وان المرحلة مرحلة جني ثمار الاستقلال من خلال مغانم وامتيازات السلطة ،نسى وتناسى هؤلاء أن النضال الحقيقي يبدأ ما بعد الاستقلال ،ما بعد الاستقلال يبدأ الجهاد الأكبر أو النضال الحقيقي لتوفير الحياة الكريمة للمواطن الذي لم يكن هدفه من الانخراط في حركة التحرر الوطني وفي الثورة أن يكون له علم ونشيد وجيش وسجن وطني فقط ،بل ناضل من اجل الحرية والحياة الكريمة التي كان يفتقدها في ظل الاستعمار وفي ظل الأنظمة الاستبدادية المأجورة .
منذ الاستقلال ونحن نشهد صراعا على السلطة ،غالبا ،إن لم يكن كليا، صراعا دمويا غير ديمقراطي عبر الانقلابات التي سُميت ثورات وعبر حروب أهلية أو انتخابات شكلية لا علاقة لها بالممارسة الديمقراطية الحقيقية،وكل ذلك كان وما زال يتم باسم الوطن والمصلحة الوطنية أو باسم الدين ،وحتى اليوم، فالذين يتمسكون بالسلطة يستقوون بالأجهزة الأمنية والجيش ،والذين يتطلعون إلى السلطة عبر العنف السياسي أو الجهادي ،وغالبية الذين يتطلعون للسلطة ويناضلون للوصول إليها موظِفِين خطاب الثورية والوطنية أو خطاب الديمقراطية ،إنما يتطلعون للوصول للسلطة كهدف بحد ذاتها.
هذا ما لمسناه خلال العقود الماضية حيث أن من يصل للسلطة ينسى كل شعاراته الكبيرة عن الوطن والوطنية ويصبح هدفه الحفاظ على السلطة والتمتع بامتيازاتها على حساب الوطن كفضاء للحرية والحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين،وهنا نلاحظ كيف أن تضخم السلطة في العالم العربي يتواكب مع انهيار الوطن والدولة الوطنية ،نلاحظ أن نخب السلطة تزداد ثراء وفسادا ،فيما الوطن ينهار وتصبح الدولة الوطنية محل تساؤل ،من الصومال إلى السودان واليمن والعراق، حتى مصر والجزائر ولبنان ليسوا بعيدين عن أزمة الدولة الوطنية.فهل مفهوم الوطن عند الحوثيين في اليمن هو نفسه عند الحراك الجنوبي أو عند أحزاب السلطة؟هل مفهوم الوطن عند شيعة العراق نفسه عند البعثيين المُبعدين عن السلطة والسياسة ؟هل مفهوم الوطن عند السلفية الجهادية في الجزائر نفسه عند جبهة تحرير الجزائر؟هل مفهوم الوطن عند حركة حماس نفسه عند حركة فتح وسلام فياض؟هل مفهوم الوطن عند تنظيم القاعدة في أي بلد يتواجد فيه نفسه مفهوم الوطن عند السلطة وأحزابها ونخبها؟الخ.
السلطة في العالم العربي حلت محل الوطن، وأصبح نضال غالبية الأحزاب والنخب ليس من اجل الوطن بل من أجل السلطة،فليس بعد الوصول للسلطة من جهد إلا للحفاظ عليها.السلطة كأشخاص ومؤسسات وعلاقات سلطوية بين الحاكمين والمحكومين ليست الوطن، بل أداة تنفيذية لاستقلال الوطن إن كان محتلا ولبنائه إن كان مستقلا ولحمايته إن كان مهددا، ذلك أن هدف كل سلطة سياسية في أي مجتمع هو تأمين المجتمع من المخاطر الخارجية وتحقيق الوفاق والانسجام الداخلي بين مكونات المجتمع،كما أن السلطة أحد مكونات الدولة بالإضافة إلى الشعب والإقليم .وفي جميع الحالات وبغض النظر عن مصادر شرعية السلطة السياسية القائمة يجب أن تكون العلاقة واضحة ما بين السلطة ذات السيادة والدولة والمجتمع ،والانسجام بين هذه المكونات الثلاثة يُنتج ما يسمى الوطن كحاضنة مادية ومعنوية للمواطن وكانتماء وشعور يحمله معه المواطن أينما حل وارتحل.السلطة وحدها ليست وطنا والدولة لوحدها ليست وطنا ،فالمواطن يخضع لهما قانونيا ولكنهما لا تشكلا انتماء وجدانيا ،وحتى المجتمع قد لا يشكل وطنا لأبنائه في بعض الحالات فكثير من الأفراد يشعرون بأنهم ساكنة وليسوا مواطنين حيث ينتابهم إحساس بالاغتراب الاجتماعي والسياسي في مجتمعاتهم،والتطلع للهجرة للخارج وخصوصا بالنسبة للمثقفين والأدمغة خير دليل على ذلك.
عندما نتحدث عن السلطة السياسية في الدول الديمقراطية إنما نتحدث عن أجهزة ومؤسسات عسكرية أو مدنية بيروقراطية ثابتة لا تتغير مع كل رئيس أو حزب جديد،وعن نخبة سياسية حاكمة تعمل بتكليف من الشعب لفترة زمنية ثم تتغير لتحل محلها نخبة جديدة ،دورة النخبة أو التداول على السلطة لا يسمح لمن هم في السلطة بترسيخ علاقات مصلحية دائمة حيث يوجد فصل ما بين السلطة والثروة،وبالتالي فإن أصحاب الثروات في الغرب ليسوا أصحاب السلطة السياسية بل من نخب اجتماعية واقتصادية ،أما في عالمنا العربي وحيث لا يوجد تداول على السلطة إلا ضمن نطاق ضيق ،وحيث أن النخب الحاكمة تستمر لعقود فإن اقترانا يحدث ما بين السلطة والثروة ،ولتحمي السلطة المقترنة بالثروة نفسها تلجأ لإفساد كبار رجال الجيش والأجهزة الأمنية وقادة الرأي العام من قادة أحزاب ومؤسسات مجتمع مدني ورؤساء تحرير أهم الصحف ورجال دين الخ ،بالمال والامتيازات ،كما تسعى لإنتاج نخب جديدة مستفيدة من السلطة القائمة لحمايتها وفي كثير من الحالات تكون نخب عائلية أو طائفية أو إثنية،وتصبح علاقة اعتمادية متبادلة ما بين الطرفين،ويصبح هدف السلطة والنخب التابعة ليس مصلحة الوطن بل الحفاظ على ما بيدها من سلطة لأن السلطة هي التي تضمن حفاظها على مصالحها،وهذه الأطراف مستعدة للدخول بحرب أهلية ليس دفاعا عن الوطن بل دفاعا عن مصالحها ،أو دفاعا عن وطن تضع السلطة مواصفاته ومرتكزاته بحيث يتماها مع السلطة وبالتالي يصبح المساس بالسلطة مساسا وتهديدا لهذا الوطن ،وطن السلطة وليس وطن الشعب.
هذا التعارض والفصل ما بين السلطة والوطن الحقيقي,وطن كل الأمة، وتحول السلطة إلى هدف بحد ذاته لدى غالبية القوى التي تتصارع عليها سواء بوسائل ديمقراطية أو غير ديمقراطية،بل وتحولها لعبء على الوطن ،أحيا مجددا الحديث عن المشروع الوطني في العالم العربي ،ليس فقط في الدول الخاضعة للاحتلال – فلسطين والعراق- بل في بقية الدول العربية التي يُفترض أنها انتقلت من مرحلة المشروع الوطني لمرحلة الدولة الوطنية،حيث المُلاحظ ان الدول العربية المستقلة لديها أزمة دولة وأزمة علاقة بين الدولة والمجتمع وبين السلطة والمجتمع وأزمة بين مكونات المجتمع الإثنية والطائفية،بمعنى أنها تعاني أزمة وجودية ،وهذا ما يتطلب عقدا اجتماعيا جديدا يؤسس لمشروع وطني جديد يقوم على أسس ديمقراطية،هذا المشروع الوطني الديمقراطي يحتاج لنخب جديدة وقوى سياسية جديدة نأمل أن يكون الشباب الذين خرجوا في ثورة عارمة في تونس ومصر نواة هذه النخبة.
ثالثا :الديمقراطية الشكلانية تكشف فساد النظام السياسي وأزمة الدولة الوطنية
لا يمكن الفصل ما بين عودة الثورة فكرا ونهجا إلى المشهد السياسي العربي وأزمة الانتقال الديمقراطي التي شهدها العالم العربي خلال العقود الثلاثة .الحديث عن الديمقراطية في العالم العربي تحتاج لمقاربة جديدة تؤسس على الواقع لا على الخطاب والنموذج الجاهز،والواقع يقول بأن التجارب الديمقراطية تحولت إلى أنظمة حكم وشعارات فضفاضة إن كانت تتضمن بعض مفردات الديمقراطية وثقافتها في بعض المجتمعات، إلا أنه يصعب القول بأنها أنظمة ديمقراطية.صحيح حدث حراك سياسي وتقدم نسبي في منظومة حقوق الإنسان وفي وعي المواطن بحقوقه،إلا أن هذا الحراك تعبير عن ألتوق إلى التغيير ورفض الاستبداد والقمع والسعي للحياة الكريمة بغض النظر إن كان النظام المُراد الوصول إليه مُهيكل حسب النظرية الديمقراطية كما هي عليه في النموذج الغربي أم لا. كل الأنظمة القائمة اليوم إما أن تصف نفسها بالأنظمة الديمقراطية أو بأنها تريد أن تكون ديمقراطية،ولكن على مستوى الواقع القائم سنجد أن أوجه التباعد ما بين هذه الأنظمة العربية التي تقول بأنها ديمقراطية والديمقراطية السائدة في الغرب فيما يتعلق بشكل النظام وآلية إدارته وطبيعة الثقافة السائدة فيه.فما الذي يجمع مثلا ما بين الديمقراطية في العراق وأفغانستان والديمقراطية في السويد؟وما الذي يجمع ما بين ديمقراطية الكويت أو مصر وديمقراطية فرنسا أو اليابان؟الخ .
زعم الأنظمة العربية بالأخذ بالديمقراطية لم يؤد لإحداث تغييرات بنيوية في ثقافة واقتصاد المجتمع ولم يؤد لإحلال علاقات ونخب وأفكار جديدة تمثل قطيعة مع مرحلة سابقة، لأن ولوج أنظمة الحكم العربية عالم الديمقراطية جاء نتيجة ضغوطات خارجية وإرادة نخب وجدت في الديمقراطية أيديولوجية جديدة يمكن توظيفها لاكتساب شرعية تعوضها عن أزمة شرعياتها التقليدية.في سعي الأنظمة لتطويع الديمقراطية بما يخدم مصالحها انكشفت أزمة الدولة حيث أدت هذه الديمقراطية لإحياء الطائفية والإثنية وتباعدت الشقة ما بين الحكام والمحكومين وما بين طبقات الشعب .
في السنوات الأخيرة طرأت متغيرات فرضت على الأنظمة العربية التعامل مع الاستحقاق الديمقراطي دون الإيمان بالديمقراطية،واهم هذه المتغيرات :-
1)انكشاف شرعية أنظمة الحكم بسبب تآكل شرعيتها التقليدية من دينية وثورية .
2) سقوط ذريعة رفض الديمقراطية وكبت الحريات حتى يمكن التفرغ لمواجهة إسرائيل ومواجهة المؤامرات الاستعمارية حيث باتت الأنظمة ملتزمة بإستراتيجية السلام مع إسرائيل وباتت واشنطن والغرب حلفاء وأصدقاء.
3) تلمس الجماهير خطاها على طريق الحرية والإدراك لحقيقة أوضاعها المتردية ويعود الفضل في ذلك لما راكمته الحركات التقدمية والديمقراطية الحقيقية طوال عقود وللفضائيات وشبكات الانترنيت وتقارير منظمات حقوق الإنسان.
4) خشية الأنظمة من وصول القوى الديمقراطية الحقيقية لسدة الحكم في وقت باتت المصالح الغربية في المنطقة متعاظمة بشكل غير مسبوق ومُهَددة في نفس الوقت من جماهير تعادي الغرب ومصالحه .
5) تزامن مأزق الأنظمة ورغبتها بتجديد شرعيتها مع تغيير في إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية وقوى أوروبية في التعامل مع منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي على وجه التحديد ،حيث وجدت هذه القوى أن الدعم المباشر للأنظمة والحكومات الاستبدادية يضر بمصالحها في المنطقة ومن هنا رأت أهمية الدخول للمنطقة من بوابة أخرى ،فبدأت بالحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الديمقراطية في الشرق الأوسط وخصوصا في العالم العربي مطالبة بتسريع الانتقال نحو الديمقراطية مع التركيز على العملية الانتخابية .لم يكن هدف واشنطن والغرب دمقرطة العالم العربي بل مواجهة المد الأصولي وحالة التمرد على الوجود الأمريكي في المنطقة وخصوصا بعد احتلال العراق ،وانحياز واشنطن لإسرائيل.
إن المدقق بواقع المشهد الديمقراطي في المجتمعات العربية سيلمس أن الجانب المؤسساتي الشكلاني للسلطة – وجود انتخابات ودستور ومجلس تشريعي ومنظومات قانونية تتحدث عن الحقوق والواجبات- والخطاب السياسي المدجج بشعارات الديمقراطية ،كان لها الغلبة في توصيف المشهد بالديمقراطي أكثر من توفر ثقافة الديمقراطية ومن انعكاس الديمقراطية حياة كريمة للمواطنين،وبالتالي فإن المقاربة الدستورانية القانونية لا تصلح للحكم إن كان توجد ديمقراطية أم لا. ما يجري من سلوكيات وأنماط تفكير وتطبيقات للديمقراطية يتطلب إعادة النظر سواء بمفهوم الحرية كشرط ضرورة لأي ممارسة ديمقراطية أو بالنسبة للديمقراطية كثقافة أو بالنسبة لعلاقة السلطة بالمعارضة وبالمثقفين وبالحريات بشكل عام وحتى بالنسبة لمقولة أن الشعب يريد الديمقراطية.
القول بإعادة النظر لا يعني التخلي عن الديمقراطية بل إعادة النظر بفهمنا وبممارستنا للديمقراطية والابتعاد عن محاولات استنساخ التجربة الغربية أو الجري وراء أوهام الدلالة اللغوية للكلمة،وأن نأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على علاقة النظم السياسية بالخارج و بالمتغيرات التي تطرأ على المشهد الثقافي في مجتمعاتنا وخصوصا ظاهرة المد الأصولي والعنف السياسي و الإرهاب وبروز الجماعات الطائفية والإثنية ،التي كانت تشكل ثقافات فرعية غير مسيسة وبالتالي لم تكن حاضرة كقوى سياسية عندما بدأت النخب السياسية العربية تتعامل مع ظاهرة الديمقراطية قبل عدة عقود.
من خلال تجربة العقود الأربعة الماضية في البحث عن مخارج ديمقراطية لأزمات مجتمعنا العربي ،ومن خلال ما يجري على الأرض اليوم من حراك سياسي يستظل بظل شعارات الديمقراطية، أو ما يجري في فلسطين و العراق من إقامة أنظمة (ديمقراطية) في ظل الاحتلال وفي ظل وجود جماعات وشعب مسلح ،من خلال كل ذلك فأن الحاجة تدعو لإعادة النظر إما في مفهوم الديمقراطية المتعارف عليه أو في توصيف ما يجري بأنه تحول ديمقراطي.
إن سؤال: هل توجد ديمقراطية في العالم العربي أم لا ؟أصبح متجاوزا أو من الصعب الإجابة عليه انطلاقا من المقاييس والمؤشرات التقليدية حول وجود أو عدم وجود ديمقراطية. الديمقراطية الموجودة في غالبية الأنظمة العربية القائلة بها ليست تعبيرا عن إرادة الأمة بقدر ما هي استجابة-بالمفهوم الإيجابي والسلبي للاستجابة- لاشتراطات خارجية وتحديات داخلية ليست بالضرورة تعبيرا عن توفر ثقافة الديمقراطية،فقليلا ما نرى أو نسمع عن مظاهرات ومسيرات كبيرة للمطالبة بالديمقراطية – باستثناء ثورتي تونس ومصر- ،فيما تستطيع قوى اليسار أو الإسلامي السياسي إخراج مظاهرات مليونية لنصرة غزة أو العراق مثلا أو للتنديد بإهانة الرسول.باستثناء العربية السعودية وليبيا فإن كل الأنظمة العربية سواء كانت ملكية أم جمهورية ثورية أو عسكرية،غنية أم فقيرة… تصنف نفسها بأنها ديمقراطية أو تسير نحو الديمقراطية أو لا تعارض الانتقال الديمقراطي، وفي جميع الحالات سنجد ما يربط كل نظام سياسي بآلية ما أو مظهر ما من مظاهر الديمقراطية كوجود انتخابات أو دستور عصري أو مؤسسات تشريعية أو تعددية حزبية الخ ،ومع ذلك يبقى السؤال: أية ديمقراطية توجد في هذه الأنظمة.
قد نبدو مبالغين إن قلنا بان لكل نظام عربي تصوره وتطبيقه الخاص للديمقراطية وبعضها غير مسبوق تاريخيا ويعتبر اختراعا عربيا بجدارة -كالنظام القائم في ليبيا – إلا أن هذه المداخل لن تؤدي لديمقراطية حقيقية لأنه ليس واردا عند الأنظمة أن تؤسس ديمقراطية تؤدي للتداول السلمي على السلطة وإشراك الشعب في الحياة السياسية إشراكا فاعلا ومسئولا .أيضا يجب تجنب المبالغة في الحديث عن الديمقراطية في العالم العربي بشكل عام وكأن العالم العربي دولة واحدة أو مجتمع واحد.بعيدا عن الخطاب الأيديولوجي العروبي ومع عدم تجاهل وجود قواسم مشتركة كاللغة والدين وعادات وتقاليد،فإن الواقع يقول بوجود أثنين وعشرين نظاما وكيانا سياسيا لم تتشكل كلها ضمن نفس الشروط التاريخية والموضوعية،فلا يجوز أن نضع في سلة واحدة الدولة المصرية ذات الخمسة آلاف سنة من الوجود مع دولة الإمارات العربية ذات الأربعين سنة من العمر،كما لا يجوز وضع المغرب بتاريخه وخصوصيته الثقافية والسياسية مع لبنان بخصوصيته وشروط تشكله التاريخي،نفس الأمر بالنسبة لتونس والكويت أو الجزائر أو فلسطين الخ.
رابعا:انسحاق الديمقراطية ما بين مطرقة الأنظمة وسندان الإسلاموفوبيا
ما بين مطرقة السلطة وسندان جماعات إسلام سياسي أنتجت ظاهرة الإسلاموفوبيا، تم سحق الأوطان والقوى الديمقراطية الحقيقية في العالم العربي.انسحاق الأوطان التي تشكل فضاء للحرية والمساواة والعيش الكريم لكل مكونات الشعب دون تمييز طائفي أو عرقي،وانسحاق القوى التي ناضلت لعقود للانعتاق من ربقة الاستبداد والتخلف والمتطلعة للحداثة والتقدم واحترام حقوق الوطن والمواطن وتحويل الشعب من ساكنة ورعايا إلى مواطنين وتحويل الأرض التي يقيمون عليها من محل إقامة إلى وطن يفتخرون بالانتساب إليه والعيش فيه.
كل مراقب لأوضاع العالم العربي سيلاحظ ارتكاسة الفكر والواقع العربي من فكر يدعو للتقدم والتحرر والوحدة العربية إلى فكر طائفي وقبلي أو وطني مأزوم يجاهد للحفاظ على تماسك الدولة الوطنية حتى في ظل استبداد أنظمة الحكم القائمة ،هذه الأخيرة التي باتت تبرر استبدادها واستمرارها بالحكم بذريعة الحفاظ على الوحدة الوطنية ومواجهة المخططات الخارجية ومواجهة التطرف الديني!. في ظل ما يسمى بالانتقال الديمقراطي والانتخابات التي تحولت لأداة لشرعنة الطائفية والإثنية والاستبداد وتأكيد حضورها كحقيقة يجب التسليم بها أرتكس الواقع العربي لمزيد من الفقر وتدهور العدالة الاجتماعية و لحالة من الفتنة والطائفية والإثنية تتعايش بل تتعاظم.
المراقب للانتخابات التي جرت خلال العقدين الأخيرين سواء من حيث القوى المتصارعة على السلطة أو الفائزة في الانتخابات سيلمس ضعف حضور القوى السياسية – أحزاب وشخصيات- الوطنية والقومية التي كان لها دور الريادية في مواجهة تسلط الأنظمة ،حيث باتت الحياة السياسية اليوم شبه ثنائية قطبية ،النظام السياسي وحزبه ونخبه من جانب وجماعات الإسلام السياسي من جانب آخر،المراقب سيلمس ضعف الروح والفكرة الوطنية الجامعة عند الأطراف الكبرى المتصارعة على السلطة،الأمر الذي أدى لأن تفقد الأحزاب والحركات السياسية ثقة الجمهور بل بات الجمهور ينظر لها كعبء على الحالة الوطنية.
لم تكن الحياة السياسية العربية أرضا يبابا تسودها الدكتاتورية والاستبداد والجهل قبل ظهور جماعات الإسلام السياسي وصراعها مع أنظمة الحكم القائمة .لعقود والديمقراطيون الحقيقيون يناضلون بكل أشكال النضال ضد أنظمة الاستبداد بكل تلاوينها الرجعية اليمينية و(الثورية التقدمية )،من المغرب إلى مصر وسوريا والعراق ومن عُمان إلى السودان والصومال .ربما لم تكن الديمقراطية العنوان الأبرز للمناضلين الأوائل ،ولم تكن الانتخابات الوسيلة الوحيدة لمقارعة السلطة الحاكمة ولاختبار قوة الحضور الجماهيري، ولكن نضالاتهم كانت تصب في جوهر النضال الديمقراطي ما دامت من أجل الحرية وضد الاستبداد ،لقد سيِّروا المظاهرات وقاموا بالاعتصامات وحملوا السلاح أحيانا ودخلوا السجون والمعتقلات واستشهد كثيرون دفاعا عن كرامة وحرية الوطن والمواطن .خلال هذه المسيرة الطويلة الممتدة ما بعد الاستقلال مباشرة حتى نهاية الثمانينيات راكم المناضلون إنجازات مهمة حيث ساهمت في إثارة الرأي العام وخلقت حالة من الوعي الجماهيري دفعت الأنظمة لتخفيف قبضتها الأمنية و للتفكير بمصالحة قوى المعارضة ومحاولة استمالتها .خلال هذه المسيرة لم تكن جماعات الإسلام السياسي جزءا من الحركة النضالية الشعبية التقدمية والديمقراطية المتصادمة مع أنظمة القمع والاستبداد.بعض الجماعات الإسلامية كحزب التحرير وبعض فروع الإخوان المسلمين دخلت بمواجهات ساخنة مع أنظمة عربية ولكنها لم تكن تندرج ضمن النضال الديمقراطي بل كانت أقرب لمحاولات الانقلاب على السلطة للهيمنة عليها وتطبيق الإيديولوجية الدينية لهذه الجامعات وهي أيديولوجيا غير متصالحة مع الديمقراطية بل كانت آنذاك تنظر بريبة للديمقراطية و الديمقراطيين.
كانت نقاط التباعد ما بين جماعات الإسلام السياسي وأنظمة الحكم لا تقل عن نقاط التباعد بينها وبين القوى التقدمية والديمقراطية ،وفي كثير من الحالات كانت الجماعات الدينية تأخذ موقع المحايد المراقب لما يجري من تصادم بين الأنظمة ومعارضيها من السياسيين ،وبعضها كان اقرب لمواقف الأنظمة لأنها لم تكن تؤمن بالديمقراطية وثقافتها وأحيانا كانت تنظر للقوى الديمقراطية باعتبارها علمانية وكافرة ،وقد وظفت بعض الأنظمة جماعات إسلامية لمحاربة معارضيها التقدميين والديمقراطيين .
صحيح أن جماعات الإسلام السياسي وخصوصا الإخوان المسلمين واجهت في بعض المراحل الأنظمة وعانت من الأنظمة وكانت تريد تغيير الوضع القائم ولكن لم يكن واردا عندها تأسيس نظام ديمقراطي يؤمن بالمشاركة والتعددية السياسية ،كانت تريد إحلال استبداد أنظمة وضعية باستبداد أنظمة دينية،ومن هنا لاحظنا أن جماعات الإسلام السياسي لم تدخل في تحالفات ثابتة مع القوى السياسية الديمقراطية والتقدمية في أي دولة عربية،وكنا وما زلنا نسمع عن القوى الإسلامية والقوى الوطنية أو القومية ،ونسمع عن الصحف الإسلامية والصحف الوطنية والقومية ،لم يكن مفهوم الوطن والهوية والثقافة عند الجماعات الإسلامية يتوافق مع مفهومهم عند القوى الوطنية والقومية والتقدمية –ما لاحظناه أخيرا في مصر من تنسيق بين الأخوان المسلمين وقوى تقدمية ووطنية بعد الانتخابات لا يعدو كونه ردود فعل انفعالية على نتائج الانتخابات أكثر مما هي مؤشر على تحالف دائم -.
ما كان يبدو حراكا ديمقراطيا في العالم العربي كان يخفي دوافعا غير ديمقراطية عند القوى الرئيسة الكبرى في هذا الحراك ،حيث تم نزع راية النضال الديمقراطي ومصادرة الفكرة الديمقراطية المنبثقة من الإرادة الحرة للشعب بالتغيير الديمقراطي من يد الديمقراطيين الحقيقيين لتتسلمها أو تستلبها أطراف تقول بالديمقراطية ولا تؤمن بها . الديمقراطيون الحقيقيون في العالم العربي تمت محاصرتهم من ثلاثة قوى:أنظمة الحكم ونخبتها، جماعات إسلام سياسي لا تؤمن بالديمقراطية ،واشنطن ورؤيتها لديمقراطية تخدم سياسة ( الفوضى البناءة ) في المنطقة . لا شك أن الجماعات الإسلامية ليست على نفس الدرجة في اقترابها من الديمقراطية وبالتالي ليست على نفس الدرجة في صدقها بالدخول في العملية الانتخابية.بعض جماعات الإسلام السياسي وطَّنَت أيديولوجيتها الدينية وعقلنت خطابها بحيث بات أكثر تسامحا وقبولا بالآخر ،هذه الجماعات تقبل مبدأ الشراكة السياسية ومستعدة للعودة لصفوف المعارضة إن خسرت الانتخابات ،إلا أن جماعات أخرى دخلت الانتخابات بروح جهادية أو بعقلية الغزو والفتح،دخلت الانتخابات ليس إيمانا بالديمقراطية ولكن كوسيلة للسيطرة على السلطة بعد أن فشلت في الوصول إليها بوسائل أخرى،ولذلك نجد هذه الجماعات توظف كل ما لديها من إمكانيات مالية ولوجستية وخطاب ديني متشنج لكسب الانتخابات وفي حالة نجاحها لن تسمح بانتخابات أخرى.
ومع ذلك فإن ما وصلت إليه الأوضاع العربية من انسداد أفق على كافة المجالات وما وصلت إليه الأنظمة من ترهل ومن تباعد عن مصالح الجماهير الشعبية يتطلب إفساح المجال لكل القوى السياسية للمشاركة في الحياة السياسية لأنه لا يُعقل أن تكون شعوبنا عاقرا وغير قادرة على إنتاج قيادات جديدة ونخب جديدة ،فعقود من النضال السياسي متعدد الجبهات والانفتاح غير المسبوق على العالم الخارجي جعلت الجماهير العربية أكثر إدراكا ووعيا لمصالحها وحقوقها وأكثر جرأة على مقاومة الطغيان وما يجري في تونس والجزائر ومصر والسودان واليمن مؤشر على الثمن الذي يمكن أن تدفعه الأنظمة إن تجاهلت مصالح شعوبها وأعاقت الممارسة الديمقراطية الحقيقية وهو ثمن ستدفعه أيضا الدولة الوطنية ليس فقط كنظام حاكم بل كوجود .
صحيح أن خطاب وشعارات بعض جماعات الإسلام السياسي تثير القلق بل والرعب ،ولكن الغرب الاستعماري وأنظمة الحكم يضخموا وبشكل مبالغ فيه من خوف الجمهور من هذه الجماعات ليس دفاعا عن المصلحة الوطنية أو لان هذه الجماعات تشكل بالفعل تهديدا للمصلحة والوجود الوطني بل لخوف الأنظمة ونخبتها من فقدان مواقعها وامتيازاتها،كما أن الأنظمة توظف فزاعة الإسلام السياسي –الإسلاموفوبيا- لقطع الطريق حتى على القوى التقدمية والديمقراطية الحقيقية.لقد رأينا كيف أن الخاسر في الانتخابات الأخيرة في مصر وقبلها الأردن والمغرب والكويت والعراق ليست جماعات الإسلام السياسي فقط بل كل القوى الديمقراطية الحقيقية ومجمل المسار الديمقراطي.
حالة الاستقطاب ما بين أحزاب السلطة وجماعات الإسلام السياسي ،وتراجع شعبية وفاعلية الأحزاب السياسية بشكل عام عززا من قوة حضور المجتمع المدني وقطاع الشباب غير المسيسين ،هذه القوى الصاعدة باتت أقوى من الأحزاب من حيث قدرتها على تحريك الشارع وهذا ما لمسناه في الثورة التونسية وفي الثورة المصرية أيضا.
خامسا: انقلاب الانتخابات على أصولها الديمقراطية
ارتباطا بما سبق ،فعندما تختزل الديمقراطية بالانتخابات وتكرس هذه الأخيرة سيطرة الحزب الحاكم والرئيس الأبدي وتنتج برلمانا بدون معارضة وتعيد أنتاج نفس النخب المسيطرة،وعندما تتواكب الانتخابات مع القهر والفتنة والفوضى وتفتح المجال لتدخل قوى أجنبية ،وعندما تؤدي الانتخابات إلى تعزيز واستنهاض الطائفية والعرقية والقبلية والعائلية وزيادة بؤس ومعاناة الشعب ، فهذا مؤشر على انحراف الانتخابات عن وظيفتها الديمقراطية وعن ردة ديمقراطية تحتاج لمزيد من الدراسة والبحث. الانتخابات والديمقراطية الشكلانية والموجهة في العالم العربي انقلبت على ماهيتها ووظيفتها الأولى بحيث أصبحت أداة لوأد الديمقراطية وتهميش الديمقراطيين الحقيقيين،والنتيجة الحتمية لكل ذلك هو ما نشهده في تونس والجزائر ومصر وحالة انسداد الأفق في بقية البلاد العربية .
صحيح، إن مأزق الديمقراطية الشكلانية وتعثر الانتخابات في إحداث عملية انتقال ديمقراطي سلمي بات ظاهرة عرفتها أكثر من دولة، أخرها ساحل العاج، ولكنها في العالم العربي وخصوصا في مشرقه من فلسطين إلى العراق ومصر وقبلهم الجزائر ،أكثر خطورة ودلالة مما هي في بقية العالم . تعثر الانتخابات والانتقال الديمقراطي في بعض الدول الإفريقية يمكن فهمه لقرب عهد هذه الدول بالديمقراطية وبالمسألة الانتخابية،ومع ذلك فالانتخابات تؤسس هناك لبدايات ممارسة ديمقراطية ،أما في الدول العربية التي لها تجارب سابقة من ممارسة الانتخابات والحياة البرلمانية وبعضها منذ بدايات القرن العشرين،وبما لها من إمكانيات مالية وانفتاح نخبها على الغرب وثقافته وتجربته الديمقراطية ،فإن مؤشرات مقلقة لا تخفيها العين تشير لتراجع عن كثير من المنجزات الديمقراطية التي تحققت سابقا وتشير لمحاصرة الديمقراطيين الحقيقيين ،يجري ذلك باسم الديمقراطية وبتوظيف احد أدواتها – الانتخابات – .
وكما سبقت الإشارة فإن ما استجد أخيرا على المشهد السياسي في العالم العربي ،زعم جميع الأنظمة بأنها ديمقراطية أو لا تعارض الانتقال إلى الديمقراطية ولكن كل منها بطريقتها الخاصة،حيث لكل نظام عربي ديمقراطيته الأبوية الخاصة به.كانت الانتخابات والاستفتاءات على شخص الرئيس المرشح الأوحد (حامي حمى الأمة وراعي الديمقراطية ) ،مدخل جميع الأنظمة لولوج عالم الديمقراطية بحيث تم تعميم الانتخابات وخصوصا التشريعية والأخذ بها من طرف غالبية الأنظمة العربية مع تراجع المكونات الأخرى للديمقراطية ،حتى يجوز القول بأنه تم اختزال الديمقراطية بأحد أدواتها – الانتخابات – ،وتهميش كل مقومات الديمقراطية الأخرى وخصوصا ثقافة الديمقراطية والتربية الديمقراطية والإيمان بالتعددية وقبول الآخر والتوافق المسبق على ثوابت ومرجعيات الأمة التي لا تخضع للعملية الانتخابية وأخيرا كون الديمقراطية تعبيرا حرا عن إرادة الأمة وليس خضوعا لإملاء قوى خارجية لا يعنيها دمقرطة المجتمع بل خلق الفتنة ،تحولت الانتخابات من أداة لهدف بحد ذاته ،من أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية التي يفترض أن الديمقراطية ما قامت إلا لأجلها لهدف من خلاله يتم تكريس النظام القائم وشرعنة الاستبداد والاستغلال وكأن الانتخابات وجدت من اجل إضفاء شرعية دستورية على الحكام وليس من أجل الشعب.
حتى على مستوى العملية الانتخابية، فعندما قررت الأنظمة -برضاها أو بسبب الضغوط الخارجية –التعامل مع الاستحقاق الانتخابي تعاملت معه كمجرد آلية ميكانيكية إحصائية لتحديد من يحصل على أكبر نسبة من الأصوات،آلية يمكنها التحكم فيها وضمان نتائجها ،وتجاهلت هذه الأنظمة أن الانتخابات ثقافة أيضا،ثقافة المواطن وثقافة القائمين والمشرفين على عملية الانتخابات ،إنها الاختيار الحر للشعب ،الواعي والمدرك لفعله ولنتائجه،في المشاركة السياسية.لقد شكلت اللعبة الديمقراطية الشكلانية ليس فقط غطاء للاستبداد وملهاة للقوى السياسية ومدخلا للقوى الشعوبية لشرعنة وجودها بل حلت أيضا محل الفكر والنضالات الثورية والتقدمية حيث همشت كل المنظومة الفكرية التحررية والتقدمية والوحدوية التي طبعت الفكر العربي في مرحلة ما بعد الاستقلال مباشرة.
من خلال العملية الانتخابية الحقيقية يمكن قياس حضور وشعبية الأحزاب والقوى السياسية وإتاحة الفرصة للشعب للمشاركة السياسية بطريقة مباشرة من خلال الوصول للمؤسسات التشريعية أو بطريقة غير مباشرة باختيار من يمثلهم ،وبالانتخابات يتم إعمال مبدأ التداول السلمي على السلطة بين قوى تؤمن بالديمقراطية ومستعدة للتخلي عن السلطة في الجولة القادمة للانتخابات إن فقدت ثقة الشعب،وأهم من ذلك، فإن الانتخابات تعتبر لحظة مفارقة ومتميزة في حياة المواطن ففيها يشعر المواطن بأنه سيد وصاحب قرار في تحديد من سيتولى السلطة ،المرة والفرصة الوحيدة التي يتودد فيها الكبار للمواطن ليمنحه صوته .
عندما نُحيل الانتخابات – بالمفهوم المشار إليه أعلاه – إلى الديمقراطية ونربط هذه الأخيرة بالثقافة الديمقراطية وبحرية المواطنين بالتعبير الحر عن إرادتهم إنما لتحرير الانتخابات من حالة الابتذال التي صارت عليها العملية الانتخابية في الدول العربية حيث اختزلت لمجرد ماكينة أو عملية حسابية .في الانتخابات الديمقراطية الحقيقية لا يُعد عدد المشاركين بالانتخابات أو عدد الأحزاب المشاركة المقياس الوحيد على وجود ديمقراطية من عدمه ،أيضا لا تعتبر الشعارات المرفوعة أو الأموال المهدورة على العملية الانتخابية مقياسا على وجود الديمقراطية .المقياس على وجود انتخابات ديمقراطية هو توفر الإرادة الحرة للمواطن في التعبير عن رأيه من خلال ورقة الانتخاب بحرية لا أن يكون مضطرا لبيع صوته برغيف خبز أو بحفنة من المال أو تحت الترهيب والضغط أو تحت بريق شعارات وأيديولوجيات مخادعة.الانتخابات في بلادنا العربية لم تعد تنافسا حرا بين مواطنين أحرار،يدركون ما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات لتمثيل الأمة بل باتت صراعا بين أصحاب المال والنفوذ للهيمنة على السلطة لخدمة مصالح فئوية وحزبية لا مصالح الأمة ،وسط هذا الصراع ولخدمته يتم توظيف كل الأيديولوجيات من طرف كل من هب ودب بشكل مبتذل وتوظيف أموال منهوبة من الشعب أو جاءت من مصادر مشبوهة ،أما غالبية الجماهير الشعبية المسحوقة والمُضَللة والتي تدعي القوى المتصارعة على السلطة بأنها تمثلها وتنطق باسمها ،فتتحول لمجرد أدوات ينتهي مفعولها بانتهاء العملية الانتخابية.
إن الملاحظ لمجريات الأحداث المرتبطة بالمسار الديمقراطي الذي تم اختزاله بالماكينة الانتخابية منذ الانتخابات التشريعية في الجزائر في ديسمبر 1992 مرورا بالانتخابات التي جرت في المغرب وتونس والأردن والكويت والبحرين وفلسطين الخ– مع أن للانتخابات الفلسطينية خصوصية داخل الخصوصية العربية – وانتهاء بالانتخابات المصرية بداية ديسمبر 2010،سيلاحظ أن الصراع أو التنافس لم يكن على أساس برامج سياسية واجتماعية وحول مفاهيم ومفردات الديمقراطية بل كانت مواجهة مكشوفة بين السلطة وأعوانها ونخبها من جانب ومعارضة إما ضعيفة وممزقة أو غير متصالحة مع الديمقراطية كالجماعات الإسلامية من جانب آخر،أما الأحزاب والقوى السياسية الديمقراطية العريقة فبالكاد كان يُسمع صوتها أو لها تأثير في مجريات العملية الانتخابية أو نتائجها، والأدهى من ذلك أن بعض هذه القوى كانت تضطر للتحالف إما مع النظام وحزبه أو مع جماعات الإسلام السياسي مع علمها بان كلا الطرفين لا يؤمن بالديمقراطية إيمانا صحيحا. أيضا فإن المنعطف الخطير الذي تسير فيه الانتخابات أنها باتت تنافسا بين قوى وأحزاب بدون مرجعية وثوابت قومية توحدها،لم تعد انتخابات وتنافس بين برامج في إطار ثوابت ومرجعيات بل تنافسا وصراعا على الثوابت الوطنية ذاتها،فيما ثوابت الأمة يجب ألا تخضع للتنافس الحزبي ولنتائج الانتخابات بقدر ما تحتاج لتوافق كل القوى السياسية والاجتماعية.ارتداد الانتخابات في العالم العربي على أصولها يعكس أزمة ديمقراطية ولا شك ولكنها تعكس أيضا أزمة مشروع وطني وأزمة ثقافة وهوية .
ما يجري في تونس ومصر هو نتيجة تراكم فشل الديمقراطية الأبوية والموجهة ،إنه حصاد الديمقراطية الشكلانية ، الديمقراطية الملهاة التي غطت على القضايا الحقيقية للأمة وحالت دون بناء الدولة والمجتمع والنظام على أسس المواطنة الصحيحة. ما يجري أزمة دولة ومجتمع وهو مؤشر على فقدان ثقة الشعب بالانتخابات كآلية للتغيير وفقدان ثقة الجماهير بالقوى والهياكل السياسية القائمة وقد يكون بداية مرحلة جديدة تقرر فيها الجماهير انتزاع حقها بيدها وهذا معناه العودة لنقطة الصفر،إلى مرحلة ما قبل مسرحية الانتخابات ،ولا نستبعد أن تفكر القوى التي فقدت ثقتها بالانتخابات وفشلت بولوج السلطة من بوابة الانتخابات بالبحث عن سبل أخرى كاللجوء للعنف أو الانقلابات العسكرية.
سادسا: تجديد الثورة العربية على أسس ديمقراطية
خلال شهر واحد سيطر خطاب الثورة الوطنية على المشهد السياسي العربي مغيبا كل الخطابات الأخرى حتى خطاب الإسلام السياسي. خطاب الثورة سواء في تونس أو في مصر خطاب وطني خالص متحرر من كل الأيديولوجيات الحزبية التي مزقت وحدة الأمة طوال عقود.خلال شهر واحد اهتزت عروش الملوك وعروش الرؤساء – في العالم العربي زالت الفوارق بين الملوك والرؤساء -.لا شك أن الثورة كحدث سياسي واجتماعي وثقافي يمنحها خصوصية، وحيث لا مجتمع يتطابق مع مجتمع آخر فلا يجب أن نتصور ثورة تتشابه تمام التشابه مع ثورة أخرى.صحيح أن الفقر والبطالة من أهم أسباب الثورات، ولكن الفقر والبطالة لا يشكلا دافعا للثورة إلا إذا أحس الناس بأنهم فقراء وان هناك أغنياء يستغلونهم وهنا يأتي دور الثقافة السياسية والوعي السياسي والإعلام.أيضا سمعنا مَن وصف الثورة التونسية والثورة المصرية بأنهما ثورتا الفيسبوك والفضائيات وفي هذا تقليل من شأن الثورة ،لا شك أن تقنيات التواصل الحديثة سهلت الأمر على الشعب وعلى الثوار لتواصل أسرع وأوسع بعيدا عن رقابة السلطة وأجندة الأحزاب،ولكن تقنيات الاتصال الحديثة موجودة في كثير من البلدان وبنسبة انتشار أكثر من مصر وتونس ومع ذلك لم تحدث ثورة .كما يجب إعادة النظر بالقول بأنها ثورة شباب فقط ،لا شك أن الشباب غير الحزبيين كانوا القوة المحركة للثورة ولو ترك الأمر للأحزاب ما قامت الثورة، ولكن الثورة لم تزعزع النظام إلا عندما أصبحت ثورة كل الأمة حيث شاهدنا الأطفال والشيوخ والنساء بل كانت أسر بكاملها تشارك في الثورة،لا يعني ذلك التقليل من أهمية الشباب ومن شرعية مطالبهم ومن حقهم في صناعة مستقبل مصر ،ولكن لا نريد أن يُفهم وكأن المشكلة خاصة بالشباب وبالتالي تلبية مطالبهم بالشغل سيحل المشكلة.
الثورة المصرية – كما هو الأمر بالنسبة للثورة التونسية -كانت ثورة كل الشعب ،ثورة الشاب خريج الجامعة الذي لا يجد عملا ،وثورة الشاب الذي لا يجد شقة ليتزوج بها ،وثورة العامل الذي يتقاضى جنيهات لا تكفي لشراء الخبز فكيف باللحمة التي لا يتذوقها إلا بالأعياد ،ثورة الطبيب والمهندس وأستاذ الجامعة الذين يتقاضون راتبا بالكاد يكفيهم أجرة مواصلات وسكن ،ثورة كل مواطن أُجبِرَ أن يتحول لخادم للسياح العرب والأجانب الذين يدرون دخلا بملايير الدولارات سنويا تذهب لحساب شركات السياحة المملوكة لوزير السياحة ومافيات صناعة السياحة ولدعم أجهزة القمع الرسمية ، ثورة كل مواطن يقف بالطابور لساعات حتى يحصل على خبز أو مواد تموين مدعومة ،ثورة كل مواطن تُمتَهن كرامته كل يوم على يد رجال الأمن والشرطة والمخابرات،ثورة ملايين العائلات التي تعيش بعيدا عن عائلها الذي اضطر ليعيش في الغربية لسنوات حياة شقاء لا تخلو أحيانا من إذلال حتى يوفر لأفراد أسرته الحد الأدنى من العيش الكريم،ثورة التاجر الصغير وأصحاب المصانع والورش الصغيرة الذين سحقتهم مافيا شركات رجال الأعمال الكبار المحسوبين على الحزب الحاكم والعائلة الحاكمة. إنها ثورة كل مواطن أذله القهر وامتهان الكرامة.الثورة بهذا المعنى فعل مركب ومعقد ونجاحها بكل أبعادها مرهون بإعادة بناء النظام السياسي والاجتماعي بما يحقق مطالب كل فئات الشعب:العمال والفلاحون والمثقفون والطلاب والنساء الخ،أو على الأقل يعطبهم أملا بان غدهم سيكون أفضل من يومهم.
كثيرة هي الدروس التي نتعلمها من الثورة المصرية وكثير من الرسائل التي ترسلها الثورة المصرية،بعض هذه الدروس والرسائل أتت أُكلها مباشرة مما نشاهده اليوم في كافة العالم العربي من انتشار روح الثورة على الحكام وكسر حاجز الخوف وتجاوز ثقافة الخضوع، إلى التفاؤل بعالم عربي أفضل تسوده قيم الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ،ولكن بعض الدروس والرسائل ما زالت خفية وتحتاج إلى إيضاح وستظهر أهميتها مع مرور الزمن وبعد فورة العاطفة والانفعال التي تسيطر على الجمهور .الثورة المصرية بقدر ما أحيت من آمال وبددت من أوهام فقد أثارت تخوفات على الثورة ومن الثورة.
أولا :المد الثوري الشبابي أعاد العرب إلى التاريخ
ليس من المبالغة القول بان الثورتين التونسية والمصرية وما تلاهما من مد ثوري أعادوا العرب للتاريخ ،قبل الثورة كان يُضرب المثل بالعرب بالتخلف والانقسام والخضوع والإرهاب،كان الشعب العربي يعيش حالة من الركود والبلادة والإحباط حتى فسر بعض المراقبين الأجانب بل والعرب بأن هذا الوضع ليس جديدا عن العرب ،فالعرب منذ الأندلس خرجوا من التاريخ وباتوا عالة على الإنسانية والحضارة ،وان أقصى ما يقدمونه للعالم، مواد أولية من بترول وغاز ينفقوا مردودها على بذخ ملوكهم ورؤسائهم وعلى |أجهزة أمنية وجيوش لم تعد تقاتل إلا الشعب أو الجار العربي والمسلم،ويد عاملة رخيصة تمارس أرذل المهن في الغرب ،وإرهاب يضرب في كل بقاع الأرض بدون هدف،أما دون ذلك فهم عبئ على البشرية وعلى أنفسهم .لم يستوعب العرب الحداثة قبل أكثر من قرن وبقوا خارجها ،لم يستوعبوا الديمقراطية وبقوا خارجها أو طبقوها بطريقة مشوهة ،وبقوا مترددين بدخول عالم العولمة والتقانة .ساد اعتقاد أن العرب لن يتغيروا إلا باستعمار أو بقوة خارجية تسير أمورهم عن بعد ،وجاءت الثورة المصرية لتعلن نهاية تاريخ وبداية تاريخ جديد،تاريخ أصبح الشعب فيه سيد نفسه.
ثانيا : إسقاط فزاعة الإسلام السياسي
كان الاعتقاد السائد قبل ثورتي تونس ومصر بان جماعات الإسلام السياسي هي التي تسيطر على الشارع العربي ،وكانت الأنظمة العربية تُشيع أن الأصوليين الإسلاميين سيستولون على السلطة في حالة إذا ما تُرِك الأمر للشعب ليعبر عن رأيه بحرية من خلال الانتخابات أو من خلال الثورة ،وكانت واشنطن والغرب يعززوا هذه المخاوف ويستعملوا ورقة الإسلاموفوبيا ليبرر دعمه ومساندته للأنظمة العربية القائمة وليبرر تواجده العسكري في المنطقة.الثورتان التونسية والمصرية أكدتا سقوط هذا الوهم .في تونس كان حضور الإسلام السياسي ضعيفا جدا، وفي مصر كان لهم حضور ولكنه ليس بالشكل الذي كان يعتقد البعض، فغالبية الذين خرجوا لميدان التحرير وفي بقية المناطق المصرية لم يكونوا من جماعات الإسلام السياسي.
ثالثا : لم تكن ثورة على النظام فقط بل وعلى الأحزاب التقليدية
كان إسقاط النظام العنوان المعلن للثورة ولكن ما هو غير معلن هو رفض الأحزاب السياسية التي كانت عجزا أم تواطؤا تشكل عبئا على الشباب وعلى الحالة الوطنية،لم تطرح الأحزاب فكرة الثورة على النظام بل كان أقصى ما تسعى إليه أن يكون لها نصيب في مؤسسات النظام وضمن الدستور وقواعد اللعبة التي يحددها النظام .الشعب ممثلا بالشباب هم الذين طرحوا هدف إسقاط النظام ثم تبعتهم الأحزاب.الثورة المصرية والتونسية تفرض اليوم على الأحزاب أن تعيد النظر في بنيتها التنظيمية وفي مواقفها السياسية وفي أيديولوجيتها لتصبح أحزابا وطنية بمعنى الكلمة.إن لم تسارع الأحزاب لذلك فستصطدم قريبا بالشباب وبالشعب وخصوصا عندما تستغل الأحزاب حدث الثورة لتحقق أهدافا حزبية خاصة بها.
رابعا : عودة الروح الوطنية والفكرة الوطنية كجامع للكل الوطني .
خلال السنوات الأخيرة تراجعت الأيديولوجية الوطنية والفكر الوطني لصالح الإسلام السياسي أحيانا ولصالح أنظمة صادرت وشوهت الوطنية عندما جعلت الوطنية متماهية مع مصلحة الحاكم ورؤيته السياسية ولصالح أحزاب حاكمة حملت اسم الحزب الوطني أو شبيه ذلك مصادرة بذلك الفكرة الوطنية محولة إياها لأيديولوجيا مشوهة تخدم السلطة .الثورة اليوم ليست ثورة طبقة ولا ثورة يساريين وشيوعيين ولا ثورة جماعات إسلام سياسي ولا ثورة أجندة خارجية ، بل ثورة كل الشعب ،الثورة كشفت أن الأيديولوجيات والصراعات الحزبية حول السلطة كانت جزءا من أزمة النظام السياسي وعاملا معيقا لاستنهاض كل الأمة،لقد أكدت الثورتان التونسية والمصرية أن ما يوحد الأمة أكثر بكثير مما يفرقها ،وان حسابات الأوطان ليست حسابات الأحزاب .أكدت الثورة المصرية أن لا شرعية تعلو على الشرعية الثورية الشعبية ،وهذه لا تكون إلا وطنية لا يُعبِر عنها حزب أو أيدلوجية محددة بل تُعبِر عنها الوطنية الجامعة التي تستوعب كل الأحزاب والأيديولوجيات وتخضعها لها.عودة الروح الوطنية والثقافية الوطنية في العالم العربي ستمهد الطريق لعودة الروح القومية والثقافة القومية وبالتالي إحياء المشروع الوحدوي العربي.
خامسا :الثورة السلمية أجدى من العنف العبثي لجماعات الإسلام السياسي .
لثلاثة عقود والعالم العربي يعاني من عمليات عنف دموي تمارسه جماعات إسلام سياسي انتشرت كالفطر في كل ربوع العالم العربي من الصومال إلى اليمن ومن مصر إلى المغرب، موظفة خطابا دينيا يتناقض مع روح الإسلام السمح.كانت نتيجة هذا العنف الدموي مقتل مئات الآلاف من المواطنين وتدمير البنية التحتية وإثارة الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد وتشويه صورة العرب والمسلمين ومنح الغرب الذريعة والمبرر ليعيد هيمنته على المنطقة .هذا العنف المدمر بدلا من أن يؤدي للتخلص من الأنظمة القائمة أدى لتشديد القبضة الأمنية لأنظمة الحكم وإرجاع الأمة سنوات للوراء. خروج الجماهير اليوم بطريقة سلمية وحضارية أسقط أنظمة خلال شهر واحد أكد أن قوةة الشعب تكمن في إجماعه على أهداف واضحة وقابلة للتحقيق كما تكن في قوة تنظيمه وفي الطابع السلمي والحضاري لتحركه. كان الطابع السلمي والمنظم والحضاري لملايين الناس الذين شاركوا في الثورة هو مصدر قوة الثورة وكان رسالة قوية بأن الشعب العربي ليس مجرد جموع تهيمن عليها النزعة الدموية والانقسامية والتخريبية بل شعب يمكنه التصرف بحضارة .ولكن كبقية الشعوب حتى الأكثر تقدما وحضارة يبقى الخوف حاضرا ،فإذا ما أجهض الجيش الثورة أو التف على مطالبها فسيؤدي ذلك لتبرير العودة للعنف وآنذاك سيكون أكثر تدميرا وشمولية.
سادسا:مركزية دور مصر في المنطقة
مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الاستقرار في مصر ما بعد الثورة ومحاولات الالتفاف على الثورة الشبابية وأهدافها،إلا انه من المؤكد عندما تنهض مصر تنهض الأمة العربية وعندما تنتكس مصر تنتكس الأمة العربية .فعندما تبنت ثورة يوليو الفكر القومي ورفعت شعارات ثورية وتقدمية معادية للاستعمار ولإسرائيل استحقت قيادة الأمة العربية حيث كانت صور عبد الناصر تُعلق في كل بيت من صنعاء إلى مراكش،آنذاك لم تجرؤ دولة أو نظام عربي على منافسة مصر في دور الريادة،ولكن عندما اعترفت مصر بإسرائيل وربطت نفسها بالمشروع الأمريكي الغربي وعندما تحالفت مع واشنطن بالعدوان على العراق ،فقدت دور الريادة وتجرأت أكثر من دولة لمنافسة مصر على دور الزعامة حتى قطر و ليبيا.كان لخروج مصر من ساحة المواجهة مع إسرائيل نتائج مدمرة على القضية الفلسطينية ،فالنظام المصري إن لم تكن متواطئا مع إسرائيل كان يشكل عائقا أمام الفلسطينيين والعرب وانتهاج طريق الثورة والتصدي للمشروع الصهيوني أو البحث عن معادلة سلام أكثر شرفا من المعادلة الراهنة.الثورة المصرية، وما سيترتب عليها من تداعيات في المنطقة،أحيت الأمل بان تستعيد مصر دور الريادة في العالم العربي وأحيت الأمل بإمكانية إعادة النظر بنهج التسوية الذي ساد خلال العقود الماضية، وإن كان الأمر سيحتاج لحين من الوقت لأن الانشغالات الوطنية ستشغل مصر لفترة من الزمن عن القضايا القومية.أيضا عدم تجاهل القوى التي تسعى لتحويل الثورة لفتنة.
سابعا : لا تكتمل الثورة إلا بإنجاز أهدافها
لا تنتهي الثورة بإسقاط الرئيس أو الملك ،هذه مرحلة أولى من الثورة وهي مهمة في رمزيتها،فمجرد تخلي مبارك عن منصبه خلق حالة من الارتياح والفرحة العارمة عند غالبية الشعب واعتقد كثيرون أن الثورة حققت أهدافها ،ولكن الثورة لا تنجز مهمتها وتكتمل رسالتها إلا إذا أقامت نظاما سياسيا واجتماعيا بديلا عن القديم،المرحلة الأولى تهيمن عليها العاطفة والانفعال وردود الأفعال ،أما المرحلة الثانية فهي مرحلة العقل والحسابات الإستراتيجية،وعليه يجب الحذر الشديد في الانتقالية الراهنة والمرحلة الثانية الآتية،وفي التجربة الثورية المصرية توجد أكثر من جهة محلية ودولية معنية بالتدخل في عملية إعادة بناء النظام السياسي بما لا يخل بمصالحها،والخشية أن تتلاقى مصالح أطراف داخلية وخصوصا من قيادات في الجيش وبقايا نخبة الحزب الوطني مع أطراف خارجية لتوجيه الأمور بعيدا عن المطالب الحقيقية للقطاع الأوسع من الشعب .من خلال التجارب التاريخية فإن كل الثورات تتعرض لمحاولات سرقتها أو حرفها عن مسارها ،وأن الجماهير التي تقوم بالثورة في مرحلتها الأولى ليست نفسها التي ستعيد بناء النظام الجديد،فجماهير ميدان التحرير سيعودون لبيوتهم اليوم أو غدا ليستلم آخرون مقاليد الأمور. أيضا التجارب التاريخية تؤكد أن الثورة لا تنجز أهدافها دفعة واحدة بل تحتاج لوقت ،المهم أن يحافظ الشعب على روح الثورة وألا ينفرط عقد الإجماع الوطني الذي جسدته الثورة في مرحلتها الأولى،وفي جميع الحالات فإن حال مصر والمنطقة العربية بعد اندلاع الثورة لن يكون حاله قبلها.
خلاصة
ما جرى ويجري في تونس ومصر وبقية البلاد العربية يمكن توصيفه بالظاهرة غير المسبوقة في التاريخ العربي الحديث من حيث حجم واتساع التحرك الشعبي وقوة المواجهة بين الشعب وأجهزة الأمن ، ما جرى فاق كل التوقعات ولا نعتقد أن أحدا يزعم بأنه كان يتوقع صيرورة الأمور إلى ما صارت إليه.ولأن الأمور سارت بهذه الوتيرة السريعة فإن غالبية التحليلات والتعليقات أتسمت بالانفعالية والعاطفة أكثر مما هي ناتجة عن دراسات معمقة ،وعليه فإنه من التسرع الحكم بان المشهد الذي جرى في تونس سيتكرر بنفس الشكل في بقية الدول العربية .
بقدر ما أثارت الثورتان التونسية والمصرية الإعجاب والتقدير عند الشعوب العربية بل كسبتا احترام كل شعوب الأرض لأنهما أكدتا بأن الأمة العربية بخير وبأن الخلل ليس بالشعب بل بنخبه وقياداته ،إلا أنهما في نفس الوقت أثارتا الخوف ،الخوف عليهما من لصوص الثورات من الديماغوجيين الجدد ومن بقايا نخبة النظام السابق والخوف من الثورة نفسها بأن تاستمرئ الجماهير أو بعضها حالة الفوضى والخروج للشارع مما سيسيء للثورة.كما أن سيرورة الثورات في البحرين واليمن وليبيا وسوريا تثير التخوف من انزلاق بعض الثورات لحرب أهلية بل إقليمية.
مارس 2011