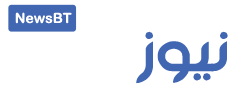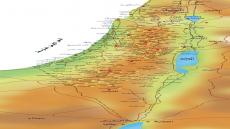أهمية البيت في الوجدان الشعبي الفلسطيني:للبيت مكانة عاطفية مرموقة في الوجدان الشعبي الفلسطيني؛ فهو يرمز للسعادة العائلية ووحدة الأسرة والستر، وليست هناك سعادة عائلية بدون بيت يضم الأسرة، ونحن نستدل على ذلك من أمور عدة، إذ إن الفلاح الفلسطيني وكذلك الفلسطيني المشرد أعطيا أهمية فائقة لوجود البيت، وعندما كان الواحد منهما يحصل على النقود كان يفكر في بناء بيت، أو شراء أرض والزواج، وحتى الآن فإن كل هذه الممارسات ترمز إلى حس إنساني غريزي في الرغبة بأن يكون للإنسان وجود ثابت في بيت وعلى أرض ومع أسرة، هذا فضلاً عن تعبير حقيقي من جانب الإنسان الفلسطيني في الانتماء والولاء للأرض. إن الفلاح يجوع ليوفر ما يعينه على إكمال بناء بيته، وتعتبر مساعدة الفلاح في بناء بيته واجباً أدبياً على كل أهل قريته، وهم يقومون بما يسمى “عونة” –معاونة– عند العقد، ومن أكثر أمنيات اللاجئ الفلسطيني أن يكون له بيت، ففي المخيم أعطت “وكالة الغوث” اللاجئ الفلسطيني خيمة صغيرة، أو ساعدته في بناء غرفة واحدة، لكن هذا اللاجئ سرعان ما تخلص من الخيمة وأضاف للغرفة غرفاً أخرى أو بنى بيتاً كبيراً متعدد الطوابق، ومن السهل أن نشاهد هذه البيوت في مخيم الوحدات (الأردن)، اليرموك (سوريا)، صبرا (لبنان) وغيرها من المخيمات الفلسطينية. وفضلاً عن التوسع في البناء، فإن المخيم الفلسطيني يعطى انطباعاً آخر من ناحية الحس الغريزي في التمسك بالأرض من خلال زراعة أشجار العنب والزيتون والأشجار الباسقة، فبمجرد أن ينشأ مخيم في منطقة ما سواء كانت خضراء أو مقفرة حتى يبدأ اللاجئ في تحويله إلى ما يشبه الغابة الخضراء. إن هناك أقوالاً شعبية تؤكد أن البيت هو رمز السعادة العائلية ووحدة الأسرة. (فش مثل بيتك يا الإنسان)، بمعنى لا يوجد ما هو أكثر جلباً للسعادة مثل البيت. ففي البيت يشعر الإنسان بحريته من القيود، لدرجة أنه من الممكن أن يملأ فمه بالطعام بصورة كبيرة وبلا حرج، وهذا ما لا يفعله أمام الآخرين. (ريت هالبيت يظل مفتوح والحبايب تيجى وتروح)، إن القول المأثور يربط بين وجود البيت، فالبيت المفتوح رمز لوجود الإنسان وللمكان الذي يلتقي فيه الأصدقاء والأحباب، ومن أكثر الأمور التي يفتخربها البدوي الفلسطيني هو أن يكون له “بيت شعر” (خيمة كبيرة من شعر الغنم)، تأوي إليها أسرته، ويتردد عليها الضيوف. (بيت ربانى ما راح وخلانى)، حتى البنت التي تغادر بيت أهلها إلى عش الزوجية تظل تفتخر بالبيت الذي رباها وتحس بالسعادة لوجوده، فذلك البيت لا يتخلى عنها. وتعتقد المرأة الفلسطينية في الوسط الشعبي أن “البيت” ليس مجرد بناء فحسب، بل هو ذو محتوى أساسي، وذلك المحتوى هو الرجل وأن قيمة البيت بمحتواه، بمعنى أن البيت الذي لا يضم رجلاً يعتبر بيتاً ناقص المحتوى، فالرجل سواء كان زوجاً، ابناً أو قريباً هو “شمعة البيت”، ” نوارة البيت”، “عمود البيت”، وتشهد بذلك أساليب الدعاء بالخير والتي تصدر من امرأة لأخرى، مثل: “الله يخلي لك عمود بيتك”، الله يخلى لله نوارة بيتك، الله يخلي لك شمعة بيتك. ونجد في سيرة “الزير سالم أبو ليلى المهلهل”، أن البنات والنساء كن في غيبة الزير يسكن في بيت لا يشعلن فيه النور، وعندما وصل الزير السالم فجأة؛ وبعد غيبة سبع سنوات بادرت إحداهن إلى إضاءة البيت، وزغردت رمزاً إلى أن الرجل هو “شمعة البيت” الحقيقية، وأن البيت بدون الرجل يظل معتماً حتى لو أشعلت فيه نور. إن الرجل هو المنتج الوحيد لغذاء الأسرة، وعليه وحده يتوقف بقاؤها، كما أن الرجل هو المدافع عن النساء والأرض، وهذا فضلاً عن أن الحياة الاعتيادية والسوية لا تتوفر في بيت ليس فيه رجل، ونحن نتحفظ هنا بالقول بأننا نسوق هذا الكلام ليس بهدف الانتقاص من مكانة المرأة، بل لنساعد المرأة المعاصرة لترى صورتها في التراث، ولتتأكد بأنه لا يمكن للمرأة أن تنال كامل حقوقها، إذا ظل الرجل هو المنتج الوحيد لغذاء الأسرة. الدار مصدر فخر: إن وجود الدار لدى الإنسان في الوسط الشعبي وعلى الأخص إذا كانت كبيرة وجميلة وحديثة، فهي مصدر فخر وتباه، ونجد هذا التفاخر ينساب في الأغاني النسوية الشعبية وفضلاً عن كون الدار مسكناً للأسرة، فهي أيضاً تحقق أهدافاً أخرى، ومن هذه الأهداف إن الدار الواقعة على الطريق العام أو على مفترق الطرق هي المكان الذي يقصدها الضيف والعطشان.
ونسمع في أغاني نساء بدو النقب التفاخر بوجود الدار الواقعة على “الدربين” مفترق الطرق وقد ارتفع صوت “دق القهوة “، كدعوة مفتوحة لكل الناس للمرور بهذه الدار وتناول القهوة. دامت عينك يا عابد بانى بيتك ع الدربين يللى قهوتك بتدق وفناجيلك ع الصفين. إن بناء الدار هو دليل على القدرة المالية، وبالتالي فإن إثبات هذه القدرة يتم عن طريق بناء بيت، و أبرزها كدعم للادعاء بتلك القوة. لولانا مقدرين ما عقدنا عقود لا جبنا من بنك ولا بعنا زيتون وتظهر الدار الكبيرة والجميلة مصدر فخر في كونها تصلح لاستضافة “العسكر”، إن كلمة العسكر هنا ترمز لكل الحكام الذين تعاقبوا على أرض فلسطين، وكما هو معروف فإن أولئك الحكام الأجانب والمستعمرين كانوا يمثلون أشكالاً من القمع والتعسف تتجه دوماً لابتزاز الشعب وتجاوز حقوقه، وكان الشعب يثور عليهم ويحاربهم، ثم يضطر في بعض المراحل لاسترضائهم ومسايرتهم، وهل هناك ما هو أفضل من الدار الكبيرة لاستضافتهم ؟ إن الذي يلقى نظرة على المراجع التاريخية التي تتحدث عن حياة شعبنا في القرن التاسع عشر، أو يستعرض الصحافة اليومية التي تسجل تشريد شعبنا، ودمار قراه ومساكنه ابتداءً من أوائل هذا القرن وحتى الآن يلاحظ بوضوح القمع المنظم والسحق المتواصل الذي يعانيه هذا الشعب، ويتمثل في ضربه بدون رحمة وبلا هوادة. إن سبايردون مؤلف “اليوميات الفلسطينية”، كذلك محرر الأخبار في أي صحيفة يومية معاصرة يوصلاننا إلى نفس النتيجة: ففي فترة مقاومة الفلاحين لحملة إبراهيم باشا، كان يشرّد أهالي قرى بأكملها، ويذبّح الرجال بالعشرات والمئات ويدمر أشجار الزيتون للانتقام. وفى فترة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين تسحق القرى عن آخرها، وتدوس البلدوزرات أكواخ الخشب والصفيح في المخيمات، وتقطع أشجار البرتقال في غزة وقلقيلية، وتسمم الطائرات مئات الدونومات من المحاصيل، وتتعدى الآلة العسكرية الإسرائيلية الحدود العربية لتلاحق الرشيدية والبداوى والبارد، وتزال مخيمات عن الخارطة مثل ضبية، وكرنتينا، وتل الزعتر في الحرب الأهلية اللبنانية بتدخل مباشر من الإسرائيليين. ويبدو أن الظروف المعاكسة مستمرة في مواكبة هذا الشعب، والذي يواصل عبر الزمن نضاله المستميت من أجل تحقيق حريته في أرض آبائه وأجداده (أرض فلسطين)، وتحت سقف بيت أحس فيه بالأمان، هو وعائلته التي لا ذنب لها سوى أن هناك طامعين وغرباء، جاؤوا من أطراف الأرض، ويصرون على الاستحواذ على أرضه وطرده من بيته. ونحن هنا نستعرض أمثلة من الأيام القاسية التي جابهت عامة الناس بسبب الغزوات الخارجية أو الحربات التي كان يؤججها الأشياخ والمتنفذون، فيجعلون من الفلاحين وقوداً لها. نقرأ في (اليوميات الفلسطينية) عن مصطفى باشا (الوالي العثماني)، الذي أغضبه رفض أهل قرى القدس دفع ضرائب غير قانونية فوق العشر، فأمر بتدمير قراهم. وعندما ذهب جنوده ليفعلوا ذلك في شباط من عام 1825، “لم يجدوا سوى بيوتاً فارغة وأكواخا”. وتحدثنا هيلما جرانكفيست عن الأزمات والمآسي التي مرت بأهالي قرية أرطاس (بالقرب من بيت لحم) قائلة: “وعندما أتت الحرب الأهلية على الجزء الأكبر من السكان، أجبر الباقون على الهرب من القرية” وتضيف: “إن مثل هذه الحوادث كثيراً ما كانت تحدث في فلسطين، وكانت تجعل مراكز التجمع السكاني غير مستقرة. وبعد مضي الوقت وعندما يمر الخطر كان اللاجئون، أو أحفادهم يعودون إلى بيوتهم القديمة”. إن حرباً أهلية من الممكن أن تحدث لمجرد حدوث اعتداء على أمر، وفى حالة كهذه يضطر أقارب المعتدى للجلاء عن القرية. فبعد أن قتل تسعون شخصاً هرب دار عودة (من أرطاس) إلى وادي فوكيين، وهربت عشيرة ربيع إلى قرية خنزيرة (الكرك)، وهربت جماعات أخرى إلى الخليل وبيت أمر وعجور، واستغرق الارتحال هذا أكثر من مائة عام، وفى عام 1830 عاد الناس إلى أرطاس، وفى عام 1828 زارها إدوارد روبنسون، ليذكرها تحت اسم “قرية أرطاس الخربة”، وليقول: “ما زال المكان مأهولاً وعلى الرغم من أن البيوت كانت خرائب وأطلالاً، فإن السكان يقيمون في الكهوف وبين الصخور. أسهمت غارات البدو على القرى في استمرار خراب البيوت، ويروى أن أهل أرطاس الذين عادوا لقريتهم بعد الأحداث الآنفة الذكر، لم يستطيعوا إعادة إعمار القرية بسبب غزوات عرب التعامرة، واستمر أهل أرطاس يعيشون في القلعة الخربة والواقعة مقابل برك سليمان -على الطريق من القدس إلى الخليل، وفي النهار كان أهل أرطاس يأتون إلى القرية لزراعة الأرض، وفى الليل يتراجعون إلى القلعة. وحصل نفس الشيء في أرطاس عام 1848. ونجد أمثلة أخرى صارخة في ما كتبته السيدة فن، زوجة القنصل البريطاني في فلسطين والتي عاشت سبعة عشر عاماً ونصف العام في البلاد، تمكنت فيها من إتقان اللغة واتصلت اتصالاً مباشراً بالعامة من الشعب الفلسطيني. وهى تحدثنا عن “قرى كاملة أرسل كافة الرجال فيها إلى التجنيد في جيش السلطان العثماني، ولم يبق أحد ليقوم بمهمة إعمار القرى، كما تحدثنا عن “الحرابات”، التي كانت تجرى بين أهال القرى المنتظمة في صفوف ” القيس”، وتلك القرى التي في صفوف “اليمن”، وتقول: ” كانت النار تشتعل في كل قرية. لقد تضافرت أحداث تاريخية وتقاليد عشائرية قديمة على بعثرة السكان و إعادة توزيعهم، نأخذ ذلك مثالاً قوياً ما ذكره الراوية “موسى أبو علقم”، لقد تشرّد هذا الرجل سنوات طويلة في البلقاء هرباً من التجنيد الإجباري التركي، وجعل من نفسه بدوياً اسمه سالم، تاركاً قريته “دير نظام” -رام الله- عدة سنوات، وبعد أن عاد إلى قريته بعد طول غياب تورط في حرب عشائرية ثأرية بين أهل قريته و أهالي مسكة (طولكرم)، وبدأ رحلة الشتات شمالاً ماراً بقرى: الطيبة، جت، باقة الغربية، الخضيرة، عرب الحوارث، أم الدفوف، السنديانة، الشفية، وأخيراً استقر في قرية السنديانة. إن مثل تلك الأحداث أدّت إلى ما يلي: 1- نلاحظ من خلال المرويات وقراءة كتب الرحالة أن عدد القرى كان (في أوائل هذا القرن) ضئيلاً بالنسبة لمساحة الأرض. 2- حجم القرية الواحدة صغير والبيوت ضئيلة البنيان وصغيرة لدرجة حجم الأكواخ، لكن هذه القرى كانت مغمورة بالطبيعة الخضراء من بساتين وحدائق يانعة كما يصفها القنصل الذي زار أرطاس بصحبة باشا القدس عام 1854 ودهش لجمالها وخضرتها. 3- كثرة وجود الأماكن الخربة والمدمرة سواء ما دمر منها منذ أيام الكنعانيين أو ما دمر منها في القرون الوسطى. وليس الحال بأفضل في الأحداث المعاصرة؛ فهناك العديد من الأحداث المؤلمة التي مازالت مثالاً صارخا يتوج المجتمع الدولي بعار السكوت على مرتكبيها وبتأييدهم، ومن هذه الأحداث: أحداث ثورة 1936 في فلسطين، كانت قوات عسكرية بريطانية تخلي البيوت من أصحابها لتنسفها بدعوى قيام أهلها بإيواء الثوار، ودعمت حكومة الانتداب البريطاني على فلسطين أطماع اليهود في شراء وسلب الأرض العربية، واستعملت الجند لإخلاء المزارعين من بيوتهم بقوة السلاح، مثل ذلك حصل لعرب الحوارث بعد أن باع آل سرسق أرض مرج بن عامر. وفى مستهل حرب عام 1948، مارست العصابات الصهيونية حرب إبادة وترويع بهدف إجبار الناس على ترك بيوتهم والفرار من وجه الفظاعة والوحشية، وعندما كانت العصابات الصهيونية تجد عدداً قليلاً من الناس في قرية ما كانت تدفعهم للانضمام إلى أهل قرية أخرى، ثم تجبر الجميع على الاتجاه شرقاً. وبعد عام 1948، كانت القوات الإسرائيلية تعبر الحدود إلى الضفة الغربية لتدمر البيوت وتنسفها فوق رؤوس الآمنين بحجة الانتقام من رجال المقاومة، وحصل ذلك في العديد من الأماكن مثل: قلقيلية، وقبية، ونحالين، وحوسان، وفوكين، والسموع. وخلال سنوات الاحتلال الطويلة تركت قوات الاحتلال جماعات من أهالي فلسطين المحتلة يعيشون “لاجئين فلسطينيين” داخل فلسطين المحتلة، مثال ذلك ما حصل لأهالي قريتي أقرت وكفر برعم، إن هناك “حرباً سكنية” قائمة تديرها حكومة إسرائيل ضد شعب فلسطين العربي، فهي تمنع العرب أو تعرقل رغبتهم في بناء بيوت جديدة وفى نفس الوقت تبنى آلاف المساكن لليهود الغرباء، إن الحكومة الإسرائيلية تلجأ لأساليب شتى لمنع الناس من بناء بيوت جديدة بهدف تقليص وجود البيت العربي وبالتالي تقليص وجود الإنسان العربي. وعندما استولى المعتدون الإسرائيليون على الضفة الغربية بعد حرب 1967 هدموا بيوت قرى كاملة مثل يالو وبيوتاً أخرى كثيرة في قرى مثل زيتا وقلقيلية. واستعملت قوات الاحتلال قوانين تبيح للحكام العسكريين نسف أي بيت يقتنعون أن صاحبه هو من رجال المقاومة أو من المتعاونين معهم، وقد هدموا بيتاً بحجة أن أماً جاءها ابنها الفدائي ذات ليلة وهو جائع وعطش فأطعمته وأسقته، واعتبر ذلك “تعاوناً مع العدو” وهكذا عندما نسمع السامرين في قرية فلسطينية يغنون: يا دار من عدنا كما كنا لاطليك يا دار بعد الشيد بالحنا. فأننا نفهم من وراء تلك الكلمات صدى كل تلك الزحوف من قوات الاحتلال، وليس ذلك عبر القرون الأخيرة بل وعبر تاريخ هذه المنطقة التي توالت عليها زحوف قوات شعوب ما بين النهرين، مصر بلاد اليونان والرومان والأتراك والمماليك. إن المسألة هي مسألة ” توارث الحزن ” فالمآسي التي خلفتها أعمال العنف والقسوة ترن في ضمير الشعب وتوارثها الأجيال، وإلا كيف نفسر أن وجدان شاب لم يكمل السنة العشرين من عمره يغني للدار فيملأ جنبات المكان حزناً على الدار التي كانت عالية فأصبحت أطلالاً إذ يقول: يا دارنا يا دمعة المسكين يا دارنا يا بسمة الحلوين يا دارنا يا رمز للإنسان يا دارنا زهرة بفلسطين إن مثل هذا الشاب – الشاعر الشعبي موسى حافظ موسى- لم يرد داره التي هجرها أبوه، ولم تكتحل عيناه بمرآها، ولم يكن هناك تماس مادي بينه وبين الدار، إنه لم يبين داراً ولم يخسرها، لكنه رضع الحزن على فراق الدار من والديه، وعاش في مجتمع يبكي حزناً ولوعة على خسارته للدار والأرض وهو كشاعر شعبي وابن شاعر شعبي ذائع الصيت عكس الحزن الذي يعتمل في صدر شعبه. إن هناك العديد من النصوص التي تتحدث فيها الأغاني والأشعار الشعبية بلهجة الحزن الذي يفتت الأكباد على الدار المهجورة، ومن الصعب جداً على الباحث المعاصر أن يربط بين كل أغنية حزينة وبين الحادثة التاريخية السريعة التي قذفت بالسكان بعيداً عن بيوتهم، ولم تظل لهم سوى الذكريات والحزن من وسيلة للارتباط بالدار المهجورة، إن مقطوعة مثل: يا دارنا يا أم الحجل والطوق يا عالية مشرعة لفوق يا دارنا يا أم الحجر لحمر احنا رحلنا وغيرنا توطن يمكن أن تنسحب على كل الأحداث المريعة التي تعرض فيها الفلاحون الفلسطينيون للهجرة من بيوتهم، لكن هذه الفقرة والتي تقول: يا دارنا إن نزلوك عربان غيرنا توصى بهم يا دار حتى نعاود لا بد وأنها قيلت أثر هجمة عشائرية على مجموعة من القرى، فأسرع الفلاحون هاربين بأرواحهم وأرواح عائلاتهم وتركوا البيوت ليسكنها الغزاة الجدد من العربان. هندسة القرية والمدينة الفلسطينية: مسألة موقع البناء تتضمن مغزى خاصاً حول اختيار الإنسان في الوسط الشعبي المكان الذي يراه الأنسب لبيته، ونحن نرى أن الكثير من القرى الفلسطينية تحتل رؤوس الجبال والتلال ولا شك أن هناك اعتبارات كثيرة أملت هذه الرغبة. وأولى هذه الاعتبارات الرغبة في الاستفادة من حصانة الجبل، فالخبرة منحت السكان عقيدة راسخة بأنهم يقعون في الممر الرئيسي لجيوش الغزاة. وفى ظل الحكم العثماني كانت الزعامات المشيخية الفلسطينية تبني القرى والقلاع في رؤوس الجبال؛ للتحصن فيها بوجه ولاة الدولة العثمانية الذين كانوا يبتزون السكان أصنافاً غير مقررة من الضرائب، وفى تلك الأماكن الجبلية الحصينة كان المدافعون يتمترسون أسابيع وشهوراً دون أن تلين لهم قناة، وفضلاً عن ذلك فإن الأماكن العالية تعتبر مواقع يسهل الدفاع عنها ضد غزوات التجمعات المحلية المجاورة، في ذلك الوقت الذي لم تتطور فيه أسلحة الدمار والتي لم تستطيع التغلب على صعوبات الموقع. وفى زمن الحرب الصليبية بنيت مقامات الأولياء والأنبياء فوق أضرحة وهمية على رؤوس الجبال؛ بهدف أن تكون أيضاً أمكنة لتجمع الناس ولمراقبة تحركات الصليبيين، ومن الطبيعي وبدافع ديني محض أيضاً أن تنمو حول المكان قرية. وكذلك فإن وقوع القرية في المرتفعات يعرضها بدرجة أقل لأخطار المياه والفيضانات. وهناك عامل نفسي لا يمكن إنكاره، ومؤداه أن الإنسان بطبيعته ميال للبحث عن الأماكن العالية المشرفة على كل ما يحيط بها؛ انطلاقاً من إحساسه بالرغبة في التفوق والسيطرة. وتبنى القرى في المرتفعات حتى لا تكون المقابر في قيعان الوديان فيجرى الماء فيها وينقل أجزاء من الجثث المتفسخة إلى الينابيع. وقد بنيت القرى على الجبال بهدف السيطرة والإشراف على الحقول والبساتين، إذ عندما تكون الأبنية في الأماكن العالية، يصبح من السهل مراقبة المزروعات وحمايتها من اعتداء الإنسان أو الحيوان، ومن السهل تفهم هذا الاعتبار إذا لاحظنا سيادة فترات الفوضى وعدم توفر الضابط الأمني، وخاصة في العهد العثماني، أضف إلى ذلك أن سنوات المجاعة والمحل في ذلك العهد جعلت من الاعتداء على ممتلكات الغير أشبه ما يكون برياضة قومية يمارسها الجياع دونما اعتبار لحقوق الملكية. وفى حالات أخرى نرى أن الرغبة في البقاء بالقرب من الماء يجذب القرية من القمة إلى الوادي كما هو الحال في قرى سلوان ولفتا وأرطاس، لكن هذه الحالات لا تصلح كأساس للتعميم، فهناك الكثير من القرى التي تقع على رؤوس الجبال و تضحي بالكثير من الجهد والوقت لنقل الماء من الينابيع الواقعة في قاع الوادي إلى قمة الجبل، ومن الأمثلة على ذلك: قريتا دير نظام والنبي صالح في قضاء رام الله والواقعتان على قمتين متقابلتين، بينما يقع الينبوعان اللذان منهما ترتوي القريتان في أسفل نقطة في الوادي. المدن الفلسطينية المسورة: إن البلاد في القرن التاسع عشر كانت تعيش جو القرون الوسطى بكل ما في هذا الجو من فقدان السلطة الحكومية المركزية، وتنامي سلطة الأشياخ المحليين، والسلطات المحلية بصورة عامة، فإن أسلوب البناء في كل قرية كان يعتمد على تلاصق المباني وكذلك الأمور في المدينة مع وجود السور. وبسبب مسألة فقدان الأمن والخوف من الغزاة مع عدم وجود سلطة مركزية حاكمة كانت شوارع المدينة ضيقة جداً، وتعرج لتسهل مقاومة الغزاة أو حتى اللصوص، وعندما تغيب الشمس تغلق أبواب المدينة نهائياً، ولا يسمح لأحد بالدخول، وتزدحم الشوارع الضيقة بقوافل الجمال المحملة أو الحمير التي تحمل الماء أو الحطب. لقد شاهد تومسون قوافل الحمير تعبر شوارع القدس والمدن الفلسطينية الأخرى الضيقة، لدرجة أن حملها كان يصطدم بالجدران وأرضية الشارع، بحيث لم يجد هو متسعاُ ليمر، فاتكأ داخل فجوة في جدار الشارع وسمع صيحات الرجال الذين يسوقون تلك الدواب وهم يقولون: وشك ظهرك وشك (بكسر الواو وتشديد الشين المفتوحة) أي أن تصطدم الأحمال بوجهك أو ظهرك. وتحمل الشوارع والأسواق اسما مشتقاً من صفة العمل الذي يجرى فيها، أو ملامح السكان الذين بنوا بيوتهم فيها، لنأخذ بعض الأمثلة: حارة المغاربة: لتجمع بيوت المغاربة فيها سوق النحاسين: حيث يعمل مصنعوا النحاس سوق الحدادين: حيث يعمل الحدادون. ويجوز لنا الاعتقاد أن مسألة التجاور بين بيوت الحمولة الواحدة قد تطورت عن تجاور خيام -أو بيوت الشعر- للقبيلة، والذي لابد أن يكون قد حصل عندما تطورت القرى الزراعية عن مضارب الخيام؛ فبنى أفراد الحمولة الواحدة بيوتهم متجاورة لأسباب عدة منها: الرغبة في تجاور ذي القربى، والتعاضد والتكاتف أثناء الشدة، ونأخذ على هذه الظاهرة مثالين: المثال الأول: قرية دير الغصون (طولكرم) وفى هذه القرية ثلاث حارات متمايزة هي: 1- حارة الصورا (بفتح الصاد المشددة وفتح الواو). 2- حارة الخليلية: وتقع مساكن الحارة الأولى في الجزء الشرقي من البلد، بينما تقع مساكن الحارة الثالثة في الجزء الغربي منها، أما الحارة الثانية فتكِّون مع الحارتين الأولى والثالثة رأس مثلث وتقع في الجزء الجنوبي من البلد. و يوحي اسم “دار غانم”، كما يوحي اسم الخليلية (بمعنى القادمين من الخليل)، بأن عشيرة واحدة أو عدة عشائر مختلفة من مدينة الخليل أو قضاء الخليل أصبحت تحمل اسماً جديداً بعد أن سكنت في منطقة جديدة بشكل متجاور، على الرغم من أن أسر الحارات لا ترتبط بعلاقات قرابة مباشرة، فإن الجميع أفرادها يحسون بالانتماء إلى ما يشبه القبيلة وهي “الحارة”. 2- وأما المثال الآخر فهو القدس: وقد سكن هذه المدينة أتباع الديانات المختلفة في مناطق منفصلة، بحيث سكن كل أتباع ديانة واحدة بشكل متجاور، وعلى نحو المثال الذي رأيناه في قرية دير الغصون، وهناك على سبيل المثال: – حارة المسيحية – حارة الأرون: حارة اليهود – حارة المغاربة. وعلى هذا النمط تجاور في المدينة المقدسة، ومدن فلسطينية أخرى، أصحاب الحرف في أسواق مثل: سوق الصياغ الريفي العطارين، سوق القطانين، سوق الخضرة. ونلاحظ مسألة التجاور هذه في مدينة الناصرة، فبينما يسكن الأرثوذكس اليونان في شرقي المدينة، يسكن الروم الكاثوليك والمارونيون واليونان الكاثوليك في غربها وفى جزء من الوسط، والناحية الجنوبية كلها يقطنها المسلمون. لقد كان لكل مدينة فلسطينية أسوار، ولهذه الأسوار بوابة أو أكثر، وداخل البوابة يزج بالناس وبكل شيء ذو قيمة من قطعان المواشي، الجمال، الخدم وكل ما يملكه المجتمع، وعند المساء ترى الآدميين وحيواناتهم يسرعون إلى داخل الأسوار خوفاً من الظلام. وفى مدينة الناصرة اعتبرت التلال المحيطة بالمدينة أشبه بحام لها، وهكذا وجدنا البيوت ذات الغرفة الواحدة والتي حملت جمال الكوخ الريفي الفلسطيني. وفى مدينة يافا تحمل بوابات السور أسماء مأخوذة من واقع المنطقة التي توجد فيها البوابة ولنأخذ بعض الأمثلة: – باب البحر لأنه يؤدي إلى البحر – باب الخليل لأنه يؤدي لمدينة الخليل – باب الدباغة لقربه من الشارع الذي تكثر فيه محلات دبّاغي الجلود. – باب الشريعة لقربه من سرايا الحاكم ونجد في كتاب ماري إليزا روجرز، ولورانس أوليفات، إشارات لسور كان يحيط بمدينة حيفا ولكن الزمن قد أعفى عليه. ولأن المباني تكون متلاصقة داخل أسوار المدن، فإن لبوابة المدينة أهمية خاصة ولذلك وجدنا أن البوابة دائماً تكون ذات قبة وظلال، وعند البوابة يجتمع السكان ويلتقون، وبعضهم يذهب إلى البوابة لتلقي الأخبار من القادمين إلى المدينة، وكذلك فإن الذهاب إلى بوابة المدينة هو واحدة من الفرص للمشاركة في تجارة، أو الاشتراك في قافلة مسافرة. وقد أعطت بوابة المدينة أهمية خاصة من ناحية الأمن؛ على اعتبار أنها مدخل المدينة ونقطتها الإستراتيجية الرئيسية، ولذلك كانت محروسة بصورة خاصة ومزودة بالأبراج والطلاقات. وفى أيام الحزن يبكي الناس مصابهم في اجتماعاتهم عند بوابة المدينة، وعند هذه البوابة يحتفلون في مناسبات الفرح ويهزجون ويرقصون. وعند بوابة المدينة يجلس القاضي ورجال للفصل في أمور الناس كما يجلس كاتب الرسائل. القرى الفلسطينية المحصنة والمسورة: قلنا أن البلاد -فلسطين- كانت تعيش في القرن التاسع عشر أجواء العصور الوسطى، ولذلك كان أشياخ البلاد وزعماؤها الإقطاعيون يسكنون في قرى محصنة ومسورة، مثلما كانت تحصن وتسور مدن فلسطينية أخرى مثل القدس، حيفا، يافا، عكا. وتخبرنا ماري إليزا روجرز: أن شفا عمرو كانت لها قطعة تحميها، وأن بيت محمد بك عبد الهادي في عرابة، كان يضم طابقاً أرضياً يشغله الجنود والخيل، وأن ديوانه في الطابق الثاني كان غرفة واسعة ذات قبة، وكانت نوافذه ذات أقواس، وقد سيطر الديوان على الوادي وكذلك على بوابة المدينة، وهذا يعني أنه كان لقرية عرابة سور. ونقرأ في الأصول العربية لتاريخ سورية في عهد محمد على باشا، وكذلك ما كتبه مصطفى مراد الدباغ، أخباراً متفرقة عن تحصينات قرية عرابة، ويبدو أن هذه التحصينات كانت قد سببت مضايقة كبيرة للدولة العثمانية لدرجة أنه عندما هاجم الجيش العثماني عرابة في 17 نيسان 1859، واستولى عليها، دُمرت بيوتها على يد بنّائين جئ بهم لهذه الغاية، وقد أشارت ماري إليزا روجرز إلى هذا الدمار. ونقرأ في اليوميات الفلسطينية إن الشيخ قاسم الأحمد زعيم مشايخ “جبل نابلس”، الذي تصدى لحملة إبراهيم باشا على فلسطين، كان للشيخ المذكور قصراً في قرية بيت قوزا الواقعة على رأس جبل، وأن القصر كان محاطاً بالأسوار، بحيث بدا وكأنه قلعة حصينة، وقد دمر إبراهيم باشا القصر. ولا تزال بقايا سور “صانور” وأبراجها ماثلة لليوم، على الرغم من أن عبد الله باشا، والي صيدا والقدس، قد أمر بدك صانور وهدمها على أن لا يبقى فيها حجر سنة 1830م، وقد كانت قلعة عظيمة حصينة من القلاع الكبار، ونستدل على حصانة القرية المسورة وقلعتها من طول مدة الحصار الذي حاصرها إياها عبد الله باشا وهو ثلاثة أشهر، وفى خلال هذا الحصار كانت النساء تشارك في المقاومة بغمس اللحف بالزيت وإشعالها للمساعدة في حرب القنص الليلية، واضطر عبد الله باشا، لإحراق كفر راعى، والرامة، وعطارة، وسيلة الظهر، والفندقومية وغيرها لتضييق الخناق على صانور. وصمدت صانور كل ذلك الوقت الطويل رغم قطع المياه عنها، وبالرغم من مدفعية العثمانيين إلى أن توصل شيخها عبد الله الجرار إلى اتفاق مع العثمانيين لإخلاء القرية. ونقرأ في الوقائع الفلسطينية أنه كان لصانور سور قرية له أبراج ومدافن منقورة في الصخر وكتابات ونحت في الصخور ومغمر وصهاريج. الحاجات التي يلبيها تكوين البيت: يلبي تكوين البيت الشعبي عدداً من الحاجات لدى الفلاح ويمكن استقراء هذه الحاجات من الملاحظات التالية: أولاً: الحاجات الاقتصادية: نلاحظ أن البيت الشعبي التقليدي يضم في داخله، أو في مكان متصل به حيزاً لإيواء الحيوانات وطعامها، كما يحتوى على حيز كبير لخزن مؤونة الأسرة ومخزونها من الطعام لفصل الشتاء، فعلى صعيد حاجة الأسرة يضم البيت. العقادية: سدة على بعد معقول من السقف لخزن السمن، العسل، البصل، الثوم، والمؤون الخفيفة الأخرى. الخوابي: جمع خابية وهى خزانة من الطين لخزن الحبوب فيها من أعلى وتستقبل من أسفل عند الحاجة. القطع: جزء مفصول من البيت لخزن الحطب للوقود المؤمنة الثقيلة، وعلى صعيد حاجة الأسرة للحيوان ومؤونته فإننا نجد بعض البيوت الشعبية تحتوي على مذاود في نفس المصطبة التي تقيم عليها الأسرة، بينما تقف الحيوانات على مصطبة أكثر انخفاضاً، ويلحق بالبيت أحياناً زرائب للحيوانات وحظائر لحفظ علفها، وأخرى لحفظ روثها لاستعماله في الوقود أو التسميد. ثانياً: الحاجة الأمنية: غالباً ما يبنى البيت الشعبي من جدران تتألف من (بتتين وركة)، أي واجهتين من الحجر بينهما بلاط وحجارة متوسطة، وقد يبلغ سمك الجدار في بعض الأحيان متراً كاملاً، وكذلك فإن البيت يخلو من الشبابيك وتصنع له (طاقات)، أي نوافذ في غاية الصغر في الجزء العلوي من الجدار وعلى ارتفاع يزيد على الأربعة أمتار، بالإضافة إلى باب يغلق بقفل من خشبة طويلة تُعد خصيصاً لذلك تجعل من المستحيل فتح الباب بالقوة، والهدف من هذه الإجراءات هو الوقوف في وجه (الحرمنة)، أي سرقة البيت بالسطو، والمعروف أنه في مطلع هذا القرن وفى عقوده الأولى كانت تحدث سرقات كثيرة يقوم بها محترفون يغزون بيوتهم ويسرقون أمتعتهم وفلوسهم ودوابهم. ثالثاً: الحاجة الاجتماعية: نلاحظ إن إمكانية استقبال الضيوف في البيت كانت صعبة لعدم توفر المكان والفراش المناسب، ولذلك لجأت الحمائل إلى أسلوب بناء الدواوين والمضافات التي تعتبر مكاناً لاستقبال ضيوف الحمولة، ثم أصبح الناس من ذوي الإمكانية المعقولة يخصصون غرفة في طرف الدار لاستقبال الضيوف، بحيث يكون لها باب يؤدي إلى البيت لاستعماله في البيت، وباب آخر يطل على الشارع العام لدخول وخروج الضيوف. إن أهمية خاصة أثناء عملية البناء تعلق على مسألة حماية الحريم من أنظار الرجال الغرباء، بحيث تمنع أي احتمال باعتداء أجنبي على النساء ولذلك نلاحظ: 1- يكون لغرفة الضيوف باب خارج باحة الدار ليدخل منه الضيف، وباب يطل على البيت ومن خلال هذا الباب الداخلي يمكن لصاحب البيت أن يتناول القهوة، الطعام أو أي شيء آخر ويقصد من ذلك تحاشي اطلاع الضيوف على “منطقة الحريم”. 2- يبنى المرحاض الخاص بالضيوف والغرباء خارج الدار أو في مكان قريب من غرفة الضيوف؛ حتى لا تكون هناك ضرورة لوصول الغرباء إلى منطقة الحريم. 3- يبنى سور عال يحيط بالبيت ويلحق بالسور بناء إضافي من حجر مخرم، ونسيج من الحصير ونحوه لمنع السابلة من النظر إلى “منطقة الحريم” 4- على أسطحة البيوت تبنى الجدران، بحيث تسمح للجالسين على تلك الأسطحة أن يروا ما يجري في الشارع دون أن يراهم أحد، وكذلك لتتمكن أي امرأ ة في البيت من استعمال سطح البيت وهى في مأمن من أنظار الرجال. 5- تصميم بوابة الدار، بحيث تضم باباً صغيراً يسمى “خوخة”، ومن خلال هذه “الخوخة” يطل أهل البيت ليتعرفوا على الشخص القادم قبل السماح له بالدخول، ويصل القادم إلى باب البيت فيدق الباب بقبضة حديدية مثبتة على الباب، وهنا يصدر الإذن له بالدخول وقد يصدر الإذن بالدخول لمجرد لفظ كلمة “أنا”، إذا كان صوته مألوفاً. وبصورة عامة يمكن القول أن شكل البيت هو في الواقع استجابة للحاجات المرتبطة بالواقع المعيشي. فالبيت القروي يبنى من مواد متينة كالحجر ونحوه على اعتبار أن أهالي القرية يريدون بيوتاً ثابتة مستقرة نظراً لاستقرارهم إلى جوار حقولهم وبساتينهم، أما البدو فقد ابتنوا بيوتاً خفيفة نسجوها من شعر أغنامهم، يسهل بناؤها ونقلها نظراً لاضطرارهم إلى الانتقال بحثاً عن الماء والكلأ لأغنامهم ومواشيهم. ومن ناحية واقعية فإن القرويين الجبليين ابتنوا بيوتهم من الحجر لتوفر المادة الحجرية، بينما ابتنى القرويون في السهل بيوتاً من الطين بسبب ندرة الحجر وصعوبة الحصول عليه. وسنرى كيف أن سكان القرى بالقرب من بحيرة الحولة اعتمدوا على أغصان الشجر، والحصر المصنوعة من البربر والحلفاء في بناء بيوتهم، فإذا كان البيت من ناحية هو استجابة لظروف المعيشة، فهو أيضاً مرتبط بوفرة المواد الخام اللازمة لإنشائه. بيت الله هو المسجد، وبيت ولي الله هو المزار أو المقام الذي يضم ضريح ولي من أولياء الله الصالحين. وفى القرية يعتبر المسجد بيتاً لله، وهو أيضاً بيت مفتوح لكل المؤمنين من أصحاب القرية وزوارها وعابري السبيل وهذا البيت مفتوح لكل المؤمنين، فيه يصلّون، وفيه ينامون في النهار والليل إذا شاؤوا، ومن الممكن للغريب والمسافر وعابر السبيل أن يقضى الليل في هذا البيت، وأن يستريح أثناء النهار، وفى شهر رمضان بصورة خاصة يكثر الناس من التردد على بيت الله فبعد أن يؤدوا الصلوات يستريحون أو يقومون بقرآة القرآن، ومن الممكن أن يناموا على “حصر الجامع”، حتى إذا ما أخذوا قسطاً من النوم نهضوا للتوضأ والصلاة وأخذوا بعد ذلك يستمعون إلى حديث ديني أو تلاوة من القرآن. وفى الغالب فإن الأشجار تحف ببيت الله، والناس يتفيأون ظلالها في حر الصيف، ويسهرون على سطح الجامع في الليالي المقمرة ويجتمعون في أروقته في كل وقت وحين. وفى هذه الموسوعة فإننا لن نتطرق لبنيان المسجد على اعتبار أنه جزء من الموروث الرسمي لا الشبعى، لكننا سنعطي أهمية خاصة لبنيان المزار لصلته بالعامة من الناس أكثر من صلته بالجهات الرسمية، ونظراً لأنه يشبه البيت الشعبي إلى حد كبير ببساطته وعفويته. يبنى المزار في العادة على قمة جبل أو تلة أو على مرتفع بسيط في السهل، وحتى تلك المزارات التي تبنى على جانب منحدر من الجبل أو في حوض الوادي فإنها تبنى في مكان يساعد الجميع على رؤيتها من كل جهة، بحيث تشرف على أكبر منطقة ممكنة، إن ذلك مرتبط بفكرة أنه من الضروري أن تكون قبلة لكل زائر وأن تكون واضحة المعالم ومعروفة. وهذه قائمة بالمزارات المبنية في مناطق عالية، قمة جبل أو مرتفع يسيطر على المكان الذي حوله: النبي صموئيل، الشيخ القطروانى بين بيرزيت وعطارة، الشيخ الكركي الطيار، في القسطل أبو هريرة وادي الشريعة، العزيز، بالقرب من عورتا. الشيخ العمري الجعبة، بالقرب من بيت عنان، وقد بني هذا المزار على قمة جبل، إن المنظر من ناحية الغرب خلاب، فمن المزار تطل على الرملة، اللد، ويافا، وكذلك البحر وكل هذه المواقع ترى بوضوح إذا كان الجو صافياً. الشيخ عبد السلام، عناتا، سلوان الفارسي، جبل الزيتون، النبي لقيا، شيوخ الدواعرة، صور باهر، النبي موسى، قرب أريحا، النبي يوسف بيت أجزا، الشيخ دير ياسين، الشيخ أحمد خربة السعيدة، الشيخ أعمرة بيت دقو. وقد لاحظ الدكتور توفيق كنعان أن 70% من المزارات التي رآها في ست وعشرين قرية قد بنيت على قمة تل أو جبل، وأن 24% منها كانت على سفح جبل (أسفل قمته)، وأن 5% منها فقط كانت في السهل أو الوادي، كما لاحظ صاحب تلك الدراسة إن جزءاً كبيراً من تلك المزارات التي وجدت في السهل هي ينابيع مقدسة، أشجار، حويطات وكهوف ذات طابع قدسى. إنه لمن المذهل حقاً أن نلاحظ بأن كثيراً من الجبال المهجورة في فلسطين عليها مزارات أولياء أو جبالاً كثيرة تحمل في ذراها مزاراً لولي من أولياء الله، وهذا يوضح فكرة القداسة في الجبال والتي اعتنقها المواطنون من عامة الناس في فلسطين. بناء المزار على الغالب هو رباعي الزوايا وذو قبة وتعتبر القبة ملمحاً بارزاً من ملامح الطبيعة الفلسطينية. وللمزار باب منخفض وشباك صغير، وفى بعض الحالات تكون هناك فتحات صغيرة تسمى الواحدة منها طاقة وجمعها طاقات، أو إشراقة وجمعها شرا قات، ويتألف السطح من قبة بسيطة مقنطرة مع حجر عمودي في الوسط فوق القبة ومنحوت على شكل هلال، ومن الممكن أن يكون الهلال من المعدن مع ثلاث كرات معدنية أدناها أكبرها. والمزار من الداخل (مقصور أو مطين)، وكذلك مبيض بمحلول الكلس، ولكن بما أن الأبنية قديمة فإن كل شيء خرب وآيل للسقوط، إن عدداً من المقامات هي بحالة سيئة بسبب الإهمال وعواصف الشتاء والزمن الطويل. وكانت الحرب سبباً آخر في دمار هذه المزارات كما هو الحال في مزار الشيخ أحمد الحركي الطيار، والنبي صموئيل، والشيخ حسن “بيت اكسا”، والقطروانى بالقرب من بيرزيت، وأبو العون (بدو)، والشيخ عبد العزيز(قرب بيت سوريك)، وخلال الحرب فإن بعض هذه المزارات قد سويت بالأرض (مثل الشيخ نوران بين الشلالة وخانيونس)، وقد نهب الجنود الأبواب واستعملوها وقوداً مثلما جرى لمزارات الشيخ عنبر، عبد السلام، والعمري، والجعبة، وفى بعض الحالات قام السكان باستبدال الأبواب وأصلحوا حال المزارات بطرق بدائية. وفى داخل المزار نشاهد طاقات وهى فتحات غير نافذة وتستعمل أشبه بخزانة صغيرة، نراها في جدران المزار وتستعمل في العادة لوضع المصباح، الزيت والكبريت، وهي في الغالب مكان قذر، وفى مزار الشيخ بدر (شمال غربي القدس)، وفى العزيز (عورتا)، أكثر من اثنا عشر طاقة موزعة على الجدران الأربعة. زخرفة المزار: يوحي داخل المزار بأنه كان يوماً ما مزخرفاً من الداخل بالنيلة أو الحنة أو كليهما، وتتألف الزخارف من خطوط مستقيمة أو متعرجة تشكل “زنارا” على الجدار الداخلي، وهناك “طبعة اليد”، وهى تمثل في المأثورات الشعبية الإسلامية يد فاطمة ابنة الرسول. ويعتقد أن مثل هذه الزخارف تجلب البركة، ونجدها على “اصداغات” الباب أو ” الشايشة”، وكذلك على الجدران الداخلية للمزار، وبشكل خاص بالقرب من المحراب، ومن الممكن أن نجد مثل هذه الزخارف في بيوت القرويين أيضاً. إن طبعة اليد تنتج عن غمس راحة اليد بالدم، أو الحنة، أو النيلة ونسمع في الأغاني الشعبية. يا دارنا لا تخافيش واحنا حماتك وسورك بالدم الأحمر لحنيك من كل وبش يزورك فالأصل هو “تحناية”، الجدار بالنيلة والحناء. وكذلك يحنون جدار المزار بدم الضحية؛ بهدف طرد الشياطين والجن، وفي هذا المقطع من الأغنية يعد الشاعر داره بأن يطرد عدوه من الدار ويقتله ويحنّي الدار بدمه. الحنا بالدم: بعض المزارات يكون المحراب مجرد خطوط مرسومة أو حزام ملصق. وفى كنسية الخضر بين بيت جالا وبرك سليمان، والتي يحترمها المسلمون أيضاً فإن اتجاه الصلاة يوضح بواسطة صور كبيرة للقديس جورج، إذا وقف المصلي المسلم قبالتها فإنه يستقبل القبلة. أرض المزار: في المزارات الفقيرة تجد الأرض عارية أحياناً تجد بعض الحصر، وفى مزارات أخرى تجد الأرض مفروشة بالحصر والسجاد. القبة: في الشكل البسيط منها تكون القبة مبنية على الجدران الأربعة مباشرة، وهناك شكل آخر للقبة تتكئ فيه على “ركب”، تعتمد على الجدران وفى حالة وجود قبتين تكون كل منهما سقفاً لغرفة، وبين الغرفتين يبنى قوس قوي ليساعد على حمل السقف بدلاً من الجدار الملغى. وفى نوع آخر من المزارات يكون هناك: رواق، وهو قاعة كبيرة محمولة على أقواس وفي هذا الرواق يجتمع الناس، يأكلون ويحتفلون، ويوجد مثل هذا الرواق في جامع السلطان إبراهيم في بيت حنينا، وكذلك في “الشيخ سلمان الفارسي” جبل الزيتون. وقد يضاف للمزار غرفة أو أكثر لتستعمل مطبخاً، أو مكاناً لإقامة خادم المزار (القيم)، ومن الممكن أن يكون هناك مستودع وغرفة للكتاب (مدرسة القرية)، وأخرى للخطيب (المدرس)، وفى بعض الحالات توجد غرفة ملحقة بالمزار تستعمل لغسل الموتى كما هو الحال في ” العزيزات “، وجامع العزيز في قرية أبو غوش. وفي الشيخ أبو إسماعيل (بيت لقيا)، والشيخ حسين (بيت عنان)، تستخدم الغرفة الأمامية كمضافة، أما في الشيخ ياسين (دير ياسين)، فالمضافة مقابل المقام وتفصلها ساحة خالية عن المقام نفسه، وتضم في العادة غرفاً عديدة وتتألف من 2-3 طوابق. مقامات الأنبياء: وتخصص الغرف الزائدة لزوار المقام في الأعياد ويكون هناك خادم مكلف بالخدمة طوال العام، ومن هذه المقامات: مقام النبي موسى، مقام النبي صالح (الرملة)، مقام الأنبياء مقام النبي يوسف (نابلس). وهناك مزارات تتألف من غرفة واحدة لا تعطي أي انطباع بوجود ضريح، محراب أو قبة، وهي في حالة سيئة من هذه المزارات: الشيخ عبد الله (بيت سوريك)، الشيخ صالح (دير ياسين)، الشيخ سرور (عورتا)، الشيخ النوراني (نابلس والأبنية كانت ذات يوم مساكن). وكثير من المقامات تبنى على شكل مزار مفتوح، بحيث يتكئ السقف على أعمدة، ومن هذا النوع في مقام حسن الراعي يفترض فيه أن يكون راعي غنم النبي موسى، والمقام بناء مستطيل متعامد مبني من الحجر والملاط وذو سقف معقود متكئ على ستة أعمدة وبين هذه الأعمدة يوجد ضريح الولي. إن كثيراً من المقامات الموجودة في القرية تستغل أيضاً كمسجد يصلى فيه الناس، وفى حالات أخرى بنيت المساجد بجوار المقامات، كما هو الحال في الشيخ جراح، وسعد، و اسعيد (القدس)، وسلمان الفارسي في جبل الزيتون. وهو شائع فقط في “تحناية” البيوت المبنية حديثاً بدم الضحية، ومن الممكن أن يحنّي شخص باب المزار بدم الضحية التي ذبحها تقدمة لساكن المزار “الولي”. وتزخرف جدران المزار أيضاً برسوم سعف النخل، ويتألف الرسم من خط عمودي مع خطوط أقصر تلتقي معه، إن مجموع الفروع ليست واحدة في كل الحالات ولكنها غالباً ما تكون 3،5 أو سبعة مع بعض الشذوذ، وفى كل الحالات فإن عدد الفروع على كل جانب مساو للعد على الجانب الآخر. إن شجرة النخل ذات سمعة طيبة إذ يقال إنها خلقت من نفس الأرض التي خلق منها آدم. ومن هذه الزخارف شكل الحية التي تشير لطول الحياة. وهناك زخارف مثل: شكل مسجد، منارة، سفينة، أزهار والغرض الرئيسي من هذه الزخارف هو تجميل المزار فحسب، وفى بعض الأحيان تصادفنا زخارف مؤلفة من آيات قرآنية مكتوبة بطريقة جميلة على الجدران، وكذلك اسم الله و أسماء الأنبياء والصحابة ففي مزار الشيخ ياسين، نجد اسم الله واسم محمد تحيط بهما زخارف من أشكال الزهور، وكذلك شعار: لا اله إلا الله، محمد رسول الله، وهناك علمان: العلم التركي وعلم الرسول، وكذلك هلال ونجوم متعددة، وفى المحراب رسمت المبخرة معلقة بالسلاسل. ويعتقد بعض القرويين أنه لا يجوز رسم زخارف المزار بالنيلة بل بالحنة، والسراقون (المينوم)، ويعجن بالحنة حتى يتحول إلى معجون وقد يضاف إليه السمن، ومن هذا المعجون تصنع طبعة اليد، وبعد أن يجف المعجون ويسقط يترك على الجدار أثراً بنياً مائلاً للحمرة. المحراب: وهو الثغرة غير النافذة في المزار التي تبين الاتجاه للقبلة، وعلى الأقل يوجد محراب في كل مزار، وفى بعض المزارات نجد أكثر من محراب، ففي قبر الراعي قرب النبي موسى هناك ثلاثة. إن بعض المواقع المقدسة الموجودة في الحقول تستعمل كمكان ليصلي فيه الناس وهم على سفر، ومن هذا النوع الإمام علي (على الطريق العربات من القدس إلى يافا). وتوجد في المقامات أماكن مرتفعة من الحجر تظل نظيفة دائماً وهى خارج البناء- وتستعمل كمصلى، كما هو الحال في الشيخ صالح (عناتا). في بعض المزارات نرى كتابات توجد عادة فوق باب المزار، أو فوق مدخل البهو وربما نجدها فوق الشباك (الشيخ جراح)، أو فوق أعمدة القبة (الشيخ جراح)، أو فوق أعمدة القبة (الشيخ حسن الراعي)، وانقل هنا نصوص تلك الكتابات عن دراسة الدكتور توفيق كنعان. النص الأول: فوق باب مزار الخضر وقد نقش على حجر رخام (نابلس). “عمر هذا المسجد أيام السلطان الملك سيف الدين قلاوون الصالح عزه الله ووالده السلطان الملك الصالح علاء الدين عز نصره. النص الثاني: في مقام الخضر (نابلس). يا داسوقى يا بدوي مقام الخضر احمد البدوى عبد القادر الجيلانى النص الثالث: كتابة علي المخمل موضوعة علي مقام الأنبياء (نابلس). “هذا ضريح أنبياء الله الكرام من أولاد سيدنا يعقوب وهم ريالمون ويشجر و أشر على نبينا وعليهم وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة و أتم السلام”. النص الرابع: في الرواق المجاور لمقام الأنبياء. ” كلما دخل زكريا للمحراب وجد عندها رزقا “ النص الخامس: على حجر من الرخام فوق مدخل مزار السلطان إبراهيم الأدهم (بيت حنينا). “باسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذا المعبد.. الحج سويد بن حمايد رحمه الله في سنة سبع وثلاثين وستماية”. النص السادس: فوق باب مقام اليقين، بنى نعيم على حجر رخام. بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذا المسجد محمد عبد الله على الصالح.. هذا من ماله. النص السابع بين القبتين الشماليتين لمزار حسن الراعي (قرب النبي موسى)، نقرأ: “أنشأ هذه القبة المباركة علي حسن الراعي، قدس سره صاحب الخير محمد باشا، حين أتى من استقبال حجاج المسلمين فشرع في البناء فلم يلقى ماء فبعلو همته حفظه الله تعالى نقل الماء على البلد من قرية أريحا وحصل الثواب سنة 1 ربيع عشر ومائة وألف” النص الثامن: على قبر الشيخ أبو الحلاوة (القدس)، “هو الحي الباقي هذا قبر ولي الله الشيخ حسن أبو الحلاوة، لروحه الفاتحة. بيت الضيافة: في كل قرية من قرى الفلاحين يبنى بيت للضيافة وربما أكثر من بيت واحد ليحمل اسم مضافة، ديوان، ساحة، جامع، مظيف أو ما شابه ذلك. وقد تبني القرية هذا البيت ومن الممكن أن تبنيه حمولة، وقد يتوقف عدد المضافات على عدد الحمائل، إلا إذا كانت العلاقات بين الحمائل طيبة فتكون عندئذ المضافات قليلة. يجتمع القرويون ويقولون: “نريد أن نبني بيتاً للضيوف والغريب والشاعر والشحاد، والتعمير أفضل من التخريب. وهكذا يقوم كل واحد منهم بإحضار عدد من حجارة البناء، وكذلك حجارة العقد – الريش – بالإضافة إلى 30-40 جرة ماء، ويدفع كل شخص من 1-2 مجيدي لتستعمل كأجور للفعلة. وتقوم كل عائلة بتقديم الطعام للضيوف بالتناوب وكذلك الكاز، والقهوة، والحطب، وكذلك العلف للخيول (خيول الضيوف)، وتنفق العائلات بالتناوب على إضاءة المضافة. أما فراش المضافة فهو مهمة شيخ القرية لتحضيره، ما عدا الفراشات للضيوف فيحضرها القرويون. وتوزع النفقات على الرجال الذكور الذين تخطوا السنة الثالثة عشرة من العمر. إن هذا البيت بالنسبة للقرية يمكن أن يقوم بهمة تكاد تفوق مهمة البيت الذي يملكه الشخص، ويمكن أن تلخص هذه المهمة فيما يلي: 1- مكان لتسلية القرويون وضيوفهم. 2- مكان لاستضافة الضيوف وإقامتهم بالمجان. 3- مكان يعتبر محكمة القرية. 4- مكان لاجتماع عام ومناقشات عامة في شؤون القرية. 5- مقهى للقرية. 6- مكان للقراءة، حيث تقرأ الجرائد وتبليغات الحكومة. وتجد الناس من أهل القرية وضيوفها (الرجال فحسب)، وقد تجمعوا في المساء يحمصون القهوة ويطحنوها، وقد أخذوا يتناقشون في النور ويأخذون في ممارسة ألعاب مثل الخويتمة، المنقلة، السيجة وغيرها. بيت الحجر: إن بيت الحجر المألوف في فلسطين يتألف من الحجر والطين، ويتألف الطين من خليط من التراب والجير، ويضاف الجير للتراب ليتكون من المزيج الذي يعجن بالماء ملاطاً قوياً. ويتم البناء بأسلوبين: 1 ـ بتة وركة، فالبتة هي سلسلة الحجر، والركة هي التصفيح الذي يدعم البتة ويتألف من حصى كبير وطين. وتسمى أيضاً كتة وتصفيحة. 2 ـ بتتين وركة. وفي هذه الحالة تنهض سلسلتان من الحجر وبينهما منطقة عرضها في حدود الثلاثين سنتمتراً تملأ بالحصى الكبير والطين لتساعد على تماسك “البتتين”. كان أسلوب بناء بيوت الحجر يعتمد على البيت الواحد وليس على مجموعة الغرف وتوابعها في شقة أو مسكن واحد، فكان هنا العقد أو البيت المؤلف من غرفة واحدة كبيرة واسعة وعالية الارتفاع (انظر فيما بعد نماذج من بيت الحجر في هذه الفقرة)، ويعتمد السقف في بعض هذه البيوت على أسلوب العقد. أما البعض الآخر فيعتمد على القناطر، وقد يكون في البيت الواحد قنطرة، اثنتان أو ثلاث، وعلى هذه القناطر يتكئ السقف المؤلف من جذوع الأشجار، أغصانها والتراب. ويقول تومسون: “إن البيوت التي شاهدتها في الرملة، غزة ويافا هي بوجه العموم من طابقين وعالية ويعتمد السقف فيها على أسلوب العقد. ويستعمل أسلوب العقد حتى في حالة تعدد الطوابق، وفي هذه الحالة كانوا يرفعون الجدران الخارجية ثم يقومون بتعبئة الفراغ في القبة الخارجية بالتراب ونحوه. ويمكن أن يعزى السبب في استعمال أسلوب “العقد” و ” القناطر” إلى عدم توفر جسور من الحديد أو الخشب والقصب أن الناس كانوا يسقفون البيوت باستعمال جسر خشبي (أو حديدي في وقت)، ويصفّون القصب بشكل متراص، ثم يغطون حصير القصب بالخيش وبعد ذلك يضيفون التراب والحصى. وبالنتيجة فإن البيت يصبح غرفة مكعبة ينهض سقفها على قوس أو أكثر ويكون السقف غاية في العلو. هذا البيت يتألف من: 1- غرفة واحدة ذات أرضية واحدة منبسطة. 2- غرفة واحدة ذات أرضية تتألف من جزأين: أ- مصطبة، وهي جزء عال يرتفع مسافة في حدود المتر عن الجزء الآخر القريب من الباب، ويخصص لجلوس الآدميين وأثاثهم، ويخصص الجزء الآخر والذي يسمى “قاع البيت” للحيوانات. 3- غرفة واحدة ذات أرضية من جزأين، وطابق آخر تدخل له من الداخل بواسطة درج يرفق به مخزن ويرتفع مسافة المترين عن الأرض. ويحمل الطابق الآخر على أقواس حجرية. وفي الزمن الماضي كان يصمم الدرج المؤدي إلى الطابق الأول، بحيث يكون في مواجهة الباب الخشبي، حتى فيما أطلقت النار عبر الباب الخشبي فإن النائمين في الطابق الثاني لن يصلهم شيء من الخطر لأن الرصاص يصطدم بالدرج. وكلما ازداد عدد أفراد العائلة بزواج الأبناء ومجيء زوجات وإنجاب أطفال جدد تضاف بيوت أخرى بزوايا قائمة مع البيت الأول وحول بهو تفتح نحوه الأبواب. وتضاف غرف كطابق ثان مع درج خارجي. وهكذا يتطور البيت ليتحول ما يشبه القلعة، حيث يسكن الأبوان، الأبناء وزوجاتهم وأبناؤهم. ونجد وصفاً لبيت الحجر المبني دون وجود الطين في ما كتبته ماري إليزا روجرز، وكذلك اليهوجرانت وكتباً أخرى كثيرة من تلك التي تصنف عادة تحت اسم “وصف فلسطين”، ويسمى مثل هذا البيت باسم: خشبة أو سقيفة، والتي هي غرفة واحدة من الحجر المصفوف حجراً فوق آخر دون ملاط، أما السقف فيتألف من أغصان الشجر وفوقها القش والطين. وشاهد تومسون أكواخ الطين في قرية أريحا والسهل المحيط بها، وقد أحيط على كوخ بجدار من الشجيرات الشوكية لحمايته وقال: إن الأكواخ ذات ارتفاع يتألف من عدة أقدام، أما الجدران فهي مبنية من الحجر الدبش (غير المذب) ودون استعمال الطين في تثبيت الأحجار. ويتألف السقف من الشجيرات الشوكية وسوق سنابل القمح، وفوق ذلك وضعت طبقة رقيقة من التراب. نماذج من بيت الحجر: 1- بيت للسكنى- السنديانة- حيفا (194) يتألف البيت هذا من ساحة سماوية طولها 22 متراً وعرضها 14 متراً، لها مدخل وباب خشبي ذي مصراعين. أرضية الساحة خالية من التراب وهي ذات مظهر صخري مستو. على يمين المدخل غرفة صغيرة تستعمل كمطبخ ومكان لإشعال النار وهي أشبه بمستودع. وإلى جوار هذه الغرفة غرفة أخرى كانت في يوم من الأيام دكاناً ثم أصبحت مستودعاً للتبن. أمام هذه الغرفة (قصة)، أي صفة يجلس عليها أصحاب البيت في أمسيات الصيف. وفي صدر الساحة السماوية بين السكن الرئيسي. ويتألف هذا البيت من بناء طوله 8م وعرضه 8م وارتفاعه 5م، وهو من قطعة واحدة، ويدور على (صير) من الجلد. وفوق الباب مباشرة توجد فتحات صغيرة ذات شكل مثلث تسمى ثريا. وإذا دخلنا البيت لاحظنا السقف مقاماً على ثلاث قناطر حجرية، أما السقف فهو من فروع وجذوع الأشجار المغطاة بالوبل. وتتألف مصطبة البيت من جزأين: جزء عال يعد للجلوس والنوم ويبلغ طوله 6م وعرضه 5م متأخر، أما الجزء الآخر فيتألف من مساحة 3م× 2م يعد لإيواء الحيوانات، وبين الجزأين مذودين لعلف الحيوانات ودرج بينهما يصل بين الجزء المنخفض والجزء العالي، وعلى يمين المدخل تقع سدة تصل بين الجدار الشرقي والقنطرة الأولى، وتسمى (عقادية) وتستعمل مستودعاً للمواد الغذائية مثل السمن، والعسل، والبصل ونحو ذلك. وبين القناطر تبنى(الخوابي)، وهي مستودعات للحبوب، وتلقى الحبوب فيها من أعلى وتؤخذ بواسطة فتحة صغيرة منخفضة قريبة من المصطبة. وعند أقصى يسار المدخل، وفى الجزء المنخفض يقع المصرف وهو المكان الذي يستحم فيه أهل البيت تاركين الماء يتسرب إلى الساحة الخارجية. 2- حوش (البرانسى) -الطيبة- طولكرم: تعني كلمة حوش مجموعة من المساكن المتلاصقة ذات شكل شبه دائري، ويؤدي كل منها إلى ساحة سماوية مكشوفة، ويعيش في كل بيت من بيوت الحوش أسرة مستقلة، ويتألف الحوش الذي نتحدث عنه مما يلي ابتداء من المدخل الشمالي: 1. سقيفة صغيرة ذات مصطبة واحدة وباب واحد. 2. بيت كبير ذو قنطرتين. 3. غرفة 5×5 ذات أرضية وسقف من الأسمنت. 4. غرفة 4× 5 ذات مصطبة واحدة. 5. مساحة مستورة بألواح الزينكو طولها 12م وعرضها 8م وليس لها باب، وبابها هو كل الواجهة الشمالية. 6. سقيفة صغيرة 3×3.5 م مع بيوت الحوش لنجد ما يلي: 1- بيت كبير ذو ثلاث قناطر ومصطبة مزدوجة. 2- بيت أصغر نسبياً ذي قنطرتين ومصطبة مزدوجة. 3- جدار المسجد يصل بين البيت الأخير والمدخل الشمالي. أما خارج الحوش فتقع مضافة الأسرة وتتألف من قاعة 10×8 ذي أرضية منبسطة وسقف من الأسمنت، وفى هذه المضافة كان آل البرانسى يقدمون طعام الإفطار طوال أيام شهر رمضان المبارك لكل من يلوذ بالمضافة عند مغيب الشمس كل يوم من أيام الشهر المبارك. 3- حوش الحاج أسعد: دير الغصون- طولكرم وفى صدر الحوش (عقد) 6×8 سقفه من البوص وأرضيته من الأسمنت، وهو المسكن الرئيسي والساحة السماوية مستطيلة، وعلى جانبها الأيمن ثلاث سقائف بالأسمنت على الجانب الأيسر فهناك بيت ذو قنطرتين وسقيفة وعند المدخل مرحاض، أما البوابة فهي ضخمة وفى وسطها (خوخة). 4- زناكية البطل: غرفة واحدة من ألواح الزينكو المثبت بالخشب والمسامير، حولها ساحة سماوية من (الحجر الناشف). 5- حوش دار علقم – السنديانة – حيفا تقع البوابة على الواجهة الشمالية، وعلى يسار البوابة غرفة صغيرة 4×3 ثم هناك بيت ذو قنطرتين ومصطبة مزدوجة، وبعد ذلك بيت 6×6 بقنطرتين ومصطبة مزدوجة، وبعد ذلك بيت 6×6 بقنطرتين ثم سقيفة، وأخيراً وعلى يسار المدخل عقد مبلط بالأسمنت وسقفه من البوص ولهذا العقد باب يطل على الشارع باعتباره مضافة. 6- حوش في دير الغصون- المدخل في الواجهة الغربية ابتداء من يسار المدخل غرفة 5×5، بعد ذلك درج يؤدى لعيلة من غرفتين ثم هناك فرن لأهل الحارة، وبعد الفرن غرفة 5×8، ثم بيتان كل منهما ذو قنطرتين، وبعده بيت بثلاثة قناطر، وبيت آخر بقنطرتين. الساحة السماوية غير منتظمة وتأتي على شكل زاوية، وتضم الساحة السماوية بئرين يمتلئان بماء المطر. 7- بيت في باقة الغربية: ساحة سماوية 15×12، سقيفة 3×4، بيت بقنطرة واحدة. 8- بيت في باقة الشرقية: وهو بيت متصل بحديقة كبيرة وليس له ساحة سماوية مغلقة ببوابة، وإنما مفصولة عن الحديقة بسور من الحجر الناشف. يتألف البيت من ساحة غير منتظمة وواجهتها الشرقية تضم: 1- بيت يضم المذود في صدره المستعملة في ما بعد أسرة لاجئة. 2- بيت بثلاث قناطر ومصطبة مزدوجة. 3- سور حجري. 4- غرفة حديثة 4×4، مبنية من الحجر المقسم، ومبطنة جدرانها بالأسمنت، سقفها أرضها من الأسمنت. أما الواجهة الشمالية مفتوحة، والواجهة الغربية خالية من البناء وهنا تبدأ حديقة بطول 140متر وعرض 85 متراً، وتعتبر الحديقة إحدى موارد دخل الأسرة، فهي مزروعة بالتين والرمان والعنب وتزرع خضراً وبقولاً متنوعة. 9- سقيفة في النبي صالح – رام الله: البناء من الحجر الناشف دون ملاط، وتبدو من الخارج أشبه بسلسلة حجرية، وشكلها شبه دائري، والسطح من فروع وجذوع الأشجار المغطى بالوبل، ومن الداخل تبدو الحجارة شبه ناتئة. وقد قطعت السقيفة والمؤلفة من مساحة 6×4 بفاصل حجري يقطع مساحة 3×2 لتنام هناك والدة صاحب البيت، بينما يقيم باقي أفراد الأسرة في الجزء الآخر من البيت، وحول السقيفة سور من الحجر الناشف والذي يضم حظيرة صغيرة 3×2.5 م لإيواء الحمارة. 10- حوش في قفين: يضم الحوش ساحة سماوية تساوى 50×75م، وهي ساحة صخرية تأوي فيها مجموعة كبيرة من الأغنام، وفي وسط الساحة مغارة ضخمة تحت الأرض تبيت فيها الأغنام في الشتاء، وتستعمل أحياناً كمستودع وأحياناً أخرى (لفرع التتن العربي). يشمل الحوش غرفة 4×6، ومضافة 8×10، وبيتاً قديماً ذا قنطرتين ومستودعين للتبن والزبل من الحجر الناشف يحيط بالساحة السماوية. 11- بيت محمد سعيد في الناصرة: يتألف من مسكن واحد ذي مصطبة عالية تؤلف ¾ مساحة السكن، ويستعمل قاع البيت (الربع المنخفض من المسكن) كمدخل ومكان للاستحمام، وهو رطب وله باب وشباك من خشب سميك يغلق الواحد منهما بخشبة سميكة. 12- بيت مسيحي في الناصرة: ليوان طويل تطل عليه عدة غرف، ولغرفة الضيوف باب خارجي. 13- بيت الشعر: يسمى البدوي خيمته “بيت الشعر” أو “بيت الوبر” ويتألف هذا البيت من قطع صغيرة العرض تنسج يدوياً من شعر الغنم – الماعز. يصنع البدو بيوت الشعر من قماش خشن، في الغالب أسود على اعتبار أنه من شعر الغنم، و إذا كان من وبر الجمال صبغوه باللون الأسود، وتقوم المرأة البدوية بغزل الشعر إلى خيوط ثم تنسه على نول خاص تصنعه بنفسها. ولا يزيد عرض القطعة الواحدة المنسوجة عن التسعين سنتمتراً، وعندما تتوفر قطع كافية فإنها توصل الواحدة بالأخرى بخيوط سميكة من شعر الغنم. والخيمة في العادة هيكل طويل تظل واجهته الأمامية مفتوحة وغالباً ما تكون هذه الواجهة باتجاه الشرق. إن لنسيج بيت الشعر ميزات خاصة فهو من جهة يمتص أشعة الشمس، وعليه فإن بيت الشعر يهيئ جواً أبرد من الصيف من خيمة الأوروبي البيضاء، وفى الشتاء فهو لا يسمح بدخول المطر. يتألف بيت الشعر من جزأين رئيسيين: 1- شق الضيوف. 2- بيت الحريم أو المحرم. وتفصل بينهما قطعة من نسيج بيت الشعر تسمى الساحة (أو الزفة)، وورد اسمها “معند” في مقالة بالدنسبرجر على المرأة البدوية في فلسطين وقال باحتمال وجود بيت شعر صغير لرجل كبير فقير من مساحة واحدة للرجال والنساء. ويقع الجزء المخصص للرجال على اليمين، أما شق الحريم فهو على اليسار، وفى العادة فإن شق الرجال هو غرفة الاستقبال، أما شق الحريم فهو مخصص للنساء، و لإعداد الطعام، وإيواء الأطفال وأثاث البيت الذي تستعمله المرأة. كل خيمة (بيت شعر) تتألف في العادة من 4-8 شقق (جمع شقة)، وهي قطعة منسوجة وإذا تلفت إحداها توضع من الخلف لتبقى الجديدة من الأمام ولهذه القطع أسماء. وجه البيت: الأمامية * واسطة * جادن * رواج * ورا (جفا) البيت * حضنة وفيها باب من البربير (البردى) يغطى في الشتاء بستار من شعر الغنم المنسوج. تقام الخيمة على النحو التالي: عمود في الوسط ويسمى الواسط أو عمود البيت، وهو يتصل بنسيج البيت بواسطة “واوية” قطعة خشب مكعبة. وتوجد هناك تسعة أعمدة تحمل بيت الشعر وتنتظم هذه الأعمدة في ثلاثة صفوف، ومن المحتمل أن يصل عدد الأعمدة في بيوت الشعر الكبيرة إلى 24 عموداً. أما ارتفاع بيت الشعر فقد يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، وهو ينحدر على جانبي الوسط لتحاشى وجود أماكن منبسطة في السطح تسمح بتسرب دخول مياه المطر. وبالإضافة إلى الأعمدة تشد بيوت الشعر إلى الأرض أوتاد قوية تغرز في الأرض متصلة بحبال تنتهي عند طرف نسيج بيت الشعر بحلقة معدنية، ويتوقف سمك الحبل وطول الوتد على حجم البيت، وكلما كبر البيت كلما احتاج البدوي إلى حبال غليظة وأوتاد ضخمة. ويحاط بيت الشعر بقناة تساعد على ترصيف مياه الأمطار من حوله دون أن يجتاحه ويسميه العرب (ناي). ويحرص البدو على حماية بيت الشعر من الرياح ولذلك ففي فصل الشتاء يلجؤون إلى الأراضي المنخفضة وقيعان الوديان المحمية من هبوب الريح، وكذلك يكون باب الخيمة متجهاً نحو الجنوب، الشرق والشمال، ولكنه لن يوجه ناحية الغرب من حيث تهب الرياح. وخلال فصل الشتاء أيضاً يترك البدو الحبال التي تشد الخيمة متراخية حتى لا تتقلص وتنقطع. ونجد وصفاً آخر طريفاً لمسكن البدوي فيما يكتبه بالد نسبرجر، إذ يقول: أن ذلك المسكن يتألف من ثلاث أو أكثر من الخيام تتخذ شكل خط أو مربع، وذلك عائد لعددها، فعندما يكون هناك عدد كاف من الخيام لتكوين شكل مربع يترك مكان واسع في الوسط، حيث تتقاطع حبال الخيام. ونرى بيت الشعر الخاص بشيخ القبيلة في وسط مضرب الخيام، وقد وصل طوله إلى ما يزيد عن خمسة وثلاثيين متراً وقد صنعت بيوت الشعر الأخرى حوله على شكل دائرة أو شبه دائرة، وفى حالة مضارب الخيام الكبيرة فإننا نلاحظ إن بيوت الشعر تتخذ شكل صفوف مستقيمة تاركة بينها ما يشبه الشوارع. الخربوش: خيمة من الجوت أو أكياس الخيش القديمة ويستعملها الفقراء من البدو في الصيف، وقد يستعملها المعدمون من الناس طوال العام. وقد يكون الخربوش مؤلفاً من قطع من الخيش والشادر معاً. المغارة: هناك أشكال أخرى من الأماكن التي تستعمل بمثابة البيت، ومن ذلك المغارة التي ينام فيها الرعاة على سرير بدائي مؤلف من “سدة” من فروع الشجر، أما باب المغارة فيغلق عادة بواسطة شجرة ضخمة مقتلعة من أصلها. وشاهد د. توفيق كنعان، بيوتاً محورة عن مغاور وقد صنع لها باب خشبي وذلك في القرية النبي صموئيل “قرب عين الأمير”. الخص والعريشة: شكل شبه هرمي مؤلف من جذوع الأشجار و أغصانها وهو أشبه ما يكون من حيث الشكل بالخيمة المخروطة، منطرة أو منطار أو عريشة أو معرش وتتألف من بناء من الحجر دون ملاط يستعمل كمستودع في الكروم، وفوق هذا البناء يقام المعرش من فروع الأشجار وأوراقها ليكون بمثابة السكن “النواطير” الذين يحرسون الكرم، ومكان عال يمكن منه مراقبة البساتين. وفى شمال فلسطين تحمل اسم عرزان، ويتألف العرزان من أربع ركائز من الخشب وتكون جوانب البناء الأربعة مفتوحة، أما السقف فيغطى بالفروع الدقيقة للأشجار وأوراقها. ونادراً ما يستعمل البدو هذه الأنواع من العرائش لأنهم يكثرون من التنقل والترحال، ويصعب حمل معداتها الخشبية، هذا فضلاً عن أن المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية التي يتنقلون فيها فقيرة بالأخشاب. وتبنى العرائش أيضاً فوق سطوح البيت لينام الناس فيها في ليالى الصيف الحارة، وبهذا المعنى يقول الناس. في الصيف في الشجر ولا في الحجر أي أن الإقامة في حمى الأشجار وتحت ظلها في الصيف أفضل من الإقامة في البيوت. وبالقرب من الحولة، حيث يوجد هناك مستنقع ينمو في القصيب (قصب الخيرزان والبربير (البردى)، تبنى أنواع من البيوت التي هي في مرحلة بين البيت والخص، تتألف ركائز الجدران من جذوع الشجر العنبر والطرفا، أما الجدران فهي من حصر خشنة من القصيب، و من نقس هذه الحصر تصنع السقوف مع إضافة الوبل الذي هو فروع وورق النباتات مع التراب والحصى، وبالطبع فإن السقف يعتمد على جذوع أقوى وأكبر. ويمكننا أن نصف هذا النوع من البيت بأنه كوخ، سيقان ذلك القصب ليس بدائرية و إنما هي مثلثة الشكل وقد وصفها تومسون، كما شاهدها بالقرب من الحولة والنهيرات القريبة في السهل الساحلي الفلسطيني إلى الشمال من يافا، فقال: أن طول الساق يتراوح من 8-10أقدام (أي أقل من ثلاثة أمتار)، وتنتهي رؤوسها بما يشبه المكنسة التي تتماوج مع النسيم. وحول نباتات مستنقع الحولة هذا تتركز صناعة حصر نشطة، تستعمل في الغالب لفراش البيوت. المنظار: يمكن النظر إلى المنظار على أنه من ناحية مسكن من الحجر، ومن ناحية أخرى فإن الجزء العلوي هو نوع من “الخص أو العريشة”. ويهدف بناء المنظار- والذي يبنى في الحقول والكروم إلى توفير مكان يخدم الأعمال الزراعية، ففي جزئه السفلي للمراقبة و إقامة “الناطور” – حارس الكروم من تعديات الإنسان والحيوان. ويبنى المنطار (والذي يحمل اسم القصر أيضاً)، في مكان يسمح للمقيم به بالإشراف على منطقة الكروم كلها. ويختار صاحب الكرم مكاناً مرتفعاً صخرياً ليبني المنظار ويتم ذلك دون أن يستعمل الطين أو أيه مادة لاصقة أخرى. وتستعمل في البناء حجارة تخرمت بفعل التآكل والعوامل الجوية وأمراض الحجارة. وقد يبنى المنظار بالحجارة المتوفرة والتي تقتلع من الكروم، أما إذا كان بناؤه ضرورياً، فإن الحجارة قد تجلب إليه من مكان ما ويكون ملتقى الأحمال في آخر إذا كان ذلك ضرورياً. يحفر للمنظار أساس دائري ويوضع في هذا الأساس الحجارة الضخمة حتى تكون هناك أركان قوية. وعلى مستوى سطح الأرض يوضع المدماك – الطوف الأول – ويوضع الرخام في الوجه الداخلي، أما الوجه الخارجي فيصلح له أي نوع، ويعبأ ما بين الوجهين بالحجارة الصغيرة؛ لتزيد من تماسك البناء وقوته، ثم يوضع الطوف الثاني، ويراعى في الوجه الداخلي أن يكون الطوف أكثر تقدماً نحو الداخل، ثم يأتي الطوف الثالث والرابع وهكذا حتى نجد أنه تم على سقف مخروطي متماسك قوي بلا ركائز ودعائم على ارتفاع مترين أو ثلاثة، ويمنع سقوط هذا السقف تماسك كل طوف وكل حلقة حجرية واحدة ذات مركز ثقل يتحد مع مراكز الأطراف العلوية. حجر القمة: ومن حجر القمة يعاد توزيع الأحمال على مساحة الأساسين، هذا ويحسب حساب الباب عند البناء، إذ تترك فتحة ارتفاعها متر إلى مترين وعرضها متر أو أقل قليلاً، كما تجعل ” طاقة ” أو أكثر للتهوية أو النظر من خلالها ناحية الكرم، ويصبح الشكل النهائي الخارجي للمنظار شكل مخروط مقطوع الرأس، ويراعى في الوجه الخارجي بناء درج للصعود إلى سطحه، إما بوضع أحجار بارزة تتحمل الأثقال المتحركة عليها بشكل لولبي كما هو الدرج الهوائي في المعمار الحديث، أو جعل هذا الدرج يرتكز مع الجدار على الأساسين. ويتراوح ارتفاع المنظار من 3-5 وقطره الأسفل يتراوح من 3-4، أما قطره العلوي فيضيق ليصل متراً ونصف فحسب، وسمك جدار المنظار يصل إلى المتر الواحد، وتؤسس فوق سطح المنطار “عريشة” من جذوع الأشجار وغالباً ما تزرع “دالية – شجرة عنب” لتظل تلك العريشة. ويسكن الأطفال والنساء في المنظار بشكل دائم طيلة فترة موسم الكروم، في حين ينشغل الرجال بالقطاف والتسويق والتردد على مراكز الأسواق. الخيمة الفلسطينية: بعد كل هزيمة كانت تنصب آلاف من الخيام الجديدة التي تضم تحتها المشردين، وهكذا ظهر نمط جديد من المسكن الشعبي وهو: المخيم، كان المخيم في البدء عبارة عن مضرب خيام وما لبث المخيم أن تحول إلى أكواخ الصفيح و الإسبست ثم أكواخ البيوت فالعمارات. والمخيم الفلسطيني هو واقع سكني جديد اتخذ طريقه ليمثل أبسط وأفقر وسائل السكن الفلسطينية في عهد المنفى والشتات، وهو يمثل أكثر أوضاع السكن تخلفاً. وبصورة عامة يمكن القول: أن المخيم هو عبارة عن صفوف متراصة من الأكواخ الصغيرة تفصل بينهما طرقات ترابية وأقنية للمياه العادمة. الأثاث والديكور: في البدء دعنا نلقي نظرة عامة على بيت شعبي فلسطيني، يمكن للمرء أن يدخل للبيت الشعبي من الباب الرئيسي الوحيد والمؤدي لغرفة كبيرة تكون مربعة على الأغلب، وفى حدود مساحة 64 متراً مربعاً، وهذا البيت ذو علو في حدود الستة أمتار، وسقفه محمول على قناطر اثنتين أو ثلاثة (بالطبع نحن نتحدث عن بيت حجر)، ومن النظرة الأولى يكتشف الناظر أن البيت مقسوم إلي قسمين رئيسيين: 1- المصطبة: وهي الجزء الأعلى من البيت وعلى المصطبة يعيش الآدميون ويضعون فراشهم وأثاث البيت، وهناك تؤسس الخوابي لحفظ حبوبهم. 2- قاع البيت: الجزء الأدنى من البيت وهو مخصص لوقوف الحيوانات، فضلاً على أنه المدخل للمصطبة وفى زاويته “المصرف” مكان الاستحمام. وبينما تحتل المصطبة العالية ثلثي عرض البيت، يحتل قاع البيت الثلث الآخر ومن “قاع البيت” يرقى الداخل إلى المصطبة بواسطة درجات قليلة، وعلى طرفي الدرجات يقع مذودان يوضع فيهما علف الحيوانات. ترى لماذا بنى الفلاح الفلسطيني بيتاً كبيراً يتسع له ولحيواناته، ولم يبن غرفاً صغيرة متلاصقة واحدة له، وأخرى للثيران، وثالثة للخيل وهكذا ؟ إن مقتضيات الأمن في العهد العثماني أجبرت الفلاح على أن ينام في مكان واحد مع حيواناته، لقد عاش الفلاح في عهد كان على كل شخص أن يحمي نفسه وممتلكاته، ولذلك كان من غير المؤتمن أن ينام الفلاح في مكان ويترك حيواناته في مكان آخر، ونحن نرى أن الفلاح يحتاج إلى اقتناء العشرات والمئات من الحيوانات (الغنم مثلاً) لذلك كان عليه أن ينام إلى جوارها (في الصيرة)، وإذا اضطر لأن يتركها تبيت في الخلاء في مغارة أو حتى في العراء، فإنه كان ينام معها. لقد نمت علاقة وثيقة ومصيرية بين الفلاح وحيواناته، فتلك الحيوانات تحرث الأرض، وتقدم اللبن، والزبد، والسمن، واللحم، ومن صوفها يصنع جزءاً من ثيابه وفراشه، وبالتالي فهي جزءاً هاماً من حياة الفلاح لا غنى له عنها. واعتاد الفلاح أن يتكيف مع وجودها معه لدرجة أن الرواة يقولون لنا: أنهم كانوا ينامون على صوت اجترار البقر، ويستيقظون إذا توقف هذا الاجترار لأي سبب من الأسباب. كان بيت الفلاح واسع، بحيث يجتمع داخل هذا البيت المؤلف من “غرفة واحدة واسعة وعالية” كل ما يحتاجه الفلاح، وكل ما يحرص على وجوده بجواره بعيداً عن أيدي اللصوص والغزاة، فالحيوانات في قاع البيت، والحبوب في الخوابي (خزائن الطين) على جانبي المصطبة، وجرار الزيت والسمن والعسل والدبس واللحم المجفف (القورما) تحفظ على العقادية (رف من الطين بين قنطرتين أو بين قنطرة وجدار)، والفراش له ولأسرته على المصطبة، وكذلك يوجد هناك أدوات الطعام والقهوة، وعند “المصرف” يقضي حاجته الخفيفة ويستحم، نجد إن كل ما يحتاج الفلاح ويحرص عليه موجود تحت يده. الفراش: تغطى أرضية البيت الشعبي عند الفلاحين في الغالب بالحصر(جمع حصير)، وعند البدو بالبسط (جمع بساط)، وبينما يصنع الرجال من الفلاحين الحصر، فإن أماكن عديدة في فلسطين وعلى الأخص في غور الأردن وهي أماكن تعتمد على جذوع نباتات “البربر”،و “الحلفا”،و “السعد”. وكانت تستورد من الخارج مفارش تسمى دروج (جمع درج) مصنوعة من قش الرز المصري، وتستعمل لفرش أرضية بيوت الميسورين من الفلاحين. ويتألف الفراش من: فرشات: حشايا من الصوف (جمع فرشة). لحف: (جمع لحاف) أغطية محشوة بالصوف. وسائد: (جمع وسادة) حشية صغيرة توضع تحت الرأس أثناء النوم. مساند: حشايا من القش تغلف بالقماش. يوضع الفراش أثناء النهار في “قوس الفراشات” في الغالب، لأن الفراش لا يستعمل إلا عند حضور الضيوف، وهو عبارة عن فتحة في الجدار، وفى الليل ينزل الناس الفراش ويضعونه فوق الحصر أو البسط ليناموا ،، وفى الليل يستعملون الجنبيات (حشايا رقيقة) للنوم ليظل الفراش نظيفاً وجاهزاً للضيوف، ولا يستعمل البدو البسط للجلوس بل يطوونها ويبقونها جاهزة لتقدم الضيوف. ويختلف وضع الفراش في النهار للجلوس عليه، عن وضعه في الليل للنوم، ففي النهار توضع الفرشات بوضع أفقي محاذ لجدران البيت، وبين كل فرشة وأخرى وعند كل منتصف فرشة وسادتان الواحدة فوق الأخرى. وتوضع المساند لتفصل بين الجالس والجدار. الأثاث الخشبي: قد تخلو بيوت الفقراء من الأثاث الخشبي باستثناء صندوق العروس، ويركز الناس في الوسط الشعبي على الاهتمام بالفراش والذي يتمثل في: الفرشات، واللحف (جمع لحاف)، والوسائد، والمساند. وصندوق العروس هو وعاء مكعب الشكل وذو أحجام مختلفة بعضها لا يصل ارتفاعه إلى المتر وبعضها يقارب ارتفاعه المترين، وهذا الصندوق قد يتألف من الخشب البسيط المصفح بألواح التنك، وقد يتألف من خشب ذي قيمة مزخرف ومطعم ومشغول بالحفر، ويستعمل صندوق العروس لحفظ الثياب والمجهورات والأشياء ذات القيمة، ومن المحتمل أن يخبأ فيه نوع من الطعام. ولا يكاد بيت شعبي يخلو من “المهد” – سرير الطفل – والنموذج الذي كان شائعاً في مطلع هذا القرن، يتألف من وعاء خشبي ذي رجلين مقوستين ليسهل تحريكه ذات اليمين وذات الشمال لهدهدة الطفل الذي ينام فيه، ومن الأعلى تكون له عارضة خشبية تعلق فيها أدوات زخرفية يتسلى الطفل بمنظرها، أو أدوات من الخرز الأزرق والحجب لتحمي الطفل من الحسد. وبعد ذلك شاع وجود نموذج معدني من ذلك المهد، ويستعمل الفقراء المعدمون بدلاً منه “الجدل” وهو عبارة عن قطعة من الخيش مربوطة من طرفيها في زاوية البيت بحبال، وتفرش بالقماش لتستعمل كسرير للطفل. السمندرة: حامل من الخشب يرتب فوقه الفراش، الفرشات، اللحف (جمع لحاف)، والوسائد والمساند. البورية: عبارة عن خزانة ذات جوارير أفقية طويلة، توضع فيها الأدوات الصغيرة لا سيما أدوات المطبخ وقطع الملابس الصغيرة. السجلون: أو الصفة وهي عبارة عن سرير خشبي يغطى بحشايا من الصوف، ولا تتوفر هذه الأداة إلا في بيوت الميسورين من القرويين وفى ديوان المختار. الزخرفة والديكور: تزخرف واجهة البيت الشعبي، كما تطلى وتزخرف الجدران الداخلية، وكذلك تعلق أدوات ذات طابع زخرفي على تلك الجدران الداخلية، وتزخرف الواجهة الخارجية للبيت بأسلوب يهدف لتحقيق الناحيتين الجمالية والمعتقدية. فمن الناحية الجمالية البحتة تطلى الواجهة الخارجية للبيت بمحلول الجير والنتلة ذات اللون السماوي، وقد تطلى أطراف الشبابيك أيضاً من الخارج بنفس المحلول، إن ذلك يساعد على تجميل المدخل و إبرازه، بالإضافة إلى أن اللون الأزرق الخفيف الذي يبعثه لون النيلة يساعد على رد العين الحاسدة كما يعتقدون. ومن الممكن أن تكون هناك رسومات وكتابات على الواجهة الخارجية، ويرسم فنان شعبي مبتدئ “عرجة” على شكل رقم 7 مكرراً، وقد يرسم راحة الكف وهي بلون النيلة، ولا تزال راحة الكف التي قد يرمز إليها بكف فاطمة ابنة النبي مستعملة حتى في زخرفة السيارات، ومن الناس من يفسر الكف بأنه أشبه بطعنة في وجه الحسود. وقد تثبت على الجدار خميرة العجين أو الحنة، والأولى ترمز إلى أن هذا البيت هو الذي يضم خميرة الأسرة ونماءها وإخصابها، و أما خميرة الحناء فالمقصود منها تحنية البيت أي تجميله كما تجعل العروس عند زواجها. ومن الممكن أن تعلق بيضة مفرغة، حذوة، خرزة زرقاء، والهدف من كل هذه الأشياء هو رد العين الحاسدة، فعندما يزور شخص حاسد البيت ينصرف نظره عن الحسد إلى التفكير في تلك الطريفة المعلقة. وقد تزخرف الواجهة الخارجية بالخط العربي إذ تتم كتابة كلمات وعبارات مثل: الله، محمد، عمر، علي، عثمان، بسم الله الرحمن، عين الحسود فيها عود، الحسود لا يسود، وما شاء الله، هذا من فضل ربى، وكل هذه الكلمات والعبارات لها القدرة على طرح البركة وطرد الشر، وفى حالة بناء البيت من الحجر نقش بعض هذه الكلمات أو العبارات على حجر خاص يثبت في وسط الواجهة وفي القسم العلوي، وعادة ما يكتب عليه: هذا من فضل ربي، أو ما شاء الله. ومن الداخل تزخرف الجدران الداخلية بالنيلة والرسوم والخطوط، ويزخرف الموسرون جدران بيوتهم الداخلية أيضاً بطبقة وحدة زخرفية متكررة، يغطي كل الجدران والسقف مع ترصيع السقف بصحون القاشاني المزخرفة، وتعلق على الجدران أدوات ذات طابع زخرفي مثل: أدوات من القش: طبق، صينية، قبعة صغيرة، مشكول …الخ وهي أدوات تكون في الأصل ملونة فتعطي الجدار مسحة من الجمال. وهذه الأدوات المهفة، وهي قرص من القش المشغول تنتهي أطرافه بشرابات من القطن، وله مقبض من الخشب يغلق بقماش ناعم، والهدف من المهفة تحريك الهواء للترويح عن الجالس، وفى أيام الصيف توضع مثل هذه الأداة على الوسائد التي يرتكي عليها الجالسون، لتكون جاهزة للاستعمال في أية لحظة. الزخرفة باللوحات، هناك مستنسخات عن رسوم شعبية تمثل أبطال وبطلات من السير الشعبية، وهي رسوم ملونة تعلق على جدران البيوت الشعبية، وتحمل صور عنترة وهو يركب حصانه وسيحمل سيفه، الزير سالم يركب الأسد، الجازية (بطلة من بطلات بني هلال) وغيرهم، وكذلك تزخرف الجدران بصور أفراد العائلة، وأقاربها، وأصدقائها والموضوعة داخل إطارات ومعلقة على الجدران. وهذا يتم غالباً في بيوت العزاب، أو في أماكن العمل مثل الكراجات، المشاغل وما شابه ذلك، ومثل هذا العمل ينطوي على الرغبة في الترفيه عن نفوس العاملين التي تعانى الكثير من وطأة العمل. وتعلق على الجدران الداخلية أدوات مثل البندقية، والمكحلة. فأما البندقية فترمز لإبراز طابع القوة، و أما المكحلة فهي مادة خزفية أنثوية توحي بأن ربة البيت امرأة ذات ذوق، والمكحلة هي زجاجة صغيرة تضم الكحل، وتغلف بشكل زخرفي هو عبارة عن غلاف من القماش مطرز ذو شرابات من القطن الملون والخرز، ويعلق الغلاف الكبير بواسطة خيط ذي شرابات على الجدران، بحيث لا تظهر الزجاجة الصغيرة على الأطباق.، كان طول الزجاجة لا يزيد عن طول الإصبع الصغير، فإن الغلاف المحشو بالقماش يكون أضعاف طول الزجاج أربع أو خمس مرات. تدفئة البيت الشعبي: استعمل الناس في الوسط الشعبي النار لتدفئة البيت، وكانت تشعل النار بالحطب المتوفر في شمال فلسطين من فروع وجذور السنديان، البلوط، السريس وغيره من الأشجار البرية، وكلما اتجهنا للجنوب فإن الغطاء الحرجي يتضاءل، و بالتالي يعتمد الناس على الفروع الجافة من الزيتون فأشجار الحمضيات، واللوزيات، والتفاحيات، وكذلك على بعض النباتات البرية الشوكية مثل النتش. وكانت توقد النار في موقد يصنع من الطين ويسمى كانون طين، أو موقدة طين، والموقد هذا عبارة عن وعاء من الطين غالباً ما يكون اسطوانات وله نهايات بارزة ليمكن وضع آواني الطبخ عليها عند الحاجة، وتملأ فوهة الوعاء بالطين إلى حد يسمح بوضع الوقود وإشعاله، وعند اشتعال النار يتسرب الدخان إلى البيت، عندها يقول الناس: “الدخان يعمينا ولا البرد يهرينا” أي من الأفضل أن نصاب بالعمى من الخشب المصفح بالتنك، ويعمل على شكل مستطيل ذي أربعة أرجل تفرش في قعر طبقة من الرماد، وتوقد النار فوقها. وهناك طريقة أخرى لتجهيز جمر ملتهب بالنار، وتتلخص هذه الطريقة في أن تشوى قطع الخشب (الرامي) على ساس الطابون، “وتتم العملية طوال الليل، وعند الصباح تستخرج هذه القطع وقد أصبحت كتلاً ملتهبة من الجمر، يصف بعضها في الكانون، والبعض الآخر يصب عليه الماء ليتحول إلى فحم”، ويستغل هذا الفحم بدوره لتأريث الجمرات الأولى أو تكاد. وهناك الوجاق الذي هو عبارة عن كوة في الحائط تشعل فيها النار، وفيها مجرى للدخان الذي يصرف عبر الجدار إلى السطح ثم إلى الهواء، ويحرق في الوجاق وقود من الحطب. وقد شاهد نماذج من هذا الوجاق في “سقائف” غاية في البساطة في النبي صالح – رام الله. ويخزن الفلاحون الوقود بأشكال متعددة: 1- يخزن “القرط” أي قطع جذوع الأشجار في “القطع”، وهو عبارة عن جزء من البيت يفصل بواسطة جدار. 2- يتم خزن فروع الأشجار الدقيقة أو النتش ونحوه، لأن مثل هذه المواد ضرورية للمساعدة على إشعال كتل الحطب. 3- ويخزن البعض كميات من فحم الحطب الذي يصنع في “المشاجر”، وذلك بحرق خشب الأشجار الحرجية حرقاً بطيئاً بمعزل عن الهواء. 4- وفى شمال فلسطين تقوم الفلاحة بتخزين حزم الحطب بالقرب من البيت في ما يسمى “مركاس”، وجمع الوقود هو مهمة نسوية “فتذهب المرأة إلى المناطق الحرجية وتقطع الحطب “بالشرخ”، وتصنع منه حزمة طويلة تربطها بفروع الأشجار الدقيقة والمرنة والتي تسميها “خروص”، وتجمع الحزم في المركاس الذي عادة ما يكون بالقرب من البيت”. 5- أما الوقود من روث الحيوانات فهو الجلة وبعر الغنم. الإضاءة: خلال ليالي الشتاء تظل مصابيح الزيت الصغيرة مشتعلة، لكن في الفصول الأخرى من السنة فإن النور يطفأ بعد وجبة العشاء، وعندما لا يكون هناك ضيوف أو زوار. إن نفقات الإضاءة (أي توفير الزيت للمصباح) هي من واجبات المرأة، والتي يتوجب عليها أن توفرها من مالها الخاص والذي تحصل عليه من بيع بيض الدجاج، أو ما تحصل عليه من “بعارة” أثناء جني المحاصيل، أو مما تبيعه من نتاج ما تزرعه هي وتبيعه في سوق المدينة. وتقول ماري إليزا روجرز في كتابها: “قابلنا عند باب البيت خدم وحاملو مصابيح”. وهناك إشارات في كتب الرحالة عن وجود فوانيس كاز أو زيت تعلق على أعمدة في شوارع المدن الفلسطينية، ويقوم بإضاءتها شخص مخصص على الطرقات العامة في الليل. أدوات الإضاءة: كان هناك ما يسمى بالزلفة وهي قطعة فخارية تشبه السراج الفخاري الأثري، ولها “بعبوزة” مكان ضيق – للفتيل – ويشتعل الفتيل المغموس بالزيت، وكان الزيت ينفذ أثناء الليل، مما يضطر صاحب البيت لإعادة ملئه بالزيت. ولدينا رواية عن امرأة من قلقيلية، تتحدث فيها عن حادثة تسبب فيها فأر قام بسحب فتيل الزلفة وهو مضاء، وهرب الفار إلى وكره في خشب سقف البيت مما تسبب في إحراق البيت. وبعد ذلك شاع استعمال سراج من التنك شكله شكل القمع، وله غطاء ذي فتحة ضيقة تمسك بالفتيل. ثم أخذ الوسط الشعبي يستعمل القنديل أو ما يسمى باللمظة “من لامب” وهي وعاء من الزجاج يملأ بالكاز وله فتيل تصنعه المصانع، ويثبت الفتيل بواسطة رأس يسمى (جرس)، ويحمل الرأس زجاجة القنديل التي تساعد على الاحتراق وتوهج الضوء، ومن هذا النوع: القناديل الصغيرة ( نمرة1 )، والكبير ( نمرة 2)، والأكبر ( نمرة 4)، وهناك الشمعدان الذي تتألف الزجاجة الحاوية للكاز فيه من وعاء محمول على قاعدة طويلة. التهوية: يفضل الفلاح الفلسطيني أن يكون بيته مبنياً بطريقة تحقق الأمن الأكبر مما تحقق التهوية، ولذلك فإن الشبابيك تكاد تكون غير موجودة، وتقوم مقامها فوق الباب فتحات صغيرة ومثلثة الشكل، وهم يسمونها ثريا، وفي مقابل هذه الثريا ثريا أخرى في الجدار المقابل، وإذا وجد شباك أو باب صغير إضافي سموه “السر”. وفى العادة فإن الفلاحين يشعلون نار الحطب داخل البيت مما يساعد على إفساد الهواء، لكن العقلاء لا يدخلون الفحم أو الحطب المحروق إلا بعد أن يتم اشتعاله. مستودع البيت الشعبي: يعتمد في الوسط الشعبي على مخزون من الطعام والوقود والأغذية الجافة والمجففة لاستعمالها في فصل الشتاء البارد وعند الحاجة، ولا غنى للبيت الشعبي عن مستودع أو مكان لخزن: الزيت، القطين، البقول، الخروب، الزيت، العسل، الجميد، الزبد، السمن، البصل الجاف، اللحم المقدد، الماء، الجبن،..الخ، وكذلك علف الحيوانات. كما أن هناك أماكن تخصص لخزن الوقود مثل أغصان الأشجار الجافة، قطع من جذوع الأشجار(برامي)، ورق النبات الجاف (القيشة)، روث الحيوانات الذي يجفف كوقود للطابون (زبل)، الفحم، النتش، أو البلان الذي يساعد على اشتعال الحطب. ترى كيف وأين تخزن تلك المواد؟. الخابية: خزانة من الطين مثبتة بالجدار على أحد جانبي المصطبة تستعمل لحفظ الحبوب، وتصب فيها الحبوب من أعلى لتستقبل من أسفل بواسطة فتحة صغيرة تغلق بقطعة من القماش، وفى العادة يكون هناك أكثر من خابية. العقادية: وهى نوع من “السدة” التي تؤسس بين جدار البيت والقنطرة، وتوضع عليها جرار الزيت، والسمن، والمؤونة. الصيفار: فتحة في الجدار فوق الباب تخزن عليها أدوات تحتوي مواد صغيرة الحجم. خراقة: طاقة في الجدار توضع فيها علبة مثلاً أو نحو ذلك. المطمورة: حفرة في ساحة البيت يطلى جدرانها بمادة من التراب والشيد والرماد وتخزن فيها الحبوب. البئر: حفرة اسطوانية عميقة لحفظ زيت الزيتون أو الماء، وإذا خصصت الحفرة لزيت الزيتون، بذل الناس مجهوداً كبيراً في جعل الجدران ذات قدرة على منع التسرب. وفي القرى التي لا تعتمد على الينابيع وتقتصر في استهلاكها على مياه الأمطار، فإن حفر البئر وتجهيزه لخزن الماء، يعتبر من أهم مرافق البيت إن لم يكن من أهمها على الإطلاق، وهم يسمونه “بئر”. وفي الصيف تصبح لهذا المرفق أهمية فائقة لدرجة أن الماء يشتري بالشبر، وتتم عملية القياس بإنزال حبل في نهايته ثقل يصل إلى أدنى البئر، وأما الأجزاء التي بين نهاية البئر وسطح الماء فهي المسافة التي تقاس بالأشبار وتباع، أي يعطى حق نزح الماء لعمق شبر أو أكثر مقابل مبلغ من المال. ويحدثنا سكرم جور: عن طريق حماية جدران البئر من إمكانية التسرب، فيقول: “أن الفلاحين يدخلون في الطين الذي يستعمل في قصر الجدران مسحوق الفخار المدقوق، ويقومون بتنخيل هذا المسحوق، وبعد عملية التطيين يقوم العامل بصقل الجدار، وقال: أن آبار مدينة الناصرة كانت تسع إلى حد ثمانية آلاف جرة”. ويعطينا سكروم جور فكرة عن ثمن الماء في الصيف، فيقول: إن كل 100 جرة تباع بأربعة بشالك أي مقابل شلن واحد وعشرة بنسات، بالإضافة إلى أن سحب الماء هو على المشتري. المرجع: موسوعة الفلكلور الفلسطيني الطبعة الكاملة من الألف إلى الياء، تأليف نمر سرحان، الناشر دائرة الثقافة، منظمة التحرير الفلسطينية، الطبعة الثانية – عمان 1989. |
البيت الشعبي