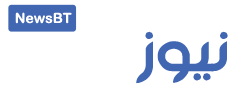مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 17 ،العدد 66) ربيع 2006
الانتخابات والمسألة الديمقراطية في الحقل السياسي الفلسطيني
يشهد النظام السياسي الفلسطيني، وخصوصاً بعد فوز “حماس” في الانتخابات التشريعية، تحولات بالغة الأهمية لا تقتصر دلالاتها ونتائجها المرتقبة على إعادة توزيع مناصب السلطة ومنافعها فحسب، بل تتعداها أيضاً إلى بنية النظام السياسي من حيث التحول في مصادر الشرعية،وفي آلية اتخاذالقرار،وفي الصفة التمثيلية للسلطة . لقد خاض الفلسطينيون، بروح من المسؤولية وبوعي بآليات الممارسة الديمقراطية، الانتخابات التشريعية للمرة الثانية، بعد أن خاضوا بنجاح الانتخابات المحليةوالانتخابات الرئاسية مرتين أيضاً. فما هو تقويم هذه التجارب الانتخابية؟ وما هي علاقتها بالديمقراطية كنظام حكم؟ وما هي انعكاساتها على النظام السياسي الفلسطيني، وعلى الصراع في فلسطين بصورة عامة؟ سنتناول الموضوع من خلال المحاور التالية: المحور الأول: النظام السياسي الفلسطيني بين التشارك التوافقي والمشاركة عبر الانتخابات . المحور الثاني: مراهنتان متناقضتان على الانتخابات . المحور الثالث: ما بعد الانتخابات. النظام السياسي الفلسطيني أولا ً: خصوصية النشأة وتداخل المهمات لا بد من الإشارة بداية إلى أنه مما يتعارض مع الدقة العلمية الحديث عن نظام سياسي ديمقراطي فلسطيني، وذلك لسببين : الأول: غياب الدولة الفلسطينية المستقلة، وبالتالي غياب السيادة عن النظام السياسي الراهن. فالديمقراطية هي نظام سياسي يحدد علاقة الحاكمين بالمحكومين، والشعب الفلسطيني لم يكن يحكم نفسه بنفسه عبر التاريخ الحديث، باستثناء مرحلة الحكم الذاتي، مع أنه يمكن القول إن الفلسطينيين عرفوا شكلاً من الممارسة الديمقراطية على مستوى مؤسسات اجملتمع المدني من نقابات واتحادات شعبية. الثاني: كون الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة التحرر الوطني، وحركات التحرر الوطني، كما هو معروف، كانت تؤجل قضايا الصراع الاجتماعي والاستحقاقات الديمقراطية إلى ما بعد التحرير، إذ إن متطلبات مواجهة العدو أسبق في الأولوية من ترف الفكر الديمقراطي والممارسة الديمقراطية. هذا بالإضافة إلى أن حركة التحرر الفلسطينية كانت محكومة بالفكر الاشتراكي والقومي، وهو فكر لم يكن على علاقة ودية بالفكر الديمقراطي الليبرالي. ومع ذلك لم يخل الأمر عند حركة التحرر الفلسطينية من ممارسة تنسب إلى الديمقراطية كالتعددية التنظيمية والسياسية، ودرجة من حرية الرأي والتعبير، وعلاقات توافقية ما بين التنظيمات المسلحة، وهذا ما كان يطلق عليه: “ديمقراطية غابة البنادق”. إلاّ إن هذه التعددية كانت على الأغلب بحكم الضرورة، والإملاءات الخارجية، وغياب سلطة مركزية فلسطينية قادرة على ضبط الحالة السياسية الفلسطينية، أكثر مما كانت تعبيراً عن إيمان بثقافة الديمقراطية. الانتخابات الفلسطينية مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد 17 ،العدد 66) ربيع 2006 ،(ص 43 2 من هنا يمكن فهم الغموض والإرباك اللذين يصاحبان الحديث عن المشروع الوطني الفلسطيني، على الرغم من تواتر الحديث عنه يومياً. فمن المعلوم أن هذا المشروع، الذي كان القاسم المشترك بين الفصائل المؤطرة في منظمة التحرير الفلسطينية، ظل حتى سنة 1988 – أي قبل ظهور الحركات الإسلامية – يضع هدفاً له تحرير كامل فلسطين، مع القبول بسلطة على أي جزء من فلسطين يتم تحريره، لكن كمرحلة نحو الهدف الاستراتيجي. أمّا وسيلة الوصول إلى الهدف فهي كل طرق النضال، وعلى رأسها الكفاح المسلح. هذا النظام، الذي جسّدته منظمة التحرير، كان مدفوعاً بزخم قواعد للثورة خارج الوطن، وثورة داخل الوطن، ومعسكر حلفاء واسع يشمل المعسكر الاشتراكي ودول عدم الانحياز وحركة التحرر العالمية وحركة التحرر العربية؛ أي أن هذا المشروع، في الحقيقة، لم يكن ً وطنيا خالصاً، وإنما كان حصيلة تداخل والتقاء ظرفي ما بين التطلع الوطني الفلسطيني إلى الاستقلال وبين المشروع الأيديولوجي القومي العربي والمشروع التحرري العالمي، بالإضافة إلى تطلعات شعبية إسلامية مؤيدة للفلسطينيين. لكن بعد سنة 1988 تبنت منظمة التحرير هدف إقامة دولة مستقلة في حدود سنة 1967 مع تطبيق قرارات الشرعية الدولية كافة. وبعد سنة 1993 أصبح النظام السياسي أسير اتفاق أوسلو بنصوصه الغامضة وملاحقه وتطبيقاته المأساوية. وفي ظل الانتفاضة أصبح مفهوم النظام السياسي، وبالتالي المشروع الوطني، أكثر لبساً، إذ يتراوح ما بين دولة مستقلة في الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشريف وضمان حق العودة وفق المواثيق الفلسطينيةوالدولية،وبين دولة بحسب خطاب الرئيس الأميركي بوش،وخطة خريطة الطريق، وأخيراً القبول بخطة شارون أوالاستعدادللتعامل معها. إلاّ إنه مع بداية الانتفاضة الأولى ظهرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” من خارج المؤسسة الوطنية الرسمية، متميزة بأيديولوجيتها الإسلامية، وبنهجها الجهادي غير المعترف بالتسوية وبالمفاوضات، وبشبكة علاقاتها وتحالفاتها. وقد تجسد ذلك في ميثاقها الذي أطر لنظام سياسي فلسطيني مغاير. وقد تعزز وجود حركة “حماس” والجهاد الإسلامي في ساحة العمل السياسي الفلسطيني خلال انتفاضة الأقصى، الأمر الذي أوجد في الساحة الفلسطينية تصورين، إن لم يكن أكثر، لمفهوم النظام السياسي، سواء من حيث الهدف أو من حيث الوسائل النضالية أو من حيث الأيديولوجيا المؤطرة، إلخ. غموض والتباس مفهوم النظام السياسي والمشروع الوطني شكلا، وما زالا، أهم عوائق تشكيل قيادة وحدة وطنية ذات استراتيجيا واضحة. وإذا كان الغموض في بعض المراحل أمراً مبرراً ومطلوباً، لأنه أتاح للفصائل استقطاب جميع شرائح اجملتمع، ولم يكن هناك من يحاسب أحداً على ما يقول وما يفعل، إلاّ إن الوضع تغير اليوم. فكل فصيل، وكل زعيم، يُتابَع اليوم دولياً على كل كلمة يقولها، وعلى كل ممارسة ينهجها، كما أن للتسوية استحقاقات مؤلمة يجب دفعها تمس جوهر مشروعنا الوطني التاريخي. هذا الأمر دفع القوى السياسية إلى التفكير في التوصل إلى تصور مشترك للنظام السياسي وآليات عمله. ثانيا ً: النظام السياسي من الشرعية الكاريزماتية والتاريخية إلى الشرعية الدستورية قبل ظهور حركة “حماس” والجهاد الإسلامي كانت كل الفصائل الفلسطينية تقريباً تشارك في النظام السياسي تحت قبة منظمة التحرير، وكان نظام الحصص أو “الكوتا” هو المعمول به. وعلى الرغم من وجود اختلاف في المواقف السياسيةفإن هذه الاختلافات لم تكن تصل إلى درجة الخروج عن النظام السياسي، أو طرح مشروع وطني مناقض للميثاق الوطني. حضور “حماس” على الساحة بنهجها الجهادي، وبأهدافها المطالبة بتحرير كل فلسطين، وبمرجعيتها الدينية، ثم توقيع اتفاق أوسلو الذي اعتبره البعض خروجاً عن الثوابت الفلسطينية، وبالتالي ً تجاوزا للمشروع الوطني الفلسطيني، كل هذا أحدث انقساماً في النظام السياسي الفلسطيني وصل إلى درجة التشكيك في الانتخابات الفلسطينية مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد 17 ،العدد 66) ربيع 2006 ،(ص 43 3 تمثيل السلطة الوطنية للشعب الفلسطيني، بل طرحت “حماس” نفسها، ضمناً، كممثل شرعي بديل للشعب الفلسطيني. ولولا الانتفاضةوتداعياتها لاحتدم الصراع بين السلطةو”حماس” منذ أعوام. أدت شخصية أبو عمار الكاريزماتية وخياراته التكتيكية الوطنية دوراً في استيعاب ما يبدو تناقضاً بين مختلف مكونات المشهد السياسي، إذ عمل على توظيف الأعمال العسكرية لـ “حماس” والجهاد وكتائب شهداء الأقصى وبقية الفصائل في تحسين الموقع التفاوضي للسلطة ومنظمة التحرير، وفي إجبار إسرائيل والولايات المتحدة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. كما كان يستعين بها كحماية له من منافسيه داخل “فتح”. إلاّ إن وصول هذه المراهنة إلى طريق مسدود، وتزايد الإرهاب الإسرائيلي، وانقلاب الموقف الأميركي إلى معاداة السلطة ورئيسها، ثم مأزق المنظمات الجهادية، كل هذا فرض على الطرفين – سلطة ومعارضة – البحث عن صيغة جديدة لنظام سياسي جديدومشروع وطني جديد بعدفشل المراهنة على إحياء منظمة التحرير الفلسطينية. ولأن “حماس” وفصائل المعارضة كانت تريد أن تشارك في الحياة السياسية، وتريد شرعية سياسية معترفاً بها دولياً تعوضها عن شرعيتها الجهادية المرفوضةدولياً،وتريد أيضاً أن يكون لها موقع قدم في أي تسوية مستقبلية كي تبعد عن نفسها تهمة الإرهاب، لكل ذلك بدأت حركة “حماس” تتعامل مع الأطروحات التي تطالب بإحياء منظمة التحرير، أو المشاركة في العملية السلمية وفي أطرافها الدولية، ثم قبلت بمبدأ الانتخابات بعد أن كانت تحرمها. لم تنجح كل جولات الحوار بين القوى السياسية، سواء التي جرت داخل الوطن أو خارجه، في التقريب بين المواقف فيما يخص إعادة بناء النظام السياسي على أسس من التشارك في السلطة والقرار. ويبدو أن غياب الثقة بين الطرفين، والدور السلبي لأطراف خارجية، قاما بدور في عدم التوصل إلى تفاهمات استراتيجية تخرج النظام السياسي من مأزقه، لكنهما حققا بعض التقدم في تحريم الاقتتال الداخلي،وفي التوصل إلى تهدئة متفق عليها . وبقبول “حماس” وبقية القوى السياسية بالمشاركة في الانتخابات المحلية بداية، ثم التشريعية بعد طول ممانعة، تكون قد اتخذت قراراً بالانتقال إلى مفهوم المشاركة السياسية، وخصوصاً أن الانتخابات هي جزء من خطة خريطة الطريق، ومن استحقاقات دولية. لكن هل الانتخابات، في ظل تباعد البرامج وتعدد الاستراتيجيات، ستخرج النظام السياسي من مأزقه؟ ثالثا ً: الانتخابات كاستحقاق ديمقراطي خارج سياق التطور الاجتماعي لم يعد أحد اليوم يحاجّ في أهمية الانتخابات كآلية للممارسة الديمقراطية، وفي أن الديمقراطية هي “أقل الأنظمة السياسية سوءاً.” لكن الديمقراطية ليست عقيدة جامدة، وإنما هي نظام للحكم يقوم على مبادئ عامة أهمها تجسيد إرادة الأمة، والتنافس الحر والنزيه بشأن السلطة بين أحزاب وقوى سياسية ذات برامج مختلفة، وخلق دولة المؤسسات والقانون بدلاً من دولة الزعيموالحزب الواحد. وهذه المبادئ العامة يتم تبيئتها بحسب خصوصيات كل مجتمع، وبالتالي هناك مداخل متعددة للديمقراطية، إلاّ إن أهم شرط من شروطها هو شرط الحرية، حرية الوطن وحرية المواطن، فلا يمكن لمواطن غير حر يعيش في وطن خاضع للاحتلال أن يمارس انتخابات نزيهة، أو يؤسس نظاماًديمقراطياً؛فالاستعمار نقيض الحرية،وبالتالي نقيض الديمقراطية. وعليه، نلاحظ أن مسألة الديمقراطية لم تكن مطروحة عند حركات التحرر في العالم، وكان المبدأ الموجه لها أنه عندما يكون الشعب خاضعاً للاحتلال تتوقف كل الصراعات الطبقية، وكل الصراعات فيما يتعلق بالسلطة، لمصلحة جبهة وطنية متحدة لمواجهة الاحتلال. وفقط بعد القضاء على الاحتلال،وبعد التحرير، يمكن الالتفات إلى نظام الحكم. أيضاً من شروط نجاح الانتخابات كآلية للتحول الديمقراطي أن تكون المنافسة بين قوى سياسية تختلف بشأن البرامج لكنها تتفق على ثوابت ومرجعيات وطنية، أو ما يصطلح عليه باسم “الاختلاف داخل الوحدة”. وكلما كانت الفوارق بين برامج الأحزاب أقل حدة، كان تداول السلطة، وتأليف حكومات ائتلافية، أكثر يسراً. ولو نظرنا إلى الانتخابات الفلسطينية مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد 17 ،العدد 66) ربيع 2006 ،(ص 43 4 بعض التجارب الديمقراطية في الغرب، لوجدناقوى سياسية كثيرة لم يسمح لها بالمشاركة في الحياة الديمقراطية، وبالتالي المشاركة في الانتخابات، إلاّ بعد أن غيرت برامجها لتصبح أكثر توافقاً مع القيم والمبادئ العامة التي يقوم عليها النظام السياسي. وهذا ما جرى مع الأحزاب الشيوعية في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا التي كانت تسعى لإنشاء نظام يقوم على دكتاتورية البروليتاريا وترفع شعارات الوصول إلى السلطة عن طريق الثورة، ولم تصبح جزءاً من النظام السياسي إلاّ بعد أن تخلت عن هذه المبادئ المشار إليها لأنها تتناقض مع الليبرالية التي هي جوهر النظام الديمقراطي. وهذا ما جرى في بداية السبعينيات مع ما سمي ظاهرة “الأورو شيوعية”. الأمر الخطر في الحالة الفلسطينية هو أن الانتخابات جرت بين فصائل متناقضة في برامجها واستراتيجياتها، بعضها يقول بالكفاح المسلح لتحرير كل فلسطين من البحر إلى النهر وعدم الاعتراف بإسرائيل، وبعضها الآخر يقول بالتسوية والمفاوضات ويعترف بإسرائيل. ليس هذا فحسب، بل إن كل فصيل له جيش وميليشيا ومؤسساته الاجتماعيةوالسياسيةوجامعاته الخاصة به. وهذا الاستقطاب التناقضي هو الذي يضع التجربة الديمقراطية أمام تحد كبير،ويثير تساؤلات تتعلق بقدرة الانتخابات على إخراج النظام السياسي من مأزقه. لا نروم من هذا التمهيد التقليل من أهمية الانتخابات الفلسطينية، أو الزعم أن الممارسة الديمقراطية تتناقض مع العمل ضد الاحتلال. لكن مرامنا التأكيد أن أولوية الشعب الخاضع للاحتلال هي مقاومة الاحتلال لا الصراع بشأن سلطة وهمية، إذ إنه لا يمكن تأسيس نظام ديمقراطي في ظل الاحتلال، والتأكيد أيضاً أنه كان من الضروري أن تسبق الانتخابات تفاهمات وتوافق وطني فيما يخص الثوابت والمرجعيات. لكن هذا لا ينفي أهمية الممارسة الديمقراطية عند الشعب الخاضع للاحتلال، سواء لاختيار قيادته، أو لتوزيع المهمات، أو لتحديد استراتيجيات العمل الوطني. وما يصح بالنسبة إلى الدول العربية يصح أيضاً في الحالة الفلسطينية. فلو أن الأنظمة العربية الثورية والتقدمية والمحافظة وفرت لشعوبها الحياة الكريمة سياسياً واقتصادياً، وكانت معبرة عن إرادة الأمة، لما كانت دعوات الإصلاح الديمقراطي الأميركية وجدت تجاوباً؛ ولو لم تكن السلطة فاسدة باعتراف الجميع، بمن فيهم أهلها، ولو تمكن الفلسطينيون من تشكيل قيادة وحدة وطنية، لما كان هناك مبرر للحديث عن الإصلاح والديمقراطية بالطريقة التي تحدث اليوم. مراهنتان متناقضتان على الانتخابات في الحالة الفلسطينية لا يمكن الفصل بين الانتخابات وبين ما يمكن تسميته ديمقراطية الضرورة. وهذا النمط من الديمقراطية لا يأتي في سياق سيرورة سياسية واجتماعية مشبعة بثقافة الديمقراطية، ولا يتطلب أصلاً وجود هذه الثقافة،وإنما تمليه اعتبارات خارجية أو ضرورات داخلية نابعة، من جهة، من تأزم النظام السياسي القائموتأكل شرعيته، وبالتالي عدم قدرته على إنجاز المشروع الوطني، ومن جهة أُخرى، من وصول قوى المعارضة إلى درجة من القوة والنضج تجعل من الصعب إبقاءها خارج الحكم وحرمانها من المشاركة في صنع القرار واقتسام غنائم السلطة، شرط أن تتخلى عن المراهنة على انهيار النظام السياسي أو إسقاطه بوسائل غير ديمقراطية. وقد تملي هذا النمط من الديمقراطية ضغوط خارجيةقوية نابعة من مصالح مغلفة بشعارات براقة. والخطر في مثل هذا النمط من الديمقراطية، نظراً إلى ضعف الثقافة والمؤسسات الديمقراطية، هو أن تؤدي الانتخابات إلى نوع جديد من الاستبداد بدلاً من القديم، أو أن ينتج منها نظام لا يعبر تعبيراً صحيحاً عن إرادة الأمة، وخصوصاً إذا كانت الاعتبارات الخارجية هي التي أملت إجراء الانتخابات. وبالنسبة إلى الحالة الفلسطينية لا شك في أن الخارج هو الذي أدى الدور الأكبر في استدعاء الانتخابات، ومن الضروري، كي تخدم الانتخابات الأهداف الفلسطينية، لا أهداف الخارج، أن يتعزز الوعي بأن الانتخابات ليست هدفاً بحد ذاته، والسلطة ليست ً هدفا أيضاً، بل هما مجرد أداتين لإعادة بناء النظام السياسي ليصبح أكثر قدرة وتأهيلاً لإنجاز المشروع الوطني التحرري. وهذا المشروع لا يمكن لحزب واحد أن ينجزه،وإنما يحتاج إلى جهود كل الشعب الفلسطيني. الانتخابات الفلسطينية مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد 17 ،العدد 66) ربيع 2006 ،(ص 43 5 لا محاجّة في أن مشاركة “حماس” وبقية القوى السياسية في الحياة السياسية العامة وفي النظام السياسي تعد تحولاً إيجابياً، بل يمكن القول إن المصلحة الوطنية كانت تحتم مشاركة “حماس” في الانتخابات،وإحرازها ً نجاحا كبيراً، ذلك بأنه لا يعقل أن تطلب السلطة والقوى الخارجية من “حماس” التخلي عن العمل العسكري من دون أن يُفتح لها باب المشاركة في العمل السياسي الرسمي، إذ ماذا ستفعل “حماس” بما لها من قوة الحضور الشعبي والعسكري، إن مُنعت من العمل العسكري وحيل بينها وبين المشاركة في السلطة، أي المشاركة في القرار وفي الغنائم؟ مشاركة “حماس” وكل القوى السياسية المعارضة تخدم المصلحة الوطنية العليا، حتى لو تضررت مصالح حزب السلطة ومن يدور في فلكه. فالقوة المتوفرة لدى “حماس” تحتاج إلى مسارب تُفرغ فيها، وليس بالضرورة أن تعني المشاركة في السلطة السعي لاحتكارها أو التخلي نهائياً عن خيار المقاومة، بل إن ذلك قد يكون مدخلاً إلى البحث عن صيغة توفيقية لإجماع وطني بشأن مفهوم المقاومة في المرحلة المقبلة إن لم تلتزم إسرائيل تعهداتها . أحوال الشعب الفلسطيني، كشعب خاضع للاحتلال، ومرتهن باتفاقات ومعاهدات سياسية، ويعتمد اعتماداً شبه كلي على العالم الخارجي، وتميل موازين القوى مع عدوه إلى غير مصلحته، بالإضافة إلى ما تعرفه مناطق السلطة من انفلات أمني خطر، وحالة من الانفلات السياسي والتنظيمي عند حزب السلطة وأحزاب أُخرى، وضغوط تمارس على السلطة والفصائل لنزع سلاح الجماعات المسلحة، والعدوان المتواصل على قطاع غزة واستباحة الضفة الفلسطينية، كل ذلك جعل نتائج الانتخابات تُوقف الحديث عما سمي العرس الفلسطيني، وتطلق الحديث عن مأزق لم يكن في الحسبان، وهو فوز “حماس” فوزاً كاسحاً مع تمسكها باستراتيجيا متناقضة مع استراتيجيا النظام السياسي الرسمي والتزاماته الدولية. ضمن المشهد السياسي الراهن يمكن تلمس صراع بين مراهنتين متناقضتين على الانتخابات الفلسطينية: الأولى هي المراهنة الأميركيةوالإسرائيلية؛ الثانية هي المراهنة الوطنيةوالتي بدورها تتضمن مراهنتين أوتصورين. 1 – المراهنة الأميركية والإسرائيلية سيكون من السذاجة الاعتقاد أن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية ترغبان في تعليم الفلسطينيين أسس الديمقراطية، أو في مساعدتهم على إقامة دولة ديمقراطية. كما أن من الوهم الشديد القول إن إسرائيل كانت تحول دون تمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لأنهم أرادوا تحقيق هذه الحقوق بوسائل الكفاح المسلح والجهاد، وبالتالي إذا ما أصبحوا ديمقراطيين وطالبوا بحقوقهم بالطرق السلمية والديمقراطية فستوافق على نيلهم حقوقهم. إذاً لماذا هذا الاهتمام الأميركي بالانتخابات الفلسطينية وعدم الممانعة الإسرائيلية؟ هدفت الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال تشجيع الانتخابات إلى إلهاء الفلسطينيين بالتنافس في شأن السلطة بدلاً من مقاومة الاحتلال، وأيضاً إلى تصوير الواقع على غير حقيقته بالزعم أنه لا يوجد احتلال، وإن وجد فهو احتلال حضاري لا يحول بين الفلسطينيين وممارسة حياتهم العادية، وإنشاء علاقات مع العالم الخارجي، وتلقي المساعدات، وإقامة المشاريع التنموية، واستقبال الوفود الأجنبية، وإجراء الانتخابات. وللأسف ساهمت السلطة في تمرير هذه المقولة عندما قبلت بإجراء الانتخابات بوجود الاحتلال، وتنازلت عن شرطها السابق القاضي بانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي دخلها بعد أيلول/سبتمبر 2000 .كما كان ضمن الأهداف الأميركية – الإسرائيلية ضمان استمرارية السلطة في يد بعض رموز حركة “فتح”، التي التزمت التسوية وربطت مصالحها الاقتصادية والماليةوالحياتية بها،ومحاولة إبرازقيادة جديدة تُسوَّق كقيادة شرعية للشعب الفلسطيني تقر ما تم توقيعه من اتفاقات، وتوقّع بصفة شرعية مستمدة من صناديق الانتخابات الحلول السياسية المقبلة، سواء ما ستسفر عنه خطة خريطة الطريق أو خطة شارون. إن مشاركة كل القوى السياسية، وعلى رأسها حركة “حماس” التي لم يكن في الحسبان أن تحقق مثل هذا الفوز الكاسح في الانتخابات، كان يؤمل منها اندماج هذه القوى في نظام سياسي يؤطره اتفاق أوسلووما تلاه من تفاهمات،ومن ثم تحويلها من حركات جهادية تهدف إلى تحريرفلسطين بالعمل العسكري إلى حركات سياسية تسعى إلى مواقع السلطةوتتنافس بشأنها. الانتخابات الفلسطينية مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد 17 ،العدد 66) ربيع 2006 ،(ص 43 6 إن الولايات المتحدة وإسرائيل غير معنيتين بأن نكون ديمقراطيين، أو بأن نؤسس نظاماً ديمقراطياً، بقدر ما هما معنيتان بالجانب الشكلي للديمقراطية، أي الصفة التمثيلية لقيادة لا تخرج عن نهج التسوية التي تخططان لها. وللأسف الشديد فإن ما جرى خلال الانتخابات التمهيدية داخل حركة “فتح”، ثم الجدل الجاري اليوم بعد فوز حركة “حماس” بالأغلبية، يجعلاننا نتخوف من تحقيق القوى المعادية لبعض مراميها. 2 – المراهنة الوطنية الفلسطينية هذه المراهنة الأميركية والإسرائيلية قد لا تلقى، على الرغم من تخوفاتنا، حظاً كبيراً من النجاح لأن أغلبية الفلسطينيين واعية لها ومدركة خطورتها. إن المراهنة الفلسطينية على الانتخابات تنبع من وعي سياسي بخطورة المرحلة، وبضرورة قبول التحدي الديمقراطي، وخصوصاً أنه منصوص عليه في خطة خريطة الطريق التي يطالب الفلسطينيون إسرائيل بالتزامها؛ وهي مراهنة على أن الانتخابات هي الوسيلة المتاحة لإعادة بناء البيت الفلسطيني الداخلي بعد أعوام من تعثر التوصل إلى قيادة وحدة وطنية. والأهم من ذلك أن الفلسطينيين لا يرون في الانتخابات وفي الديمقراطية هدفاً بحدذاته، بل وسيلة لتمتين البيت الفلسطيني، كي يكون أكثرقدرة على استكمال المشروع التحرري الوطني، مع إدراكنا خطورة الأمر وصعوبته، إذ إن استحقاقات حركة التحرر تختلف كثيراً عن استحقاقات الممارسة الديمقراطية. ومن هنا ضرورة التحذير من أن يؤدي انغماس القوى السياسية في الصراع بشأن سلطةوهمية إلى قطع الطريق على نهج التحرر إذا مافشلت التسوية السياسية. إن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي حصدت فيها حركة “حماس” أغلبية كبيرة من الأصوات (74 من مجموع 132 هو عدد مقاعد اجمللس التشريعي)، أوجدت ارتياحاً مصحوباً بحالة من القلق؛ ارتياحاً إلى نجاح التجربة الانتخابية وما يمكن أن يتبع ذلك من عملية إصلاح وتغيير داخلية يأمل الشعب بأن تؤدي إلى وضع حد للفساد ولكل أوجه الخلل الاقتصادي والاجتماعي في مناطق السلطة، وقلقاً سياسياً إزاء قدرة حركة “حماس”، إذا ما ألّفت الحكومة، على التعامل مع القضية الوطنية دولياً في ظل تمسكها بثوابتها، وخصوصاً عدم الاعتراف بإسرائيل. ما بعد الانتخابات : النظام السياسي إلى أين؟ في الأيام الأولى التالية لإعلان نتائج الانتخابات تصرّف الشارع الفتحاوي بشكل استفزازي عبر عن عمق الصدمة والألم. بعض قادة حركة “فتح” سارع إلى اتخاذ موقف بعدم المشاركة مع “حماس” في الحكومة، وبعضهم الآخر حرض الشارع الفتحاوي وأخرجه بتظاهرات أشبه بحالة التمرد على نتائج الانتخابات وعلى ما يزعمون أنه تقصير من القيادة التقليدية. أمّا حركة “حماس” فراحت تناور وتتلاعب بالكلمات فيما يخص الاعتراف بإسرائيل والمفاوضات والمقاومة، وبدت، أو تعمّدت أن تبدو، كأنها حائرة ما بين التمسك بثوابتها وبين الاستجابة للضغوط التي تمارس عليها كي تكون أكثر واقعية مع المتطلبات الدولية والاتفاقات التي وقعتها السلطة السابقة ومنظمة التحرير مع إسرائيل. وأمّا الدول الأوروبية والولايات المتحدة، فقد أخذت ترسل رسائل التهديد والوعيد بأنها ستقاطع حكومة برئاسة “حماس”،وتقطع المساعدات عن السلطة إذا لم تعترف “حماس” بإسرائيل وتلتزم الاتفاقات المعقودة معها وتنبذ العنف إلخ. ورأى كتّاب ومحللون كثيرون أن “حماس” ستسير في الطريق نفسه الذي سارت فيه منظمة التحرير، أي التدرج في النزول من الشجرة – من تحرير كل فلسطين بالكفاح المسلح إلى الاعتراف بإسرائيل وبقرارات الشرعية الدولية – بمساعدة مصر والأردن ودول خليجية. وهم يعتقدون أن سرعة نزول “حماس” من الشجرة ستكون أكبر لأنها انتقلت، من حيث لم تحتسب، من المعارضة إلى حزب سلطة بأغلبية مرتفعة من الأصوات. لا مجال للتقليل من أهمية فوز “حماس” في الانتخابات، أو التهوين من شأن الاختيار الشعبي. فـ “حماس” فازت فوزاً كاسحاً، وحركة “فتح” وقوى اليسار ومن يسمون التيار الثالث هزموا شر هزيمة. وفي تفسير ذلك هناك من يرى أن “حماس” فازت لأنها أتقنت التعامل مع الماكينة الانتخابية، وعرفت كيف تكسب الجمهور؛ وهناك من يرى الانتخابات الفلسطينية مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد 17 ،العدد 66) ربيع 2006 ،(ص 43 7 أنها فازت لأن السلطة بزعامة “فتح” لم تعط الشعب أملاً، لا على المستوى السياسي، ولا على المستوى الاقتصادي؛ وهناك من يعتقد أنها وصلت إلى السلطة بفعل صفقة دولية بدأت منذ عامين تقريباً عندما قررت “حماس” المشاركة في الانتخابات المحلية لأنها لمست أن مشروعها الجهادي وصل إلى طريق مسدود وقررت الولايات المتحدة والأوروبيون إشراكها في السلطة كجزء من استراتيجيا عالمية تعتمد سياسة استيعاب الحركات الإسلامية في إطار النظم السياسية القائمة. إلاّ إنه مهما تكن الأسباب فقد أصبحت حركة “حماس”، وبمقتضى قواعد اللعبة الديمقراطية والقانون الفلسطيني، مؤهلة نظرياً لقيادة النظام السياسي الفلسطيني داخل مناطق السلطة. وكي يمكنها كحكومة منتخبة إخراج النظام السياسي من أزمته كان يتعين عليها حل مشكلة المرجعية التمثيلية للشعب، أي العلاقة بينهاوبين منظمة التحرير الفلسطينية،وكان يتعين عليها أيضاً العمل الحثيث لتشكيل حكومة ائتلافية، أو على الأقل أن تكسب ثقة أغلبية الكتل البرلمانية لأن تفردها بالسلطة لن يساعد في حل مشكلة النظام السياسي. وربما كان السؤال الأهم الذي يترقب الجميع جواباً عنه هو: هل ستكون “حماس” قادرة على التخاطب مع العالم ومواصلة مسيرة المفاوضات والتسوية؟ لكن حدث ما كان يخشاه البعض، وبدلاً من أن تستقيم أمور النظام السياسي ازداد الوضع تأزماً بعد رفض اللجنة التنفيذية، بصفتها الأداة التنفيذية لمنظمة التحرير، برنامج الحكومة التي ألّفها رئيس مجلس الوزراء المكلف السيد إسماعيل هنية؛وهو رفض متوقع، لأنه لا يُعقل أن تعترف مرجعية أعلى بمرجعية أدنى لا تعترف بهاولا بالقانون الأساسي الذي شرّع الانتخابات! وبات للنظام السياسي ثلاثة رؤوس أساسية: منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد بمقتضى الميثاق الوطني والقانون الأساسي للسلطة والاعتراف العربي والإسلامي والدولي؛ رئيس للمنظمة والسلطة؛ حكومة تترأسها أغلبية انتُخبت من جزء من الشعب على جزء من الأرض، على أساس برنامج متعارض مع برنامج الممثل الشرعي لكل الشعب ! إن تأليف حكومة حمساوية، بعيداً عن مشاركة القوى السياسية الأُخرى والمستقلين، يضع النظام السياسي والمشروع الوطني الفلسطيني برمته موضع تساؤل. فكيف يمكن أن يقاد هذا المشروع بأكثر من رأس ومرجعية؟ وما فائدة الانتخابات إن لم تؤد إلى تشكيل حكومة ائتلافية؟ وما هو المشروع الوطني الذي تقوده حركة سياسية (“حماس”) تقول إنها امتداد لحركة أُخرى (جماعة الإخوان المسلمين) ليست فلسطينية، لا من حيث المنشأ ولا من حيث القيادةولا من حيث الاهتمامات؟ ومع كامل الاحترام والتقدير لحركة “حماس” كحزب انتخبه الشعب في الضفة وغزة وله تاريخه النضالي، ومع الإقرار بأن تهميش منظمة التحرير بدأ على يد أصحابها، وبأن سلطة “فتح” فشلت – أو أُفشلت – في الارتقاء إلى طموحات الشعب، إلاّ إن “حماس” بمشروعها الديني، الذي هو امتداد لقيادة خارجية، ويتجاهل الهوية الوطنية والاستقلالية الوطنية، لا يمكنها أن تكون إطاراً مستوعباًوموحداً لكل فئات الشعب وأحزابه السياسية، بينما منظمة التحرير يمكنها أن تكون كذلك، لكن، بطبيعة الحال، بعد إنهاضها من كبوتها وبث الروح فيها واستيعابها لكل القوى السياسية الجديدة، وخصوصاً “حماس” والجهاد الإسلامي. ونعتقد أن ميثاق المنظمة وقانونها الأساسي من المرونةوالأريحية السياسيةوالعقائدية بما يسمح بأن تمثل أطياف المشهد السياسي الفلسطيني كله . أخيراً، وبما أن المشكلة هي ليست من يحكم، وإنما من يستطيع أن ينجز المشروع الوطني التحرري الذي يواجه تحديات صعبة وعدواً قوياً، فإن من الحيوي جداً إدراك أن حزباً واحداً لا يستطيع القيام بذلك بمفرده. إن التفاهمات الداخلية،ووجوداستراتيجياوطنية موحدة (وحتى هذا لم يتحقق إلى الآن) أمر ضروري، إلاّ إن المحددات الخارجية لها دور كبير في العملية السياسية برمتها، ومن هذه المحددات الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل وقرارات الأمم المتحدةوالمبادرة العربية . ويبدو أن ما يؤخر تعامل حركة “حماس”، وبالتالي الحكومة الفلسطينية الجديدة، مع هذه الاستحقاقات الدولية هو مرجعيتها الدينية. فالحركة أسيرة برنامج سياسي أسّس ثقافة شعبية عند جمهورها تعتبر أن الاعتراف بإسرائيل من المحرمات، وتعتبر أن “حماس” تمثل توجهاً دينياً وتطرح نفسها كمعبرة عن الإسلام والمسلمين في فلسطين، الانتخابات الفلسطينية مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد 17 ،العدد 66) ربيع 2006 ،(ص 43 8 وأنها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين. ونظراً إلى البعد الديني للصراع مع الكيان العبري، فإن اعتراف “حماس” بإسرائيل سيشكل انقلاباً في مجمل الصراع في المنطقة، وسيكون له تداعيات أبعد مدى من فلسطين. الاعتراف بإسرائيل من طرف حركة المقاومة الإسلامية “حماس” سيدفع كل مسلم إلى التساؤل عن معنى القول إن فلسطين وقف إسلامي لا يجوز التفريط به، وعن معنى أرض الرباط والأرض التي باركنا حولها، وعن معنى حمل الرايات الخضر، ومعنى الإسلام هو الحل، ومفهوم العمليات الاستشهادية، ولماذا كانت أصلاً، ولماذا سقط أكثر من 400 شهيد خلال الانتفاضة، إلخ . وعلى الرغم من وجود أكثر من تصريح من أكثر من مسؤول حمساوي يستشف منه محاولة الحركة الاقتراب من متطلبات التسوية ومغازلة الولايات المتحدة والأوروبيين، وإيجاد طمأنينة عند الجمهور الفلسطيني لجهة تأمين مصادر التمويل الأجنبي، وطمأنينة عند الدول الأجنبية إلى أن “حماس” ليست حركة إرهابية بالشكل الذي تعتقده هذه الدول، والتزامها التهدئة حتى الآن وزيارة قادتها للقاهرة وروسيا الاتحادية وتركيا وغيرها من الدول، ثم ما ورد في خطاب رئيس مجلس الوزراء المكلف، السيد إسماعيل هنية، أمام اجمللس التشريعي من دعوة الرباعية إلى الحوار والحديث عن المقاومة بصيغة مبهمة وعامة شبيهة بما هو منصوص عليه في دساتير كل الدول المستقلة وفي ميثاق الأمم المتحدة، على الرغم من كل ذلك فإننا نعتقد أن اعتراف حركة “حماس” بإسرائيل سيكون أكثر خطورة من اعتراف كل فصائل منظمة التحرير، وسيكون له انعكاسات خطرة، سواء على الوضع الفلسطيني الداخلي، أو على مستوى الصراع في المنطقة برمته. خلاصة لقد بات واضحاً أن جذور المأزق الذي يعيشه النظام السياسي الفلسطيني ترجع إلى اللحظة التي دخلنا فيها انتخابات تشريعية قبل الاتفاق على ثوابت ومرجعيات مشتركة؛ ذلك بأنه لا يمكن أن يحدث تداول ديمقراطي سلمي للسلطة بين أحزاب سياسية ذات برامج متناقضة في الجوهر. لكن يبدوأن أغلبية الأطراف السياسية لم تدخل اللعبة الانتخابية والديمقراطية بثقافة وعقلية ديمقراطيتين، وإنما بعقلية انقلابية وبفعل ضغوط خارجية، ومن كان منها حسن النية حاصرته، من جانب، ثقافة شعبية مشبعة بالعواطف، ومن جانب آخر قوى التآمر والتخريب التي تسيرها أطراف خارجية. وكذلك ترجع الجذور إلى بنية مؤسساتية تفتقر إلى الفكر والتفكير الاستراتيجيين، ذلك بأن وصول المشهد السياسي الفلسطيني إلى ماوصل إليه يفسَّر بواحد من اثنين: الأول: إن العملية الانتخابية برمتها هي صفقة دولية بمشاركة أطراف محلية تفتقر إلى الوطنية، هدفها وقف الانتفاضة وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني من خلال تدمير قواه الحية: حركة “فتح” وحركة “حماس” وفصائل منظمة التحرير، بعد أن عملت تلك الأطراف لأعوام على تدمير المنظمةوتحييد حركة الجهادتمهيداً لتصفيتها. الثاني: غياب المفكرين الاستراتيجيين في مراكز اتخاذ القرار عند السلطة والمعارضة معاً، بحيث لم تتم قراءة خطة شارون للانفصال الأحادي الجانب قراءة استراتيجية تربط بينها وبين مأزق المفاوضات ومأزق النهج العسكري للفلسطينيين، ثم التهدئة، ثم الإصرار الأميركي على إجراء الانتخابات في موعدها على الرغم من وضوح التدهور المتزايد لحركة “فتح” وقوى اليسار، وأيضاً عدم أخذ الحوار الوطني للتوصل إلى ثوابت ومرجعيات مشتركة مأخذ الجد. ما الحل؟ الحل أن تغلِّب القوى السياسية المصلحة الوطنية على المصلحة الحزبية والشخصية، وأن تحدَّد الصلاحيات والاختصاصات بين الحكومة ورئيس السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية: الحكومة تتولى الاهتمام بالأمور الحياتية الداخلية ووضع حد للفساد والانفلات الأمني؛ رئيس السلطة ومنظمة التحرير يتوليان مسؤولية ملف المفاوضات والشؤون الخارجية. وإذا ما وضعنا نصب أعيننا أننا ما زلنا تحت الاحتلال، وإذا ما اعترفت حركة “فتح” بأن نهجها التفاوضي كان عقيماً وأدى بنا إلى التحول إلى شعب من الشحاذين – كما قال أحد رموز السلطة الدكتور نبيل شعث – وإذا ما اعترفت حركة “حماس” ومن ينهج نهجها بأن الحسم العسكري لمصلحتنا غير الانتخابات الفلسطينية مجلة الدراسات الفلسطينية المجلد 17 ،العدد 66) ربيع 2006 ،(ص 43 9 ممكن في المدى المنظور، وأن العمليات الاستشهادية والتباهي بعدد الشهداء هو أيضاً نهج عقيم وكان سبباً في حصاد الانتفاضة المر، وإذا تمكن الطرفان من التوصل إلى استراتيجيا عمل وطني موحد، آنذاك سيتأكد الشعب من أن نخبته السياسية أهلاً لأن تكون قيادة لهذا الشعب العظيم. المشكلة ليست مشكلة دستورية فقط، ولا مشكلة نصوص والتزامات، بل هي أيضاً مشكلة انعدام ثقة بين القوى السياسية،ومشكلة مصالح ضيقة.▄ (*) أستاذالعلوم السياسية في جامعة غزة .