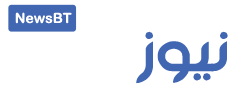تاريخيا حدث تلازم ما بين القضية الفلسطينية ومحيطها العربي والإسلامي،حيث تزامن فكر النهضة العربية الإسلامية نهاية القرن التاسع عشر مع ظهور الحركة الصهيونية كما أن ظهور القضية الوطنية الفلسطينية بداية القرن العشرين لم يكن منقطع الصلة بظهور الحركة القومية العربية من جانب وبالمخططات الإستعمارية لتقسيم المنطقة العربية والهيمنة عليها من جانب آخر.
منذ ذلك التاريخ حملت القضية الفلسطينية دون غيرها من القضايا العربية نعت (البعد القومي للقضية الفلسطينية) وكان هذا البعد حاضرا طوال مسيرة القضية كما كان المسلمون ينظرون بقدسية لمدينة القدس وبعضهم يعتبر فلسطين وقفا إسلاميا أو الأرض المباركة الخ. كانت أية تحولات أو متغيرات كبيرة تحدث في العالم العربي تنعكس مباشرة على القضية الفلسطينية ،فعندما تنتكس الحركة القومية والثورية العربية تنتكس القضية الفلسطينية وعندما تنهض الحالة العربية أو الإسلامية تنهض معها القضية،فما كانت فلسطين تضيع وتحدث النكبة عام 1948 لو لم تكن الحالة العربية والإسلامية عاجزة بل ومتواطئة مع بريطانيا والغرب،وما كانت الحركة الوطنية الفلسطينية تعرف نهوضا مع حركة فتح وبقية القوى الوطنية منتصف الستينيات لولا حالة المد الثوري والتقدمي العربي ،في المقابل فإن الانتكاسات التي أصابت القضية الفلسطينية أخيرا غير منقطعة الصلة بتراجع الحالة الثورية والتقدمية العربية منذ توقيع مصر لاتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل ثم انهيار النظام الإقليمي العربي بعد حرب الخليج الثانية .ومن هنا فإن أي نهوض وتغيير تشهده المنطقة سيكون لها تداعيات على القضية الفلسطينية ،ولكن هذه التداعيات مرتبطة بالحوامل الاجتماعية والسياسية وبالتوجهات الفكرية للقوى التي ستقود عملية التغيير وتتسلم مقاليد الحكم ما بعد نجاح الثورة .
بالمقابل أثرت القضية الفلسطينية وصراع الفلسطينيين مع الاحتلال على المحيط العربي شعبيا ورسميا ،فالممارسات الإجرامية الصهيونية بحق الفلسطينيين وعجز الأنظمة العربية عن مساعدة الفلسطينيين إن لم يكن تواطؤهم مع العدو راكم عبر السنيين حالة من النقمة الشعبية العربية على الأنظمة وممارساتها.الجماهير العربية لم تنسى أو تغفر للأنظمة وهي تقف موقف المتفرج على الإجرام الصهيوني خلال سنوات الانتفاضة سواء الأولى أو الثانية ولم تنسى أو تغفر صمت الأنظمة وطائرات العدو ودباباته تقصف وتحرق غزة ،ولم تنس أو تغفر للأنظمة صمتها وتواطؤها والعدو يستوطن الضفة ويهود القدس ويدنس المقدسات،لقد كانت فلسطين حاضرة في ضمير ووجدان الثوار وإن لم تكن العنوان الرئيس لثورتهم أو على رأس سلم اهتماماتهم .وبالتالي يمكن القول بأن العلاقة بين الثورات العربية والقضية الفلسطينية كانت تأثير وتأثر .
لكن استعادة ارتباط القضية الفلسطينية بمحيطها بعد الثورات الراهنة بات مرهونا بالقوى الرئيسة في الثورة ولا يبدو ان هذه القوى ذات توجهات قومية وحدوية كما كان الحال خلال الخمسينيات والستينيات والسبعينيات،فالتوجهات الإسلامية واضحة وكامنة تنتظر الفرصة وبالتالي قد تعزز الثورات في مرحلتها الأولى البعد الديني للقضية الفلسطينية ولكن دون رؤية استراتيجية لهذا البعد.
الإشكالية الرئيسية لبحثا هذا ستتركز على تأثير صعود جماعات الإسلام السياسي بعد الثورات العربية وما إن كان سيؤدي لإضعاف المشروع الوطني الفلسطيني بل إعادته لنقطة الصفر من خلال عودة المراهنة على الخارج كمنقذ للفلسطينيين،أم أم سيعزز هذا المشروع بمده بمقومات الصمود والنضال لاستكمال مشروع التحرير؟.ذلك أن هناك خشية أنه بعد عقود من النضال الوطني لإستعادة استقلالية القرار الوطني وتحريره من الوصاية العربية التي كانت ترفع شعار (الوحدة طريق التحرير) أن تعمل جماعات الإسلام السياسي على مصادرة القرار الوطني الفلسطيني تحت شعار (الإسلام هو الحل) أو (الوحدة الإسلامية الطريق لتحرير المقدسات).
لذا سنتطرق بداية لجدلية العلاقة بين الوطني والقومي في الساحة العربية والفلسطينية وتأثيرها على القضية الفلسطينية ثم نقارب الثورات العربية والانتقال إلى جدلية الوطني والإسلامي وعلاقتها بمستقبل القضية الفسطينية. وبالتالي سنعالج هذا الموضوع من خلال المحاور التالية:- أولا:ما قبل الثورات العربية: الوطنية الفلسطينية ومحيطها العربي (جدلية التحالف والتصادم)
ثانيا: من ثنائية الوطنية والقومية لثنائية الوطنية والإسلام وتأثيره على القضية الفلسطينية
ثالثا: الثورات العربية وحساب الربح والخسارة فلسطينيا
أولا:ما قبل الثورات العربية: الوطنية الفلسطينية ومحيطها العربي (جدلية التحالف والتصادم)
بعد عقد من هزيمة 1948 ثار الجدلل ما بين القومية العربية المعبر عنها آنذاك من خلال الناصرية والقوميين العرب وحزب البعث العربي الإشتراكي من جانب والحركة الوطنية الفلسطينية الناشئة ممثلة بحركة فتح وفصائل المقاومة ثم منظمة التحرير بعد 1968 .وطوال أكثر من أربعة عقود اتسمت العلاقة بين الطرفين بشد وشذب،التقاء وتصادم،حيث كان البعد القومي للقضية الفلسطينية مجسد شعبيا وليس رسميا،فرسميا كانت العلاقة بين الطرفين محكومة بمحاولة الإحتواء من الأنظمة وبنضال من أجل الاستقلالية – استقلالية القرار الوطني- من طرف الوطنيين الفلسطينيين .
في أوج المد القومي العربي في النصف الثاني من القرن الماضي، كانت فكرة الوحدة العربية تحضا بقبول شعبي عارم وتشكل حالة ضاغطة على الأنظمة العربية لتتجاوب مع الفكرة بتجاوز المنطق القطري إلى رحابة العمل القومي الوحدوي. الإحساس بوحدة الانتماء والمصير والإدراك بالمخاطر المحدقة بالأمة العربية كانت عوامل تجعل من مطلب الوحدة العربية ضرورة قومية بل حياتية ،ومع ذلك وبالرغم من أن الجماهير الشعبية والنخب والأنظمة كانت تتحدث عن الوحدة وضرورة تحقيقها ،إلا أن الإيمان بالوحدة والسعي الصادق لتحقيقها لم يكونا عاملا مشتركا بين الجميع .
المشكلة لم تكن بالجماهير ولكن بالنخبة التي رفعت رايات الوحدة العربية ونصَّبت نفسها ناطقة باسم الأمة العربية ومنادية بتحرير فلسطين،بعض النخب القومية كانت منتمية حزبيا وفكريا للفكر القومي الوحدوي دون استعداد للتضحية في سبيل تحققها،حيث كانت خلفيتها وأصولها الطبقية أو مواقعها الرسمية في الحكم تشدها نحو مصالحها الضيقة على حساب مصلحة الأمة،وكان حالها كحالة الشخص المصاب بالشيزوفرينيا أو ازدواجية شخصية ،ومن هنا كانت خطورتها على المشروع القومي الوحدوي والقضية الفلسطينية أكبر من خطورة الشعوبيين وأعداء الوحدة العربية . وشريحة أخرى من( القوميين) سايروا الحس الشعبي الجارف برفع الشعارات القومية والوحدوية وتحرير فلسطين بل اعتبروا أن القضية الفلسطينية قضيتهم الأولى، ولكنهم في العمق كان يعملون كل ما من شانه إفشال كل مسعى وحدوي بل وضرب القوى الوحدوية والتضييق عليها بطرق غير مباشرة. والتصادم مع حركة التحرر الفلسطينية والتضييق عليها.
أيضا لم يكن الخلل بالوحدة فكرة وهدفا، فهي فكرة نبيلة ،ولا بشعار قومية القضية الفلسطينية،ولكن الخلل كان في أدواتها من أحزاب وأنظمة ،لأن الوحدة القومية تعني البحث عن/ والاتفاق على القواسم المشتركة التي تحقق المصلحة القومية للأمة ،والقواسم المشتركة تعني تنازلات متبادلة من الأنظمة ،أي تغليب المصلحة القومية على حساب مصلحة النخب الحاكمة.كان الفشل أمرا حتميا لعدم الاتفاق على الثوابت والمواقف قبل تحقيق الوحدة ،والنتيجة، لا الوحدة العربية تحققت ولا المصلحة القطرية والتي نعتوها بالمصلحة الوطنية تحققت ولا فلسطين تحررت،النخب الحاكمة بما فيها النخب القومية ،كانت المستفيد الوحيد ،واليوم تدفع الأمة العربية ثمن فشل التجارب الوحدوية وتراجع الفكر القومي ،والثمن الأبهظ هو أن الوحدة الوطنية أصبحت مهددة،بمعنى أن المسار الوحدوي أصبح يسير بشكل معكوس،فمن وحدة المجزأ إلى تجزئة المجزأ.
لقد ضخم البعض من حالة التعارض بين المصلحة القطرية (الوطنية) والمصلحة القومية العربية،وما بين المصلحة الوطنية لكل دولة واستحقاقات دعم الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ، وإن كان أعداء الوحدة العربية هم أكثر المروجين لوجود هذا التناقض والمغذين له فكريا وماديا من خلال خلق نخبة رأسمالية محلية مرتبطة مباشرة بالمركز الرأسمالي بدلا من ارتباطها بسوق عربية ومجالات استثمارية داخل الوطن العربي،ومن خلال خلق نخبة فكرية ثقافية تدافع عن ثقافات فرعية ومضادة في مواجهة الثقافة القومية العربية ،ورفع شعار مصر أولا أو لبنان أولا الخ،إلا أن أنظمة وحركات كانت ترفع رايات الفكر القومي الوحدوي ،ساهمت – عن قصد أو دون قصد-في تعزيز التوجه القُطري الانفصالي وبالتالي خلق حالة موهومة من التعارض بين التوجه القومي الوحدوي والعمل القُطري (الوطني) وما بين المصالح الوطنية ومصلحة الشعب الفلسطيني.
نعم ، لقد ساهمت أنظمة ترفع رايات القومية ومن يسندها من حركات سياسية ،في ترسيخ المنطق القطري الإقليمي- ولا نقول الوطني- على حساب التوجه القومي،فأنظمة دكتاتورية استبدادية تقمع الجماهير وتحد من الحريات لا يمكنها إلا أن تؤسس لنظام طائفي أو فئوي يتعارض مع تطلعات الغالبية الشعبية ،حتى وإن رفعت هذه الأنظمة شعارات قومية ووحدوية وثورية.قد يحضا النظام بشعبية واسعة في سنواته الأولى،حيث تكون الجماهير منتشية بالثورة وشعاراتها ومتشوقة للعمل القومي والوطني الجاد الذي نادي به النظام الجديد ،ولكن مع مرور الوقت و كنتيجة حتمية لميكانزمات عمل الأنظمة الاستبدادية والعسكرية يخلق النظام زبانيته من منتفعين ومتسلقين، ويشكل هؤلاء مراكز نفوذ بل وأصحاب قرار، يحجبوا الحاكم عن الشعب، ويُقرب النظام فئات على حساب أخرى ،تتوسع الهوة ما بين النظام (الثوري القومي الوحدوي) والجماهير ، ،تتبلور شبكة مصالح متعارضة مع مصلحة القطاعات العريضة من الجماهير ومع ما كانت تتوق إليه، تبدأ الاحتجاجات والشكوك المتبادلة ،تصادر الحريات وتتزايد السجون والمعتقلات ،تروج مقولات المؤامرة الخ ، فتخشى النخبة الحاكمة على مصالحها وتبحث عن مؤيدين وأنصار من خارج من منحوها الولاء بداية على أسس إيديولوجية،فيكون هؤلاء الأنصار الجدد من طائفة الحاكم أو الأقلية الإثنية التي ينتمي إليها .
لتخفي الأنظمة المُنزلق الذي آلت إليه،فأنها تضفي على شبكة علاقاتها الضيقة اسم المصلحة الوطنية ،وفي هذه الحالة يصبح مفهوم المصلحة الوطنية لا يعبر عن مصلحة الوطن ولا يعكس المصالح الحقيقية للمواطنين بل مصلحة الحاكم والنخبة،ويتم خلق مماهاة مزيفة بين مصلحة النظام والنخبة من جانب و المصلحة الوطنية من جانب ثان،وفي هذه المرحلة أيضا تتبلور بإيحاء من الحاكم و حزبه ومثقفيه منظومة الثوابت والمرجعيات (الوطنية).
مع تباعد الوحدة العربية فكرا وممارسة، تتحول القطرية من حالة مؤقتة إلى حالة دائمة تأخذ أسم الوطن والوطنية،وهي حالة وفكرة تجذب إليها بقايا الأنظمة والحركات القومية ،فتدعمها سرا وتقوم بتكييفها حسب مصالحها ، وتلعنها علنا .وحتى يحافظ النظام (القومي) على مصالحه المهددة من جيرانه ومنافسيه ومن معارضيه السياسيين ،وحيث انه لا يستطيع التراجع عن شعاراته القومية والوحدوية ،فأنه يروج بان شروط الوحدة الحقيقية غير ناضجة أو أن الآخرين لا يريدون الوحدة الخ .و عندما تكشف الجماهير الحقيقة فأن النظام يتجه نحو مزيد من الاستبداد والانفصال ليس فقط عن الجماهير العربية التي وعدها بالوحدة بل أيضا عن الجماهير في إطار القطر الذي يحكمه.
وهكذا وخلال أربعة عقود أنشغل العقل السياسي العربي بالعلاقة بين الوطنية والقومية بما فيها العلاقة بين الوطنية الفلسطينية والقوى والأنظمة القومية العربية ،وهل من تناقض بينهما ؟ ومن يملأ فراغ تراجع الفكر القومي الوحدوي وما ارتبط به من ثقافة ومنطلقات وتنظيمات ؟.
لا غرو بأن القوى المعادية لوحدة الأمة العربية ما زالت قائمة،ونقصد هنا تحديدا الولايات المتحدة وإسرائيل وأنظمة حكم ونخب سياسية. وحيث أن الأوضاع العربية ازدادت تدهورا بحيث باتت أكثر سوءا عما كانت عليه عندما كان الفكر القومي يدغدغ مشاعر الجماهير ،فلا قطر عربي يخلو من مشاكل اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية ،واخطر هذه المشاكل هو تفشي النعرات الطائفية والعرقية التي تهدد وحدة النسيج الاجتماعي والثقافي لكل قطر ،وعودة الاستعمار مجددا للمنطقة سواء كان استعمارا مباشرا أو غير مباشر وهذا الأخير اخطر من الأول…،لكل ومع ذلك ، تجددت التطلعات الشعبية للملمة شمل الأمة ومواجهة ما تعتبره تهديدا لوجودها وكينونتها،وعادت بعض مفردات الخطاب الوحدوي، ولكن هذه المرة على أساس ديني وليس قومي.
ثانيا: من ثنائية الوطنية والقومية لثنائية الوطنية والإسلام وتأثيره على القضية الفلسطينية
مع تراجع الحركة القومية العربية ومع أزمة اليسار المتفاقمة تزايدت شعبية جماعات الإسلام السياسي التي كانت في حالة كمون والاشتغال على التوغل اجتماعيا واقتصاديا،وبدأ الخطاب الإسلامي يطغى على الخطاب القومي وحتى الوطني،وكما وظف القوميون القضية الفلسطينية وظفها الإسلاميون حيث كانت المظاهرات والمسيرات التي ينظمها الإسلاميون دعما لفلسطين وتنديدا بالممارسات الصهيونية فرصة لتبرز هذه الجماعات قوتها في الشارع ولتستقبط مزيدا من الاتباع .من جهة أخرى وفي خضم صراع الغرب مع جماعات الإسلام المتطرف وخصوصا بعد تفجيرات 11 سبتمبر 2001 ،تفتقت العقلية الاستراتيجية لواشنطن عن مخطط لضرب جماعات الإسلام السياسي المتطرف وخلق بلبلة وفوضى داخل العالم العربي والإسلامي ،وهذه الخطة تقوم على استيعاب الإسلام المعتدل ومطالبة الأنظمة العربية بإشراكهم في الحياة السياسية ،وهذا ما جرى في وقت متزامن تقريبا في مصر والمغرب والأردن منتصف العقد الماضي .
بالرغم من أن الديمقراطية يمكنها استيعاب كل التيارات والقوى السياسية من وطنية وقومية وعلمانية وإسلامية،إلا أن بعض تيارات الإسلام السياسي تعاملت بحذر من النهج الديمقراطي و تعاملت مع الديمقراطية الرسمية أي الديمقراطية الموجهة من النظام دون أن تتخلى عن ثوابتها ومرجعيتها الدينية مما جعل مشاركتها في العملية الانتخابية والديمقراطية لا تؤسس على قناعات راسخة بقدر ما هي غائية تهدف لتوظيف مساحة الحريات التي أُجبرت الأنظمة على منحها للجمهور لتشرعن وجودها وتبعد عن نفسها تهمة الإرهاب.
لأن انخراط الأسلاميين في الحياة السياسية الرسمية لم يكن عن قناعة بالنهج الديمقراطيفإن ما تسمى بالثوابت والمرجعيات الوطنية باتت محل خلاف وخصوصا بعد الثورات وخصوصا في مصر، فالمرجعية الفكرية اليوم لغالبية تيارات لإسلام السياسي هي الفكر الديني(قرآن وسنة واجتهادات السلف الصالح ) و الأمة هي الأمة الإسلامية والهوية هي الهوية الإسلامية والدولة هي دولة الخلافة الراشدة ،وأصبحت الثنائية التي تشغل الحقل السياسي العربي والإسلامي اليوم هي الإسلامي والوطني،مع تسطيح وتعويم كبير لمفهوم الإسلامي (الحركات الإسلامية ) ومفهوم الوطني ،بل يمكن القول بأن ما يبدو على السطح من استقطاب بين المنتمين لكلا التيارين لا يستطيع ان يخفي الخلافات داخل كل تيار وهي خلافات قد تكون أوسع مما هي بين التيارين وبعضهما البعض.
وجدت قطاعات لا ياستهان بها من الجماهير العربية في الإسلام الإطار الذي يمكن أن يمثل الجدار الأخير في مواجهة (الأعداء) والمرجعية المُوحدة لما هو مشترك بين الجماهير العربية والإسلامية ،إلا أن نفس المشكلة التي واجهت الحركة الوحدوية القومية تواجه اليوم فكرة الوحدة الإسلامية ،فوحدة المرجعية الدينية-حتى هذه عليها خلاف- لا تعني وحدة المرجعية السياسية للمسلمين أو حتى وجود مرجعية سياسية متفق عليها،حيث أن الإسلام السياسي منقسم على نفسه في البرامج وآليات العمل وفي موقفه من العمل الوطني ،فمن أبن لادن وتنظيم القاعدة الذي لا يؤمن بالعمل الوطني أو بالنضال السياسي القطري ،إلى جماعة الإخوان المسلمين التي بلورت أخيرا نوعا من المصالحة ما بين العمل الإسلامي ألأممي والعمل الوطني ،وما بينهما حركات إسلامية متعددة الاتجاهات والتصورات.
والسؤال الذي يفرض نفسه ،هل يمكن تحقيق وحدة الأمة بالإطار الإسلامي حيث فشل تحقيقها بالإطار القومي العربي ؟وهل يمكن تجاوز الخلافات بل التناقضات بين متطلبات واستحقاقات وآليات العمل الوطني من جهة واستحقاقات وآليات العمل السياسي التي تنتهجه الجماعات الإسلامية؟. وماذا بالنسبة للقضية الفلسطينية ؟هل سيتم الانتقال من شعار (الوحدة العربية الطريق لتحرير فلسطين) إلى شعار (الوحدة الإسلامية الطريق لتحرير فلسطين).
للإجابة عن ذلك لا بأس من استحضار مقومات وموجبات أو مبررات الوحدة في الحالتين ومعيقات تحققهما .
عديد من القوميين والإسلاميين تناولوا باستفاضة العلاقة بين القومية والإسلام ،وغالبية هؤلاء اتفقوا على عدم وجود تناقض حتمي بين الطرفين،ونعتقد بأن حالات التصادم التي وقعت بين الطرفين كانت تندرج في إطار الصراع على السلطة أكثر مما كانت صراعا بين أيديولوجيات ،فكل من الإيديولوجيتين تنتمي لمنظومة مختلفة ،الإسلام يمكنه أن يوحد الشعوب عقائديا ولكن من الصعب عليه توحيدهم جغرافيا وسياسيا ،ونعتقد بأن شعارات الوحدة الإسلامية الذي ترفعه بعض الجماعات الإسلامية هو اقرب لمفهوم الأممية الذي رفعته الأحزاب الشيوعية والاشتراكية ،ليس من حيث المحتوى الإيديولوجي بل من حيث الوظيفة الأيديولوجية وهي توحيد وتقارب الشعوب إيديولوجيا،أما توحيدها سياسيا وجغرافيا فالأمر يحتاج للدخول في مواجهة مباشرة ليس فقط ضد الأنظمة والنخب الحاكمة بل ضد النظام الدولي القائم من قوانين وعلاقات ومنظمات.أما الفكر القومي وحركاته السياسية فيمكنها بل مطلوب منها توحيد أبناء الأمة، سياسيا وجغرافيا في إطار دولة قومية، وهذا هو مبرر وجود الفكر القومي وقد أنجز الفكر القومي هذه المهمة في أكثر من مكان في العالم إلا العالم العربي لأسباب سبق سردها.
المشكلة المطروحة اليوم ليست علاقة القومي بالإسلامي ،فالقومي- حركات ونظم- اضعف من أن يواجه المد الأصولي،وهذا لا يعني نهاية الفكر القومي الوحدوي أو التخلي عن حلم الوحدة العربية ،بل إقرار واقع أن الأنظمة القومية وصلت لطريق مسدود والحركة القومية بشكل عام أصابتها حالة من الترهل أو الإحباط ،وكثير من منتسبيها انخرطوا إما بالعمل الوطني الديمقراطي أو تحالفوا مع الإسلام المعتدل . المشكلة اليوم هي علاقة التيار الإسلامي بالقوى الوطنية من علمانية وديمقراطية والتي تشتغل على ثوابت ومرجعيات لا تتفق عليها القوى الإسلامية .لقد تجلى هذا التعارض بل التصادم الدموي أحيانا قبل الثورات العربية في: الجزائر ،مصر ،تونس ،الأردن ،المغرب، وفي فلسطين ولبنان .العمل الوطني يعني وجود تحديات ومهام وثوابت وطنية تحتاج لمعالجات وطنية،بمعنى أن القرار بهذه الأمور يجب أن يكون قرارا وطنيا لا يخضع لأي مرجعية خارجية حتى وإن كانت دينية ،فلا يمكن أن تكون وطنيا وقرارك خارج الوطن،وهذا يتطلب (توطين) الجماعات الإسلامية سياسيا لا دينيا ،بمعنى أن تصبح الجماعات الإسلامية في كل بلد جزءا من المشروع الوطني لا أن يُلحق المشروع الوطني بأجندة الجماعات الإسلامية وخصوصا الأممية منها كجماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة .
وأخيرا لا نعتقد بوجود تناقض حقيقي ما بين العمل من أجل الوطن -الدولة الوطنية- والعمل من أجل القومية والوحدة العربية والعمل من أجل وحدة وترابط الأمة الإسلامية عقائديا ،والمشكلة هي ترتيب الأولويات وتنسيق المهام حسب خصوصية كل بلد وحسب تحديات كل مرحلة ،فمثلا لا يمكن الحديث عن الوحدة العربية فيما أقطار عربية تعيش صراعات وحروب طائفية وعرقية تهدد وحدة نسيجها الاجتماعي والوطني ،كما لا يمكن الانتقال لوحدة الأمة الإسلامية حول مرجعيات سياسية واجتماعية واقتصادية ،فيما لم نتمكن من تحقيق ذلك بين الدول العربية التي يجمعها، بالإضافة إلى المرجعية الدينية، وحدة اللغة والعادات والتقاليد والتاريخ المشترك ؟.لقد حدث التصادم ويمكن ان يحدث ولكن ليس بين انتماءات حقيقية بين هذه الدوائر بل بين نخب توظف هذه الانتماءات من اجل الوصول للسلطة ،وفي هذه الحالة تصبح السلطة هي سبب الصدام وليس الانتماءات بحد ذاتها.
الإسلام السياسي وركوب موجة الثورات العربية
ما أن اندلعت الثورة في بعض الأقطار العربية حتى راود الأمل الكثيرين بأن العالم العربي يشهد انتفاضة جماهيرية ستعيد رسم الخارطة السياسية في المنطقة وتعيد الآمال العربية بالتحرر والوحدة وما سيترتب على ذلك من تغيير معادلة الصراع مع العدو وخصوصا ان إسرائيل وواشنطن تنظران بقلق للأحداث في مصر وفي مجمل الساحة العربية .
مع أن المد الثوري أخذ بعدا وطنيا في بداياته حيث لم يرفع المحتجون أو الثائرون شعارات كبرى كتحرير فلسطين أو الوحدة العربية أو القضاء على إسرائيل وأمريكا بل لم يتم ترديد ولو شعار واحد ضد واشنطن وإسرائيل او حرق العلمين الإسرائيلي والأمريكي ،كما كان الحال مع الثورات أو الانقلابات العربية السابقة ،إلا أن البعض يراهن على أن الثورات العربية سيكون لها تداعيات على كل المنطقة ولو بعد حين لأن الملايين التي خرجت للشارع وكسرت حاجز الخوف لن تعود لبيوتها خاوية الوفاض ولأن رسالة الثورة وصلت لكل الأنظمة العربية وللغرب ولإسرائيل.
كل ثورة تعبر عن قيم وثقافة ومتطلبات المرحلة ،بالتالي لا نتصور أو نتوقع أن الثورات المعاصرة ستكون نسخة من الثورات السابقة لا من حيث القوى المحركة ولا من حيث أهداف الجماهير التي قامت بالثورة،وبالنسبة للحراك الشعبي العارم والذي يضع الشعوب العربية على أعتاب ثورة حقيقية، لا نتوقع أن تقوم القيادة الجديدة في مصر مثلا – في حالة حدوث التغيير الذي تريده الجماهير – بمباشرة خطوات دراماتيكية في السياسة الخارجية لمصر سواء من حيث العلاقة مع إسرائيل أو مع واشنطن والغرب حتى وإن شاركت في هذه القيادة جماعة الإخوان المسلمين ،حيث ستطغى انشغالا الوضع الداخلي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على أية انشغالات أخرى .
الأيديولوجية القومية العربية والمواقف المعادية لإسرائيل كامنة ولا شك في عمق العقل الجمعي للشعوب العربية ولكنها ليست من أولويات الجماهير التي لها مطالب ذات طابع وطني ،وبالتالي فالتحول في توجهات الثورة قد يحدث مع مرور الوقت ،وهذا يذكرنا بـ (ثورة) يوليو 52 في مصر التي كانت في بدايتها ثورة وطنية خالصة ،وهذا ما كان واضحا في مبادئ الثورة، وفيما بعد أصبح لها توجهات قومية وثورية تحررية .ونعتقد أن الحائل بين السلطات الجديدة التي ستنتج عن التغيير والدخول بمواجهة مع تل أبيب والغرب ليس فقط الأيديولوجية بل أيضا لأن القوى المؤهلة لاستلام زمام الأمور تدرك أن الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل كبير على الخارج – معونات أمريكية سنوية ،السياحة ،الاستثمارات الخارجية الخ – .
في هذا السياق علينا التمييز بين التداعيات بعيدة المدى والتداعيات المباشرة،التداعيات الإيجابية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتغيير الحالة العربية ،ستكون بعيدة المدى وحدوثها مرتبط بطبيعة القوى الصاعدة التي ستستلم مقاليد الأمور،أما التداعيات قصيرة المدى والمقصود بها خلال الفترة الانتقالية الفاصلة ما بين إسقاط النظام أو خروج الناس للشارع وبناء النظام على أسس جديدة ،في هذه المرحلة علينا أن نكون حذرين جدا لأنها مرحلة ستتسم بعدم استقرار سياسي ينتج عنها فراغ أو ضعف امني وهو الأمر الذي سيثير الخوف لدى إسرائيل مما قد يدفعها لاتخاذ خطوات استباقية في علاقتها بقطاع غزة -كما سبق الإشارة – لأنها عندما انسحبت من داخل القطاع كانت تراهن على وجود نظام قوي في مصر ملتزم باتفاقية السلام وقادر على حفظ امن حدوده مع القطاع ومع إسرائيل،وأن تحدث حالة فراغ أمنى في سيناء ويتغير نظام الحكم في مصر فهذا مدعاة لقلق إسرائيل ودافعا لتعيد حساباتها الإستراتيجية .
الثورات العربية تربك العقل السياسي العربي
لا شك أن العالم العربي يعيش مخاضا غير مسبوق فيما بات يُعرف بالربيع العربي أو الثورات العربية،ولكن،ككل مخاض تبقى التخوفات واردة،ليس بالضرورة من باب التشكيك بالثورة بل من باب الخوف عليها وأحيانا منها . تدل الشواهد التاريخية بأن الحكم على الثورات لا يكون من خلال خروج الجماهير للشارع ضد النظام ولا من خلال إسقاط رأس النظام ،بل من خلال مخرجاتها النهائية بمعنى التغيير الجذري للنظام: سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ،أيضا أن الثورات لا تؤتي أكلها مباشرة فقد تحتاج لسنوات حتى تستقر أمورها ويشعر الشعب بأن تغييرا إيجابيا قد حدث،إلا أن مؤشرات تظهر في بدايات الثورة يمكن من خلالها تبليغ رسائل طمأنينة أو رسائل قلق وخوف من المستقبل .
الثورات العربية ما زالت في المرحلة الانتقالية ومجرد استمرار خروج الشعب إلى الشارع في مظاهرات ومظاهرات مضادة يدل على أن الثورة ما زالت تبحث لها عن اتجاه وهدف وأن مجرد سقوط رأس النظام لا يعني نهاية النظام،كما أن البروز المتزايد للنزعات الدينية والتدخل الخارجي في مجريات الثورة يثير القلق على الثورة ومن الثورة . مع أن الثورتين التونسية والمصرية أنجزتا حتى الآن نجاحات لا يمكن إنكارها ،إلا أن هذه الإنجازات يمكن فقدانها مع مرور الوقت إن لم تنتج الثورة ثقافة الثورة بمضامين ديمقراطية تحررية .
لا شك انه من السابق لأوانه نشر روح الشك والإحباط من حالة عدم الاتستقرار حتى الآن فما يجري أمر طبيعي في المراحل الانتقالية في الثورة بالرغم من التخوفات المُشار إليها،وأن نشير لهذه التخوفات إنما للتحذير من وهم سيطر على بعض قطاعات الشعب بأنه بمجرد خروج الشعب للشارع وسقوط رأس النظام تكون الثورة قد حققت أهدافها.إن كانت مصلحة الشعب هي الهدف والمبتغى في أية ثورة ،وإن كان لا يمكن أن نتحدث عن ثورة بدون خروج الشعب للشارع ،إلا أن دور الشعب في الثورة يظهر ويكون مهما في المرحلة الأولى أي مرحلة الخروج للشارع وإسقاط رأس النظام ،أي أنه مجرد أداة،أما تغيير النظام وبناء نظام جديد فهذه مهمة القوى السياسية والنخب المنظمة،عسكرية كانت أو مدنية.هذه القوى تقرر إن كانت ستغير النظام جذريا أو التضحية برأس النظام السابق لتعيد إنتاج النظام بنفس أدواته الأمنية والعسكرية والإدارية وبنفس نهجه السياسي ولكن بشعارات جديدة وشخصيات جديدة،وإلى هذه القوى السياسية المنظمة تعود مسؤولية فشل أو نجاح الثورة وليس للشعب.
في الحالتين التونسية والمصرية يمكن الحديث عن ثورات شعبية وطنية وخصوصا في بداياتها حيث شاركت كل القوى وقطاعات الشعب بالخروج إلى الشارع وحيث كان التدخل الخارجي محدودا أو جاء لاحقا ليركب موجة الثورة،فواشنطن مثلا ركبت موجة الثورتين لاحقا في محاولة لتبييض صفحتها السوداء في العالم العربي،وكانت هاتان الثورتان وطنيتين لأنهما حررتا الوطنية من الحزب الحاكم الذي صادرها لسنوات ونصَّب نفسه مدافعا وناطقا باسمها وهو في حقيقة الأمر صادر الوطنية لصالح الحزب الحاكم ثم وظف الحزب لخدمة نخبة قليلة ،وهو نفس ما جرى لعقود في غالبية الدول العربية ،فمثلا صادر حزب البعث القومية العربية والوطنية السورية والعراقية لصالح الحزب ثم لصالح الحاكم .
بالإضافة إلى هاتين الثورتين توجد تحركات شعبية أو (ثورات ) في ليبيا واليمن وسوريا والبحرين ،في هذه الحالات يصعب الحديث عن ثورات بنفس سياق الحالتين التونسية والمصرية ،أو فلنقل إن الثورة في هذه البلدان بدأت تثير التخوفات منذ بدايتها،ذلك أنها أثارت نزعات طائفية وشعوبية من بدايتها و تم اللجوء إلى السلاح بشكل كبير و الأخطر من ذلك أنها موجهة ومدعومة بشكل كبير من الخارج وخصوصا في ليبيا ،فكيف نتكلم عن ثورات شعبية بقيادة ودعم واشنطن وحلف الأطلسي؟ كما أنها ثورات لا تهدد فقط بإسقاط النظام بل تهدد وجود الدولة ووحدة الشعب.
لا محاجة أن الأنظمة العربية أنظمة استبدادية ومعيقة لنهضة وتقدم الأمة وبالتالي لا يمكن الدفاع عنها أو التباكي عليها،ولكن في نفس الوقت ليس بديل الثورة وصاية غربية جديدة واحتلال جديد مباشر أو غير مباشر قد يكون أكثر خطورة من أنظمة الاستبداد.تجربة العراق ما زالت حاضرة حيث تم توظيف نصوص دينية وقوانين دولية بالإضافة لاختلاق الأكاذيب حول السلاح النووي والكيماوي وانتهاك حقوق الإنسان الخ لتبرير الاستعانة بواشنطن وجيوش الأطلسي واليوم نشاهد حال العراق المأساوي بعد عشرين عام من العدوان الأول عليه .
التحدي الأكبر أمام العقل السياسي العربي لمرحلة ما بعد الاستقلال وأمام الجماهير العربية الثائرة يكمن في كيفية اشتقاق مناهج وأدوات للموازنة بين الثورة والتغيير من جانب والحفاظ على الاستقلال الوطني من جانب آخر؟ كيفية التوفيق بين المأمول من ثورة تحرر الوطن والوطنية من ربقة عبودية النظام والحزب الحاكم وتحفاظ على وحدة الشعب من جانب و تجنيب البلاد النزعات الأثنية والطائفية والشعوبية من جانب آخر؟.
سكوت المثقفين والمفكرين عما يجري في العالم العربي وبقاء أغلبهم في حالة ترقب وانتظار وانحياز بعضهم لأحد الفريقين المتصارعين يعبر عن حالة تيه فكري أو أنهم يعيدون النظر في برادغمات ومنظومات فكرية سادت لعقود، وخصوصا إن كان سكوتا من مثقفين ومفكرين قوميين نظَّروا كثيرا وكتبوا طويلا عن الحرية والاستقلال والوحدة العربية وعبأوا الشعب بمعاداة الغرب والامبريالية الأمريكية ونظروا لديمقراطية يؤسسها الشعب ومفارقة للديمقراطية المفروضة من الخارج .
يبدو أن المفكرين والثوريين العرب في مواجهة متغيرات غير مسبوقة وهي ان الثورات العربية الراهنة تشكل حالة انقلاب على فكر ومفاهيم الثورة والتحرر والديمقراطية التي استقرت في العقل السياسي العربي حيث كانت مفردات الحرية والاستقلال والقضاء على الاستعمار ورفض التبعية للغرب والتحكم بثروات البلاد الخ تشكل المضمون الفكري للثورة أو أيديولوجية الثورة الديمقراطية التحررية.
ما جري في ليبيا و ما يجري في سوريا يثير تساؤلات كبيرة حول مفهوم الثورة وأدواتها وأهدافها،بل تفرض على العقل السياسي العربي إما أن يعيد النظر في كثير من مقولاته وتصوراته السابقة وخصوصا نظرته للغرب ولواشنطن باعتبارهم قوى استعمارية امبريالية وحلفاء لإسرائيل وللصهيونية العالمية وأعداء للشعوب العربية ونهضتها،أو يعيد النظر في مفهومه للثورة والتحرر والديمقراطية المشتق من الفكر الثوري والقومي ويتعامل معها ضمن مفاهيم وثقافة عصر العولمة والهيمنة الغربية.
حتى لو وضعنا جانبا كل التساؤلات السابقة فإن ستة دول عربية فقط تمر بحالة ثورة فيما ست عشرة دولة تعرف حالة استقرار حتى أن إرهاصات الثورة التي لاحت فيها إثر الثورة التونسية تراجعت،فهل نفسر ذلك بأن الدول التي تشهد ثورات أكثر استبدادا وسوءا من غيرها؟أم أن هناك حسابات خارجية بأدوات داخلية تحدد بوصلة الثورة ؟.
ليس من السهل إعطاء إجابة الآن ،ولكن من المؤكد بان العقل السياسي العربي والمثقفون العرب المنتمين لجيل ما بعد الاستقلال وما قبل العولمة يواجهون تحديات غير مسبوقة ،تحديات فكر وتحديات واقع وتحديات تدافع الأجيال بسرعة غير مسبوقة.
الإسلام السياسي والغرب: بين نظرية المؤامرة والواقعية السياسية
إن يسقط دكتاتور عربي واحد،فهذا ولا شك إنجاز،فكيف إن سقط ثلاثة منهم – بن علي ومبارك والقذافي- وكيف إن تزعزعت كراسي البقية وباتوا يتحسسون رؤوسهم؟.ما دامت غالبية الشعب تقول بأنهم مستبدون وكانت ترفض حكمهم،فلا يهم إن سقطوا بإرادة حرة وخالصة للشعب أم بتخطيط خارجي أم بجمع بين الاثنين؟. الثورات محصلة لنضوج أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية ولتضافر عدة عوامل داخلية وخارجية،في لحظة تاريخية ما تتجمع كل هذه العوامل فيثور بركان الثورة،بحيث يكون من الصعب نسبتها لعامل واحد،ولكنها تُنسَب دائما للجهة التي تتمكن من توجيه الثورة أو ركوب موجتها،وفي بعض الحالات لا يكون مفجرو الثورة ووقودها نفسهم الذين يستفيدون منها ويقودون النظام الجديد.
المجتمعات العربية التي أسقطت الدكتاتورية لن تعود مجددا لنفس الأوضاع السابقة حتى لو طال عمر الثورة أو انحرفت عن مسارها أو ركبت موجتها قوى داخلية مشكوك بمدى التزامها بالديمقراطية أو قوى خارجية لها أجندة خاصة في المنطقة لأن الثورة تغير في نفسيات الشعب وفي الثقافة السائدة وتُولِد تطلعات جديدة.لكن في نفس الوقت فإن إسقاط طاغية وإحلال قوى جديدة بشرعية انتخابية أو بشرعية الثورة لا يعني أن ملائكة حلوا محل شياطين،بل يجب النظر والتعامل مع القادة الجدد كقوى لها مصالح وإيديولوجيات وارتباطات أو كسلطة لا يكفي أن تقول بأنها تستمد شرعيتها من خطابها وأيديولوجيتها ولا حتى من صناديق الانتخابات،بل من قدرتها على الحفاظ على وحدة الأمة وإحداث نقلة نوعية سياسية واقتصادية واجتماعية في حياة الشعب،والأهم من ذلك الحفاظ على ثوابت الأمة التي تحفظ للدولة ثباتها واستقرارها ووحدتها الوطنية،وثوابت الأمة لا تتغير مع كل دورة انتخابية لأنه لو حدث ذلك فلن تكون للأمة ثوابت وما دامت الدولة على حالها ،ولذا فإن ثوابت الأمة لا يضعها الفريق الفائز بالانتخابات بل يتم الوصول إليها بالتوافق الوطني.
إذن الثورة فعل اجتماعي/سياسي مركب ومعقد،وفي حالة كالحالة العربية حيث المنطقة محط أنظار العالم ومحل تطلعات هيمنية للدول الكبرى، وحيث دول المنطقة فقيرة وتعتمد اعتمادا كبيرا على الدعم الخارجي واقتصادها مرتبط بالغرب،فإن سيرورة الأحداث في المنطقة لا تسير بفعل القوى الذاتية للشعوب ونخبها السياسية فقط،بل يكون لتأثيرات وتدخلات القوى الخارجية دور فيها،سواء كانت تدخلات مباشرة كما جرى في ليبيا، أو غير مباشرة ولوجستية لقوى داخلية بعينها كما هو الحال في سوريا وبدرجة أقل في مصر.تونس كانت الحالة الوحيدة لثورة شعبية خالصة،وفي جميع الحالات (الثورية) السابقة – عدا بعض الأحزاب الصغيرة في تونس -لا يوجد أي حزب أو قوة سياسية تطرح رؤية معادية للغرب بل يمكن القول بأن باتت اليوم كلها تتودد للغرب وخصوصا لواشنطن ولا تناصبه العداء،ولكنها تتفاوت في درجة تقربها للغرب وفي دور الغرب في تأسيسها ودعمها،فجماعة العدالة والتنمية في المغرب جماعة إسلام سياسي وطني وولدت من رحم المجتمع المغربي بعيدا عن اية ارتباطات خارجية،كما أن فوزها بالانتخابات جزء من استراتيجية للنظام السياسي المغربي بدات منذ نهاية الثمانينيات تهدف لدمج قوى المعارضة حتى المتطرفة منها في النظام السياسي لتعزيز الديمقراطية الدستورية .
وهكذا نلاحظ كثرة الحديث عن دور أمريكي غربي في الثورات العربية سواء من حيث التخطيط لهذه الثورات أو ركوب موجتها ودعمها لوجستيا وخصوصا من خلال الإعلام الغربي أو العربي التابع،وأن هدف التدخل الأمريكي تنفيذ إستراتيجية أمريكية تقول باستيعاب الإسلام المعتدل ودمجه بالحياة السياسية،أو خلق حالة من الفوضى البناءة تُمكِن واشنطن من إعادة بناء الشرق الأوسط مجدد تحت عنوان الشرق الأوسط الكبير أو الجديد بما يمكنها من تصفية كل من يشكل تهديدا لمصالحها الإستراتيجية الآنية أو المستقبلية أو تهديدا لإسرائيل.إن كنا لا نستطيع إسقاط نظرية المؤامرة لأن لا سياسة تخلو من تآمر وما يراه البعض تآمرا ما هو إلا السياسة الواقعية بعينها،إلا أنه لا يجوز أيضا القول بأن كل ما يجري تآمر،فما جرى ليس انقلابا عسكريا أو حراكا سياسيا لعشرات من العسكريين أو السياسيين بل تحرك شعبي مليوني شارك فيه ممثلو كل قطاعات الشعب ولا يمكن أن يكون كل هؤلاء منفذين لمخطط خارجي.
وعليه يجب إعادة النظر في الأفكار المسبقة عن الثورات كما اختزنها العقل السياسي العربي باعتبارها فعلا جماهيريا شعبيا حر الإرادة معاد بالضرورة للاستعمار والامبريالية وللغرب ولإسرائيل،أو أنها ثورة تقودها القوى القومية واليسارية والتقدمية في مواجهة أنظمة ملكية أو رجعية موالية للغرب،أيضا إعادة النظر في تصورنا بأن الشعوب العربية ما زالت تنظر لواشنطن وللغرب باعتبارهم قوى في عداء كامل مع العرب والمسلمين (الحرب الحضارية أو الصليبية كما روج لها البعض).بدلا من ذلك يجب النظر بعقلانية وواقعية إلى ما يجري حتى وإن كان واقعا محفوفا بمخاطر الانزلاق لمتاهات غير مسبوقة في خطورتها.الواقعية السياسية السائدة اليوم تقول بأن الشعوب وأحزابها (الثورية) لا تضع على رأس سلم اهتماماتها معاداة واشنطن والغرب ولا القضايا الكبرى كالوحدة العربية والإسلامية أو تحرير فلسطين الخ، بل تريد التخلص من الدكتاتورية وتحقيق الحرية والحياة الكريمة وخصوصا الاقتصادية، وفي مسعاها هذا مستعدة للتعاون أو التحالف مع أي طرف خارجي سواء كان الناتو أو واشنطن أو تركيا أو أنظمة عربية محافظة موالية للغرب وتنفذ سياساته. والواقعية السياسية تقول أيضا بأن الغرب الذي يحكمه مبدأ (لا توجد صداقات دائمة ولا عداوات دائمة بل مصالح دائمة) مستعد للتحالف أو التعامل مع أي حزب أو جماعة عربية أو إسلامية مستعدة للحفاظ على مصالحه في المنطقة والبحث عن قواسم مشتركة بين الطرفين.
في هذا الإطار يمكن فهم وتفسير ما يمكن تسميته بالتحالف الخفي بين جماعة الإخوان المسلمين وواشنطن.ذلك أن تاريخ الأخوان المسلمين يدل على أنهم منذ نشأتهم لم يكونوا معادين أو متصادمين مع الغرب سواء مع بريطانيا في بداية نشأتهم أو واشنطن لاحقا،وعندما كان الغرب يخوض حربا ضروسا في مواجهة ما يسميهم (المتطرفون الإسلاميون) وكان يقتل الأبرياء بمئات الآلاف في العراق وأفغانستان،كانت عواصم الغرب تحتضن قيادات الإخوان وتقدم لها كل ما يساعدها على الانتشار والتمكين في بلدانها الأصلية بل ضغطت على الأنظمة القائمة لتُشرك الأحزاب الدينية في الحياة السياسية من خلال الانتخابات – أشرفت السفارات الأمريكية في الأردن والمغرب ومصر بشكل مباشر في الحوارات بين الأنظمة والجماعات الإسلامية قُبيل الانتخابات التي شهدتها هذه البلدان منتصف العقد الماضي – .ما جعل الالتقاء أو التحالف الخفي بين الطرفين ممكنا هو التحول في الإستراتيجية الأمريكية في السنوات الأخيرة.
منذ أن بدأت واشنطن تشعر بأن القوة الخشنة أو العسكرية لا تحقق لها أهدافها الإستراتيجية أو تمكنها منها بأثمان باهظة كما هو الحال في العراق وأفغانستان ،أخذت بالتفكير بتوظيف القوة الناعمة من خلال محاولة استقطاب دول وجماعات للسياسة الأمريكية أو التغيير في مواقف دول أخرى ليس بالقوة الخشنة ولكن من خلال الإقناع والتأثير على العقول وخصوصا الشباب والنخب الفاعلة موظفة وسائل الإعلام ودعم القوى السياسية ذات النفوذ الشعبي. مشروع الشرق الأوسط الكبير وسياسة الفوضى الخلاقة يقومان على هذه القوة الناعمة أو المزاوجة بينها وبين القوة الخشنة عند الضرورة بما يسمى القوة الذكية.ويبدو أن واشنطن من خلال هذه الإستراتيجية الجديدة التي طبقها أوباما استطاعت تحقيق نجاحات نسبية مكنتها من الخروج من ورطتها في العراق وأفغانستان بخسائر أقل.وهي الإستراتيجية التي تطبقها في التعامل مع التحركات الشعبية العربية.
القول بتحالف أو تنسيق بين جماعة الإخوان المسلمين وواشنطن لإحداث تغيير في المنطقة لا يعني أن هذا التحالف له بعد استراتيجي وأهداف واحدة من الطرفين،فهو أقرب من التحالف التكتيكي أو الظرفي ومن غير المؤكد استمراره طويلا،وهو تحالف لا يتضمن حكم قيمة سلبي بالضرورة على جماعة الإخوان ضمن منطق الواقعية السياسية ،لأنه لو لم يكن للإخوان حضور شعبي واسع ولو لم يكونوا قوة فاعلة ما توجهت واشنطن للتحالف معهم أو دعمهم ،فهناك أحزاب ليبرالية وعلمانية تجاهلها الغرب وواشنطن لأنها أحزاب بدون شعبية أو تم تجريبها وفشلت،كما أن نظامي بن على في تونس ومبارك في مصر وحتى نظام القذافي بعد تسوية لوكيربي لم يكونوا مصدر تهديد للمصالح الغربية ولكن الغرب شعر أن الدور الوظيفي لهذه الأنظمة قد انتهى وأن قوى جديدة صاعدة –الإسلام السياسي- لا يمكن مواجهتها بالقوة ،فركب الغرب موجة الثورات حتى لا يخسر حلفائه القدامى والقوى الصاعدة في نفس الوقت .
بداية كان الغرب يوظف الإسلام السياسي كأداة لمواجهة مناوئيه من الحركات والأنظمة كعبد الناصر والشيوعيين والقوميين،ولكن بعد اشتداد عود هذه الجماعات فهو مضطر لإعادة النظر في إستراتيجية التعامل معها بما يتناسب مع كل حالة،فإن ترافقت قوة الجماعات الإسلامية مع سياسية معادية للغرب كان لا بد من ضربها واستئصالها كما جرى مع تنظيم القاعدة،ولكن إن استمرت هذه الجماعات تنهج سياسة براغماتية مهادنة للغرب ولا تهدد مصالحه فلا بأس من استمرار التعامل معها بعد وصولها للسلطة بل مساعدتها على ذلك،وبعد ذلك ستُحدد العلاقة بين الطرفين حسب نهج هذه الجماعات وهي في السلطة.
ما يبدو تحالفا أو تنسيقا بين جماعات الإسلام السياسي وخصوصا الإخوان المسلمين والغرب يدعو للتساؤل إن دعم واشنطن للإسلام السياسي المعتدل وللثورات العربية هدفه خلق الاستقرار في المنطقة وتأمين مصالح الغرب من خلال أنظمة إسلامية موالية؟هذا ممكن،ولكن يمكن طرح السؤال بشكل مغاير:ألا يمكن القول بأن هدف واشنطن من دعم الثورات والإسلام السياسي خلق الظروف للفوضى الخلاقة التي تريدها واشنطن لإدراك واشنطن أن الإسلاميين لا يمكنهم تحقيق دولة مدنية حضارية وأنهم سيدخلون في مواجهات مع بقية شرائح المجتمع سواء من أصحاب الديانات الأخرى أو مع العلمانيين أو في مواجهات داخل الجماعة بين من تستهويهم السلطة وامتيازاتها ويخضعون لاستحقاقاتها من جانب وبين قوى داخل الجماعة تطالب بتطبيق الشريعة والعودة للأصول والتعامل مع الغرب وإسرائيل كقوى كافرة؟.
سنترك للأيام الحكم إن كنا أمام ثورات شعبية بمضامين وطنية وقومية وتحررية تؤسس لديمقراطية الشراكة السياسية والمواطنة والتداول السلمي على السلطة،أم سنواجه (الفوضى الخلاقة) التي بشرت بها واشنطن؟.ولكننا في نفس الوقت نؤمن ونتمنى بأن تكون القوى السياسية وخصوصا في مصر وسوريا على درجة من الوعي بخطورة المنعطف الذي تمر به الأمة العربية ككل وتمر به كل دولة عربية من حيث قدرتها على الحفاظ على الوحدة الوطنية ومواجهة التطلعات التوسعية والهيمنية من دول الجوار.
ثالثا : الثورات العربية وحسابات الربح والخسارة فلسطينيا
أي حديث حول تأثير الثورات العربية على القضية الفلسطينية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حداثة الظاهرة وعدم اكتمالها حتى الآن وفي نفس الوقت مقاربة نتائج الثورات على الوضع الفلسطيني على مستويين :الأول داخلي وخصوصا مدى استفادة الإسلام السياسي الفلسطيني من تجربة الإسلاميين في دول الجوار ،والثاني يتناول تأثير الثورات على علاقة الفلسطينيين بمحيطهم العربي والإسلامي.
هل ستسير حركة حماس على هدى إخوان مصر والأردن؟
قبل سنوات طالبنا بتوطين أيديولوجية كل القوى السياسية الفلسطينية لتصبح جزءا من المشروع الوطني الفلسطيني لأننا نعيش مرحلة تحرر وطني تحتاج لإعلاء راية الوطنية والتمسك بالهوية والثقافة الوطنية،وتمنينا على حركة حماس أن توطن فكرها وأيديولوجيتها إن رغبت بأن تكون جزءا من النظام السياسي الفلسطيني و تقود الشعب الفلسطيني،فلا يجوز ولا نقبل لحركة سياسية تقول بأنها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين وفرع من فروعها أن تحكمنا لأن ذلك يعني أن الأصل هو الذي يحكمنا أي نصبح محكومين ومسيرين لجماعة الإخوان المسلمين ويصبح مصير قضيتنا الوطنية رهن بما تأول إليه الأمور في هذه الجماعة ولحساباتها وتوازناتها ومصالحها الأممية.
توطين الأيديولوجيات ظاهرة سبقتنا إليها شعوب أخرى،فبالرغم من أممية الأيديولوجية الماركسية / الشيوعية إلا أن ماوتسي تونغ مفجر الثورة الصينية 1949 اختطت نهجا مستقلا يمكن تسميته توطين الماركسية لتتناسب مع خصوصية المجتمع الصيني،نفس الأمر جرى مع يوغسلافيا تيتو وكوبا كاسترو وبقية الدول الشيوعية.وفي الحالة العربية فبعد سنوات من عمل الشيوعيين واليساريين والقوميين في إطار حركات قومية وأممية انحازوا للخيار الوطني بعد ظهور الحركة الوطنية الفلسطينية منتصف الستينيات،فظهرت الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية وحزب الشعب ومنظمة الصاعقة وجبهة التحرير العربية كحركات وطنية داخل الإطار الوطني – منظمة التحرير الفلسطينية -دون أن تفقد فكرها أو يطالبها أحد بأن تتخلى عن فكرها،فالوطنية وعاء يستوعب كل الأفكار والأيديولوجيات.
لو نظرنا للعالم من حولنا اليوم سنلاحظ أنه ما كان لحزب التنمية والعدالة التركي أن ينجح لو لم يوطن أيديولوجيته الدينية ويشتغل ضمن حدود الدولة القومية العلمانية وبما يخدم المصلحة الوطنية التركية دون ارتباط بأي إطار خارجي،نفس الأمر في إيران حيث تتوحد القومية الفارسية مع الإسلام الشيعي بل تعمل على توظيف الإسلام الشيعي خارج إيران لمصلحة الدولة القومية الفارسية.وفي الحالتين يجري تكييف الدين بما يخدم المصلحة الوطنية وليس العكس،والإسلام يسمح بذلك.وما هو قريب من ذلك ما يجري في ماليزيا واندونيسيا من تعايش وانسجام ما بين الدين والوطنية حيث لا يزعم مسلمو تلك البلدان بأنهم امتداد لأي جماعة سياسية دينية خارجية،والتجربة تتكرر في المغرب بشكل متميز وواعد.
لقد أدركت فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن خطورة المأزق الناتج عن كونها فروع لجماعة أممية ترفع شعار الخلافة وأيديولوجية سياسية شمولية عن الإسلام متجاهلة الحالة الوطنية كثقافة وهوية وروابط يؤسسها العيش المشترك في كيان سياسي متمايز عن غيره ،من جانب ،والحاجة للانخراط في الحياة السياسية الوطنية المحكومة بدستور وقوانين والمؤسسة على مفهوم المواطنة من جانب آخر.ومن هنا قررت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تشكيل جبهة العمل الإسلامي كحزب وطني وعلى أساسه دخلت الانتخابات التشريعية وأصبح لها حضور في المؤسسة التشريعية والنظام السياسي، مما أبعد عنها نسبيا تهمة الارتباط الخارجي،نفس الأمر يجري اليوم مع جماعة الإخوان في مصر حيث تم تأسيس حزب الحرية والتنمية حيث شارك جماعة الإخوان من خلاله بالانتخابات التي فازت بها بأغلبية المقاعد.
لقد جاءت الثورات العربية في بداياتها كثورات وطنية بدون أية شعارات أيديولوجية و أرسلت رسائل واضحة وإن كانت ضمنية لحركة حماس بأن العالم يتغير والجماهير العربية تتغير ،وان جماعات الإخوان المسلمين باتت منشغلة بقضايا الوطن في كل بلد أكثر من انشغالها بالقضايا الكلية للأيديولوجية الدينية للجماعة،بل يمكن القول بأن توجه جماعة الإخوان في مصر للدخول في المعترك السياسي المصري في المرحلة القادمة بما يتطلبه ذلك من الانكفاء الداخلي،كان وراء توجه حركة حماس نحو المصالحة والتخفيف من خطابها السياسي وهو ما لاحظناه في خطاب السيد خالد مشعل في مؤتمر المصالحة الفلسطينية في القاهرة منذ شهرين تقريبا.
قبل أشهر كتب الدكتور احمد يوسف مقالا بعنوان حماس بين النموذج الطالباني ونموذج أردوغان وكان واضحا إعجابه بالنموذج التركي ولكنه تجنب التطرق لسبب نجاح النموذج التركي للإسلام المعتدل وهو في رأينا يعود لتوطين أو قومنة الإسلام .كما أن بعض قيادات حركة حماس باتت تتحدث وإن بتردد عن المشروع الوطني بل بعضهم قال بان حركة حماس حركة وطنية فلسطينية ،فهل ستُقدم حركة حماس على الخطوة الأخيرة لتنحاز للوطن وللمشروع الوطني وتتوقف عن استفزاز الشعور الوطني بالقول بأنها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين.
لا يعني هذا أننا نطالب حركة حماس بالتخلي عن بعدها الإسلامي أو قطع صلتها بجماعة الإخوان ،فهذا شانها وشان المنخرطين فيها،ويمكنها أن تستمر بهذه الوضعية ما دامت خارج السلطة والقيادة،ولكن أن تقول أو تتطلع لقيادة الشعب الفلسطيني وفي نفس الوقت تقول بأنها امتداد لجماعة خارجية فهذا ما لا يقبله الشعب الفلسطيني لأننا لا نقبل أن يقودنا تنظيم خارجي،ولا نقبل أن يرتبط مصيرنا ومصير قضيتنا الوطنية بمصير حزب قيادته غير فلسطينية.
من حق الشعوب العربية أن تثور على أنظمة لم تكن فقط حملا ثقيلا على شعوبها وسببا في فقرها وبؤسها وكبت حرياتها بل كانت أيضا سببا في ضياع فلسطين ومحاصرة حركة التحرر الفلسطينية وفي التواطؤ مع إسرائيل وواشنطن على المصلحة الفلسطينية،أن تصبح الشعوب العربية المؤيدة والمتعاطفة مع عدالة القضية الفلسطينية سيدة نفسها وصاحبة القرار فهذا إضافة لقوة الشعب الفلسطيني في فلسطين وإعادة تفعيل وتنشيط الشعب الفلسطيني في الدول العربية حيث يعيش فيها حوالي نصف الشعب الفلسطيني حيث كانوا ممنوعين من التعبير عن فلسطينيتهم ومن ممارسة حقوقهم السياسية بحرية،الثورات العربية بعد اكتمال كل حلقاتها وتمكين الشعوب العربية من السلطة والحكم ستعيد الاعتبار لمفهوم البعد القومي للقضية الفلسطينية حيث سيؤسس على أرضية ممارسة واقعية شعبية وليس على خطاب للأنظمة والنخب يوظف كأداة للتدخل في الشأن الفلسطيني ومصادرة قراره المستقل.
المتغيرات التي يشهدها العالم العربي وحتى في حالة صيرورتها متغيرات تتجاوب مع التطلعات المشروعة للشعوب بالديمقراطية ،فإنها على المدى القريب ستشغل الشعوب العربية بمشاكلها وهمومها الداخلية لحين من الوقت ،الأمر الذي قد تستغله إسرائيل لتصعيد عدوانها على قطاع غزة و لتسريع سياسة الاستيطان والتهويد ما دام العرب والعالم منشغلين بما يجري داخل بلدانهم.
إن كانت المحصلة النهائية للمد الثوري العربي سيؤثر على القضية الفلسطينية إلا أن التأثير سيختلف من دولة إلى أخرى بل لا نستبعد أن تكون نتائج ثورة ما سلبية بالنسبة للقضية الفلسطينية ،وفي جميع الحالات فالأمر يرتبط بالقوى الثورية أو التي ستستلم مقاليد السلطة بعد الثورة ،أيضا بدرجة التدخل الخارجي في مجريات الثورة ،فالغرب وخصوصا واشنطن يتدخل في الثورة الليبية والسورية وإيران تتدخل في الثورة البحرينية .
مثلا الرغم من أهمية الثورة التونسية وما بلغته من دروس إلا أن تداعياتها على السياسات الخارجية لدول المنطقة وعلى الصراع العربي الإسرائيلي بقى محدودا ،ليس فقط لأن الثورة التونسية ثورة إصلاحية وطنية بل أيضا لأن الجغرافيا السياسية ودور تونس في سياسات الشرق الأوسط والعالم يبقى محدودا . ومن هنا نلاحظ كيف رحبت واشنطن وأوروبا والعالم بثورة الشعب التونسي ولم تجر أي محاولات للتأثير في مجريات الثورة ،أما في مصر فالعالم ينظر لما يجري ويتعامل معه بشكل مختلف والوضع لم يستقر بعد في مصر وقد تحدث مفاجئات تخرج الثورة عما كان يريده الشباب.
إذا بقينا في الحالتين التونسية والمصرية ،فإن أي تغيير جذري في النظام السياسي في مصر ستكون له انعكاسات إقليمية ودولية وسيعيد خلط الأوراق وخصوصا في ملف الصراع في الشرق الأوسط وبالتالي فإن الحسابات السياسية والإستراتيجية المرتبطة بالمصالح لها الأولوية على حسابات الديمقراطية وحقوق الإنسان ،أما في تونسفالغرب يتعامل مع الثورة فيها كقضية ديمقراطية وحقوق إنسان بالدرجة الأولى دون تجاهل وجود حسابات إستراتيجية على المدى البعيد.
إن كانت الثورة في تونس ومصر موجهة ضد أنظمة حليفة لواشنطن وغير معادية لإسرائيل وتندرج في إطار ما يسمى بمعسكر الاعتدال ،مما يرفع من سقف توقعات القوى المعارضة للغرب، فإن الثورة امتدت لأنظمة من معسكر الممانعة أو قريبة منه كسوريا وليبيا وهذا يدفع للتساؤل عن طبيعة القوى التي ستستلم مقاليد الأمور في حالة انهيار هذه الأنظمة وما طبيعة علاقتها بالغرب وإسرائيل وقد رأينا كيف باتت الثورة الليبية تحت رعاية وحماية حلف الأطلسي والأمم المتحدة.
هناك ملاحظة مهمة في الثورات المصرية والتونسية والليبية والسورية وهي أن المتظاهرين كانوا يرفعوا شعارات ويرددوا هتافات تعبر عن مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية محددة وكلها لها طابع وطني بعيدا عن أية أيديولوجية،فلم يتم رفع شعارات معادية لواشنطن أو للغرب ولا حتى لإسرائيل ،لم تحرق أعلام أمريكية أو إسرائيلية ،لم يتم ترديد شعارات كبرى كالمطالبة بتحرير فلسطين أو قطع العلاقات مع إسرائيل الخ.بصيغة أخرى كانت مطالب وطنية تندرج في إطار الإصلاح الديمقراطي .
بسبب وعي قادة المحتجين وبسبب قوة التدخل الذي تقوم به واشنطن والغرب في التأثير على مجريات الأحداث فإن القيادة القادمة ستكون في المرحلة القريبة ذات توجهات إصلاحية داخلية ولن تفتح الملفات الكبرى كاتفاقية كامب ديفد والالتزام بالسلام مع إسرائيل وخصوصية علاقة مصر بواشنطن والغرب ،بمعنى أنه سيتغير رأس النظام ولن يتغير النظام في بنيته الأساسية ومن حيث سياساته الدولية. الجيش الذي تولى السلطة سيكون أكثر حرصا على التمسك بعلاقة مصر مع إسرائيل وبالعلاقة مع الغرب على المدى القريب على اقل تقدير ،وحتى الشخصيات المرشحة للرئاسية مثل عمرو موسى ومحمد البرادعي سيكونان أكثر حرصا من الرئيس مبارك على الحفاظ على اتفاقية كامب ديفيد وعلى علاقة مصر مع واشنطن والغرب .وحتى مع تشكيل حكومة وحدة وطنية بأغلبية من جماعة الإخوان المسلمين ،فلن تتغير السياسة الخارجية كثيرا وخصوصا من جهة العلاقة بإسرائيل وبواشنطن وقد سمعنا زعيم جماعة النور وهي جماعة إسلامية جاءت في المرتبة الثانية في الانتخابات المصرية يقول لإذاعة إسرائيلية أن جماعته لن تلغي اتفاقية كامب ديفيد .ولكن الخوف يأتي من عدم التوصل لتفاهم ما بين الثوار والجيش وبالتالي حدوث حالة فتنة وفوضى ستؤدي لأعمال عنف وظهور جماعات عنف سرية وستدخل مصر في وضع خطير جدا ،وآنذاك ستكون فرصة لإسرائيل وقوى أخرى لتأجيج الفتنة وإطالة عمرها.
من حيث المبدأ فإن كل ما فيه مصلحة الشعوب العربية والإسلامية سيكون فيه مصلحة للفلسطينيين ،وبالتالي فإن الثورات العربية التي تعبر عن إرادة غالبية الشعوب العربية بالتغيير ستخدم القضية الفلسطينية إن لم يكن عاجلا فآجلا.وتاريخ القضية الفلسطينية على مدار قرن تقريبا يؤكد التداخل ما بين القضية الفلسطينية ومحيطها العربي والإسلامي بل إنها القضية العربية الوحيدة التي يشكل البعد القومي مكونا رئيسا مما جعل استقلالية القرار الوطني الفلسطيني يواجه تحديات غير موجودة بالنسبة للشعوب والنظم السياسية الأخرى ،وهي القضية الوحيدة التي يتم فيها الحديث عن البعد القومي للقضية الفلسطينية والبعد الإسلامي للقضية الفلسطيني حتى وإن كان الحديث نظريا فقط.
ما سنتحدث عنه هو تداعيات المرحلة الانتقالية للثورات العربية على القضية الفلسطينية،حيث نلمس تداعيات سلبية تستوجب من القيادة الفلسطينية التعامل معها بحذر لحين استقرار حال الثورات العربية ،ونقصد بالتعامل الحذر عدم تمكين هذه التداعيات السلبية من التأثير على الخيارات الإستراتيجية للشعب الفلسطيني ،فهذه الخيارات يجب أن تبنى على استقلالية القرار من جانب وعلى التحولات الإستراتيجية التي ستتمخض عنها الثورات بعد استقرار الأمور.إن اخطر ما يصيب شعبا من الشعوب وخصوصا إن كان الشعب يمر بمرحلة تحرر وطني هو بناء خيارات إستراتيجية تحت ضغط متغيرات مرحلية.
يمكن رصد أهم التداعيات السلبية الآنية للحالة العربية غير المستقرة بفعل الثورات على القضية الفلسطينية بما يلي:-
1- انشغال الشعوب العربية بمشاكلها الداخلية :السياسية والاقتصادية والاجتماعية .فدون تقليل من تعاطف الجماهير العربية تجاه الفلسطينيين ورغبة الثوار بفتح صفحة جديدة مع الفلسطينيين يتم فيها تجاوز أخطاء النظم السابقة،إلا أن الشعوب العربية الثائرة ستنشغل بهمومها الداخلية وخصوصا في ثورات تؤشر إلى تحولها لحرب أهلية كما يجري في ليبيا واليمن وسوريا والبحرين،وفي هذه المرحلة من عدم الاستقرار قد تلجأ الجماعات الثائرة لنسج علاقات مع الغرب ومع واشنطن لمواجهة النظام القائم كما هو الأمر في ليبيا بل قد تلجا النظم السياسية نفسها لكسب ود واشنطن لمواجهة الثوار وللحفاظ على وجودها ،وواشنطن لن تتورع عن ابتزاز الطرفين سياسيا.
2- الثورات العربية وما أدت من حالة عدم استقرار ومستقبل مفتوح على كل الاحتمال أوجد قناعة لدى واشنطن بأنه لا يمكنها المراهنة على أي نظام عربي أو شرق أوسطي كحليف استراتيجي ،وان الحليف الوحيد المضمون هو إسرائيل ،وهذه رسالة بلغها نتنياهو لواشنطن وكانت وراء تراجع اوباما عن وعوده وكانت وراء الترحاب الكبير لخطاب نتنياهو في الكونجرس الأمريكي،فالأمريكيون اقتنعوا بان لا حليف استراتيجي لهم في المنطقة إلا إسرائيل ،فقد خسرت واشنطن إيران مع ثورة الخميني ثم خسرت تركيا كحليف استراتيجي تابع بوصول حزب العدالة والتنمية للسلطة واليوم تخسر مصر وتونس ولا تعرف مصير حلفائها العرب .هذه المتغيرات ستؤدي لمزيد من التأييد الأمريكي للسياسة الإسرائيلية .
3- الثورات العربية حتى اللحظة أضعفت حركة فتح والسلطة بانهيار معسكر الاعتدال مع سقوط مبارك،كما أن الوضع في سوريا وتوجه الإخوان المسلمين في مصر للمشاركة في النظام السياسي وإعطاء هذا الأمر الأولوية على أي انشغالات خارجية ،أضعف مؤقتا حركة حماس.وبالتالي نخشى أن المصالحة التي جرت لم تبنى على قناعات راسخة بالمصالحة الإستراتيجية التي تعني إعادة بناء النظام السياسي والمشروع الوطني على ثوابت محل توافق وطني بقدر ما كانت محاولة من الطرفين – فتح وحماس – للحفاظ على الذات ومواجهة رياح المتغيرات الإقليمية.
4- كان للبعد القومي لفلسطين مضمونا معاديا للغرب وخصوصا لواشنطن،أما جماعات الإسلام السياسي المهيمن على المشهد السياسي العربي فلا تخفي مهادنتها للغرب بل والحفاظ على العلاقات الخارجية بما فيها مع إسرائيل.هذا التحالف مع الغرب والذي كان جليا في ليبيا سيقيد من توجهات الأنظمة العربية (الثورية) نحو الصدام مع إسرائيل ،مما يجعل الفلسطينيين وحدهم في مواجهة إسرائيل.
5- عدم استقرار الأوضاع في مصر وبزوغ نزعات طائفية قد يؤدي لحالة عدم استقرار في مصر وخصوصا في منطقة شمال سيناء ،الامر الذي قد يدفع إسرائيل لإتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية على حدودها الجنوبية وقد تستغل حالة الفوضى الأمنية والزعم بأن أمنها مهدد لإعادة النظر في علاقتها بقطاع غزة وقد يصل الأمر لحرب جديدة عليه أو المطالبة بتواجد قوات دولية على حدوده.
6- انتقال الثورة لسوريا سيؤدي لنتائج سيواستراتيجية خطيرة على القضية الفلسطينية.فحركة حماس بدأت بتخفيف تواجدها هناك والانتقال لمصر أو قطر ومن المعروف أن التواجد في أي من هاتين الدولتين سيكون له ثمن سياسي فلا يمكن لحماس آنذاك أن تتحدث عن المقاومة المسلحة أو ممارستها إنطلاقا من هاتين الدولتين.
أيضا سيؤثر سقوط نظام على الوضع في لبنان وخصوصا على حزب الله وسؤثر أيضا على الأردن وإيران والعراق.كل ذلك سينهي ما يسمى معسكر الممانعة.
7- استنهاض الحالة الثورية في فلسطين
نتيجة وحدة الثقافة والأنتماء المشترك والثورة المعلوماتية تأثر شباب فلسطين بما يجري في العالم العربي وخصوصا في مصر الجار القريب،ولذا حاولوا أن يقوموا بحراك شباب في مارس 2011 لم يكتب له النجاح إلا نسبيا. شباب فلسطين لهم تجارب ثورية رائدة وخصوصا انتفاضتي 1987 والأقصى 2000 ،وبالتالي عندما قرروا القيام بحراك أو ثورة كانوا معتمدين على تاريخ ثوري وتجارب سابقة مع إضافة مستجد لم يكن موجودا وهو شبكات التواصل الاجتماعي والتلفون المحمول كادوات سهلت عليهم التواصل والإعلان عن ثورتهم بعيدا عن اعين اجهزة الأمن.
لم تكن السؤال عند شباب فلسطين فقط هل يقوموا بثورة أم لا ؟بل ضد من يقوموا بثورتهم ؟ الشباب في العالم العربي قاموا بثورة ضد أنظمة فاسدة وغير ديمقراطية وكان مطلبهم إسقاط هذه الانظمة،وتجربة شباب فلسطين كانت ثورة ضد الاحتلال الصهيوني،اما اليوم فمناطق السلطة تخضع للاحتلال وفي نفس الوقت منقسمة لسلطتين وحكومتين فلسطينيتين باتتا عائقا اما الشعب ومواجهة الاحتلال.وعليه كان قرار شباب فلسطيني الثورة ضد الانقسام.
8- هناك تخوفات أن تؤدي الثورات العربية ووصول الإسلاميين للحكم إلى عودة المشروع الوطني لنقطة الصفر من خلال عودة المراهنة على الخارج لإنجاز الحقوق الفلسطينية.فقد ناضل الفلسطينيون طويلا لتحرير القضية من الوصاية العربية التي كانت تعمل تحت عنوان قومية القضية وانتزع الفلسطينيون استقلالية قرارهم الوطني ،واليوم يتم عودة القضية مجددا ولكن لبعد إسلامي غير واضح المعالم ،ويتم الانتقال من (الوحدة العربية الطريق لتحرير فلسطين) إلى (الوحدة الإسلامية الطريق لتحرير فلسطين) أو (الإسلام هو الحل) .
خلاصة
الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية تشكل منعطفا استراتيجيا وخطيرا ستترتب عنه متغيرات داخلية في البلدان العربية سواء التي تمر بحالة ثورة أو غيرها ،ولكنها متغيرات ستقلب معادلة الصراع في المنطقة والذي كان يسمى الصراع العربي الإسرائيلي ،أنظمة الثورات الراهنة ستنشغل لحين من الوقت بهمومها الداخلية وستكون أحوج ما تكون لمهادنة الغرب وخصوصا واشنطن وبالتالي لن تدخل بمواجهات مع إسرائيل ،وهذا يتطلب من القيادة الفلسطينية الحذر في إدارتها للأزمة لأن المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية مرحلة إدارة الصراع أو الأزمة حيث الظروف الوطنية والإقليمية والدولية غير ناضجة لحل تاريخي ،ونأمل من القيادة الفلسطينية حسن إدارة الأزمة في هذه المرحلة بإنجاز ما يمكن انجازه من صفقة المصالحة حتى تمر العاصفة ونصبح أمام عالم عربي جديد يمكن المراهنة عليه كحليف استراتيجي حقيقي في معركتنا الطويلة مع الاحتلال.